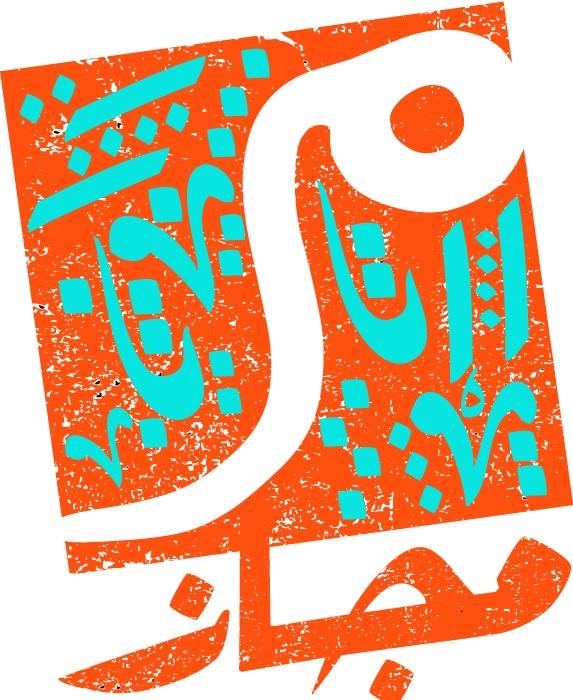 حياكة الكلام
حياكة الكلام
استند يوسف على سيارته وقال معترفاً لنفسه: "أنا نظيف تماماً، لا أذكر إلا صفعة الوجه، لأنها تشبه المنبه. توقظك من خطأك كما يعتقد. حقاً رضوان لم يترك أي علامة على جسدي، لكنه ترك جروحاً في نفسي لا تلئتم...
صحيح أنها لم تكن إلا مجرد كلمات ،لكنها كانت وصاياه التي رددها على أذني، ورغم عدم إيماني بها، اتبعتها يا وفاء... إلى الحد الذي جعلني لا أحيا، وأين هو الآن؟! قد أتم عامه الثمانين بذاكرة فارغة، نسى كل شيء، وأنا على مشارف الأربعين أذكر أدق التفاصيل... وما تقتلني إلا الذكريات".
الوصية الأولى: لا تخف
"شعرتُ بالخوف من النوم وحدي..."، قالها يوسف وهو يقف أمام رضوان مرتبكاً، فبعدما أتم عامه العاشر، ماتت أمه تاركة إياه مع أخيه طارق، في فيلا ضخمة واسعة تليق بالحياة مع أبيهما، ولأنه كان طفلاً مفعماً بالمشاعر، عانى طويلاً بعد رحيلها، فكان يصحو من نومه مفزوعاً، باحثاً عن حضن آمن، فهرب إلى غرفة المربية لينام تحت سريرها.
ظل هكذا لعدة أيام، حتى اكتشف أمره، فنظر له رضوان باشمئزاز. يلومه على الخوف كما يلومه على وزنه الزائد، ملامحه الشقراء، شعره الكستنائي وعينه الصغيرة الثاقبة، فقد كان يشبه جده بالضبط، وهذا ما لا يعجب رضوان، الذي أخذ يطرقع أصابع يده الواحد تلو الآخر، ذلك الصوت الذي أرتبط في ذهن يوسف بقرار سيتخذه والده دون مجال للاعتراض.
وبالفعل، مع نهاية اليوم، أعلن رضوان عن قراره: "من يجرؤ منكما على فتح باب غرفته سوف يحبس في السندرة!". وبالطبع لن يجرؤ أحد، فضمّ يوسف جسده مرتجفاً بجانب الباب المغلق وأخذ يبكي وحيداً، لا تؤنسه إلا دقات يد طارق على الحائط من الغرفة المجاورة. كانا يساندان بعضهما آملين أن ينجلي ذلك الليل
لكن ذلك لم يفلح، فاستيقظ يوسف ليجد أنه قد تبوّل أثناء نومه، وحينما تكرر الأمر، نهره رضوان قائلاً: "ما من رجل يتبول على نفسه، حتى أخيك الأصغر لا يفعلها! كيف تقبل أن تكون رائحتك نتنة بهذا الشكل؟ تحكم بنفسك!". قالها بطريقة قاطعة، وكان طارق يستمع له، دائماً يتأمل الصورة من بعيد، كأنه يقرأه، يدوّن إيماءاته ونظراته، يحفظه جيداً، فرغم جسده النحيل كان ذو شخصية كتومة، يخفي الكثير في أعماقه، ولهذا حينما أتى الليل، وسمع صوت أخيه يبكي في الحمام، تقدم إليه ثم قال بإصرار: "لن نخبر أحداً"، وغسلا الملاءات سوياً. كان هذا سرهما لوقت طويل، حتى توقف يوسف عن التبول أثناء نومه، دون أن يعرف كيف فعلها، ربما لأن رضوان نجح في إقناعه أنه وحده، ليس هناك أملاً في أي مساعدة، حتى من أبيه.
حينما تكرر الأمر، نهره رضوان قائلاً: "ما من رجل يتبول على نفسه، حتى أخيك الأصغر لا يفعلها! كيف تقبل أن تكون رائحتك نتنة بهذا الشكل؟ تحكم بنفسك!"... مجاز
الوصية الثانية: لا تخطئ
"جسدك مترهل. يجب أن تفقد بعضاً من وزنك". قرر رضوان، ووضع له نظاماً قاسياً، فكان يوسف يُجلب الحلويات من ورائه ويأكلها على السطح مختبئاً، فماذا يفعل حينما يكتشف الأمر؟ يحمله ويحكم قبضته عليه ثم يحبسه في السندرة، غير عابئ بصراخه. أخذ يوسف يركل الباب عدة مرات، متوسلاً له أن يحبسه في غرفته، لكنه لم يتلق أي رد. تجاهل تام. فاستسلم لنحيب طويل، واستمر هكذا ليومين، لا يحصل إلا على طعام بسيط، حتى سمح رضوان بخروجه من حجزه وخاصة في موعد الغداء، ليجد أطباقاً شهية قد وضعت أمامهم، أما طبقه فلا يحمل إلا طعاماً قاسياً، كان عليه أن ينتهي منه، لكن يوسف لم يشعر إلا بطعم مرارة الألم الذي ينخر في نفسه، ثم أطبق الصمت عليهم، ولم يعد هناك إلا صوت المعالق والمضغ والفراغ الكامن بينهما. ذلك صوت الصمت، كما يقول يوسف: "كنا نسمع أدق الأصوات في البيت، إلا صوت أنفسنا".
الوصية الثالثة: لا تبك
"ليس هناك مكان لقطط الشارع في بيتنا. أتعدني يا يوسف بذلك؟". هز رأسه موافقاً، لكنه أحب تلك القطة، فكان يُدخلها من الباب الخلفي ويُطعمها، حتى جاءت في مرة متعبة، فتركها في البيت حتى صباح اليوم التالي، ليصحو الجميع ويجدونها ميتة.
الوصايا السبع لأبي: لا تخف. لا تخطئ. لا تبك. لا تكن ضعيفاً أبداً. لا تحب. لا تحلم. كن مثالياً
انهار يوسف وعلا صوت بكائه، فصفعه رضوان على وجهه قائلاً: "ألم تعدني بألا تدخلها المنزل! إياك أن تكذب مرة أخرى. ثم لماذا تبكي؟ إنها مجرد قطة، توقف عن هذا الضعف!". فتوقف يوسف. في الحقيقة لقد توقف عن كل شيء، عكس طارق، الذي حينما تلقى تلك الصفعة، وفي المدرسة أمام الجميع، فهم اللعبة، فأصبح من يومها يُرضيه، يُسمعه ما يريده فقط، يتوسل له أن يسامحه على أخطائه، يدعي أمامه بأنه ملتزم ولن ينحرف أبداً، حتى آمن رضوان بأن طارق تحت سيطرته، وتلك غايته.
الوصية الرابعة: لا تكن ضعيفاً أبداً
كل أفعال رضوان كان مصدرها هوسه بالسيطرة، بالضبط كأمه. اعتاد يوسف وطارق أن يتأملا بروازها الضخم المعلق في بهو المنزل: امرأة ارستقراطية، جامدة الملامح، أو "مأمورة السجن" كما سموها، ورغم أنها ماتت ولم يروها، شعرا دوماً بأنها موجودة، ربما لأن رضوان يحكي عنها كثيراً، امرأة "حديدية" على عكس والده، ضعيف يُستهان به. لكن يوسف تدرب عبر سنوات عمره على أن يفهم رضوان جيداً، فأدرك أن جده كان ذا قلب رقيق، أما جدته فلعبت دور الإله في حياة رضوان، قضى حياته في محاولة إبهارها، بالتزامه ونجاحه ومثاليته، منتظراً أن تمنحه بعضاً من الحب والاهتمام، أي مديح من أمه يُشعره بأن له وجود. لكنها لم تفعل. ليس لأنها شريرة، ولكنها تؤمن ببساطة أن تلك الأفعال "دلع فارغ" لا تبني الرجال.
انهار يوسف وعلا صوت بكائه، فصفعه رضوان على وجهه قائلاً: "ألم تعدني بألا تدخلها المنزل! إياك أن تكذب مرة أخرى. ثم لماذا تبكي؟ إنها مجرد قطة، توقف عن هذا الضعف!"... مجاز
ولهذا السبب، كان رضوان يملك جسداً كخرسانة متماسكة لا تهتز، فلم يدخن أو يشرب الكحوليات أو ينحرف ولو نصف درجة عن طريق رُسم له منذ صغره، بل صار ملتزماً حقاً، ويصلي كل الفروض في مواعيدها، لكن بوجه متجهم وكأن الضحك ممنوع، فهو "رجل صلب" كما اعتاد أن يلقب نفسه، ولأنه مهندس ناجح يعامل الأبنيه بالورقة والقلم وبدقة متناهية، قرر أن يعامل أبناءه وزوجته بنفس المعاملة، فقد كان قلبه حجراً لا يلين.
الوصية الخامسة: لا تحب
"ما الذي تفعله!؟ تبني حياتك على مشاعر تافهة كالحب! إنه يجعل منك رجلاً ضعيفاً. ثم لم تفكر بصورتنا ،فتختار فتاة من مدرسة حكومية دون المستوى! هل أنت غبي؟! وفى النهاية ضربوك ولم تستطع الدفاع عن نفسك. لم تصبح حتى رجلاً بما يكفي". قالها رضوان موبخاً يوسف وهو نائم على السرير، معلقاً ساقه في الجبس، فبعدما أتم السادسة عشر، تقابل مع فتاة بسيطة، مبهجة، لكنه تعارك مع بعض الشباب من أجلها، وحينما زارته للاطمئنان عليه ،طردها رضوان، ولأنه كان كالسجين يبحث عن منفذ للهواء، والحب فرصة لا تعوض، فلم يعر رضوان اهتماماً، وذهب لملاقاة الفتاة عند مدرستها ليعتذر منها، لكن كعادة المراهقين تتبدل المشاعر بين ليلة وضحاها، فتركا بعضهما وانتهت قصة تمرد يوسف. بحث عنه رضوان في كل الأماكن، وبعد يوم واحد من الاختفاء، عاد إلى البيت بوجه حزين. حاوطه الصمت، وتعلم كيف ينفث مشاعره مع دخان السجائر التي يبتاعها في الخفاء، ذلك انتصاره الوحيد الذي لم يستطع رضوان أن يمنعه منه.
الوصية السادسة: لا تحلم
من هو صاحب القرار في البيت؟
رضوان بالطبع، ولهذا لم يفرق معه أن يبوح له يوسف بما يحلم به: أن يدرس الرسم. صحيح أنه رسام موهوب منذ صغره، لكنه لم يعر موهبته اهتماماً، فبما أنه الكبير سوف يصبح مهندساً ويكمل مسيرته بعده، لكن يوسف صمم على اختياره، وحينها عرف رضوان بأمر السجائر، وكم كان قلقاً من أجل ابنه، ولم يهدأ حتى أخبره ذلك بطريقته، فتسربت رائحة الحريق حتى ملأت المنزل. خرج يوسف مسرعاً ليجد بعضاً من رسوماته تحرق في الحديقة. خُلع قلبه وهرول محاولاً إطفائها، فأخبره رضوان بهدوء تام: "السجائر سوف تحرق رئتك هكذا. اهتم بصحتك". لحظتها تألم يوسف لكنه تعلم الدرس، فصار يخبئ رسوماته في غرفة السندرة، التي أصبحت ملاذه ومكانه الآمن.
صحيح أنه لم يصبح مهندساً لكنه دفن حلمه أيضاً، واكتفى بإدارة الشركة وحمل فوق كتفه العائلة والبيت وظل رضوان. على عكس طارق، الصامت الهادئ، الذي حينما أتم الواحد والعشرين عاماً، لملم أشياءه ونقوده وترك المنزل. أباح ليوسف منذ سنوات بفكرته: "علينا أن نتركه، نخرج سوياً من هنا". لكنه اعترض وقال: "هذا بيتنا! لماذا علينا أن نهرب!". ففهم أنه لن يفعلها، وعلى أحدهم أن يصمم على اختياره للنهاية، ولهذا شعُر رضوان بعجز رهيب، ولأول مرة رآه يوسف وهو يبكي. يهتز. ولم يعرف، أكان يبكي من أجل ابنه أم لأنه أكتشف أنه فشل في السيطرة؟ ولكن رضوان لا يخطئ، فهل يمكن لإله منزّه أن تنزلق قدمه في زلة بسيطة؟ بالطبع لا، بل كان على يقين أنه ابتلى بأبناء لا يقدرون النعمة، الأصغر سرقه وترك البيت، والأكبر ذو شخصية ضعيفة، تقوده المشاعر وتحكمه العاطفة، ولهذا عليه أن يروضه. ضيّق الخناق عليه خوفاً من أن يتركه هو الآخر، ومن لحظة رحيل طارق ،ارتفعت حرارة البيت، كأن هناك قدراً من الماء وضع فوق النار وأخذ يغلي ويغلي لسنوات دون أن يهتم به أحد. كان رضوان هو ذلك القدر، يغلي منتظراً أن تتبخر كل مياهه، غير عابئ بصهده الذي يخنق يوسف، وللمفارقة أن يوسف يتعرق بشدة ورضوان يده باردة. تماًما كالحي والميت. يعيشان سوياً في منزل بهتت ألوانه، كسجن يربطهما دن أمل في منفذ للهروب.
الوصية السابعة: كن مثالياً
حينما يرفض المرء نواقصه، يتحول إلى تمثال مصمت، ولكن رضوان لم يولد هكذا، فطالما تخيله يوسف في صغره كطفل تائه في حفلة مزدحمة، يبكي باحثاً عن أمه، وحينما يجدها يتوسل إليها، يجذبها من فستانها، يبكي بصوت عال ويشدها من يدها، لكنها تتجاهله تماماً. تظل تضحك مع الجميع، ثم تدفع يده بقوة دون أن تنظر إليه حتى، لحظتها شعر رضوان بـأنه غير مرئي، ولهذا أصر أن يكون موجوداً، موجوداً في كل مكان أكثر مما ينبغي.
"ما الذي تفعله!؟ تبني حياتك على مشاعر تافهة كالحب! إنه يجعل منك رجلاً ضعيفاً. ثم لم تفكر بصورتنا ،فتختار فتاة من مدرسة حكومية دون المستوى! هل أنت غبي؟! وفى النهاية ضربوك ولم تستطع الدفاع عن نفسك. لم تصبح حتى رجلاً بما يكفي"... مجاز
ولهذا السبب قرر أن يتزوج وهو في عمر الأربعين. حقاً! ذلك السؤال لم يبرح عقل يوسف، ما الدافع الذي أجبره ليُقدم على تلك الفعله؟ كان العالم سيمضي في مساره بشكل طبيعي دن الحاجة إلى نسل رضوان، فلماذا أنجبهم؟ هل أراد أن يعذب أحدهم، أم أراد أن يظل موجوداً حتى بعد رحيله؟ أو ربما كانت نيته بسيطة، أراد أن يبني عائلة وينشيء أبناء، فلم يكن رضوان رجلاً شريراً، بل كان يؤمن بكل ما يفعله، وأنه في مصلحة أبنائه، فهو لم يتركهم لحظة أو يتخلى عنهم، حاوطهم وتتبع خطاهم،كانت تربيته قائمة على أن يصبحوا رجالاً معتمدين على عقولهم وليست مشاعرهم، مثاليين كمانيكان الفاترينات، حينما تنظر إليهم لا ترى أي خطأ بهم، لكن إذا ضغطت عليهم سينكسرون بسهولة معلنين عن فراغ داخلي لا يُحتمل.
هكذا أصبح يوسف، ثم ظهرت وفاء في حياته.
امرأة مفعمة بالحياة، تعبر عن نفسها بكل جوارحها، وتُخرج مشاعرها للنور. لكنه على عكسها تماماً، فهو لم يعد يعرف إذا كان غاضباً، يائساً، حزيناً، مبتهجاً، قلقاً، مندهشاً، سعيداً، منزعجاً. كل ما يشعر به أنه محاصر، منهك، كأنه ينهج طوال الوقت ولم تكن السجائر هي السبب، بل لأنه يحاول اللحاق بشيء ما لا يعرفه. كل ما هنالك أنه قضى حياته كلها يسرع الخطى ملتفتاً خلفه. يهرول ورضوان يجري وراءه لا يتركه، كلاهما في سباق لا ينتهي، ولم تكن غايته الفوز أبداً، بل كل ما أراده هو الهروب. أن يختبئ من أبيه في مكان لا يمكنه الوصول إليه، لكنه لم يفلح.
"أنا الآن خال، فارغ تماماً، كل ما أعرفه أنني أعمل، أرسم،أصمت، أدخن، أتعرق. لا أعتقد أن بوسعي فعل شيء آخر، فالزواج مثلاً يعني أن تشارك أحدهم بما تخفيه داخلك، فكيف أشارك وفاء بعتمتي؟ تخبرني أنها تحبني لكني لم أعد أعرف كيف يحب المرء؟ بالتأكيد رضوان لم يحصل على إجابة لهذا السؤال، أو ربما لم يسأله أبداً. حينما أراه في دار المسنين، وحيداً تائهاً. أبكي، ولا أعرف لماذا، ربما لأنني خائف أن أصبح مثله. لقد عاش حياته كلها بداخل كذبة كبيرة. أن الصلابة تغني عن اللين، ولكني عندما أنظر إلى المرآة أدرك تماماً بأنني هش، لكني أضع قناعاً صُنع خصيصاً لي بيد رضوان، أبي الذي يظن أنه نجح في تنشئة رجل مثالي، وها أنا لا أشعر بأي شيء".
الاختيار
انتبه يوسف من ذكرياته، فجلس بداخل سيارته،وأخذ يقرأ رسالة وفاء: "حاولت مراراً ألا أفلت يدك يا يوسف، لكنك كنت تنزعج ،ثم تخبرني حججك المكررة، كانشغالك بالعمل والهاتف والتعرق، لكنك في حقيقة الأمر كنت تخاف القرب، قصر المسافات، التلامس مع الآخرين يكشف لك زاوية من نفسك ترفض أن تبصرها ،لكني مازلت أتشبث بك رغم الفراغ الفاصل بين أصابعنا، ذلك الفراغ الذي يملأك، يكمن بداخلك كحفرة عميقة مظلمة،اعتدت أن تغرق فيها كل يوم، كأنها مسكنك الذي يحتويك. لكن أتدري؟ لا يمكن للظلام أن يصبح مسكناً لأحدهم، حتى الأموات يتحررون يا يوسف. يمكنك الخروج، وإذا قررت أن تبحث عني، ستجدني".
ترك الرسالة و أراح رأسه على التابلوه، فكان يعلم أنه الآن حر، وكل شيء مرهون باختياره، ولكن ما أصعب أن يودع الماضي ويواجه آلامه، فيُحيي مشاعره التي دفنها بداخله منذ زمن، لكن كان يدرك أيضاً أنه واحداً من ضمن ملايين، حائر، مرعوب، مضطرب، و لن ينقذه إلا الحب.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


