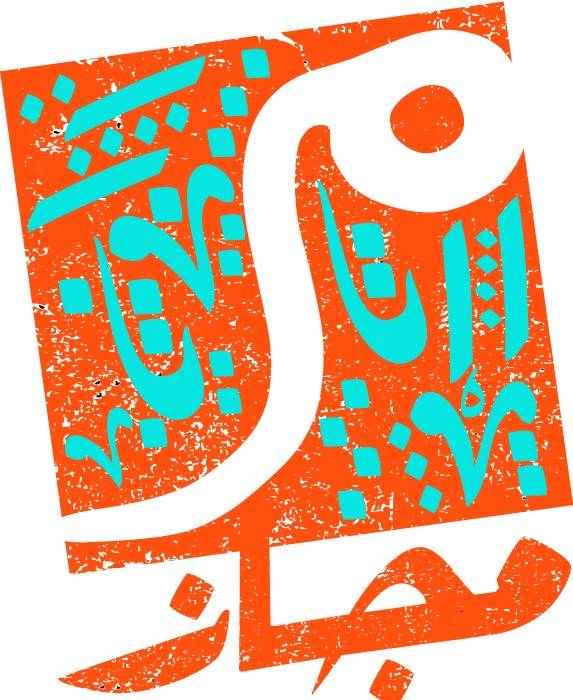 أشباح الغربة
أشباح الغربة
بالتعاون مع مسعود حيون، المحرر الضيف لشهر نيسان/أبريل
لا أدري حقيقة أيهما أقسى، غربة الروح أم غربة الأوطان؟ ربما ينتهي أمر الاغتراب بالعودة إلى أرض الوطن، أما ذلك الشعور الذي يصيبنا بغصّة ووحدة مريرة قد يصاحبنا إلى مثوانا الأخير.
سبعة منازل وخمس مدارس وثلاث مدن، هكذا عشت طفولتي مع أسرتي، نتنقل من منزل إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، وما إن ينقضي عامان حتى يجري نقلي إلى مدرسة جديدة، لأن هناك مدرسة أفضل، أو لأننا سننتقل من بيتنا أو سنغادر المدينة بأكملها، فلم أحظ بأصدقاء طيلة سنوات الطفولة حتى وصلت إلى مراهقتي، كان شعور الغربة بداخلي ينمو ويتعاظم، يصبح مطلوباً مني دوماً أن أتعرف على الأشياء والأشخاص من جديد وأن أتكيف مع الوضع الحالي وقد كنت أصغر من أن أفعلها.
ذوبان قرص الشمس
خلال سنوات طفولتي الأولى، كانت نافذة غرفة نومي وشقيقتي الثانية تطل على الهرم الأكبر، ويلاصق جدار واجهتها بيت قصير يربي أصحابه الدواجن فوق سطحه، كنت مولعة بمراقبتها ومشاهدة قرص الشمس يذوب ويختفي خلف الهرم، تاركاً وراءه حمرة تخضب السماء، وعلى الجانب الثاني من الشارع الرئيسي، كانت أول مدرسة قصدتها في حياتي، وهي الوحيدة التي كرهتها من كل قلبي بسبب معلمة الفصل.
وبينما كانت عاملة النظافة العجوز تنتظرني أمام باب شقتنا لتوصلني مع أطفال الجيران إلى المدرسة، كنت أتلكأ متعمدة وأتعلل برغبتي في الصلاة، والتي لم أكن أؤديها بشكل صحيح، أو أقضي وقتاً طويلاً في دورة المياه، في تلك المدرسة التي تبعد فقط أمتاراً قليلة، شعرت بغربة النفس، فلم أجد صديقاً، وكانت المعلمة "أمل"، التي تتشح بالسواد وتخفي وجهها خلف النقاب، تثير هلعي بسبب ضربها المبرح لزملائي، وسحلها وتعذيبها للطفل "إسلام" داخل الفصل، بسبب تأخره الدراسي وانخفاض مستوى ذكائه، فعلى ما يبدو أنه عانى من صعوبات التعلم وهي تجهل ذلك.
كنت أتلكأ متعمدة وأتعلل برغبتي في الصلاة، والتي لم أكن أؤديها بشكل صحيح، أو أقضي وقتاً طويلاً في دورة المياه... مجاز أشباح الغربة
كان الدم يسيل من شفتيه، أطبقت المعلمة على قارورة الماء خاصتي ومنحتها له ليشرب ويغسل جرحه، شعرت وقتها بالألم ورغبت في الصراخ، لكني ابتلعت لساني كيلا ألقى مصيره.
لا أعرف لماذا أخفيت الأمر وقتها عن والديَّ، خصوصاً أنها كانت مدرسة خاصة، ومن الغريب أن يحدث ذلك للتلاميذ. أغلب الظن أنني كنت طفلة في السادسة من العمر، خائفة ووحيدة، بجسد ضعيف يمرض بشكل أسبوعي، ولا أقدر على الركض والمشاركة في الأنشطة الرياضية، حتى فاض الكيل حين غرست المعلمة أصابعها في وجهي لتقرصني، ثم تدفعني بعيداً لأتعثر بإحدى الحقائب المدرسية، لأنني كثيراً ما أتغيب عن المدرسة بسبب المرض.
شعرت بالإحراج والظلم الشديد، وعدت إلى البيت حزينة لا أتكلم، بينما تحاول أمي بقلق شديد اكتشاف ما جرى لي، وبعد أسئلة كثيرة قالت لي: "وشك أحمر ليه؟ هي مس أمل ضربتك بالقلم؟"، هززت رأسي بالإيجاب، لأني لم أكن قادرة على الشرح والبوح لها بإهانتها لي أمام زملائي وقصص تعذيبها لهم.
إذلال المعلمة القاسية
ثار غضب أمي وقصدت مكتب مديرة المدرسة للشكوى، بينما المعلمة مصرة على الإنكار وتؤكد أنها لم تصفعني، وحين قابل أبي مالك المدرسة، أخبره الأخير أن مس أمل نفسها قامت بعضّ تلميذة في العالم الماضي، وغضب والدها وأراد القصاص لابنته بعضّ المعلمة!
بعد يومين زارتنا المعلمة في بيتنا محملة بأكياس الشيبسي والحلوى، في محاولة لجعلي أتصالح معها وسحب الشكوى التي ستطرد بسببها من المدرسة، لكني رفضت بقوة لا تناسب طفلة في السادسة، كنت مستمتعة بإذلالها وكأني أقتصّ للطفل الذي عذبته، بعد تلك الواقعة فُصلت المعلمة.
في نهاية العام الدراسي نقلني أبواي وشقيقتي إلى مدرسة خاصة سمعتها التعليمية أفضل، عرفت فيما بعد أنها كانت مملوكة لقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لذا كانوا يفرضون ضوابط إسلامية ويفصلون البنات عن الصبية منذ الروضة، لكني وجدت شيئاً من الراحة في تلك المدرسة، مع معلمات اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية اللواتي أحببنني وأحببتهن وعوضنني عن عجزي عن تكوين صداقات، فقد كان شعور الغربة ينتابني وسط الأطفال في مثل عمري، ويراودني شعور بأنني أكبرهم سناً ولا أنجذب لألعابهم الطفولية وأحاديثهم التافهة، فإما أن أقضي وقت فراغي بالمكتبة المدرسية أو برفقة إحدى معلماتي الأثيرات.
لكن الأمور لم تبق على حالها أكثر من عامين، حتى فاجأني قرار أبي بأننا سنرحل من بيتنا ونترك مدارسنا، لأننا سننتقل للعيش في حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.
الوقوع في غرام البحر
كانت شقتنا الجديدة شاسعة المساحة، لها شرفات تطل على شاطئ البحر برماله ناصعة البياض وأمواجه الصاخبة، وفيلات لها حدائق جميلة تغمرها الورود وبعض أشجارها مثمرة، وبها أحواض سباحة تكسوها الأتربة والطحالب الخضراء لا يجري تنظيفها إلا في الصيف حين يأتي أصحابها كل عام، أصوات طيور النورس تختلط بهدير الموج وزقزقة العصافير، وأحياناً يشقها صوت كلب ينبح أو صقر يبحث عن فريسة. نغرق في حرم الصمت المقدس، بينما يبعد أقرب جيران لنا عنا بشارع كامل، ولا يعيش حولنا صيفاً شتاء سوى عدد قليل من الغفر الذين يحرسون البيوت والأراضي ويعيشون بها مع أسرهم، وبعض صيادي السمك.
ثار غضب أمي وقصدت مكتب مديرة المدرسة للشكوى، بينما المعلمة مصرة على الإنكار وتؤكد أنها لم تصفعني، وحين قابل أبي مالك المدرسة، أخبره الأخير أن مس أمل نفسها قامت بعضّ تلميذة في العالم الماضي، وغضب والدها وأراد القصاص لابنته بعضّ المعلمة!... مجاز الأشباح
وقعت في غرام البيت الجديد والبحر والطبيعة، وللمرة الأولى شعرت بأنني أنتمي لهذا المكان ولم أعد أحس بالغربة، تصالحت مع نفسي وبدأت محاولاتي الأولى للكتابة. عدد من قصص الأطفال ومسودات لا تنتهي لمشاريع روايات لم أكتب منها غير بضع صفحات، وعرفت وقتها أنني أريد أن أصبح كاتبة.
الرسوب في الاختبار
حين بدأ العام الدراسي شعرت بالغربة من جديد داخل المدرسة، كان الجميع ينظرون إلى كغريبة قادمة من مصر، كما يطلقون على أهل العاصمة، وكنت أستغرب كثيراً من كلمات زملائي ولا أفهمها بحكم اختلاف اللهجة المحلية. يطلقون على العلكة "مستيكا" والممحاة "جوما" والنقانق "سدق" وعلى الشاي "شي" والأكياس "كيسة"، ويتحدثون دوماً بصيغة الجمع بدلاً من المفرد، قائلين: "نروحوا، نيجوا..."، وكان الأمر أسوأ مع بعض التلاميذ القلائل الذين ينتمون إلى قبائل من عرب الساحل ويتحدثون بلهجات تخصهم.
رغم جمال مدرستي الجديدة وقلة كثافة الطلاب في فصولها مقارنة مع المدرستين السابقتين واجهت صعوبة في التكيف، تعرّضت لبعض التنمر وأصبحت عدائية وتراجع مستواي الدراسي بعدما كنت من المتفوقين، فرسبت في الاختبار الشهري لمادة الدراسات الاجتماعية المفضلة لدي، للمرة الأولى والوحيدة خلال سنوات المدرسة، افتقدت "أبلة سميرة" معلمة الدراسات التي كانت تدعو الله أن يرزقها بطفلة مثلي، افتقدت طريقتها المحببة في تلقيننا الدروس ولم أجد شيئاً من ريحها في المعلم غريب الأطوار الذي يقف أمامي، أخفيت أمر الرسوب عن أسرتي، وطلبت من أمي التوقف عن المذاكرة لي لأني أصبحت كثيرة الشرود، وبدأت الاعتماد على نفسي في المذاكرة لأفاجئهم بحصولي على معدلات أعلى، بينما كنت أحاول التكيف مع المدرسة والمدينة الجديدة، واكتسب أول صديقة لي وأنا على أعتاب البلوغ، وأغرق في قراءة الكتب التي استعيرها من مكتبة المدرسة، لأنسى غربتي وشعوري بالاختلاف عن أقراني وعجزي عن الاندماج معهم.
الإسكندرية التي ذبت فيها
كنت لتوي قد بدأت أتكيف مع المدرسة والمدينة الجديدة، بعد عامين من انتقالنا، حين انتقلنا لشقة أصغر في البيت نفسه، ثم فاجأني والدي بقرار نقلي وشقيقاتي إلى مدرسة خاصة جديدة انتقل إليها بالفعل عدد من زملائنا، وأظن أن مصروفاتها كانت أقل، ويقال إن معلميها أكثر كفاءة. كنت مستاءة، أشعر بالقلق من كوني قد لا أتكيف، ولم أكن أعلم أنني في هذه المدرسة دون غيرها سأشعر بالانتماء، وستهجرني غربتي، وسألتقي بصديقة عمري وأندمج للمرة الأولى في الأنشطة المدرسية ولا سيما الإذاعة.
أصبحت أسابق الريح لأصل إليها، ونتبارى أنا وصاحبتي على الوصول إلى غرفة معلم اللغة العربية أولاً، فمن تصل أولاً تُقدم الإذاعة المدرسية ومن تصل تالياً تلقي النشرة الجوية، وصرت أتنافس على المراكز الأولى للمتفوقين بالصف وأتلقى شهادات التكريم، وفي كل يوم أزور المكتبة لاستعارة رواية جديدة، ألتهم سطورها سريعاً في طريق العودة وقبل تناول الغذاء، وأعود في اليوم التالي لإعادتها واستعارة غيرها. تمنيت ألا تنتهي سنوات دراستي بالمدرسة، ولكن بعد عامين حصلت على الشهادة الإعدادية وكان لزاماً على المتخرجين الانتقال إلى مدرسة ثانوية.
بينما كنت أخطط مع صديقاتي للتقديم للمدرسة الثانوية في الإسكندرية التي ذبت فيها حتى خُيّل إليّ أنها موطني الحقيقي، تفاجأت بأن والدي انتقل للعمل في العاصمة، وأننا بعد عام من انتقالنا إلى شقة جديدة تطل على البحر سوف تنتقل للعيش فوق جبل المقطم في القاهرة، وأنني سأكون مضطرة لتوديع مدينتي التي أحب، والبحر الذي أعشق، وأول صداقة حقيقة حظيت بها، وأجمل ذكرياتي التي دفنتها في قلبي، وحنين جارف للمكان ظل يجذبني لأعوام، جعلني أعود إليه بعد اثني عشر عاماً، لأفاجئ بأن شيئاً لم يعد كما هو، وأن حنيني كان لذكريات في عقلي، أما الأبنية فقد تبدلت، وحلّت محل البيوت والفيلات الجميلة أبراج سكنية قبيحة، وأن الضجيج والزحام ابتلعا الهدوء والجمال، وأن مشاغل العمل والزواج والأبناء ستحول بيني وبين لقاء صديقات المراهقة والطفولة إلى يومنا هذا.
شقة يسكنها الجان
كانت شقتنا الجديدة مستأجرة، ضيقة المساحة، كئيبة المنظر، تكسو أرضيتها بلاطات إسمنتية وجدرانها غارقة في لون أصفر باهت، أجواءها خانقة، تطل شرفتها ونوافذها على حديقة تصل إلى الجبل الذي يسد الأفق.
كانت شقتنا مسكونة بالجان، تقع فيها الحوادث الغربية وتكثر فيها الأصوات المريبة: المصابيح تضاء من تلقاء نفسها، وصنابير المياه تفتح عن آخرها، وأبواب الخزانة تفتح وتغلق، وأصوات مخالب تخدش الخشب لا تتوقف خلال الليل، وحبات الطعام تهتز وتتطاير... مجاز الأشباح
كان شعور الغربة يتفشى بداخلي، فالحياة كانت أكثر بساطة في مدينة ساحلية نائية عما هي عليه في حي راقٍ بالعاصمة، تتطلب الحياة فيه من مراهقة في مثل عمري أن تجاري الأجواء وتتحدث بنفس لغة "الشباب الروش" وترتدي "ستايل" معيناً من الثياب والحلي، وتزور صالون التجميل النسائي بشكل دوري، وتضع مساحيق التجميل، وتعرف كيف تجذب إليها الجنس الآخر، وتملك هاتفاً متطوراً وبضع مئات من الجنيهات لتنفقها على التسكع مع صديقاتها وتناول الأطعمة السريعة وشراء الإكسسوارات والهدايا.
أردت التركيز على دراستي في الثانوية العامة لأحقق حلمي في الالتحاق بكلية الإعلام، لكن شقتنا الصغيرة كانت تعج بضجيج أشقائي الصغار طيلة النهار، فأحاول أن أحظى بقيلولة مؤرقة بسبب أصواتهم حتى أسهر خلال الليل للمذاكرة، لكن ما لم أحسب له حساباً هو أن تكون شقتنا مسكونة بالجان، تقع فيها الحوادث الغربية وتكثر فيها الأصوات المريبة لاسيما خلال الليل. المصابيح تضاء من تلقاء نفسها، وصنابير المياه تفتح عن آخرها، وأبواب الخزانة تفتح وتغلق، وأصوات مخالب تخدش الخشب لا تتوقف خلال الليل، وحبات الطعام تهتز وتتطاير، أخلد لغفوة أثناء المذاكرة فأستيقظ من نومي وأنا أشعر بكيان ما يطبق على ساقي ويرفعني ليسحلني على الأريكة، وأنا أشعر بملمس قماشها يحتك بوجهي بقوة.
في النهاية، أحضر أهلي مقرئاً شهيراً يزعم عنه طرد الجن ليقوم بقراءة القرآن والرؤية الشرعية، ويتم إلقاء الماء المتلو عليه الآيات في أنحاء البيت، وقال لنا إن الشقة كان يسكنها عمار البيوت لأنها كانت مغلقة منذ 15 عاماً.
غربة أرواح الكاتبات
لحسن الحظ لم نمكث طويلاً في جحيم الشقة المسكونة، وسرعان ما انتقلنا منها إلى شقة أخرى، لنقضي بها ثلاث سنوات ثم نغادرها إلى بيت جديد أكثر اتساعاً وبهجة.
وخلال سنوات الدراسة الجامعية، كنت أكثر قدرة على التكيف واكتسبت الكثير من الأصدقاء، لكن شيئاً ظل مفقوداً بالنسبة لي حتى بعد تخرجي والتحاقي بالعمل وتنقلاتي الكثيرة بين الصحف والقنوات الفضائية، ظل الحنين إلى مدينتي الأثيرة ورفيقات الصبا والأمكنة يقتلني، ويقودني لزيارتها من وقت لآخر بحثاً عن فرحة لم تكتمل ومشاريع مؤجلة وأشباح الماضي وذكريات منقوصة.
تسع شقق مختلفة عشت بها على مدار ثلاثين عاماً عاماً عشتها، أصبحت أماً وزوجة ولازالت فكرة الانتقال من البيت تخيفني، ولازالت غربة الروح تنتابني أحياناً وأنا بين أهلي وأصدقائي، ودائماً حين أكون بالشارع بين الغرباء، مؤخراً تملكني ذلك الشعور بقوة وأنا أقف مع طفليَّ أمام منصة الحفل المدرسي للاحتفال بعيد الأم في مدرسة ابني الأكبر، بينما يشغلون أغاني شعبية هابطة يرددها الأطفال عن ظهر قلب.
يسيطر علي شعور قوي بأنني لا أنتمي لهذا المكان، أنا ابنة البحر والكتب، الغارقة في الوحدة، أشعر دوماً بأنني مختلفة عن جميع من حولي، أجد صعوبة في الاندماج مع الناس، تزيدني تحولات المجتمع السريعة وتغير الذائقة العامة غربة وغرابة، أخشى أن ينتهي الأمر بي كقطعة "أنتيك" يغطيها الغبار، فقط تتلاشى غربتي كلما وجدت قبساً من روحي الوحيدة في نص جميل أو في روح كاتبة تشبهني، فأجدني أتساءل: هل غربة الروح هي لعنة الكاتبات؟!
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


