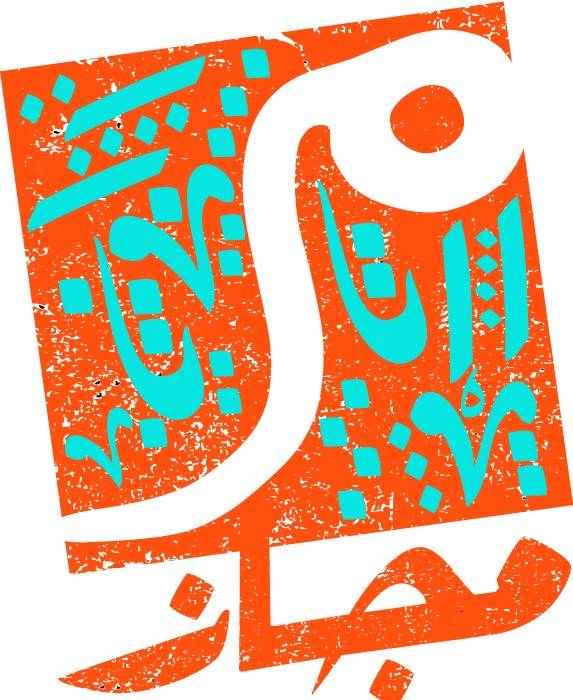 الذاكرة السائلة
الذاكرة السائلة
كيف تنجو من ذبحة قلبيّة
تحمل عائلتي في جيناتها مرضاً تظهر أعراضه بعد سن الأربعين، هو الباركنسون، نسبة لجميس باركنسون الذي شخّصه بداية القرن التاسع عشر، اسم هذا المرض الطبي أشد وطأةً وأثراً، "الشلل الارتعاشي العائلي"، لكن هذا الاسم، لا يكشف بدقة عن متلازمة أعراضه بأكملها، ولا أتحدث هنا عن الارتعاش الدائم للأطراف الذي تصل شدته حرفياً حد الشلل، بل تلك الأشد خفاءً، والتي ما زال الطب حائراً في علاجها.
يُهدد الباركنسون خلايا المخيخ المسؤولة عن العمليات العقليّة العليا (التنسيق الحركي، الذاكرة، الإدراك، الوعي بالمكان... الخ)، إذ يُفكك العصبونات المسؤولة عنها، واكتسب اسمه نسبة إلى أول ما تُفك عُراه، أي العصبونات المسؤولة عن التنسيق الحركيّ، أي ضبط أسلوب ثبات الجسد وتناغم الحركة بانسيابية، ما يؤدي إلى الرعشة، تلك التي كنا نسخر من جدتي بسببها، ونقول إنها أفضل من يستطيع التوقيع، يكفي أن تحمل قلماً، وتقترب من الورقة، فيظهر توقيعها إثر ارتعاش كفّها.
يشتد تآكل العصبونات في المخيخ مع تدفّق الزمن، ليتجاوز الأثر الارتعاش ليصل إلى "الأنا" ومكوناتها الرمزيّة ذات الأصل العصبي، أي كل الذكريات والصور والكلمات التي يخزنها الدماغ عبر تصلب العصبونات، تتلاشى، وتذبُل العصبونات ما يمنع مشي السيالة العصبية عبرها لـ"تذكر" ما هو مخزّن، ما يعني تلاشى الذات تدريجياً، فالذكريات الجديدة لا تتكون، والقديمة تتفتت وتسقط في الظلام داخل الجسد المرتعش، أما المخيخ الذي فقد قدرته على تنسيق واختيار ما يحفظه وما ينساه، فيتحول إلى وعاء من نوع ما، يتسرب منه كل ما كان فيه وما سيدخله.
تتفكك العلاقات بين مكونات "الأنا" الرمزيّة لدى المصابين بالباركنسون، كاليد التي تعجز عن أن تمسك كأساً من شدة الارتعاش وتفقد القدرة حتى على الإشارة إليه، فما يجمع الكلمات ويكسبها المعنى اختفى، وكأن ا ل أ ح ر ف، ت ف ق د ، م ا ، ي ج م ع ه ا، تلك العلاقات التي تنتج المعرفة من مجموع الأجزاء، وما نمتلكه من معارف تفيض على أصوات الأحرف والكلمات، ليبقى الوجه المرتعش نهايةً، بأسنان مكسّرة من شدة الاصطدام ببعضها، محدقاً في اللامكان، حيث لا تمتلك "الأنا" التي تنهار ما تستند عليه لتثبّت حضورها أو وعيها بما يحصل.
تتفكك العلاقات بين مكونات "الأنا" الرمزيّة لدى المصابين بالباركنسون، كاليد التي تعجز عن أن تمسك كأساً من شدة الارتعاش وتفقد القدرة حتى على الإشارة إليه، فما يجمع الكلمات ويكسبها المعنى اختفى، وكأن ا ل أ ح ر ف، ت ف ق د ، م ا ، ي ج م ع ه ا... مجاز الأشباح
الملفت أن هذا التلاشي للأنا يحررها من القلق، الفقدان، التوتر، نوبات الفزع، الحنين، سكينة اللاشيء تهيمن على كل شيء، ما جعل وجه جدتي نموذجاً على الـ"لا أنا- non moi"، أي علامة في درجة الصفر ربما، لا تدل إلا على نفسها، الآن وهنا، في ذات الوقت علامة على كل ما مضى.
المفارقة، أن المصابين بهذا المرض، لا يتعرضون للذبحات القلبيّة، أي حتى لو اشتدت العواطف العالقة في تلافيف الدماغ وظهرت فجأة صورة لابن رحل منذ سنوات، الدماء في أوعية الجسد لا تتصلبّ أو تتجلّط، السبب أن غياب الدواء لهذا المرض، جعل الأطباء (على الأقل في سوريا) يتبنون عقاراً اسمه "أنديرال"، حبات زهرية صغيرة، مميعة للدم، توصف عادةً لمن تخذلهم دمائهم أو قلوبهم، لكن واحداً من الأعراض الجانبية لهذا الدواء، تخفيف أثر الارتعاش في الأطراف عبر تخديرها والإمعان في شلّها ربما.
في اقتصاد العصبونات
لا أعرف أن كنت أتذكر أم أتخيّل، فمنذ أن تركت دمشق ووصلت إلى باريس، تحول ما مضى إلى "ذاكرة" تحكمها النوستالجيا، الانطباعات الشخصيّة، المخيلة، الصور الحديثة، البروباغاندا، الأخبار الزائفة، كلها تتدفق أمامي وتتصلب تدريجياً في عصبونات المخيخ مع تدفق السنوات.
أي نظرياً ما زلت أستطيع أن "أتذكر" و"أتذكرني" في أي لحظة، لكن عطب أسرتي الجنيني طيف حاضر دوماً، فالمكان الذي عرفته (أي دمشق)، والذي أدرسه "الآن" ويشكل أناي، مُهدد بالتلاشي، العصبونات التي رسخت مساحة منزل أسرتي، صوت أمي، طريقي سكراناً أقطع الحارات الضيقة بتخفف، كلها ستتلاشى، وحتى لو زرتها الآن لن أعرفها، فالمدينة المحكومة بسياسات الفناء تتغير ويعاد تشكيلها، فالأصدقاء والأعداء، والسفلة والنبلاء، ولاعقو الأفخاذ والباحثون عن الحبّ ومربّو الكراهية كلهم سيسقطون من ذاكرتي في لحظة ما. المُرعب، أني أمتلك عدداً محدداً من العصبونات، يجب أن أقتصد فيما أتذكره أمام احتمالات التلاشي.
هذه المواجهة مع احتمالات النسيان البيولوجيّة، يضاف إليها جهد حفظ تفاصيل جديدة، تلك التي تفرضها المدينة التي أقطنها، عليّ حفظ الطرقات، العناوين، أن أعرف طريقي إن ضعت، أسماء الأوجه التي أصادفها، الأصدقاء الجدد، رقمي الضريبي، موعد دفع تسجيل الجامعة، كلها معلومات تتطلب جهداً عقلياً لصنع روابط جديدة بين العصبونات في دماغي، أو استبدال القديمة، ناهيك عن ضرورة إعادة قراءة ما أعرفه بالفرنسية، أو على الأقل حفظ العناوين الماضية بكلمات جديدة، أي "أنا" أمام نسيانين، بيولوجيّ وبراغماتي، لكن المطمئن أني سأنجو من الذبحة القلبيّة، حين تبدأ أعراض الارتعاش بالتجلّي.
تحولت عملية الاستبدال والحفظ والنسيان إلى نوع من الفزع المريع (راع لغةً، أي جَمُدَ في مكانه، وتَعني أيضاً العقل، فالمريع هو ما يفقد العقل ويطل الانتقال، وضمن نظرية الرعب، راع أي شُلّ ولم يستطع الحركة، ولم يتفعل لديه رد فعل النجاة المتمثل بالهرب)، إذ لا يمكن الهرب من النسيان، والأهم، لا أستطيع صنع قائمة أختار منها ما أريد نسيانه وما أريد الحفاظ عليه في ذاكرتي. ازداد الأمر شدة، حين قارنته بالسيد ك، الذي تتم محاكمته لدى فرانز كافكا، لكن الحالة مختلفة، ك لم يرتاع، هرب/ ركض بين مكتب وآخر، غرفة وقبو، ليعرف ما الذي قام به، أيمكن أنه نسي التهمة الموجهة إليه؟
يقدم جورجيو أغامبين تفسيراً لحالة بطل رواية كافكا، إذ يرى أن لفظة السيد ك، قادمة من الكلمة الفرنسيّة calomnie، ذات الأصل الروماني kalumnia، والتي تعني الافتراء/المفتري، وفي الحالة الكافكاوية، السيد ك افترى على نفسه، اتهم نفسه زوراً دون أن يعلم، وفي القانون الروماني، كانت عقوبة المفتري، وسم حرف K على جبهته، ليكون افتراؤه علنياً لنفسه وأمام الآخرين، وهذا بالضبط ربما ما روّع (أفقد الشخص عقله) بطل الحكاية، ظن أن أحدهم افترى عليه دون أن يعلم أنه المفتري ذاته، فعاش التهمة، والذنب، والجريمة، والعقوبة، في آن واحد، ناسياً "أناه" أمام سلطة لا تمتلك أوراق/ ذاكرة عن إدانته، فقط افتراؤه الذاتي.
المدينة المحكومة بسياسات الفناء تتغير ويعاد تشكيلها، فالأصدقاء والأعداء، والسفلة والنبلاء، ولاعقو الأفخاذ والباحثون عن الحبّ ومربّو الكراهية كلهم سيسقطون من ذاكرتي في لحظة ما... مجاز أشباح الغربة
تحولت تساؤلاتي عن أسرتي والمكان الذي ولدت فيه وجينات هؤلاء الأشخاص الذين أحمل ملامحهم إلى نوع من اللعب الخطير، هل افتروا علي دون أن أعلم؟ أم أفتري أنا عليهم؟ هل يمكن أن أصل إلى لحظة أقف فيها مرتجفاً، ناسياً أي باب علي أن ألج لأخرج من منزلي؟ ماذا لوكان الباب هو ذاته الذي تحدث عنه لودفيك فيتغنشتاين، أفتحه فأسقط في الهاوية! ويضيع كل التشابه العائلي عما أعرفه! (مفارقة هنا أن تُسمى فرضية فيتغنشتاين اللغوية، التشابه العائلي l'air de famille ،واسم المرض، الشلل الرجفاني العائلي، الذي يحيل إلى فقدان التشابه وعلاقات بين الكلمات).
هذا اللعب حول لزوم ما يلزم وما لا يلزم، وصل إلى مرحلة حاولت فيها ضبط ما عليّ حفظه عن ظهر قلب، ذاك الواجب الذي لم أكن مضطراً للقيام به قبل مجيئي إلى فرنسا، ولا أتحدث عن الكتب أو المؤلفين أو بعض الجمل لحل المشكلات البيروقراطيّة، بل الشؤون الأبسط: كلمة سر للبنك، ولحساب مؤسسة البطالة، ولحساب مكتب الدعم العائلي، وأخرى لبطاقة البنك، وجملة طويلة من أجل المحفظة الإلكترونيّة، كلها عصبونات تترابط لتذكر ما لا يمكن أن أستغني عنه، وإلا قد أخسر ما أملك، أو على الأقل، أُحرج أمام الأصدقاء لعجزي عن تذكر كلمة سر بطاقة البنك، الباركنسون هنا لن يكون حجة مقنعة.
أن تخسر وجهك مرتين
وجه جدتي وهي لا تميزنا شديد الغرابة، وكأن ملامحها نفسها لم تعد ملكها، تذكر مثلاً أنها درست الابتدائية في مكتب عنبر في دمشق، تتذكر الطريق وشدة الشمس، وما كانت تحمله في حقيبتها، تتحدث عن ذاك الوقت وكأنها تتحدث عن شخص آخر، تستخدم ضمير "كانت" لا "كنت"، وكأنها الآن أخرى، لا تعرف من هي بدقة، ولا لمن تقول ما تقول، فوجهها حينها منسيّ، ووجهها الآن، يتغير في كلّ لحظة، عصيّة جدتي على التصوير، عدم قدرتها على الثبات، تهدد عدسة الكاميرا، هي دائماً بلا ملامح واضحة، لا أثر على "ما كانت عليه"، وكأنها عصيّة على أن توضع في إطار، عصية على أن تكون أثراً على ما كان (ça a été)، حسب تعبير رولان بارت في وصفه لفن الفوتوغرافيا.
قائمة معارف لا مانع من نسيانها
1- أسماء كل الباعة في حي ركن الدين، ومواضع إخفاء علب التدخين، ومسير خط الباص من البيت إلى الجامعة.
2- كل الأماكن التي كنت أظن أني سأجد فيها نقوداً أسقطها أحدهم من جيبه سهواً (موقف الباص، مدخل الحمامات العامة، الزاوية بجانب المدرسة حيث كنا ندخن...الخ)
3- كل دقائق الانتظار في ميترو باريس.
4- كل الملخصات عن الكتب التي قرأتها بأكملها لاحقاً، أما تلك التي لم أقرأها، فلابد من حفظ ملخصاتها.
5- الصوت الأنفي الغريب الذي ابتدعته لأنجو من الحرج حين عجزي عن تصويت نطقين مختلفين لـUn و Une الفرنسيتين.
رحلة الصوت من الدماغ إلى الحنجرة
الكوكائين وقود سكان برلين، لا، تعميم مجحف جداً، الكوكائين وقود من ألتقي بهم في برلين، يُستخدم من أجل التخلص من آثار الأفراط في الشرب، والحفاظ على إيقاع يتناسب مع المدينة.
خطوط البودرة البيضاء متوافرة في كل مكان، ترياق ضد التعب والسُكر، الكسل، لكن هناك فائدة أخرى، زيارة برلين تعني (على الأقل بالنسبة لي) تناسي عبء التذكّر، فالكوكائين يحرض الذاكرة، إذ تتوهج العصبونات، ويحضر كل العالم/الذاكرة في دقيقة أمامي، يلتمع "كل شيء" ويتضح، علي فقط أن اختار ما هو مناسب لأنطقه، أحكاماً، وسخريةً، ونقداً، وزعبرةً.
طورت علاقة خاصة (أو خوفاً) مع هذا النوع من المواد المخدرة، أحرص دوماً على ألا أفقد "الأنا"، وما إن أعلنت ذلك في الزيارة الأخيرة، حتى نبّهني عدد من الأصدقاء، أياك والدخول في الحفرة ك- K hole، بالطبع لم أتمالك نفسي من الضحك والسخرية، ما هذه الحفرة التي لا يجب أن أدخلها، الحفرة ذات المرجعية الكافكاوية بامتياز، والتي من أعراضها الولوج فيها، حسب من زاروها، نسيان الأنا.
هناك حالات لا يمتلك فيها المصاب "صوتاً داخلياً"، أي لا يسمع نفسه حين يفكر، أو يقرأ أو يحاول اتخاذ قرار، معياره في الفعل ومحاكمة الأشياء مختلف عن معايير(نا) العقلية، إذ يعتمد على إحساسه أو جسده ليقرر، لا ما يقوله له عقله، بل ما تدفعه إليه عواطفه... مجاز الأشباح
دون إطالة، دخلت الحفرة ك، الشأن الذي اكتشفته وأنا في قعرها بعد ثلاث خطوط من "الكيتامين"، ذاك الذي يأخذك إلى مكان شديد الصفاء، لكنه مرعب لشخص متوتر وبارانوياك مثلي. هناك، أي في الحفرة، لا تتوهج الأشياء والكلمات والأصدقاء والأعداء وما أعرفه وما لا أعرفه، كل ما سبق معلّب، موجود في مكان محدد، ضمن صناديق مغلقة لا أستطيع فتحها، كل العلاقات والتشابه العائلي ينهار، وكأن العصبونات تقطعت إلى حد يحافظ فيه الوعي على "جواهر" الأشياء فقط، أي أصغر مكونات تحافظ على تعريف الشيء، مثلاً، هذه صورة، هذا أبي، هذه سيجارة، لكن لا شيء يجمعها، ولا أي احتمالات لترابطها، هي لا تطفو ولا تتحرك، فقط موجودة ومنعزلة وأنا أقف بجانبها لا موقف لي منها ولا دور في ترتيبها.
أذكر أني حسدت رولان بارت بسبب قدرته على توليف ما قرأه ورآه مع ما يتذكره، إذ ألّف كتاباً "الحجرة المضيئة" بسبب صورة لأمه كانت على مكتبه، رأى علاقات وراء الصورة إلى حد تقديمه تاريخاً للفوتوغرافيا، لو زار بارت مرةً الحفرة ك لما ألّف، ولكان حداده على فقدان والدته بالشكل التالي: "هذه صورة، هذه أمي، أنا حزين".
لا مكان للذاكرة داخل الحفرة ك، بصورة أدق، البارانويا لدي تفعّلت، واشتد وهم النسيان الجيني فجأة، وتلاشت العلاقات بين الكلمات وتصاريفها وأماكنها في الكتب، كل شيء ثابت، أحاول الدخول في رحلة ك الكافكاوي لأفتح علب الذاكرة وأبوابها واكتشاف عمارتها، لكن دون فائدة. هذا صديقي، هذا فيلم، هذه موسيقا، هذا خط رابع من الكيتامين، أستطيع التأشير فقط، أجيب عن سؤال ما هذا، دون القدرة على الإجابة على سؤال، كيف أو لماذا. لكن الأشد ترويعاً، هو اختلاف صوتي الداخلي.
تهديد الصوت الداخلي شأن لا مزاح فيه، هو المساحة التي تتحرك فيها الذاكرة وما يحصل "الآن" قبل أن (يخرج) صوتاً، ذاك الهمس/ الصراخ/ الحوار الداخليّ الذي نسمعه بوضوح حين نفكر، أو حين نقرأ بصمت، صوتنا، ذاك الذي يضبط تدفق الكلمات ويقارن معانيها ويبني السياق. يعجز هذا الصوت في الحفرة ك عن الحبك، يسمّي الأشياء دون تأليفها، فيتلاشى المكان، بصورة أدق، كل الأماكن، السابقة والحالية، تصبح صوراً لست موجوداً فيها (هذا أحد تعريفات الفوتوغرافيا حسب بارت، الصورة، كل مكان لست فيه)، أقف في السواد عاجزاً عن بناء أي "معنى"، أسمّي الأشياء فقط دون سبرها.
الحالة السابقة من غياب الصوت الداخلي تتضح لدى بعض المصابين بعسر القراءة، هناك حالات لا يمتلك فيها المصاب "صوتاً داخلياً"، أي لا يسمع نفسه حين يفكر، أو يقرأ أو يحاول اتخاذ قرار، معياره في الفعل ومحاكمة الأشياء مختلف عن معايير(نا) العقلية، إذ يعتمد على إحساسه أو جسده ليقرر، لا ما يقوله له عقله، بل ما تدفعه إليه عواطفه.
لا أصدقاء ولا أعداء في الحفرة ك، لا أنا ولا آخرون، ولا علاقات تجمعني مع أي شيء، هناك كلمات منفصلة لا تتشابه عائلياً مع شيء، أذكر حينها أني طفوت من منزل الأصدقاء إلى المنزل الذي أقيم به، هكذا، دون أي أسئلة جانبية، ما معنى اسم المحطة التي سأنزل بها ؟ هل حقاً كان قصر شارلوتنبورغ مشفى أعدم فيه النازيون الأطفال المصابين بالتخلف العقلي؟ هل من يتحدث باللهجة السورية إلى جانبي يسمعني حين أفكر؟ كل هذا تلاشى، هناك "أنا" فقط عائد إلى المنزل، أي منزل.
أنا عالق مع "أنا"، التي تحيل لحظة نلتقطها إلى تماسك ما، وكتلة من ذاكرة ومعارف قادرة على النفي ذاته وإدراك ذاتها حتى في الحفرة ك، في حين أن "أنا" جدتي، غير موجودة، أو شبه متلاشيّة... مجاز أشباح الغربة
غفوت في ليالي الأسبوع اللاحق وكأني قُتلتْ، لا أحلم، لا أفكر، لا أتذكر، بصورة أدق، لا معنى لما أتذكره، لا صوت ينهرني: "اقرأ أكثر لأنك ستنسى كل شيء لاحقاً"، ولا أقصد هنا قاعدة احفظ ألف بيت ثم أنسهم لتَنبُغَ شعراً، بل احفظ بالمعنى "العائلي الارتعاشي"، أي أقرأ لأنك ستنسى دون قدرة على الاستعادة أو حتى حفظ انطباعك عما حفظته ونسيته.
أين "أنا" ؟
تلاشى الأثر الكيمائي من دمي بعد حوالي عشرة أيام، عدت للكتابة وبدأت أتذكر كيف أعمل، قمت "بجرد" الأماكن التي أعرفها، وأعدت تنظيم قوائم الحفظ والنسيان، لكن، بقي لدي أثر من حنين إلى الحفرة ك، هناك حيث جدتي التي تخاطب نفسها بصيغة الغائب، حيث لا ضرورة لحفظ أي كلمة سرّ، أو طريق، أو بناء أو وجه صديق أو اسم عدو. ربما حنين ميلان كونديرا، أي الحنين إلى المجهول، له معنى أكثر فرادة في الحفرة ك، فهناك أحن إلى ما كنت قبل أن أكون أنا، هنا تعجز اللغة العربية عن رصد ذاك الزمان، كونها لا تحوي ماضيين في تصاريف أفعالها، أي ماض قريب وماض بعيد كما الفرنسية والإنكليزيّة، خصوصاً أن ضمير أنا، يحيل إلى دوماً إلى وعي بالأنا لحظة نطقه، هناك مضارعة يستحيل استباقها.
يُمكن للنفي أن يُفيد، ربما صيغة" أنا لست هنا/ هناك" تنجح، إذ تنفي (ليس) بمعانيها السابقة على الاستخدام العربي، الزمان والمكان، ماضياً ومستقبلاً، و(أيس) يشك أصلاً بانتمائها للغة، علماً أنها تفيد بنفي المتحدث لذاته، لذا أنا عالق مع "أنا"، التي تحيل لحظة نلتقطها إلى تماسك ما، وكتلة من ذاكرة ومعارف قادرة على النفي ذاته وإدراك ذاتها حتى في الحفرة ك، في حين أن "أنا" جدتي، غير موجودة، أو شبه متلاشيّة، هي لا تمتلك الكتلة العصبية الكافية لإنتاج الأنا، وكأنها مُنتزعة من مكانها ومن جسدها نفسه، ربما تمتلك ذات "أنا " المؤلف، تلك التي تختفي وراء النص، لكنها في حالة الشلل العائلي، اختفت، ولم تعد تذكر ما تستطيع توليفه وتأليفه وتلفيقه لتُثبت حضورها، فقدت قدرتها على قرار الاختفاء نفسه، فلم تعد "أنا" بل نفي مطلق، شأن عصيّ على التثنية والتكثير، ربما أصبحت (حجرة مظلمة)، مساحة ينطبع فيها ما "كان" دون أن يثبت، وبعكس الفوتوغرافيا، لا دليل على هذا الذي كان، أي الصورة، فقط حفرة موسومة بالافتراء، وذاك الذي لم يكن ولم يحصل.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





