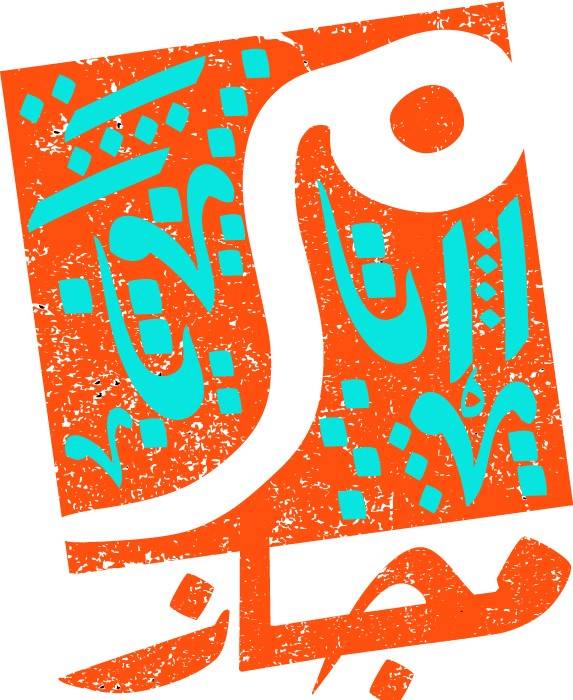 حجبوها عن الرياح
حجبوها عن الرياح
لعلاقتي بجارتي وزميلة الدراسة ومشوار المدرسة اليومي بالغ الأثر في رغبتي بارتداء الحجاب في سن مبكرة مثلها، فهي ترتدي الخمار منذ التاسعة وابنة الشيخ زايد، كنت أتردد على بيتهم كثيرا للمذاكرة واللعب، ومع الوقت اندمجت مع أسرتها المتدينة، وراقنى ما وجدته بينهم من ود وتفاعل واحتواء افتقدته آنذاك، وبوعي الطفلة أردت أن أكون معهم هناك، في تلك الزاوية من القبول والاحتواء.
بحث حثيث لا يكتمل
حرصت على ارتداء الحجاب بشهر رمضان من كل عام وخلعه بعده، وفي إحدى هذه المرات، فوجئ أبي وأمي باستمراري في ارتدائه، لم يعطوا للأمر اهتماماً كبيراً، خاصة وأن أمي لم تكن محجبة، وبشكل عام لم تكن أسرتي متدينة بما يعرف عن التدين آنذاك.
لم يتحدث معي أحد منهم عن سبب استمراري بلبس الحجاب رغم هذا السن الصغيرة، وفي إحدى خروجاتنا معاً تشاجرا معي وخلعته أمى عن رأسى بالقوة، لأنه، كما تقول، يُظهرنى أكبر من عمري الحقيقي.
أذكر بكائي وشعوري بأنه لا سلطة لي على جسدي، الشعور الذي استمر طويلاً.
كان ذلك في المرحلة الإعدادية، وعندما وصلت لمرحلتى الثانوية كنت قد شرعت في الاهتمام بمظهري كبقية أقراني، أحببت واعتنيت بشعري الطويل، فزينته بالفراشات والنجوم الملونة كلما خرجت للمدرسة، كانت الحركة محدودة فقط من وإلى المدرسة مع أقراني أو إخوتي أو أمي.
شتات حولي يكاد يطولني
في عامي الأول بالجامعة بدأت أتعرف على أشكال من التحرش، كنت أتلافي بعضها وأتجاهل البعض الآخر، وأكتم في نفسي أثرهم جميعاً حتى لا أثير حفيظة أسرتي التى دأبت على إلقاء اللوم على الفتاة، مثلها مثل معظم الأسر المصرية في ذلك الوقت.
في هذه الأثناء، كانت قد بدأت وتيرة أصوات الدعاة في التعالي حد الإزعاج والصراخ، في البدء تجاهلتها، وبعد قليل رضخت لدعوة إحدى الصديقات لحضور ندوة للداعية مصطفى حسني بساقية الصاوي بالزمالك.
كانت الحشود غفيرة بالفعل. امتلأت القاعة الأكبر بالشباب تحديداً، والبنات يفترشن الأرض بعد أن امتلأت الكراسي. أسلوب الترهيب كان دائماً هو سيد الموقف، الخوف من النار المستعرة التي تنتظر البنات السافرات المتبرّجات أمثالنا، اللواتي يوقعن بالشباب في براثنهن عندما يتزيّن وينزلن للشارع كاشفات عن شعورهن.
لم يرقني الكلام، لكنى انتبهت لخوف بدأ يتسرب لمسامات جسدي، كنت حريصة على الصلاة وإن لم يكن في وقتها، وأحببت آل البيت ودأبت على زيارتهم، وكانت معظم وسائل المواصلات العامة تتعمد الاستماع لصوت القرآن الكريم بأصوات قراء خليجيين، حيث كانت موضة جديدة، أو شرائط كاسيت لنجوم الدعاة حينها، أمثال عمرو خالد ومصطفى حسني.
لم يتحدث معي أحد عن سبب استمراري بلبس الحجاب رغم هذا السن الصغيرة، وفي إحدى خروجاتنا معاً تشاجرا معي وخلعته أمى عن رأسى بالقوة، لأنه، كما تقول، يُظهرنى أكبر من عمري الحقيقي... مجاز في رصيف22
وكان الدعاة يصرون على تحميل البنات والسيدات آثام البشرية جمعاء، فدائماً المشكلات تبدأ من عطر الفتاة أو شعرها أو ملابسها أو صوتها أو طريقة كلامها وهكذا، مما كان يكرس للتحرش، من باب أنك كشاب لست السبب، لست المحرك للأحداث هنا، أنت يامسكين مفعول به، مغلوب على أمرك، وهذا بالطبع لا يُقال بشكل مباشر ولكن يفهم من بين السطور.
رفض وغضب واحتجاب عن العالم
ذهب أمي وأبي إلى العمرة وارتدت أمي الحجاب بشكل نهائي وحافظت على صلواتها، لكنها ظلت تهتم بشكلها العام، ولم تحثّني على ارتدائه ولا مرة، في تلك السن الصغيرة حيث لم أكن وصلت لعمر العشرين عاماً بعد، تعرضت لحادث تحرش كان له بالغ الأثر في نفسيتي، لم أستطع التحدث عن الأمر مع أحد ولم أقو على استيعابه وتجاوزه، فوقعت فريسة الإحساس بالذنب، ورحت أفكر: ربما كنت أنا باهتمامي بشكلى ومظهري السبب فيما حدث لي، وإن كان ما حدث صدر عن رجل مسن يكبرني بأكثر من 45 عاماً.
ارتديت الحجاب وعدلت ملابسي بما يتلائم معه، انخرطت في سماع الدعاة الجدد وتحديداً الداعية عمرو خالد، كان الحديث يتطرق دائماً للزهد في الدنيا طمعاً في الآخرة "الجنة" حيث أنهار العسل ومرافقة الأنبياء والصديقين، وحيث كل شيء حُرمنا منه في الدنيا مباح هناك.
تسرب الزهد في الدنيا لابنة العشرين، فانعكس هذا الشعور على كل خلية بجسدي، حتى لون بشرتي واختياراتى لألوان ملابسي واهتماماتي، أصبحت أكثر انزواء وخجلاً وشعوراً دفيناً بالذنب، وكأني ذنب نبت له يدان وقدمان ورأس.
ظل هذا هو الوضع حتى عند تخرجي من الجامعة وخطبتى وزواجي، لم أخلع الحجاب ابتهاجاً بأي منهم، كما فعل جيل أمي وأبي، تبارينا كفتيات لهذا الجيل في التزمّت دينياً والتضييق على أنفسنا لكسب التعاطف والتأييد ولننال القبول المجتمعي المشروط.
سقوط مدوي وصدمات متتالية
مر الوقت وجاءت ثورة يناير وبدأت الأقنعة تتساقط من كل الوجوه التى كنا نظن فيها خيراً، دفعنا هذا نحن جيل الثمانينيات والتسعينيات لإعادة التفكير فيما كنا نظنه مسلمات، بما في ذلك الدعاة والأزهر وفتاويه، وحتى التفاسير والأحاديث النبوية، أصبحنا نبحث – باستحياء- في البداية على مصادر لإعادة تعريف لعلاقتنا بالعالم ومن ثم بأنفسنا.
صار التخبط حليفنا، خاصة البنات التي شاركن في الثورة وقررن الاستقلال فكرياً أو مادياً او مجتمعياً وبدأنا في محاولات للتخلص من الرداء المجتمعي البالي، وسط صرخات المجتمع المندد بالجحيم دنيا وآخرة.
حالة من الغليان تلبستنى ببطء وقوة، غليان فكري ونفسي بالأساس، أسئلة عن الاتساق مع الذات والهوية والتحقق ومدى ملائمة واتساق شكلي مع صوتى الجديد القادم من بعيد.
انغمست في البحث عن نفسي والبحث عن اجابات دينية على مدار عامان، حتى اطمئن قلبي الى خلع الحجاب، استكمالاً لرحلتي مع نفسي.
ولكن كيف ومتى وأين وماذا سأخبرهم زوجي وأمي وأبي وعائلتي وزملائي بالعمل وجيراني وأهل زوجي؟ كيف سأواجه طوفان الأسئلة ونظرات الاستنكار والسخرية والتفحص.
نقطة الصفر
في البداية أخبرت زوجي بقراري ووضحت أنه قرار ولا داعي للنقاش، فاحترم ذلك رغم تخوفاته وقلقه البادي على ملامحه، ثم رحت أفكر كيف ومتى وأين سأفعلها؟
لم أخلع الحجاب ابتهاجاً بتخرجي وخطبتي وزواجي، كما فعل جيل أمي وأبي، تبارينا كفتيات لهذا الجيل في التزمّت دينياً والتضييق على أنفسنا لكسب التعاطف والتأييد ولننال القبول المجتمعي المشروط... مجاز في رصيف22
أخذ الأمر مني عامين آخرين حتى أجيب على هذه التساؤلات، وعندما رُشحت بالصدفة لحضور مؤتمر صحفي بالإسكندرية مع آخرين لا أعرف أياً منهم، قلت: هذا هو الوقت المناسب.
انا أحتاج أن تكون أول مرة بعد خمسة عشر عام من ارتدائه بين ناس لا يعرفونني، يتعاملون بعادية دون أحكام مسبقة، وأنا أيضاً رغبت بأن أرى نفسي على طبيعتها دون خوف وتوتر، وبالطبع راقني أن يحدث هذا في الإسكندرية، المدينة المرتبطة معي بالميلاد والجنون ورائحة اليود.
تبقى إخبار أبي وأمي كمرحلة أولى من المواجهات اللازمة، ولكني فضلت إرجاءها حتى عودتي من المؤتمر بلا حجاب، ولكن صدف أن يزورني أبي يوم سفري ويراني وأنا أغادر المنزل بشنطة سفر دون حجاب، فيتعجب وينادينى معتقداً أني نسيت أن أضعه على رأسي، فافتح الباب في عُجالة وأنا أرد عليه بنصف وجه قائلة: "لا أنا منسيتهوش أنا خلعته"، ليصمت مذهولاً، وقبل أن يستفيق من دهشته انسحب سريعاً أو فلنقل، هرب قبل أن يبدأ الحساب.
طعم الهواء
لن أنسى ملمس شعري الطويل يطير حول عنقي مُنسدلاً أسفل كتفي ، إحساسي بالهواء يداعب رقبتي بعد 15 عام .
بالطبع كنت أتحرك بحذر وقلق، أرقب نظرات الناس لي في الشارع وزملاء المؤتمر، وكان التعامل عادياً للغاية، فقط كل ما أتذكره أن شكلي أصبح أصغر كثيراً، فجاءني عرض زواج بأول يومين بدونه.
بعد عودتي هاتفت أمي، أخبرتها بما حدث، لم تثُر، فقط عاتبتني قائلة: "بس أنت خلاص كبرتي واتجوزتي وخلفتي، هتقلعيه ليه بقى"، وكأن الهدف كان أن أبقى منزوية مختفية تحته.
أما أبي فأظهر تذمره فور رحيلي من المنزل لزوجي ولأمي، ولم يحدث أبداً أنه تقبل ما قُمت به، وكان يردد: "أعمامك وعماتك هيقولوا إيه، محدش عملها من بناتهم"، أي أن الشكل الاجتماعي كان هو الوازع الأهم لديه، وإن كان التنديد يأخذ الصبغة الدينية في الحديث.
مناورات للتأقلم والموائمة
أصبحت أظهر أقل في محيط العمل، أنتهي من عملي سريعاً لأعود قبل أن يراني أحد زملائي القدامى، وحدثت المواجهات ببطء وروية كما خططت لها.
لا أخفي استعانتي ببعض الحدة والجدية لاضفاء مظهر عملي غير ودود في البداية، خاصة مع الرجال، لأنه من المعروف لدينا خاصة بين أوساط المثقفين، أن من خلعت حجابها ربما تخلع أيضاً مبادئها وأخلاقها إلى أن يثبت العكس.
لازلت أحاول الموائمة بين اختياراتي وأفكاري وشكلي الذى يمليه علي المجتمع، فمنذ خلعت الحجاب أرى تساؤلات عن مدى تغير علاقتي بالله، وعن رد فعل زوجي وأبي وأخي وكل الرجال بدائرتي الأقرب، حتى حارس العقار الذي أقطنه
بعد قليل تعود الجميع على شكلي وأنا أيضاً أحاول أن أتعود.
بشكل ما أصبحت أكثر جرأة بمرور الوقت، وانتقل هذا إلى مظهري العام وملامح وجهي وحتى طريقة سيري، أصبحت أتساءل هل التخفي وراء حجاب يراه البعض خوف، ومن ثم يراني إنسانة خائفة، أو تحديداً امرأة خائفة في مجتمع شرقي ذكوري يستبيح ترويع الخائف؟
وإلا فما التفسير في أن المعاكسات أقل كثيراً، خاصة عندما أواجه المتحرش بنظرات حادة تشى بنمر يستعد للوثب وإن بدا ساكناً ظاهرياً؟
لازلت أحاول الموائمة بين اختياراتي وأفكاري وشكلي الذى يمليه علي المجتمع بكل فئاته ويحارب كل خارج عن سيطرته، أو فلنقل عن قوالبه الجاهزة، فمنذ خلعت الحجاب أرى تساؤلات عن مدى تغير علاقتي بالله، وعن رد فعل زوجي وأبي وأخي وكل الرجال بدائرتي الأقرب، حتى حارس العقار الذي أقطنه.
لكن ورغم مشقة المقاومة، سواء أصبت أو أخطات في قراري، فأنا الآن أكثر اتساقاً مع نفسي شكلا وموضوعاً.
قد يتغير هذا مع تغيري كإنسان يكتسب ويفقد معارف كل يوم، ولكن هنا والآن، في هذه اللحظة، أنا راضية عن نفسي ولا أتمنى إلا السلام لي ولمن حولي.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


