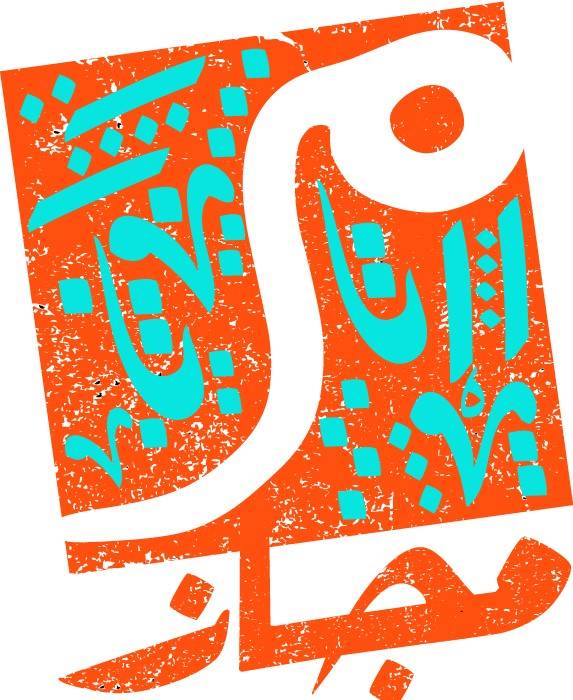 حجبوها عن الرياح
حجبوها عن الرياح
أنا البنت. أنا فرع رئيسي لشجرة عائلة الكوتشينة، أنا بجوار الولد "الملك الذهبي" والشايب "العجوز" و الجوكر "المهرج" لكن دون جدوى، فأنا ورقة خاسرة دائماً، لا تساوي إلا ورقة عليها ملكة مثلها، أهميتها الوحيدة هي لا جدواها، أنا هنا لأكمل صورة اللعبة الأصيلة، فلا يوجد ملك دون ملكة، لا شايب دون ابنة ولا جوكر دون بديل، غيابي سيجعلها ناقصة بعلامات استفهام من عار، وحضوري يجعلني النقيصة وكل العار.
التتويج
كان عمري حينها ثلاثة عشر عاماً، أي لا أفقه شيئاً في الحياة، ومع ذلك كنت أدرك أنني أكره التوجيه والاقتحام والتتويج، ذات صباح ضربت معلمة العربي "مس ذهب"، قبل بدء الدرس ونحن في الصف الأول من المرحلة الإعدادية، مثالاً بسيطاً لتوصل لمجموعة من المراهقات المتهورات فكرة مراقبة الذات والاعتماد على النفس. قالت: "لو انتي جاية تطلعي من بيت أهلك على المدرسة، وتركتي شنطة كتبك في البيت وما حدش انتبه عليكي ونسيتيها طبيعي راح يكون يومك؟".
أجبنا بصوت جماعي، بنغمة حماس شقية ونحن نمط الكلمات: "لا يا مس ما راح يكون يومي طبيعي". صمتت ثم ضربت مثالاً آخر وهي تسير بين مقاعدنا: "ولو طلعتي لابسة مريول المدرسة ومعاكي شنطة كتبك وحجابك مو على راسك راح يكون شكلك طبيعي؟". هذه المرة أجابها الجميع بنفس الإجابة والنغمة الشقية الممطوطة، أما أنا فالتزمت الصمت، تنحيت عن صفوف الجماهير ورحت أهمس لنفسي: "آه راح يكون شكلي طبيعي ويومي طبيعي، وليش ما يكون طبيعي يعني؟" .
لم تكن "مس ذهب" الموجّه الوحيد نحو ضرورة الحجاب، لأن معظمنا قد بلغ أو على وشك البلوغ، ولم تكن روايات المعلمات حينها مجرد روايات ومهمة روتينية، بل كانت إيماناً عميقاً قادراً على زرع نفسه داخلنا من فرط نقاء أرواحنا ومن فرط صدقه داخلنا، ولكن هناك شيئاً ما ناقصاً يجعلني أرغب في التنحّي عن صفوف الجماهير، لكنني أظل فيها بشكل زائف لأن القطيع دائماً على حق ودائماً أكثر أمناً.
كنت أرتدي الحجاب قبل بلوغي بكثير، أنا وبنات جيلي، لكوننا أطفالاً نحتل مقاعد مدرسة حكومية في منطقة نائية جداً، لا نتخلى عنه أبداً في فصل الشتاء من كل عام، منذ نعومة أظافرنا، فهو مصدر الدفء بالإضافة الى كونه يمثل فاصلاً طويلاً يمنح الأمهات قسطاً من الراحة، فتسريح شعورنا يومياً في صباحات أيام الشتاء القاسي أمر أكثر قسوة، ومع عودة الصيف نخرج منه ويدخل هو خزاناتنا، مع المعاطف الثقيلة والقفزات السميكة والأحذية المبطنة الطويلة.
ومع انتهاء كل شتاء، أجد نفسي أصعد في آخره درجة نحو الوعي والإدراك، وأصعد أيضاً درجة أخرى نحو العقد والارتباك، عقد مكونة من مركبين مختلفين، الأول هو كراهيتي لطبيعة شعري، والثاني تمسّكي باستمرار كشفه. أراقب زميلاتي ذوات الشعر الناعم الانسيابي وأسرح فيهم وكأنني أمام اختراع من عالم آخر.
أتساءل، كيف يمكن أن تكون الشعرة نائمة مستقيمة حريرية ناعمة، لا تحمل صاحبتها معاناة تصفيفها ولا تُعايَر بها، حتى تلجأ لحجبها عن العيون من أجل إخفاء بشاعتها وجمودها. ذات مرة كنت أحلّ مسألة رياضيات معقدة على السبورة، وكانت معلمة الرياضيات حينها جميلة جداً، وكان اسمها تسنيم على الأوراق الرسمية، أما بيننا كمراهقات كنا نسميها المس "الزاكية"، كناية عن جمالها باللهجة العامية هناك.
أنا البنت. أنا فرع رئيسي لشجرة عائلة الكوتشينة، أنا بجوار الولد "الملك الذهبي" والشايب "العجوز" و الجوكر "المهرج" لكن دون جدوى، فأنا ورقة خاسرة دائماً... مجاز في رصيف22
كانت منقبة، ولا تنزع نقابها عن وجهها في صفنا إلا قليلاً، بحجة أنها تختنق من الطباشير، أما حقيقة الأمر فهي أنها تخشى على جمالها من عيون مراهقات بدويات، بشرتهم سمراء وملامحهم متشابهه تفتقر لأي علامة جمال من العلامات التي تنعم هي بها، عدا الشعر، فـجميعهن من ذوات الشعر الجميل. كنت أنا دخيلة على القرية، والوحيدة في الصف ذات بشرة أفتح قليلاً من الأخريات، ملامح غريبة عنهم وبشعر مجعد أفريقي.
انتهيت من حل مسألة كانت تحتاج الى فتاة من الأوائل دائماً، شعرت بتميز رائع، وتسنيم تقف خلفي وتقول بصوت مشحون بالحماس: "ممتازة جداً... صفقولها". صفق الجميع وامتلأت بالغرور، وقبل أن أغادر من أمامها لمقعدي، التقطت آخر جديلتي وقالت: "شوفي شعرك متل الخريس بس ذكية والله".
انقبضت ملامحي وضحك الجميع ببراءة، لم تكن هذه المرة الأولى أو الوحيدة التي يطلق على شعري الخريس، والخريس هو لفافة من الأسلاك المصنوعة من الستانليس الحاد جداً، ويستخدم في تنظيف الأواني المعدنية، ابتلعت تسنيم المغرورة ما تبقى من سخريتها، حين بلغ إحراجي ذروته وغزت الدموع عيني، فقالت بغرور غاضب: "اخرسوا شو بضحك؟ بكفي أن شعرها نضيف... بكره فيه تفتيش على نضافتكم أنتو من القمل".
ثم نظرت إلي وواصلت: "بنشوف مين اللي راح يضحك بكرة". وكأنها تقذف في وجهي ما أكلته بغرورها من كرامتي، لتراضيني بعدما شعرت بخشونته في حلقها الماسي. ثم أشارت لي بيدها بحركة تمثيلية تلف فيها يدها حول رأسها المخمر، وقالت: "وانتي بتلبسي شال"، أي حجاب.
كانت تسنيم أول من استخدام الحيلة الأفضل على الإطلاق لأخضع لفكرة التتويج، أي ارتداء الحجاب، بنفس منكسرة، لعبت على نفسيتي التي تزداد سوءاً إثر سوء أحوال شعري، كونه مجعداً، كثيفاً، طويلاً، مرهقاً في تصفيفه وتجميله، وفي النهاية حلّه الوحيد جديلتان فوق أو بجوار بعضهما والكثير من الدبابيس للسيطرة على جفافه وهياجه، الأصول الأفريقية الجنوبية تطفح هنا لتخلق مني طفرة منبوذة بين مجتمعي الصغير الذي تتزين كل بناته بشعر بدوي رائع.
وصلنا جميعاً الى الصف الثاني من المرحلة الإعدادية، وهنا أصبح الحجاب شيئاً الزامياً، صيفاً وشتاء، داخل المدرسة، ومن المفترض خارجها، وكوني لا أنتمي لأصول بدوية، وكوني دخيلة على البلدة كلها لظروف عمل أسرتي في تلك المنطقة، كنت أشعر بتميز فلسفي فارغ، كل أبعاده هو في سماح أسرتي لي بارتداء البنطلون الجينز على السترات القصيرة، وسماحهم لي أيضاً بكشف شعري خارج المدرسة، أذكر امام زميلاتي المتكبرات بجمال شعرهم نعيم الحرية وكيف أتوسد ريشه، وأخفي عنهم مقصلة اللوم اليومية إثر تمردي على الحجاب.
في صباح مشمس، نزل مكوك فضائي على صحراء مدرستنا، وكان على هيئة معلمة في آخر العشرين، اسمها آية، لا ترتدي الحجاب، أصلها من العاصمة وجاءت لتدرس الصفوف الابتدائية كمعلم احتياطي في مدرستنا، كنا ننظر إليها طوال الوقت، ونراقبها لتتأكد أعيننا من وضوح قبحها المفترض، لأنها "مفرعة"، أي لا ترتدي الحجاب بالعامية هناك، فنندهش من لطفها البالغ ورقتها، فنبحث عن عيب من قبيلة أخرى، ونستدعيه لوصمها به بيننا، فهنا لا مجال لتكسير أي أصنام.
رحت أذكرها ليلاً ونهاراً في بيتنا. أبدأ الحديث بكلمة المعلمة "المفرعة"، ثم أستدرج كل ما هو جميل في الحياة وأخبطه بها، "مس آية جهزت غرفة خاصة للصلاة في المدرسة. مس آية دفعت الرسوم عن غير القادرين. مس آية ستتزوج من شيخ جامع. مس آية تصوم نوافل"، وآية لا تدرس إلا المرحلة الابتدائية وأنا في الإعدادية، ولم يسبق لنا أن خضنا أي حديث خاص أو عام، لكنني اعتبرتها حيلة أو كذبة بيضاء ، طعم ألقيه لأكشف من خلاله عن نوايا احتمال استمرار كشف رأسي مع الاحتفاظ بالأخلاق والنبل.
عاشت جملة والدتي داخلي سنوات، وهي تحسم نتيجة مؤامرتي الطويلة لصالحها في نصف دقيقة: "ما دخل الحجاب بالأخلاق وأكيد آية معلمة محترمة، بس إحنا ما دخلنا فيها. انتي راح تتحجبي مشان شعرك بشع، ومشان الله راح يحاسبنا نحنا عليكي، ومشان ما تفوتي جهنم بطيارة"
وكانت الإجابات دائماً مخيبة لظنوني، فأفراد عائلتي يمتلكون وعياً يجعلهم قادرين على قبول آية واحترامها، ولكن دون تقليدها أبداً. عاشت جملة والدتي داخلي سنوات، وهي تحسم نتيجة مؤامرتي الطويلة لصالحها في نصف دقيقة، بجملة قصيرة موجزها: "ما دخل الحجاب بالأخلاق وأكيد آية معلمة محترمة، بس إحنا ما دخلنا فيها. انتي راح تتحجبي مشان شعرك بشع، ومشان الله راح يحاسبنا نحنا عليكي، ومشان ما تفوتي جهنم بطيارة".
لعبة الشايب
استأصلت من أوراقي الدفاعية كل آلياتي المسكينة، وتمسكت بآلية الحيلة، على أمل أن أربح هذه المرة، ورحت أدسّ الحيلة كما أدسّ عجوز الكوتشينة في لعبة الشايب بين الأوراق الأخرى لنتبادلها على طاولة اللعب أنا ووالدي، حتى يصبح الشايب بذكاء أو دهاء من نصيبهم، فيخسروا اللعبة وأربح. فأصدر عليهم حكماً بالصمت لأكون كما أحب.
تجلّت حيلتي الأولى في صورة الحشمة مع كشف الرأس، كنت أرتدي سترات طويلة الأكمام على جينز فضفاض، أنظر وأنا ضئيلة داخلهم إلى عرض السماء، والخجل والذنب مكومان داخلي، أوجه رسائلي الى الله أطلب منه الغفران كوني إلى الآن كاشفة لشعري المجعد، وبطفولة أطلب منه ألا يرى هذا الذنب، وأن يعتبره تعويضاً لي عن خلقي بشعر كالخريس. أعده بأن تظل ثيابي محتشمة، وأطلب منه أن يسمح لي بهذا الذنب، فتنزل مشيئته كالمعجزة على عائلتي فيتركوني وشأني. أظل ساعات وساعات يومياً أمارس الدعاء والتذلل ثم التحايل حتى أغفو، فأراني في منامي معلقة من جديلتي الجافة فوق حفرة عميقة من النار، لأستيقظ بفزع وأجد ورقة الشايب تحت وسادتي الباردة، فأدرك أنني قد خسرت في هذه الجولة.
أما حيلتي الثانية فأخذت هيئة الفلسفة الفارغة، أكشف شعري للسماء وأحجبه عن البشر أملاً في تساوى كفتي الميزان، أخرج مع أهلي الغاضبين من تبرجي البريء، وأصرّ على بقائي في السيارة حتى لا تراني أعين الغرباء وأنا مكشوفة الرأس فيأثمون، أزحف بجسدي من فوق الكرسي الخلفي من السيارة كلما صفت بجوارنا سيارة بها رجال، وأضع راسي بين فخذي لأغيب عن أعين الذكور المارين بجوار نافذتي، حتى أتجنب ذنباً يلقي في حجري ورقة الشايب الذي تخلصت منها بشيء كالمخاض بعد جولتي السابقة.
أما حيلتي الثالثة فكان هدفها أن أصبح بشعر جميل. ربما كانت عائلتي تصر على حجابي حتى لا تعاير بشكل شعري الذي لا يليق بطفلة رقيقة، فحرقت شعري المجعد وأنا أحاول كيّه من خلال ملعقة طعام معدنية، أضعها لتسخن على عين تدفئة الغاز. نجحت يومها في كيّ أول خصلة منه، اكتسبت الخصلة انسيابية تشبه الحلم، ورحت أتخيل شعري بأكمله وهو منسدل على كتفي كطرحة حريرة، أكشفه بغرور أمام تسنيم وذهب ووالدي وكل الرجال، وأقبل الإثم على صفحتي البيضاء وأنا راضية لشعوري بالعدل، لأن أمام الذنب سأقتني صكوك الاعتراف بجمالي لأول مرة في حياتي.
تركت الملعقة على التدفئة طمعاً في نتائج أفضل تقربني من تحقيق أحلام يقظتي التي ذبت فيها، فاحترق شعر مقدمة رأسي بالكامل وجبهتي، وسريعاً تحول الحلم الى كابوس حي، وضمد الشايب بنفسه حريقي وقروحي بالحجاب.
أوجه رسائلي الى الله أطلب منه الغفران كوني إلى الآن كاشفة لشعري المجعد، وبطفولة أطلب منه ألا يرى هذا الذنب، وأن يعتبره تعويضاً لي عن خلقي بشعر كالخريس... مجاز في رصيف22
خضعت. حجبت شعري بشكل رسمي عن الأعين، وغلفت جسدي بسترات قصيرة على بناطيل ضيقه جداً، وهذا عكس لباسي حين كنت أكشف رأسي، وكانت هذه الطريقة بمثابة محاولة أخيرة لتقليل شعوري بالخسارة.
لعبة القشاش
ولى حكم الملكات ودوّن ورقة الولد الذهبية على أرض طاولة اللعب نسبة الربح الضئيلة جداً، حتى وإن كانت اللاعبة ملكة.
تقبلت أنني فتاة محجبة ومضيت مع الأيام كما تريد، ارتديت الفساتين المحتشمة والبناطيل الضيقة والتنانير الطويلة وكل ما هو أنيق، وظلت هيئتي مميزة ومتجددة، لا ينقصها شيء سوى شعوري بها ورؤيتها كما يراها الآخرون، لم أثق يوماً بنفسي ولم أر نفسي جميلة أبداً، ومع كل رسالة مديح تصل لي من محيطي، أنفر وأشعر بزيفها، اعتبرها مجاملة وخدعة، ربما لسيطرة فكرة أنني ملك لهم، وأن هيئتي هذه هي اختيارهم ليقبلوني بينهم، ويمنحوني ختم الشرف والطهارة ومساحة من القبول للتعايش السلمي.
لم يأكل الحجاب من جمالي شيئاً، ولكنه كأن يأكل من رأسي طول سنواتي، عشت مصلوبة تحته حتى اعتدت وضع الصلب وتوحدت معه، ولم يعد يشغلني التحرر منه بشكل ملح، بل أصبح حيزاً جيداً اختبأ تحته، لأضمن الحد الأدنى من سلامتي في المجتمع، وتصالحت كثير مع ذاتي وأيامي، وأصبح شعري موضة واسمه الكيرلي لا الخريس، وصارت والدتي تفتخر بجمالي وثقافتي، ووالدي يعتبرني أيقونة للتربية المثالية، وأصدقائي يجدونني مرسى آمناً، وأنا اليوم لا أكره الحجاب ولا أحمل للمحجبات أي ضغينة، وليس لدي أي فلسفة عميقة لأفهم أبعاد رغبتي الدفينة بخلعه، ربما أريد تقليص المساحة بيني وبين الصغيرة التي تعيش داخلي.
صحيح أنها كبرت واشتد ساعدها، ورممت صورتها الذاتية الى حد معقول، وأصبحت جديلتها سيفاً يقطع يد تسنيم، لتموت بعد أن يسيل سمها، ولكنني ما زلت غير قادرة على عناقها والتوحد معها، لنقوى ببعض ونصبح نسخة واحدة واضحة، صلبة، نهائية.
ألعب يومياً لعبة الإيمان والكفر مع أسراب الطيور المغطاة من نساء العائلة والأصدقاء والجيران، أفتخر أمامهم بصلبي، وأسأل الله أجره وأستودعه ثباتي، وسراً أهب صديقي صور رأسي وهو حر، لامتلئ بلذة نظري لنفسي وهي تتماسك من الداخل والخارج، فتصبح كفسيفساء أثرية تستطيع أن تتحدث عن نفسها وعن تاريخ ملأت ملاحم الحياة طوله وعرضه، أفيق بعد دقائق وأعود خائفة من وصم الكفر بعد الإيمان، ومن مواجهة حكم الارتداد لأنه القتل.
ملكة على ورق الكوتشينة
أنا الملكة التي تعيش على ورق الكوتشينة، أنا الرموز ذات المعنى، أنا في تاريخ الورقة السيدة رشال "سارة" زوجة نبي الله ابراهيم، المبجلة عند المسلمين والمسيحيين واليهود، والآلهة أثينا الهة الحكمة والقوة، والملكة أرجين اللاتينية، وفي حاضر الورقة كومبارس صامت.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


