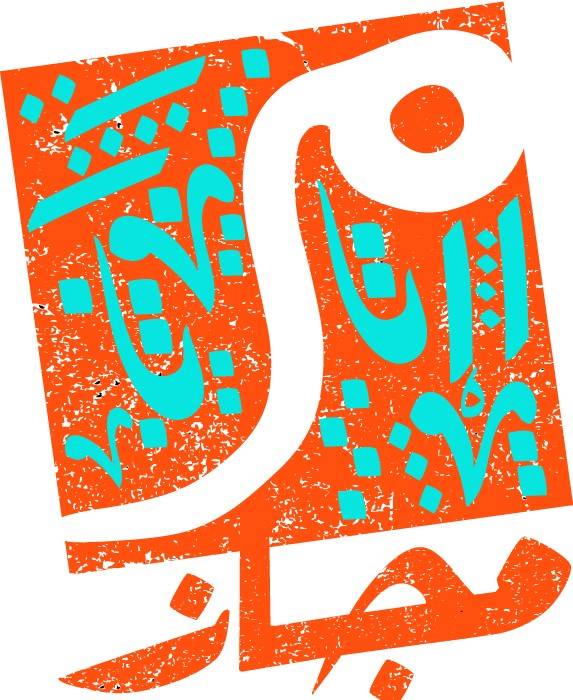 الحميم، البيوت التي نسكنها فتسكننا
الحميم، البيوت التي نسكنها فتسكننا
إعداد أحلام الطاهر
بيوت ملونة
كنت أسمّي بيوتنا السابقة بحسب ألوانها في مخيلتي، البيت الأخضر، البيت البني، البيت المُترَب، البيت الأرجواني، البيت الذي يشبه لونه ألوان لوحة لكاندينسكي، والبيت الأبيض الكامد، هذا كان أكثرها حزناً، مع أنه كان كبيراً ومُضاء ورحباً، وحين انتقلنا إليه تخيلت أننا سنصنع منه نسخة قريبة من بيت جدي، البيت الأبيض الناصع، لكننا فشلنا في ذلك وتركنا دخان أيامنا البائسة يعلق على جدرانه وصراخنا يترسب بين حدود الرخام على الأرضية.
حين غادرناه بدا كبيت متهالك، تقيأَنا خارجه ودخل المصحّة النفسية مباشرة، كان ذلك هو البيت الذي حاولت فيه شقّ معصمي مرتين على بلاط الحمام البارد، لكن السكين رفضت ذلك، أو ربما لم تكن حادة بما يكفي، والبيت الذي ابتلعت فيه كل الأدوية المخزّنة في البراد دفعة واحدة، وكانت غرفة نومه هي الغرفة التي حملت فيها سلاحاً وصوبته إلى رأسي لأدرك لحظتها أن الموت ليس مزحة، وأنني لو متُّ هنا، فلن تغادر صورتي أذهان عائلتي وسكان الحي وحتى أصحاب المنزل الأصليين، ولم أرد أن تعيش صورتي إلى الأبد في تلك الغرفة، لأن " الموت، قبل كل شيء صورة، وستظل صورة".
تمنيت لو يعيدوننا أهلي إلى البيت الأخضر، حيث لم نكن مستأجرين، ولم نكن نستصعب حفر ثقب في الجدار لتعليق صورة أو لوحة، لكنهم نقلونا إلى البيت الأرجواني. أحببت ذلك البيت كثيراً، واعتبرت أنني بدأت حياتي فيه، مع أنه كان أول بيت أهرب منه، أو ربما لأنه كان أول بيت أهرب منه، وأعود طواعية.
ذلك هو البيت الذي حاولت فيه شقّ معصمي مرتين على بلاط الحمام البارد، والبيت الذي ابتلعت فيه كل الأدوية المخزنة في البراد دفعة واحدة، وكانت غرفة نومه هي الغرفة التي حملت فيها سلاحاً وصوبته إلى رأسي... مجاز في رصيف22
خرجت بحقيبة صغيرة، مغلقة هاتفي وعقلي، أحمل أمنية واحدة هي ألا أرى مدينتي تلك ثانية. لكنني تحت التهديد والترغيب والابتزاز العاطفي والتدخلات الديبلوماسية، عدت إليه. استقبلني بمصافحات باردة ونظرات عاتبة وبعدها بمحاولات انتقام، لكنني أحببت الليالي فيه، وكتبت فيها مجموعتي الأولى من القصص، حتى حين صدرت كنت أنام محتضنة النسخة كما لو أنها طفلي الصغير.
بيت جدي
بحثت عن بيت جدي في كل البيوت التي سكنتها، والتي زرتها، وفي الأفلام التي شاهدتها، حتى رأيت شبيهاً له في بعض الأفلام اليونانية التي تجري أحداثها في السبعينيات أو الثمانينيات. كان بيتاً كبيراً جداً، وهو البيت الوحيد الذي حاز على اللون الأبيض في مخيلتي، لا أعرف السبب، ربما كان الضوء القوي الذي يدخل من الشبابيك على الملاءات القطنية البيضاء المطرزة بأيدي جدتي وخالتي، أو الوسادة التي نقشت عليها باللون الأزرق عبارة "صباح الخير"، بالحنان المألوف لأحلام الطفولة.
كان البيت الذي استثمرنا كل إنش منه في مغامرة ما، إما في القفز على الأسرة، أو اكتشاف الأغراض السرية لأصحابه في أعماق الخزائن، الصور التي لا تتبدل ولكن يضاف إليها على حواف مرايا غرف النوم، أو البهو الطويل الذي نتزحلق عليه في أيام الشتاء حين ينزوي كل الكبار في الصالون المدفأ والمفروش ببطانيات الصوف المحاكة يدوياً أيضاً.
من شدة ما تعلقت بذلك المنزل، لطالما ظننت أنه ربما كان حلماً جميلاً، لكن لو لم تكن الستائر السميكة على شبابيكه الشاسعة، ولو لم يكن أصيص شتلة الفراولة على زاوية الشرفة، ولولا الأغطية المرتبة فوق بعضها فوق طاولة خشبية في الزاوية، والكومودينة في الصالون وصحون الضيافة البلور والبورسلان المرصوفة بعناية في رفوفها، لما كنت أنا الآن، أمشي في السوق أبحث عن تحف الفخار والبورسلان الملونة بالأبيض والأزرق، والقطع الخشبية المحتوية شقوقاً والتي تبدو كما لو أنها محمولة من مكان بعيد.
كنت أنهض في الليل كي أكتب نصّاً فتتجمد أطراف أصابعي وتقتلني الشفقة على نفسي... مجاز في رصيف22
حتى الآن ما زلت حين تمر ساعة كئيبة وطويلة، أشعر أنها تشبه الساعة التي تنام فيها خالاتي وجدي وقت الظهر، حين يهمد البيت ويصبح لونه رمادياً مظللاً، حتى يستيقظوا وترش جدتي الماء على أقدامنا فوق إسفلت السطح الذي أصبح اليوم بيت خالي، وحتى الآن ما زلت حين أتخيل مكاناً سرياً، أتخيل العلية ذات الدرج الحجري، العلية الوحيدة التي رأيتها بهذه الهيبة، لها درج وسط المطبخ تحته خزانة صغيرة، وفيها ارتصفت "قطارميز" الزيتون والمكدوس والمخلل وزجاجات الزيت والبهارات والملوخية المجففة وغيرها كثير من الخفايا، لطالما تمنيت لو تكون تلك العلية غرفتي، أو لو يدعونني آخذ فيها غفوة واحدة على الأقل، دون أن يصرخوا عليّ كي أنزل.
بيت في الغد
حين غادرت بيت أهلي، كنت أنوي أن أجعل بيتي القادم شبيهاً ببيت جدي، بكامل ثقتي اعتقدت أنني سأتمكن من ذلك، لكن دمشق لا تترك لأحد الفرصة لأن يختار أي شيء فيها. عشت أيامي الأولى في غرفة صغيرة مستقلة لها شباك صغير اضطررت لإلصاق الستار عليه بلاصق الورق لأنني لم أتمكن من إيجاد تقنية أخرى، ولم أعرف أن الوحشة فيه كانت تتهيأ لقتلي، حتى صارت نوبات البكاء تداهمني ليالي بأكملها، وكنت أحتاج أن أبقى على الهاتف عشر ساعات متواصلة مع الرجل الذي كان في حياتي حينها، كيلا أموت من الذعر والوحدة.
هذا كان مستغرباً، لأنني حين قررت أن أعيش وحدي، ظننت أنني سأنام مطمئنة، أن البيت بيتي والخزانة خزانتي والشباك شباكي، لكنني حتى لم أطلق عليه تسمية "البيت"، وبقيت هذه الكلمة خاصة ببيت أهلي، بينما هو يطلق عليه "البيت الذي في الشام"، انتقلت بعده إلى بيت فارغ شاركتني فيه صبية صامتة. كان بارداً، ولم أكن أملك شيئاً، كنت أنهض في الليل كي أكتب نصّاً فتتجمد أطراف أصابعي وتقتلني الشفقة على نفسي، حتى حين أرسلت لي أمي بطانيات ومدفأة، وبعض أشيائي الخاصة من البيت، منها دميتي والكوب الذي فيه أقلامي، غرقت في بكاء مرير، وتذكرت أننا " تعود بنا صحبة الأشياء المألوفة إلى الحياة البطيئة. ونؤخذ بالقرب منها بنوع من الحلم الذي له ماض، لكنه ماض يستعيد في كل مرة طراوته".
تنقلت في الشام كثيراً، بيتاً تلو بيت نما الشعور بالاعتياد، علقت صوراً على الجدران، وأحضرت أغطية للطاولات بيضاء ومطرزة، شيئاً فشيئاً صار البيت الذي أسكنه هو "البيت" والآخر "بيت أهلي"، وصرت حين تزورني أمي وأقول لها: لا تجلسي في هذا الركن لأنه بارد، تصيبني القشعريرة، وأرغب لو أضحك وأبكي معاً، وأتساءل كيف حصل الأمر في غفلة مني. صنعت لنفسي بيتاً، ورغم أنه بلا نافذة، أشاهد منه المدينة أو المطر، والنافذة الوحيدة فيه كلما فتحتها رأيت جارنا المقابل عارياً أو نصف عارٍ في أحسن الأحوال.
إلا أنني أداري كل زاوية فيه، وأداري حتى اليمام الذي يجعل حبل غسيلي سلة مهملاته، وأقول ربما هم أيضاً يعتبرون البيت بيتهم، وحتى حين أخرج إلى مقهى أشاهد منه الناس والمارة، أتذكر القول الشهير لصديقتي: "إن العودة إلى البيت، رغم أنها أكثر الأفعال اعتيادية، تبقى أجمل ما يمكن أن يفعله المرء على الإطلاق".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


