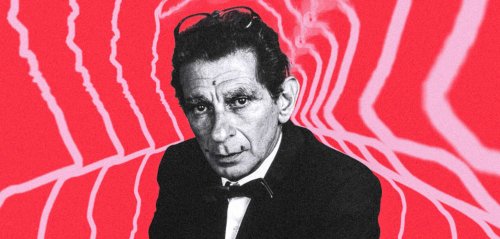عرفت السينما انتشاراً واسعاً منذ لحظة اختراعها وترويجها تجارياً. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، وبينما كان العالم يستعد لاحتضان فعاليات أحداث الحرب العالمية الثانية، والتي ستشكل لاحقاً ملامح عالمنا المعاصر، كانت السينما هي الأخرى تستعد لدخول مرحلة الصناعة والتجارة، وما إلى ذلك من دعاية، وأيديولوجيا، وتوظيف سياسي، لتكون قاعدة العصر الكولونيالي الجديد عبر استغلال السلطة الناعمة، الثقافة، لننتهي إلى هذا العالم المعولم الذي نعيش فيه.
فما مدى ارتهان السينما للسياسة، والتوظيف السياسي؟ وما هي العوائق أمام النهوض العربي في مجال الفن السابع؟
السينما المصرية... حرية النقد البَعدي
منذ البداية، ونتيجة الحضور الاستعماري الغربي أساساً، وانتشار الخواجات، لم تتأخر تكنولوجيا التصوير السينمائي عن ولوج الساحة العربية، إذ لم يمضِ أسبوع واحد على عرض أول فيلم تجاري بالمعنى المعاصر أواخر سنة 1896 في باريس، ليُعرض بعد ذلك في مقهى في الإسكندرية، ثم في القاهرة بعد شهر.
لكن السينما بقيت إلى حدود الخمسينيات امتيازاً طبقياً نخبوياً في إنتاجها، واستهلاكها، وفي قطيعة عضوية مع الوسط الشعبي. مع بداية الفترة الناصرية، ستشهد السينما المصرية طفرة نوعية أكثر واقعية واشتباكاً، إذ قرر نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر آنذاك تشييع "الكارفانات" الثقافية لتطال العمق المصري، بأريافه وبواديه، كما تزامنت تلك الفترة مع استحداث مؤسسات عمومية عدة بهدف تأميم القطاعات الفنية بصفة عامة، في إطار السياسة القومية الناصرية، كاستحداث المعهد الأعلى للسينما (1959)، والمؤسسة المصرية العامة للسينما، ومؤسسة دعم السينما (1957)، وكذلك تأميم ستديوهات مصر التي كانت مملوكة من مجموعة بنك مصر، والتي كان قد أسسها سنة 1935 طلعت حرب، أبو الاقتصاد المصري الحديث، وصولاً إلى استحداث معهد كتابة السيناريو، والذي كان فريداً من نوعه في العالم آنذاك.
التحييد السياسي للسينما هو سياسة في حد ذاته. وبهذا يمكن الحديث عن أكثر من نصف قرن من تعاطي السينما المصرية مع السياسة
كانت هذه المؤسسات، وهذا الحراك الثقافي، من أسباب انفراد مصر بصناعة السينما في العالم العربي، وبروز جيل من السينمائيين، مخرجين وممثلين وتقنيين، على غرار صلاح أبو سيف، ويوسف شاهين، وعمر الشريف... والثمرة كانت مجموعة من الأفلام كمّاً، نحو 60 فيلماً سنوياً، ونوعاً كفيلمي "العصفور"، و"الأرض"... ما شد أنظار العالم الثقافي إلى الصناعة السينمائية في مصر.
يُعد فيلم "الأرض" (1969) من أبرز الأمثلة على بداية انتقال الكاميرات من الواقعية المعيشية اليومية، والأفلام الغنائية، إلى تناول المحرمات السياسية. سمحت الرقابة المصرية طوال عقود بتناول أفلام مشابهة، إذ سعى كل نظام إلى أفلام تتناول النظام الذي سبقه.
سمح نظام عبد الناصر بتناول الغطرسة الأرستقراطية تجاه صغار الفلاحين في مصر الملكية في فيلم "الأرض"، في حين طال الحظر أفلاماً أخرى، بحجة المؤامرة الإمبريالية، أو المقدسات الدينية والوطنية، ومُنعت من العرض، على غرار فيلم "القضية 68" لصلاح أبو سيف، والذي يتناول بالنقد الفترة الناصرية، والاشتراكية العربية، وما عرفته من الفساد الذي استشرى بين موظفي الحكومة آنذاك.

من الناحية الفنية، مثّل الاعتماد على الروايات والأدب جوهر العملية السينمائية، وهو ما يُعد من نقائص السينما المصرية في تلك الفترة، إذ لم تغادر عدسات السينما صفحات الروايات، وهو ما يعبَّر عنه بالعقلية الأدبية.
الإنتاج المكثف للثقافة الشعبية
تُعد الستونيات، وبداية السبعينيات، الفترة الذهبية للسينما المصرية من الناحية الفنية، ومن ناحية الرسائل الرمزية التي تضمنتها. في إثر ذلك، ستدخل السينما عصر التحييد السياسي، عبر الإنتاج المكثف للثقافة الشعبية الكمية (Mass popular culture) المتمحورة أساساً حول الكوميديا، والمعيش اليومي، والدراما، في تنافس مع الوافد الجديد آنذاك، سينما "التلفزيون"، والمسلسلات.
واستمر الوضع على هذا الحال طوال عقود من الحياد السياسي، أو النقد ضمن الأطر في أفضل الحالات؛ أي المطالبة بتحسين شروط العقد الاجتماعي بين الدولة المصرية ومواطنيها، وكذلك الترويج للرؤية السياسية للسلطة في التعاطي مع القضايا "الحساسة"، على غرار فيلم "البريء" (1985)، الذي يصور تعامل نظام مع الشباب الجامعي الاشتراكي المتحمس للتغيير في إطار حملة التطهير ضد المذهب الناصري، و"الأبواب المغلقة" (1999)، وهو فيلم مضاد للإسلاميين تناول قصة استقطاب مراهق من قِبل إحدى الجماعات... وصولاً إلى مرحلة المنصات الرقمية للأفلام التي نعيشها الآن.

"الأفلام كلها سياسية"
الجدل حول إقحام السينما في التهافت السياسي يحيلنا إلى الجدل حول الفن عموماً، والثقافة، والتوظيفات السياسية لهذه المجالات في صناعة الرأي العام، وهندسة المجتمعات، ما يحيلنا أيضاً إلى الثقافة السياسية بصفة عامة، والسينما السياسية.
"الأفلام كلها سياسية"، يحب المخرج اليوناني/ الفرنسي كوستا غافراس Costa Gavras أن يقول في كتاب يحمل عنوان هذا القول نفسه. وينقل عن مؤسس موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الصحافي والمحرر إدوي بلينال، وصفه للسينما بأنها "ملعب للعب الجماعي، وأداة فعل سياسي، وفن شعبي في خدمة أكبر عدد ممكن".
يميل جزء مهم من النقاد السينمائيين إلى عد السينما عملية سرد تصويرية. والسرد مهما كانت أداته، هو حبكة، وأحداث، وكلمات تحمل معانياً، وتلميحات للإشارة، والإبلاغ بما يختلج في فؤادَي المخرج والسيناريست.
هنا، في هذا المستوى، يضطلع كل من المخرج والسيناريست، كمثقفَين، بدور ريادي في نهضة المجتمعات، والتقدم بها. قد تختلف وسائل السعي إلى هذا النهوض، وقد تختلف طرق الاشتباك مع الواقع، والرؤية الإصلاحية له، بين الإصلاح الفوقي، والإصلاح القاعدي، وبين الإصلاح اليميني من الداخل، والذي قد يتحول إلى بروباغندا للنظام، والإصلاح اليساري من خارج المنظومة.
عدا الجانب الفني والمالي، يبقى العامل الأساسي لتطور السينما، كمجال حيوي ثقافي، هو الإرادة السياسية، عبر تبني مشروع ثقافي للنهوض، ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها المجتمعات العربية
هذا الجدل هو موضوع صراع أيديولوجيات القرن العشرين. وكان إدوارد سعيد قد تحدث عن معادلة المثقف والسلطة في كتاب يحمل العنوان نفسه، إذ قال: "السبيل الوحيد إلى ذلك، على ندرته، هو ألا يتوقف المرء عن تذكير نفسه بأنه، باعتباره مفكراً ومثقفاً، يتحمل دون غيره مسؤولية الاختيار بين تصوير الحقيقة بأقصى ما يستطيع من طاقة، وبين سلبية السماع لراعٍ من الرعاة، أو سلطة من السلطات". ويختم: "الطوطم دائماً ما يخذل عباده".
الأفلام التونسية... بين التيه والتخفي في رداء المؤلف
يقول الناقد السينمائي التونسي خميس الخياطي لرصيف22: "ليس هناك سينما تونسية، هناك أفلام تونسية"، وهو قول كان قد أطلقه في مقابلة إعلامية سابقة أيضاً. يقصد الناقد هنا أنه لم توجد صناعة سينمائية بالمعنيين التجاري الترفيهي والثقافي المتعارفين. هناك محاولات منفردة لبعض المخرجين فحسب، إذ لم يتجاوز عدد الأفلام التونسية الطويلة الموجهة إلى القاعات مئة وفيلمين منذ الاستقلال سنة 56، وحتى قيام الثورة التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أي بمعدل فيلمين في السنة.
هي حصيلة هزيلة مقارنةً مع ما قد تنتجه الماكينة المصرية في موسم واحد. أسباب هذا الكسل في الإنتاج عديدة، منها الأنثروبولوجي، كطبيعة المجتمع التونسي الذي لم تنشأ لديه ثقافة فنون الفرجة، والاستعراض الفني، عكس المجتمع المصري الذي عرف مسارح الدمى، والسيرك، والاستعراضات الفنية والعسكرية طوال عقود.
كذلك، هناك أسباب سياسية. ففي غياب رواد الأعمال مثل طلعت حرب في مصر، تُعد وزارة الثقافة في تونس الممول الأول، والمنتج الرئيس للأفلام، طوال فترة نظامي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي الاستبداديَين. فهل كان منتظراً من الوزارة، والسلطة، أن تمول أفلاماً تنقدها، وتعرّي زلاتها؟
باعتماد المثال الثقافي الستاليني، عملت الحكومة على توظيف مجموعة من المثقفين والمخرجين والفنانين، وفي دوائر مغلقة ضمن مجالها الإرادي، لبسط سيطرتها على المجال الثقافي، والسينما كأحد فروعه، وحظيت هذه المجموعة بالجزء الأكبر من أموال الدعم الثقافي.
وتفادياً لإزعاج السلطة، هيمن الفن التجريبي على الفنون جلها في الساحة التونسية. وتحت هذه اليافطة، أُنتجت أعمال عدة بعنوان "سينما المؤلف"، لا يستوعبها إلا طيف نخبوي ضيق.
من جهة أخرى، لم تغادر أعمال سينمائية حدود المتخيل الاستشراقي، استجلاباً لمال الدعم الخارجي الذي يمثل مصدر التمويل الثاني بعد الحكومة، لذا عملت على تصوير "الحمام الشرقي"، والجسد العربي الأسمر البض، وبعض المشاهد التي ترسخ الفكرة الكولونيالية عن الشرق الشهرزادي الذي انتقم له الطيب صالح في "موسم الهجرة إلى الشمال".
في كتابه "الاستعمار الداخلي"، يستعير الكاتب صغير الصالحي عنوان إدوارد سعيد "خيانة مثقفين"، في توصيفه للساحة السينمائية التونسية. كتب تحت عنوان السينما، في عمالة الفن: "وعند التسعينيات، ظهر توجه في السينما التونسية لم تخرج فيه الكاميرا إلا نادراً من أسوار المدينة، متنقلة بين الأسطح والقصور، تكرر نفسها، وتتلهى بصمت العصافير، وبترنيمات حبيبة، وبأنغام مسيكة، وتتفادى إزعاج السلطة التي تقدم الدعم، وترفض رصد الواقع".
فور انفلات المخرجين من قالب الرقابة عقب الثورة، انفجرت كاميرات المخرجين عن 30 فيلماً بين متوسط وطويل فقط بين عامي 2011 و2016، كما اتسعت الساحة للمخرجين الشباب الأقل تموضعاً أيديولوجياً، والأكثر اشتباكاً مع الواقع التونسي، ما ينبئ ربما بسينما تونسية في طور جنيني، في انتظار استكمال البنية التحتية، من قاعات عرض، وشباك تذاكر موحد.
التجارب العربية... فكرة سريعة
عموماً، تتشابه الإشكالات التي تعاني منها بقية التجارب العربية، وتتقاطع حولها. فحتى لو غاب الاستبداد، وعين الرقابة، كما في المثال اللبناني، تبقى العوامل الخارجية كالحرب، وتدني مستوى البنية التحتية للعرض، وعوائق اللهجات، وهيمنة المد الفني الخارجي (الأفلام العابرة للقارات)، عوائق أمام النمو الفني والتجاري للأفلام العربية.
أخيراً، عدا الجانب الفني والمالي، يبقى العامل الأساسي لتطور السينما، كمجال حيوي ثقافي، هو الإرادة السياسية، عبر تبني مشروع ثقافي للنهوض، ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها المجتمعات العربية، كغيرها من المجتمعات، من الاغتصاب والتحرش، إلى التعصب الديني، والهيمنة الذكورية السلطوية، والتي يمكن تناولها، وتفكيكها، وخلق وعي مجتمعي لمحاربتها، على غرار المثال الهوليوودي، أو الياباني، بدل الاقتصار على الحل الأمني، والخطاب الديني.
على الرغم من وجود عدد كبير من المؤلفات التي تدعو إلى تبني وسائل السلطة الناعمة في المعالجة، تصمّ السلطات العربية مجتمعة آذانها، مكتفية بإدارة الواقع، والارتياب الوجودي تجاه كل نقد، أو رأي مخالف.
في فيلم "زوربا" اليوناني، قال أنطوني كوين: "يمكنك أن تطرق إلى الأبد على باب رجل أصم".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.