كان يمكن لفيلم "خطوة بخطوة" القصير أن يكون مجرد مشروع تخرج منسيّ في أحد المعاهد السينمائية في روسيا؛ إلا أن حساسية مخرجه وفهمه العميق للمخاض السياسي الذي كانت تعيشه المنطقة في السبعينيات والثمانينات، جعلت منه علامة من العلامات الفارقة في السينما السورية؛ فكانت تلك الدقائق الـ22 جديرة بتعرية المعنى الحقيقي الذي تنطوي عليه العبارة السينمائية الشهيرة: "عليك أن تصنع فيلمك الخاص".
ففي حقول "الرامة" وهضابها الواسعة ومنازلها الريفية العتيقة، اختار أسامة محمد أن ينسج مكوّنات فيلمه الخاص، ولا عَجبَ في ذلك كون الرامة قرية أسامة التي ولد فيها عام 1954؛ وهي قرية صغيرة بديعة التكوين ترتاح على حافة جبل يطل على الساحل السوري في محافظة اللاذقية. وفي تلك القرية كان صديق طفولته الذي يسميه محمد الزعتر في الفيلم قد عاد من حصار طويل لمخيم "تل الزعتر" في لبنان.
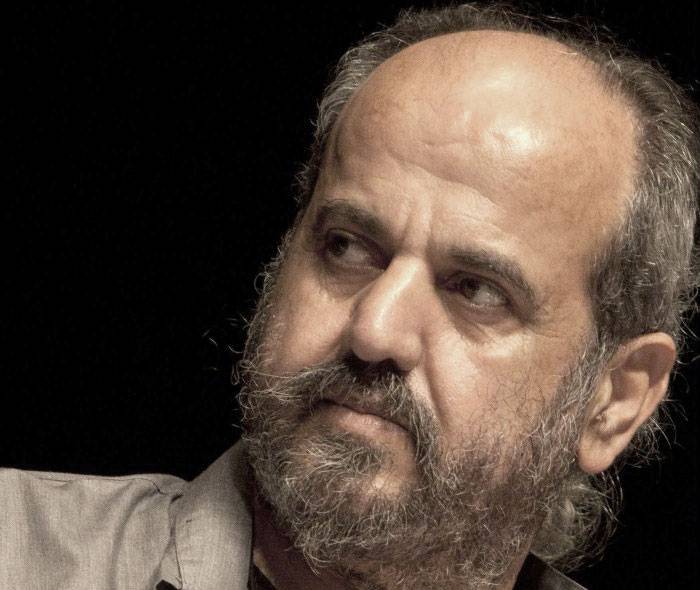 أسامة محمد
أسامة محمد
يقول لنا أسامة محمد عن محمد الزعتر وتلك التجربة: "كان هو سبب تصويري للفيلم، أطلقت عليه اسم محمد الزعتر؛ صديق طفولتي المقرب الذي حاصر مخيم تل الزعتر لمرتين، وتوفي بعد شهرين من تصوير الفيلم، أي أنه قَتَل وقُتِل".
وإذا أردنا الإيجاز في تقديم فيلم خطوة بخطوة، نقول إنه فيلم عن صناعة العنف وإعادة تدويره بطريقة ديناميكية وعقائدية عبر مؤسسات الدولة السورية الخاضعة لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" الذي حكم ويحكم سوريا منذ أكثر من خمسة عقود، عنف تبدأ ممارسته وتوطينه في المؤسسات التعليمية الأساسية لمرحلة الطفولة ويتفشى إلى مختلف المؤسسات، لا سيما العسكرية والأمنية منها.

تدور أحداث الفيلم في تلك القرية المنسية في ريف اللاذقية، ويشكل محمد الزعتر، الجندي السوري الذي شارك في حصار المخيم في لبنان، الشخصية المحورية فيه.
أما هذه القراءة النقدية فتسعى بدايةً إلى تحليل البعد الاجتماعي والنفسي لشخوص فيلم خطوة بخطوة بالاعتماد على منهج سوسيو - سينمائي مُقارب نستعين فيه بكتاب "التخلف الاجتماعي" للمفكر وعالم النفس اللبناني مصطفى حجازي، ومن ثم تنتقل للكشف عن أهم مفردات اللغة السينمائية عند المخرج أسامة محمد ودورها في تشكيل البنية السيميائية/ الدلالية للعرض، ونهايةً تسعى القراءة لتحليل سيميائية الزمن في "خطوة بخطوة" وعلاقتها بالدلالة العامة للفيلم.
وما الرامة في "خطوة بخطوة" إلا سوريا ذلك الوقت؛ سوريا التي كانت تحتقن بانتظار الانفجار الكبير، وانتفاضة الأنفاس الأخيرة التي ستُطمر حية في ما بعد؛ ليبقى المشهد كما هو: الشعب نفسه، والقتلة نفسهم، لكن على نطاق الجغرافيا السورية بأكملها، وبعنف أكبر وأشد.
"أبو سليمان صار جبلاً"... مأزق إنسان الرامة
لا ينتهج فيلمنا النهج التقليدي للسينما الروائية، فلا ينطوي مثلاً على قصة محبوكة أو شخوص تُبنى شيئاً فشيئاً مع تقدّم زمن العرض؛ ولكنه أقرب للأفلام التي تمزج بين عالم العرض التقريري/التوثيقي وعالم العرض المتخيَّل الذي يشتمل على بنية دلالية موجّهة ومقصودة.
بعد افتتاحية الفيلم التي تلتقط سير أطفال الرامة بخطاهم الوئيدة المتثاقلة إلى مدارسهم، يقودنا أسامة محمد إلى عمق المنزل الريفي لهذه القرية المهمّشة؛ فنرى أبو محمد وهو عجوز ستيني بحطّة وعِقَال، يصدحُ بصوت جبلي مهزوز:
"جبل عالي، جبل عالي، والعالي هو جبلنا، أوف يابيي
أبو سليمان صار من أمر الله جبلنا...
وبعون الله والخضر، كان الله قدّر أبو سليمان".
يبدو هذا المشهد الغنائي بمثابة خلاصة دقيقة لعلاقة أبي محمد بقائده ورئيس الجمهورية السورية آنذاك حافظ الأسد (أبو سليمان) من جهة، والطبيعة (الجبل) التي يعيش تحت كنفها من جهة أخرى.

موال تنسج كلماته عناصر الطبيعة وأوصافها الجبارة بالقائد المُقدَّر من الله (أبو سليمان صار من الله جبلنا)، فالقائد بهذا المعنى، وكما يصف مصطفى حجازي هذه الظاهرة النفسية، "يُسْتَدْمَجُ" بالطبيعة الأم في لاوعي العجوز أبو محمد.
وبالرغم من أن حجازي يعاين واقع الإنسان المقهور في كتابه ذاك بمنأى عن فيلمنا هذا ومشاهده التي ستذكر على امتداد القراءة، إلا أنه يُسعفنا إلى حد كبير في الكشف عن معظم الآثار السيكولوجية المدفونة في نفوس أهل الرامة وفي اللقطات الحساسة التي ظهروا فيها.
في البداية، يؤكد حجازي على أن "كتاب التخلف الاجتماعي (سيكولوجيا الإنسان المقهور) هو بحث في الأوليات الدفاعية أو آليات التعويض النفسية لدى الإنسان المقهور؛ تلك الآليات التي ينتجها لاوعيه يومياً لمواجهة استلاب عام مردّه إلى بطش سلطة استبدادية عبر مؤسساتها من جهة، وإلى مسلّمات عشائرية وقبلية وعائلية بنيوية متسلطة من جهة أخرى".
"كنت أحاول أن أنزع صديق طفولتي من ملابسه العسكرية، أن أستعيد جماله من اليونيفورم. كان جميلاً وقوياً وصار قاتلاً"... صناعة العنف وإعادة تدويره بطريقة عقائدية من خلال مؤسسات الدولة الخاضعة لـ"حزب البعث" عبر فيلم أنذر منذ السبعينيات بما آلت إليه الأمور في سوريا اليوم
ويشير حجازي أيضاً إلى أن الأغاني الشعبية والأهازيج في المجتمعات المقهورة تنطوي عادةً على رموز عميقة تتجلّى على شكل صور شعرية؛ والتي يمكن استخلاصها لفهم واستيعاب اشتغال تلك الآليات النفسية التعويضية عند "الإنسان المقهور".
وبناءً عليه يشغل موال أبو محمد وصوره الرمزية بالإضافة إلى العديد من مشاهد الفيلم الوثيقة الاجتماعية والنفسية التي نعمل من خلالها على استنطاق مجتمع الرامة وأشكال الاستلاب التي تدفع بأفراده للخضوع والاستسلام التام للسلطة ومفاعيلها، وإلى تسويغ العنف وتبريره واستعماله لا كعقاب أو رد فعل ولكن كلغة للتفاهم بين أفراد المجتمع.
واستناداً لحجازي وعلم النفس الاجتماعي، فإن موال أبو محمد ذاك يشتمل على ما يُصطلح عليه بـ"العلاقة الدمجية"؛ علاقة تَدمجُ الطبيعة الجامحة بالقائد المخلّص في لاوعي الإنسان المقهور، كآلية تعويضية نفسية. ويصف حجازي تلك العلاقة الدمجية بقوله: "إنها صورة الأب الرحوم ذي الجبروت الذي يسيطر على الطبيعة، ويحمي من غوائلها وتهديدها، تلك هي صورة البطل في القصص الشعبية، وهي نفسها صورة الزعيم المُنقذ".

يشبه الإنسان المقهور في كتاب حجازي إنسان الرامة في فيلم خطوة بخطوة إلى حد بعيد، ما يؤكّده أسامة محمد مراراً من خلال مشاهد ترصد التعنيف الجسدي والرمزي (الإخصاء) التي تتعرّض له شخصية غير مسمّاة (وهي غالباً جاءت لتعبّر عن المراهقة التي عاشها محمد الزعتر والتي يصعب تصويرها معه) في البيت والحقل والعمل؛ ما يفسّر لجوء تلك الشخصية غير المسمّاة وذلك الكهل (أبو محمد)، في سبيل التعويض عن الخصاء، إلى التماهي مع الأب الحامي الذي سيردع أي عدوان على الطبيعة/الوطن/الجبل.
والواقع أن هذا هو ما ينتهي إليه موال أبو محمد: "أبو سليمان هو وجيوشه بدّهم يحموا ظهرنا"، في إشارة منه إلى قوة "أبو سليمان" الحامية والمدافعة. وهذا ما يدعمه أيضاً بوح أسامة محمد فيكتب في أحد نصوصه المنشورة في العدد 119 من مجلة "الدراسات الفلسطينية": "يتخلى الأب البيولوجي عن أبنائه للأب المحتل... الأب القائد".
يقول محمد الزعتر خلف الكاميرا: "نعم سأقتل أبي من أجل أبي". وبهذا المعنى سيقتل محمد الزعتر أبيه البيولوجي فداءً لأبيه الرمزي أو القائد الذي تماهى معه، في حال تطلّب الأمر ذلك. ومن هذا الفرض الارتجالي للزعتر بإمكاننا تصوّر المدى الذي بلغه الشاب من الرضوخ والتبعية إلى السلطة الحاكمة.
لا يعيش إنسان الرامة المقهور تحت وطأة قلق الخصاء فحسب، ولكن، عبر لقطات عامة قصيرة ودقيقة، يصوّر لنا أسامة محمد أوجه المعاناة المُضافة التي يعيشها أهل قرية الرامة، ومنها قسوة ظروف العمل في موسم الزراعة وموسم الحصاد، وقسوة المناخ وعدم جاهزية المنازل، وضيق آفاق العمل في القرية وغياب الآلات والتقاني الزراعية الحديثة. إنها أوجه الحياة الفلّاحية الشظفة والمتعنّتة التي تدفع الإنسان إلى معايشة واختبار نوع جديد من أنواع القلق.
يجد حجازي بأن هذا العيش الشظف للإنسان المقهور مع الطبيعة القاسية يُنتج ضرباً جديداً من ضروب القلق النفسي، وهو "قلق الهَجْر" النتيجة المباشرة للمخاوف التي تثيرها الطبيعة في نفس الإنسان المقهور، فضلاً عن تخلّف وسائل الإنتاج الزراعي التي لا تلقى الدعم المطلوب من الحكومات في الدول النامية ولا سيّما الشرق أوسطية منها (كالتحديث الصناعي للآلات الزراعية والتزوّد بالتقاني الحديثة للري وكذا الأسمدة والمحسّنات الإنتاجية)، ما يعمّق شعور الفلّاح بقساوة عيشه بالاعتماد على هذه الطبيعة.
وتتقاطع هنا، إلى حد كبير، النتائج التي وصل إليها حجازي في بحثه مع الوقائع التي استعرضها فيلم خطوة بخطوة، فواقع الإنسان المقهور يتأزم عندما تتحالف قسوة الطبيعة مع استبداد المتسلّط واقعياً؛ لأن هذا التحالف سيثير في نفس المقهور "تحالفاً مقابلاً له في اللاوعي: تحالف الأم النابذة مع الأب القاسي ضد الطفل العاجز. فقلق الخصاء يستمدّ جذوره وأصوله من قلق الهجر، كلاهما يعزّز الآخر ويغذيه. هذا التعزيز يزيد من وطأة عجز الإنسان المقهور عن المجابهة (مجابهة المتسلّط والطبيعة) ويفجّر أقصى حالات العدوانية لديه".
هذه العدوانية المفرطة عينها التي وصّفها حجازي ليست سوى نتيجة طبيعية لـ"تخلّف مصنّع" صمّمته الدولة الفاشلة وعزّزته عبر التهميش والتدجين والتجهيل؛ ممارسات استطاع أسامة محمد أن يعيد إنتاجها بتسلسلها القيّم بعدما كانت مبعثرة وخفيّة في واقع معتَّم عليه، أكان ذلك من خلال تركيزه على لغة العنف في القرية عبر مشاهد ولقطات تكرارية، أو حتى من خلال السبب الرئيسي الذي دفعه لتصوير الفيلم؛ كون صديق طفولته البريء قد صار قاتلاً.
كيف كان ينام القاتل في خلايا الزعتر؟
كان موال أبو محمد مجرد افتتاحية لشريط سينمائي سيحفر عميقاً في المجتمع المقهور لقرية الرامة، سيسير الشريط عبر فضاءات القرية مستعرضاً إياها بغليانها وفتورها؛ فيزور البيت وينتقل منه إلى المدرسة ثم العمل فالهضبة عائداً منها إلى البيت مجدّداً.
وفي كل فضاء من هذه الفضاءات يمكنك أن ترى (محمد الزعتر)؛ وإن لم يكن هو تماماً ولكن من يسيرون على طريقه خطوة بخطوة. في هذا الإطار، يتساءل أسامة محمد في مقالٍ في مجلة "الدراسات الفلسطينية" مستنكراً الحقيقة المرّة التي بلغها: "كنت أحاول أن أنزع صديق طفولتي من ملابسه العسكرية. أن أستعيد جماله من اليونيفورم. كان جميلاً وقوياً وصار قاتلاً... هل كان قاتلاً؟ هل كان القاتل ينام في خلاياه؟"، ليجيب عن هذا السؤال بصوره الواثقة منذ أعوام خلت؛ فكيف كان ينام القاتل في خلايا الزعتر إذاً؟
من مكانك في بيتك الدافئ تشاهد تلك اللقطات السريعة التكرارية: فتاة جميلة بعينين واسعتين تُصفَع دون مبرّر أمام باب المدرسة، فتى يُقبِل كالبرعم على صباحه الندي فَيُرفَس، حمار ذكي يأبى التحرّك لحراثة الحقل فيُضرب، شاب مكسوف بيدين مرتجفتين يُلطم. هي اللغة التي يخاطبك بها المخرج دون أن ينبس وشخوصه ببنت شفة؛ دقائق من لقطات العنف والقهر المكرّرة.
لم يكن ما شاهدته في تلك اللقطات العنيفة التكرارية علكاً اعتباطياً للكاسيت/الكاميرا، إنما هي مفردات اللغة السينمائية للمخرج الشاب (كان عمر أسامة آنذاك 22 عاماً)؛ فمن خلالها أكد على استمرارية العنف وعاديته في الرامة، لا كممارسة استثنائية تهدف إلى تصويب الأمور وتقويمها، ولكن كلغة حيّة يشكل تداولها المألوف وانعدامها الهجين.
لغة تُحسنها صغيراً لتستثمر في مجتمعك وتتقوّى، تستغني بها عن التزامك الإنساني والمدني ولكنك تكسب مكانة اجتماعية يضمنها سلوكك العنيف ذاك ودوامه. فكانت اللقطة التكرارية هي وحدها من ستسعف أسامة محمد في حفر تلك الحقيقة واستخراجها.
"الصفع لغة، لغة عادية يومية، سترون أن الصفع جزء من الجملة، من يصفع لا يشعر بذلك؛ فهذا جزء من المخاطبة والفكرة. وسبق وأن طُرِدْتُ من جميع مدارس سورية لأنني لم أرضَ بالصفع، هذه العادة غيّرت مجرى حياتي"، يقول لنا أسامة محمد.
هذه التكرارية التي طبعت أسلوب أسامة محمد ما هي إلا أمانة سينمائية في تسجيل واقع الرامة الذي لا يبرح يعيد إنتاج نفسه عبر قواعده/مؤسساته (المدرسة، العائلة، المؤسسة العسكرية)؛ فالمدرس يوطّن العنف ويدجّن المعارف ويسيّسها، والأب يخصي الذكورة ويؤسّس للاستعباد، والضابط يدفع بك إلى الموت أو الإجرام؛ لا دفاعاً عن النفس ولكن أذية لها.
لاحت وجوه أولئك الأطفال كئيبة، كما لو أنهم علموا فجأة بمصيرهم الذي ينتظرهم في هذا المكان، وربما كان هذا الاستباق أيضاً بمثابة تحذير أخير أظهر أن أطفال الرامة يسيرون خطوة بخطوة إلى مصيرهم النموذجي... بأن يصبحوا قتلة
بالعودة إلى محمد الزعتر، يحكي الشاب هزيل البدن فيه عن شظف العيش في الرامة، قريتهُ المهمّشة، عن قسوة الأساتذة وطغيانهم الموجَّه والمبثوث أصلاً، وعن صراعاته مع الديكتاتورية الأبوية في الأسرة؛ فهي ذي صخور الرامة الجاثمة على صدر الصبي التوّاق للحرية والخلاص، خلاص لم يجده إلا في انتسابه لصفوف القوات البحرية في الجيش السوري.
لم تلعب اللغة السيمائية دوراً في الكشف عن عادية العنف في الرامة وحسب، وإنما وبالدرجة الأولى عن تكرارية الحياة في ذلك المكان وسير شبّانه خطوة بخطوة على ذلك النهج العدائي الذي تبدأ أول دروسه في المدرسة، وتنتقل إلى الحقل فالعمل ومنه إلى الخلاص أو المصير الذي فضحهُ أسامة بذلك المشهد على الهضبة؛ مصير إنسان الرامة كهارب إلى المؤسسة العسكرية التي تصوّر في ذهنه شكل الخلاص، الخلاص عبر القتال.
يجلس محمد الزعتر ويروي دقائق مشاركته في حصار تل الزعتر:
"- هل قتلت؟
- رامي الدبابة لا يرى ضحاياه.
-هل رميت؟
- نعم".
إذاً، الإجابة عن سؤال: كيف ينام القاتل في خلايا الزعتر؟ كانت واضحةً منذ البداية، لم يقلها أسامة مباشرةً ولكن خياراته السينمائية تكفّلت بذلك، فراح يكرّر مشاهد العنف حيناً وينوّعها أحياناً آخذاً بعين الاعتبار عامل العمر والجنس والمهنة، فكانت الشخوص التي تتعرّض للضرب بمثابة نماذج تعبّر عن مختلف أطياف مجتمع الرامة، وهكذا أخذت تتلاشى الفوارق بين هذه النماذج شيئاً فشيئاً، حتى يسلّمنا أسامة محمد في الجزء الأخير من الفيلم وقبل الختام بدقائق إلى تلك الهضبة التي يعتلي صخورها محمد الزعتر ويقول مصرّاً على رأيه: " أنا خيي (أخي) إذا حكى شي بضرّ بأمن الدولة بقتله".

السَيْر باتجاه الانفجار الكبير
"بدّي صير دكتور"، يقول طفل في الفيلم ويمضي خطوة بخطوة على دربٍ أخضر.
" بدّي صير آنسة"، تقول طفلة رائعة المبسم وهي خجلة من الكاميرا، ثم تمضي مع الأطفال صعوداً نحو الهضبة.
يتقدّم طفل أنيق الهندام من البعيد فيخترق خطوة بخطوة حقول القمح.
إنها اللقطات التي افتتح بها أسامة محمد فيلمه، ولم تكن هذه الافتتاحية لتعني الشيء الكثير لولا اللقطات الأخيرة من الفيلم التي استعرضت وجوه أطفال تلوح كئيبة في شمس حارقة؛ وطفلان صغيران يتركان والدتهما ويسيران وحيدين بين الحقول خطوة بخطوة.
وبلغة سيميائية، فإن افتتاحية الفيلم كانت بمثابة "استباق تكراري" لنهاية الفيلم عندما لاحت وجوه أولئك الأطفال كئيبة، كما لو أنهم علموا فجأة بمصيرهم الذي ينتظرهم في هذا المكان، وربما كان هذا الاستباق أيضاً بمثابة تحذير أخير أعلن فيه أسامة محمد بأن أطفال الرامة يسيرون خطوة بخطوة إلى مصيرهم النموذجي؛ طالما أن هذه البنى الاجتماعية وتلك المؤسسات الأيديولوجية المتسلّطة تشكّل عقول هؤلاء الأطفال ليذهبوا ذات يوم إلى مخيم يشبه مخيم تلّ الزعتر ويقومون بما يشبه ما قام به محمد الزعتر.
أراد أسامة محمد بطريقة أو بأخرى أن يُخرج للمشاهد لقطات لا تسعفه فقط في فهم العلاقة بين الأيديولوجيا السلطوية والشعب السوري؛ وإنما تحدد أيضاً "الشخصية المتخلفة" وعلاقتها بالطبيعة وغيرها من الشخوص، وتحدّد القوانين الثقافية والاجتماعية لهذه الشخصية؛ فصّور لنا كيف أضحى فعل القتل مطلوباً كواجب نبيل للدفاع عن السلطة بوجه "العناصر المخرّبة والهدامة".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


