لكل أمة خطاياها. وخطايا الشعوب العربية هي تلك العيوب التي لا زالت تبقيها في مؤخرة الركب الحضاري. ونحن هنا لا نفترض وجود أمة عربية متجانسة، بل نتحدث عن شعوب عربية تعاني من نفس هذه الخطايا بفعل عوامل مشتركة عديدة. وقد تشترك أمم، حتى المتقدمة منها، في بعض هذه النقاط. ولكن الفرق أن هناك من يعي الداء ويعمل على حلّه، ومن أهمل تشخيصه وعلاجه حتى أصبح مرضاً مستفحلاً. ربما تشكل النقاط التالية أهم، وليس كل، ما يثقل حركة الشعوب العربية نحو التقدم.
النظام الأبوي (الاستبدادي)
لا يقتصر هذا المفهوم على نظم الحكم التي لم يعرف العرب غيرها منذ بداية الدولة الوطنية بعد الاستقلال وحتى الآن. بل يشمل كل نواحي السلطة في العائلة، والمدرسة، والجامعة وصولاً إلى العلاقة مع السلطة الحاكمة. فهناك دوماً طرف يأمر وآخر ينفذ. ووفق نظرية هوفستيد للأبعاد الثقافية فإن الدول العربية التي شملها البحث سجلت معدلات عالية في مقياس القبول بالخضوع للسلطة، Power Distance.
فكل من مصر والعراق والسعودية والإمارات ولبنان والكويت وليبيا سجلت معدل 80 من 120 في هذا المقياس. بينما نرى معدلات منخفضة كلما اقتربنا من دول الغرب حيث سجّلت بريطانيا وألمانيا مثلاً معدل 35 فقط. أهمية هذا المقياس هو في فهم هذه القراءات التي تبين معدل المبادرة الفردية وحرية التفكير، لأن ضعف القبول بتركيز السلطة في أيدي الآخرين ينتج عن فهم لتوزيع السلطات في المجتمع والقدرة على مساءلة صاحب السلطة. وهذا المقياس يطابق في نتائجه ما نراه في البلاد العربية من توزيع هرمي للسلطة واستعداد للخضوع لها دون مساءلة أو نقاش بدءا من الأسرة والمدرسة وانتهاء بنظام الحكم.

هذا النظام يُحارب الابداع، ويحاول أن يستنسخ أجيالاً شابة تؤمن بما يسمى "الثوابت"، وبالتالي يحد من التفكير النقدي عند الأجيال الجديدة منذ نشأتها.
نقد الذات
حين تسود في المجتمع ثقافة التسليم يتقلص هامش النقد الذاتي ويتسع هامش التبرير. والنقد الذاتي المقصود هُنا ليس جلد الذات المازوشي، بل هو آلية تتبع الأخطاء من أجل التطوير والتحسين. وبدون هذه العقلية التي تتساءل دوماً عن الأخطاء والعيوب وتعمل على تلافيها وتطوير الأداء، لا يمكن لأي أمة أن تنجح في مواجهة تحديات الحياة المتغيرة، وتصبح ضحية لجمود يجعلها متأخرة عن بقية الأمم. إن ممارسة نقد الذات بشكل صحي يتطلب اعترافاً بالأخطاء، ورغبة مخلصة في تجنبها مستقبلاً، وتجرداً ذاتياً في البحث عن مسببات الأخطاء بشكل موضوعي وعلمي. وفي كل مرحلة من تلك المراحل يواجه العقل العربي إشكالية تحد من حركته تجاه نقد ذاتي سليم. فالخطأ ضعف والاعتراف به مثلبة وانتقاص من الذات. فعلى سبيل المثال، الحاكم لا يخطئ، وإذا حدث خطأ لا يمكن تجاهله فالمشكلة هي إما في التآمر الأجنبي أو في الحاشية السيئة. ولأن العقل العربي بشكل عام يميل لثقافة الإخفاء والتناسي فإننا قليلا ما نرى في تاريخنا نقدا ذاتياً أنتج تغييرات إيجابية للأجيال اللاحقة.
وللإنصاف فإن هذه العملية ليست سهلة أو بسيطة حتى بالنسبة للعالم الغربي. فهناك في فرنسا مثلاً من لا يزال يقاوم ممارسة النقد الذاتي للتاريخ الاستعماري البشع لفرنسا في الجزائر وغيرها. ولكن الفرق أن الحوار هناك مفتوح، ولا قيود على تدفق المعلومات ونشر التحليلات والآراء.
لماذا لا تعترف دولنا ومجتمعاتنا العربية بحرية الإنسان في حياته الخاصة؟ هل رأيتم دولةً غربية تعتبر إحدى مهماتها أن تدخل إلى غرفة نوم المواطن وتراقب وتجرّم ما يفعله؟
من المهم لكل أمة أن تفهم تاريخها وتدرسه جيداً لتستخلصَ العبر، ولكن من المدمر لمسيرتها الحضارية أن ينغمس أبناؤها بالتاريخ، بكل ما فيه من عداوات وحروب بشكل يحول أبصارهم عن المستقبل. نحارب وكأننا نعيش في القرن الأول الهجري..
الدين والدولة المعاصرة
لم يحسم العرب حتى الآن موقفهم فكرياً وسياسياً من إشكالية الدين والدولة. وأساس المشكلة هنا هو ليس الأحزاب والحركات الإسلامية فقط، بل هي مشكلة حتى بين صفوف الشعوب العربية التي اجتاحتها ما سميت بالصحوة منذ ثمانينيات القرن الماضي. ما هو موقع الاسلام من الحكم، بل من الحياة بشكل عام؟ هل نقيم دولة دينية في أغلب تشريعاتها كما هو الحال في إيران والسعودية والسودان مثلاً، أم نبني دولة علمانية الأساس تتضمن شيئا من الشريعة؟ وإذا كان هذا هو الخيار الأنسب فما هو الحد الذي يجب أن نقف عنده في التعامل مع الإسلام كنظام حياة وحكم. تعلم الغرب بناء دولة تقوم على فصل الدين عن الدولة واعتماد مبدأ المواطنة بغض النظر عن الدين أو العرق، وتشريع القوانين المدنية وفق إرادة الشعب الممثلة في البرلمان، وفصل السلطات الثلاث تحقيقاً لمبدأ المساءلة ومنعاً للاستبداد. ولكن الشرق لا يزال حتى الآن يسأل نفسه أين يضع الإسلام في دولة وما هو حجمه المفترض في القرن الحادي والعشرين. يتم الترويج لمفهوم العلمانية على أنه كفر والليبرالية على أنها نموذج غربي لا يصلح للمجتمع العربي ويهدف إلى ضرب الإسلام ووضع التشريع بيد البشر لا بيد الله. هذا التشويه في المفاهيم تتحد فيه الجماعات الإسلامية مع أنظمة الحكم الشمولية العربية المعادية لها. فالعلمانية تُعنى بالمواطنة بغض النظر عن الدين وهذا سيحرم الجماعات الدينية من أهم أسلحتها في حشد الدعم السياسي لها. كما أن النموذج الليبرالي يعني حرية في التعبير وصحافة بلا قيود ومجتمعاً مدنياً ينشر الوعي وكلها أدوات تهدد وجود الأنظمة الشمولية العربية.
يؤمن العرب المسلمون بمعدل 70% تقريباً بضرورة وضع الشريعة كقانون لحكم البلاد وفق دراسة مركز بيو للأبحاث. ومن المثير للاهتمام هنا أن العرب المسلمين يهاجمون اعتبار إسرائيل دولتها كياناً لليهود، فيما هم على استعداد وبشكل كبير للقيام بذات الشيء في بلدانهم واعتبارها كيانات إسلامية. والمبدأ هنا واحد والاختلاف فقط في الهوية الدينية للدولة. لقد أثبتت التجارب الانسانية الكبرى والتي اختتمت بانهيار النموذج الأكبر للشمولية في الاتحاد السوفيتي أن النظام البرلماني الليبرالي هو الأفضل والأكثر وقاية للجميع من مخاطر التمزق الديني والطائفي والعرقي. وأثبتت المسيرة الإنسانية أيضاً أن اعتماد الدين كأساس لبناء الدولة لا يتسق مع المفهوم العصري للمساواة وحقوق الانسان، خصوصاً أن إشكاليات التفسيرات المتعددة والمدارس الفقهية والطوائف المختلفة تجعل من مفهوم الدين أساساً غير واضح المعالم لبناء الدولة.

افتراض التفوق الأخلاقي
العلاقة الملتبسة مع الغرب تعترف ضمنياً بتفوقه الحضاري بكل نواحيه المادية على العرب. ولكنها، وبضغط من هذا الإحساس بالدونية تفترض تفوقاً أخلاقياً مزعوماً يختصره العقل العربي في العلاقات الجنسية. يعترف الغرب بحرية الإنسان في حياته الخاصة ولا يضع عليها قيوداً إلا فيما تمنعه القوانين. ولا ترى الدولة في الغرب أن من مهمتها أن تدخل إلى غرفة نوم المواطن وتراقب وتجرم ما يفعله. ولهذا فإن النقطة هنا تتمحور حول فهم الحرية الشخصية ومدى تدخل الدولة أو المجتمع فيها. أما النقطة الأخرى فهي اختلاف التعريف فيما يخص الأخلاق. فالغرب لا يضع الممارسة الجنسية خارج نطاق الزواج مثلاً ضمن قائمة الأعمال اللا أخلاقية فهي بالنهاية فعل شخصي لا يؤثر على الأخرين. ولكن الدولة والمجتمع يحاسبان الفرد على عدم القيام بالعمل بنزاهة، وخيانة الأمانة، والفساد المالي والتحرش بالمرأة بكل أشكاله وكل ما من شأنه الإضرار بمصالح الآخرين وخرق قوانين الدولة.

أما المجتمع العربي فإنه وبرغم وضعه لكل ما سبق ضمن الأعمال اللا أخلاقية إلا أن الممارسة الفعلية تضعها في خانة رمادية يمكن لها أن تجعل المرء مقبولاً اجتماعياً إن هو قام بالشعائر واحترم ثوابت المجتمع ولو ظاهرياً. بل إن الدراسات كشفت أن هناك تبريراً ذكورياً منتشرا للتحرش بالمرأة ويعتبره سلوكاً مشروعاً ومبرراً. إن النظر على مؤشرات الفساد في الدول العربية أو نسبة التحرش بالمرأة تبين أننا نعاني مما يعاني منه الغرب أيضاً وأحياناً بدرجات أعلى. ولكن المجتمعات الغربية اختارت مواجهة المشاكل علناً والاعتراف بها بينما نلقي بها نحن في الظلام ونتحدث عن كمال أخلاقي لم يوجد يوماً في أي مجتمع بشري.
القوقعة التاريخية
من المهم لكل أمة أن تفهم تاريخها وتدرسه جيداً لتستخلص العبر، ولكن من المدمر لمسيرتها الحضارية أن ينغمس أبناؤها بالتاريخ، بكل ما فيه من عداوات وحروب بشكل يحول أبصارهم عن المستقبل. هذا بالضبط ما يفعله العرب الآن الذين يعرفون أكثر مما يجب من تاريخهم العتيق في الوقت الذي يفتقدون فيه إلى معلومات وتخطيط علمي للمستقبل. نحن نغرق في فيض الكتب والسجالات التي تتحدث عن حرب الجمل وصفين والدولتين الأموية والعباسية ونمتشق سيوفنا لنحارب فيها وكأننا نعيش في القرن الأول الهجري.
توقف الزمن بالعرب في تلك العصور. يعيشون كل ما فيها من صدامات بشرية مفهومة ومتوقعة في أيامها كأي تجربة إنسانية. ولكنهم لا يريدون الخروج من دائرتها وكأن التاريخ تجمد عندها. تستعمل أيادينا وسائل العصر الحديث ولكنها لا تعيش روحه. فالسلفيون يرون الجنة على الأرض في تقليد المجتمع البدوي الصحراوي في أوائل سنوات البعثة النبوية. والشيعة لا يزالون يحاربون من اغتصب حق علي في الولاية. والسنة ينافحون بالغالي والنفيس دفاعاً عن كل من يمس شيئا من ثوابتهم كالبخاري وغيره. ومثلهم كثير من طوائف العرب الذين يلوذون بالتاريخ هرباً من تحديات الحاضر. ومن ناحية أخرى يحاول العقل العربي مواساة نفسه بتكرار الكلام عن فضل العرب على الحضارة الغربية وكيف أن أصل كل تلك المخترعات هي لابن الهيثم وابن النفيس والخوارزمي وابن سينا وغيرهم. وخطورة هذا الطرح تكمن في ماض نقرأه في كتبنا ولا نفعل شيئا لنعيد بناءه في حاضرنا.

العنصرية
هي الاعتقاد بوجود تميز لمجموعة من البشر على غيرها بسبب العرق أو المعتقد أو الطبقة الاجتماعية، وتقسيم البشر وفق ذلك إلى من هو أعلى ومن هو دون. ربما تكون أحد أهم الدعائم الأخلاقية للإسلام كديانة هو المساواة بين البشر بغض النظر عن العرق كما ورد في الحديث النبوي " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى". ولكن المفارقة هنا أن العرب يمارسون على الآخرين ذات الداء الذي يشتكون منه: العنصرية تجاه الآخر. فإذا كان البعض في الغرب يتعامل بشيء من العنصرية مع العرب عموماً ضمن مفهوم الخوف منهم ووصفهم بالإرهاب، فإن العرب أيضا يميزون ضد الآخرين تحت وهم التفوق العرقي أو الطبقي أو الديني. إن نظرة على كيفية التعامل مع أصحاب البشرة الداكنة في مجتمعاتنا تؤشر بوضوح لا لبس فيه على تعامل فوقي يرى في هؤلاء البشر طبقة أدنى تنتمي لعصر العبيد. ويمتد الحال إلى التعامل مع العمالة الوافدة من آسيويين أيضا ( مسلمين كانوا أو غير مسلمين) وكأنهم عبيد مملوكون وليسوا موظفين يعملون بأجر. ولا يستثنى من هذه النظرة العنصرية حتى أبناء البلد نفسه الذين قد تضطرهم الحاجة للعمل كخدم في منازل مواطنيهم الميسورين. وإذا أضفنا إلى هذا العنصرية الموروثة في التعامل مع أبناء "الأقليات الدينية والعرقية" في العالم العربي لبرزت أمامنا كل ألوان الطيف العنصري في بلادنا.
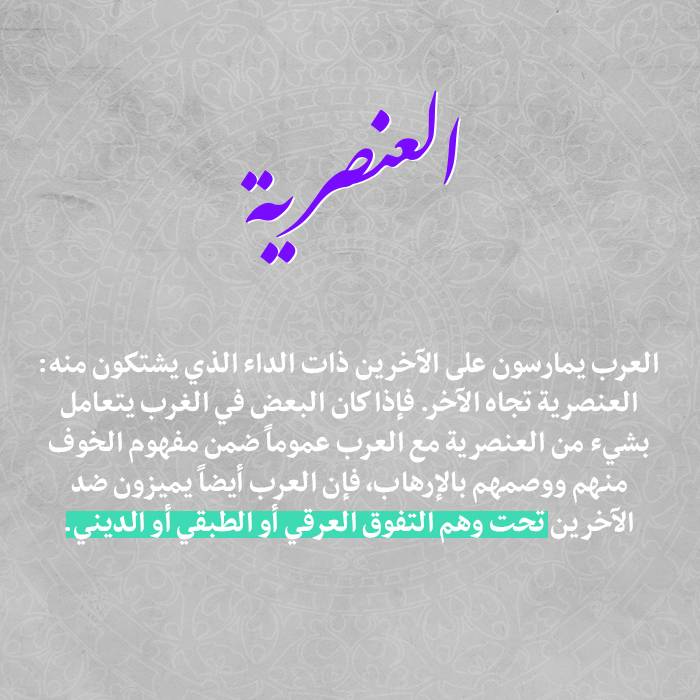
كم نعرف عن عالمنا؟
كلما ازداد الانسان علماً كلما اتسعت البصيرة وازداد الفهم للعالم الذي يعيش فيه وأصبح أكثر قدرة على التفاعل معه بشكل سليم. ولكن كيف يقوم العرب بهذا في الوقت الذي يبلغ معدل القراءة عندهم كتاباً واحداً في السنة لكل 80 مواطن؟ ويبلغ دافع القراءة بهدف الترفيه 46% بينما يقرأ 26% من العرب بدافع الفهم والتعلم. إن القول بأن طغيان الإنترنت قد أثر عالمياً على معدل قراءة الكتب يصطدم بحقيقة أن القراءة في الغرب تبلغ 200 ساعة/ السنة للفرد في أوروبا، بينما يبلغ معدل قراءة العربي 6 دقائق/ السنة. وحتى هذه الدقائق الست فإنها تصرف في قراءة كتب كالأحلام لابن سيرين، أو فتاوى ابن تيمية أو قصص الأنبياء. إن العقبات التي تشدنا إلى واقع التخلف الذي نعيشه موجودة في شوارعنا وعقولنا ونظرتنا العتيقة للتفاعل مع الحياة الإنسانية الجديدة. وإذا أردنا التقدم إلى الأمام فعلينا أن نشخص الداء بدل توهم المؤامرات عسى أن تتمكن أجيالنا القادمة من بناء مستقبل أكثر ترحيباً بالحضارة الانسانية.رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


