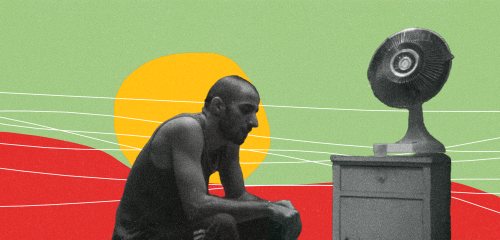بدأ الأمر مع أستاذي في إحدى الجامعات الألمانية، إذ كان يستغرب دائماً أنني أشارك بآراء نقدية في السياسة والمواضيع الأكاديمية والاجتماعية. أحياناً، كنت أقول له إنّ وجهة نظره منقوصة، ثم أقدّم أمثلةً تدعم وجهة نظري، طبعاً باحترام. كان يتفاجأ بطريقة فجّة من اطلاعي على قضايا كثيرة في العالم، ولم أفهم سبب ذلك حتى قال لي يوماً زميل في المحاضرة ذاتها: "لستِ امرأةً عربيةً تقليديةً، ظننتك لاتينية". حينها، شعرت وكأنّ دلو ماء بارد سقط عليّ! ما الذي يعنيه بذلك؟ ومن هي المرأة العربية "التقليدية" في نظره؟ من هنا جاءت فكرة هذا التقرير حول الصورة النمطية للمرأة العربية في أوروبا.
"لا يمكن أن يمرّ وقت طويل دون أن أتعثر بصورة نمطية مسبقة عن المرأة العربية، تتجلى في نظرات الأوروبيين وأسئلتهم. وغالباً ما تكون هذه الأسئلة بصيغة 'مدح' مدى 'تحضّري'! ما رأيكِ في المساواة بين الرجل والمرأة؟ كيف تنظرين إلى الزواج؟ كيف تصفين علاقتك بعائلتك؟ هل تتّبعين العادات والتقاليد أو تتمرّدين عليها؟ اللافت أنّ هذه الأسئلة لا تُطرح بهدف التعرّف الحقيقي، بل لتحديد إن كنت 'استثناء' عن الصورة النمطية السائدة للمرأة العربية. وكأنّ المرأة العربية يجب أن تثبت دوماً أنها مختلفة كي تُعامَل كفرد طبيعي"؛ هكذا بدأت هديل (اسم مستعار، 33 عاماً)، وهي فلسطينية تعمل في الهندسة الحيوية في السويد منذ العام 2021، حديثها إلى رصيف22.
حوار لا يهدأ
وتُكمل: "المشكلة أنّ بعض هذه التصوّرات تكون خفيّةً، بل متجذّرةً إلى حدّ يصعب على البعض إدراكها". أحد المواقف التي بقيت عالقةً في ذهن هديل، حين سألها رجل يعرف بأنها على علاقة عاطفية، فجأةً: "هل كل العلاقات العاطفية في بلادكم سامّة، والنساء مرغمات عليها". لم تعدّ هديل هذا التعليق مجرد رأي، بل تلميحاً مباشراً إلى أنها، كامرأة عربية، لا بد أن تكون عالقةً في علاقة غير صحية، وغير قادرة على اتخاذ قراراتها بحرّية.
تعلّق هديل: "هذه التجربة وغيرها تذكرني بأنني كامرأة عربية أعيش في أوروبا، لستُ فقط في حوار دائم مع المجتمع الجديد، بل أيضاً في مواجهة مع تصورات مسبقة أحاول تفكيكها بصبر، مرةً تلو الأخرى".
الصورة النمطية عن المرأة العربية في أوروبا ليست حديثةً، بل تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاستشراق، حيث صُوّرت المرأة ككائن خاضع ومثير وغامض، في سياق يخدم ثنائية "الغرب المتحضّر" مقابل "الشرق المتخلّف"
أما شيرين (اسم مستعار، 42 عاماً)، وانتقلت من سوريا إلى هولندا قبل عامين، فتقول إنها صادفت شريحةً من الناس ليست بالضرورة متطرفةً أو عنصريةً، لكنها ببساطة محدودة الثقافة والذكاء، وتملك معرفةً محدودةً بما يجري خارج حدود بيئتها. لذلك، فإنّ صورتهم عن المرأة العربية تستند إلى تصورات قديمة أو مشاهد مجتزأة من وسائل الإعلام.
توضح: "أتذكر جيّداً كيف سألتني امرأة في النادي الرياضي: "هل يمكنكِ أن تمارسي الرياضة بحرّية؟ هل يُسمح لكِ بالعمل دون أن تتعرّضي للعنف؟". بدا السؤال عفويّاً، لكنه في جوهره يعكس جهلاً عميقاً وسطحيةً في فهم واقع النساء العربيات. لم يكن في نبرة صوتها عداء، بل اندهاش حقيقي نابع من قلة الاطلاع، وهذا ربما ما يجعل الأمر أكثر إرباكاً: أن يُنظر إليكِ باعتبارك امرأةً خارجةً من بيئة مغلقة وقامعة، لمجرد أنكِ محجبة أو عربية".
وتضيف: "تعرّضتُ أحياناً لصورة نمطية تحمل تعاطفاً مبطّناً، وكأنني بحاجة دائمة إلى المساعدة، حيث يفترضون تلقائيّاً أنني لا أجيد استخدام التكنولوجيا أو لا أعرف التعامل مع الإجراءات الرسمية، فيُسارعون إلى تقديم المساعدة وكأنني قاصرة عن فهم الأنظمة الحديثة. لحسن الحظ، أنا خريجة تخصّص تكنولوجيا المعلومات (IT)، وأتعامل بسلاسة مع البرامج والأنظمة، لكن ذلك لا يمنع تلك النظرات التي تقول دون كلام: 'أنتِ على الأرجح لا تعرفين، دعي الأمر لنا'".
تظهر البيانات أنّ نسبة الإناث الحاصلات على تعليم جامعي في الكثير من الدول العربية تفوق نسبة النساء الحاصلات على تعليم جامعي في أوروبا. تفيد الدراسات بأنّ نحو 48% من النساء الأوروبيات بين عمر 25-34 سنةً، حصلن على تعليم جامعي في 2022، أما في الوطن العربي، فتتفاوت النسب حسب الدولة، حيث بلغت نسبة الطالبات في الجامعات نحو 70% في الإمارات، و65% في الجزائر.
كوني محجبةً وأعمل في مجال تقني يجعل بعضهم ينظر إليّ باستغراب، بل أحياناً باستهجان غير معلن. لم أكن أتوقع أن أكون محط تساؤل لمجرد اختياري لدراسة تخصّص علمي ومهني. وعندما بدأت البحث عن عمل، لاحظتُ أنّ وجود صورتي في السيرة الذاتية أصبح ضروريّاً، لتفادي المفاجآت أو الاستفسارات لاحقاً، ولإظهار هويتي بوضوح منذ البداية.
ما سبق تؤكده دراسة نمساوية أُجريت في ألمانيا، قُدّمت فيها ثلاث سير ذاتية بالمحتوى المهني ذاته، مع تغيير الاسم والمظهر فقط: امرأة محجبة باسم عربي، وأخرى غير محجبة بالاسم ذاته، وثالثة غير محجبة باسم أوروبي. النتيجة كانت واضحةً: فرص المقابلة الشخصية كانت الأعلى للمرأة ذات الاسم الأوروبي، وهو ما يعكس كيف تلعب الصور النمطية دوراً فعّالاً في إقصاء النساء العربيات من فرص التوظيف.
المرأة العربية في الخيال الأوروبي
يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي والاقتصادي، حمزة معيوي، أنّ الصورة النمطية عن المرأة العربية في أوروبا ليست حديثةً، بل تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاستشراق، حيث صُوّرت المرأة ككائن خاضع ومثير وغامض، في سياق يخدم ثنائية "الغرب المتحضّر" مقابل "الشرق المتخلّف"، والذي كان يُستخدم لتبرير الهيمنة الثقافية والسياسية باسم "تحرير المرأة العربية".
ويشير إلى أنّ هذه الصورة رسّختها الأدبيات والسينما الغربية عبر تعميم نماذج هامشية على أنها تمثل الواقع كله، ثم جاءت العولمة الثقافية لتعيد إنتاج هذه السردية بشكل مستمر.
"لا يمكن أن يمرّ وقت طويل دون أن أتعثر بصورة نمطية مسبقة عن المرأة العربية، تتجلى في نظرات الأوروبيين وأسئلتهم. وغالباً ما تكون هذه الأسئلة بصيغة 'مدح' مدى 'تحضّري'!
من منظور نفسي، يوضح معيوي أنّ هذه التصورات تتغذى على التحيز المعرفي والإسقاط النفسي، حيث يُعمِّم الأوروبيون أفكارهم عن المرأة العربية بناءً على ما تقدمه لهم وسائل الإعلام، ويُسقِطون مخاوفهم من الدين والاختلاف الثقافي عليها، فتصبح رمزاً لكل ما يهدد نظرتهم الذاتية للعالم.
ليست لدى شارلوت سكولدينغ (66 عاماً)، وهي طبيبة بريطانية تقيم في جنوب غرب المملكة المتحدة، صداقات وثيقة مع نساء عربيات، لكنها تعاملت مع عدد منهنّ في مراحل مختلفة من حياتها، سواء في أثناء الدراسة أو من خلال زميلات في العمل، بجانب خبرتها مع مريضات من أصول عربية متنوّعة.
عند سؤالها عن الانطباع الأول الذي يتبادر إلى ذهنها عند سماع مصطلح "امرأة عربية"، تجيب بأنها غالباً ما تفكّر في امرأة مسلمة، ترتدي الحجاب، وتلتزم بسلوكيات دينية واجتماعية مغايرة لما هو مألوف في المجتمع البريطاني، كرفض المصافحة أو الامتناع عن شرب الكحول.
توضح سكولدينغ، لرصيف22، أنّ جزءاً كبيراً من تصوّراتها المبكرة عن النساء العربيات تشكّل بفعل الإعلام الغربي، الذي غالباً ما يُظهر المرأة العربية من زاوية ضيقة، لكنها، في المقابل، تؤكّد أن النساء العربيات اللواتي عرفتهنّ في الواقع كنّ منفتحات، ودودات، ومهنيات، على عكس ما يُقدَّم في الإعلام.
تقول شارلوت، إنّ عملها مع طبيبة عراقية ترتدي الحجاب وتتميّز بالكفاءة والمهنية، ساعدها على كسر بعض التصوّرات المسبقة. تصف زميلتها بأنها سهلة التواصل، محترمة، ومرنة، وتتمتّع بعلاقة طبيعية مع زملائها وزميلاتها. وبرغم أنّ هذه التجربة لم تمحُ تماماً كل الصور النمطية، فإنها عمّقت إدراكها للتنوّع داخل المجتمعات العربية، فالمرأة العربية ليست نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الشخصيات والتجارب.
تقرّ سكولدينغ، بأنّ الكثير من البريطانيين يرون المرأة العربية كـ"مضطهدة" وتحتاج إلى من "يحرّرها"، خاصةً في الدول المحافظة أو ضمن الجماعات الدينية المتشددة. تقول إن هذا التصوّر غالباً ما يكون مصحوباً بشعور بالمفارقة أو الغضب لدى النساء الأوروبيات، لأنهنّ يتمتعن بحريات وامتيازات لا تتاح للنساء في بعض البلدان العربية.
لكنها تحذّر في الوقت نفسه من الوقوع في فخ "التفوق الثقافي"، مؤكدةً أنّ ما يبدو ظلماً من الخارج قد لا يُنظر إليه بالضرورة كذلك من الداخل. وتضيف: "لا أعتقد أنّ من حقّنا أن نحرّر أحداً، ما لم تأتِ هذه الرغبة مباشرة من الشخص نفسه".
من جهته، يرى معيوي، أنّ النسوية الغربية ساهمت في ترسيخ هذا الخطاب عبر تعميم نموذجها على كل نساء العالم، متجاهلةً الفروقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ما أدى إلى ضرر أكبر على النساء العربيات، خاصةً في أوروبا، حيث لا يتم الاعتراف بتجاربهنّ وواقعهنّ المختلف. كما يلفت النظر إلى غياب التضامن الحقيقي مع قضايا المرأة العربية في سياقات سياسية مثل الاحتلال أو القمع السياسي، مقارنةً بما يُمنح للمرأة الغربية، ويشير إلى أن المرأة العربية تُعامَل دائماً على أنها أقل، حتى لو كانت أعلى تعليماً أو أكثر كفاءة.
أما أماندين (31 عاماً)، وهي بلجيكية تقيم في السويد، فتقول لرصيف22، إنّ تصوّرها للمرأة العربية تشكّل في فرنسا حيث نشأت. يرتبط تصورها بالحجاب والانطوائية، وبأنّ النساء العربيات "أكثر هدوءاً" و"يمضين وقتاً أطول في المنزل"، وهو ما تعزوه إلى ملاحظات اجتماعية عامة مستمدّة من مجتمع المهاجرين، لا من معرفة مباشرة. وتضيف أنّ هذا التصور مشوَّه، لأن النساء العربيات اللواتي يندمجن بسلاسة في المجتمع الأوروبي لا يُلاحظن غالباً، بينما اللواتي لديهنّ مظهر أو سلوك "مختلف" هنّ من يلفتن الانتباه.
برغم ذلك، لا ترى أماندين أنّ تفاعلها المباشر مع النساء العربيات غيّر هذه الصورة جذريّاً، لكنها لاحظت ما وصفته بـ"التعقيد في العلاقة مع الثقافة الأصلية"، حيث لمست صراعات داخليةً لدى بعضهنّ تشبه ما تعانيه هي نفسها من تناقضات مع مجتمعها. وهذا ما جعلها تدرك أنهنّ "مثلها تماماً".
تقرّ أماندين، بوجود تحيّزات عنصرية في محيطها، فتذكر أنّ جدّتها "عنصرية بعض الشيء" تجاه العرب وتعدّهم "خطرين"، لكنها ترى أنّ هذا رأي يصعب تغييره.
مضطهدة وراضية؟
تصف هديل وقع الصور النمطية والأحكام المسبقة عليها بأنه كان مربكاً في البداية، إذ كانت ترى أمامها خطاباً لا يُشبهها، لكنه يصرّ على تمثيلها. وبرغم شعورها بأنّ ما يُقال محمّل بالسمّ والخطأ، لم تكن قادرةً على فهم فحواه فوراً. احتاجت وقتاً لتفهم وتُحلّل الكلمات والمواقف وتربطها ببنى التمييز والعنصرية.
تفكيك الصورة النمطية عن المرأة العربية يبدأ من الداخل، من المهم استعادة المرأة لصوتها من خلال مشاركة قصتها الشخصية، سواء عبر الإعلام أو البودكاست أو المحيط القريب، وهو ما يُعرف في علم النفس بـ"العلاج السردي"، إذ تخلق هذه الروايات مساحةً لتحدّي التصوّرات السائدة
مع مرور الوقت، أصبح "رادار" الوعي لديها أكثر حدّةً، بحسب وصفها، وصارت تُدرك بسرعة عندما يوجَّه إليها كلام له منبع فوقي أو تحامل أو عنصرية. تؤكد أنها لم تحاول التأقلم مع هذه الخطابات، بل رفضتها تماماً، وبدأت تواجه المتحدثين بها، وتُصرّ على التعبير عن رؤيتها وعدم السماح لهم بفرض تصوراتهم عنها.
ترى هديل، أنّ المشكلة الأعمق تكمن في افتراض البعض أنّ المرأة العربية ليست فقط مضطهدةً، بل أيضاً راضية بذلك، مستسلمة له، وربما حتى متواطئة معه. وتؤكد أنّ هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، فالكثير من النساء العربيات يُحاربن هذا الظلم يومياً، ولا يُمكن عدّ سكوت بعضهنّ رضى، بل نتاج ظروف قاهرة.
الوصم الداخلي
يرى الباحث حازم معيوي، أنّ هذه الصور النمطية لا تنعكس فقط في نظرة المجتمع الأوروبي إليهنّ، بل تتسلّل إلى وعي النساء أنفسهنّ، عبر ما يسمّيه "الوصم الداخلي"، حيث تبدأ المرأة العربية بتصديق تلك النظرة السلبية وتشعر بأنها أقل من المرأة الأوروبية، وهو ما يؤثر على تقديرها لذاتها وثقتها بنفسها.
هذا الضغط النفسي يتقاطع مع تمزّق في الهوية. كثيرات يشعرن بأنّ عليهنّ إما أن يتخلّين عن ثقافتهنّ الأصلية بالكامل بغرض الاندماج، أو أن يتمسكن بها مع تحمّل تبعات التمييز والعنصرية. في الحالتين، يبقين أسيرات صورة مسبقة لا تتيح لهنّ أن يُنظر إليهنّ كأفراد مستقلات.
اجتماعياً واقتصادياً، تخلق هذه الصور النمطية عوائق كبيرةً في سوق العمل والتمثيل العام، كما بيّنت الدراسة النمساوية سابقة الذكر.
من جهتها، تشير هديل إلى شعورها الدائم بأنها تحت المراقبة في المجتمع الذي تعيش فيه، حيث تُفحص تصرفاتها وعلاقاتها بعناية، ويُتوقّع منها أن تتبنى مواقف وسلوكيات مشابهةً لما يراه محيطها "طبيعياً"، خصوصاً في تعاملها مع شريكها أو رؤيتها لدور الرجل في العائلة.
كما تتعرض هديل، لأحكام نمطية حول الأمومة والإنجاب، إذ يُفترض أنّ حب النساء العربيات للإنجاب أمر متخلف، وتُواجَه أحياناً بردود صادمة تختزل تجربتها الشخصية، كمن يطالبها بقطع علاقتها بوالدها فوراً لأنها تعرضت للتعنيف منه. وترى أنّ كل ذلك يُشكّل محاولةً ممنهجةً لتفكيك النسيج العائلي والثقافي الذي تنتمي إليه، تحت شعار "التحرر"، فيما يُختزل تقييم "تقدم" المرأة العربية بمدى تشبهها بالنموذج الأوروبي الذي تعدّه هديل بعيداً كل البعد عن المثالية.
تظهر البيانات أنّ نسبة الإناث الحاصلات على تعليم جامعي في الكثير من الدول العربية تفوق نسبة النساء الحاصلات على تعليم جامعي في أوروبا.
ويتحدث حازم إلى رصيف22، عن استخدام الخطاب المتعلق بتحرير المرأة كأداة سياسية تُوظّفها الدول الغربية لتبرير تدخلاتها العسكرية والسياسية في العالم العربي، كما حصل في العراق وأفغانستان، وفي التغطية الإعلامية للأحداث في إيران، حيث تم التركيز على "إنقاذ المرأة". وتُستَخدم هذه الصورة، بحسب معيوي، لتقييد سياسات الهجرة، عبر القول إنّ ثقافة المجتمعات العربية لا تتماشى مع "قيم" الغرب، وتالياً يتم تبرير تشديد القيود على دخول العرب والمسلمين بحجة صعوبة اندماجهم.
تمكين المرأة العربية
يرى حازم، أنّ تفكيك الصورة النمطية عن المرأة العربية يبدأ من الداخل، عبر ما يُسمّى بالتمكين الذاتي وتنمية الوعي الشخصي، أي أن تقتنع المرأة بأنّ الصور والأفكار المفروضة عليها لا تُشبهها، فـ"الانهزام الداخلي أسوأ من الهدم الخارجي"، كما يصف.
ويؤكد على أهمية استعادة المرأة صوتها من خلال مشاركة قصتها الشخصية، سواء عبر الإعلام أو البودكاست أو المحيط القريب، وهو ما يُعرف في علم النفس بـ"العلاج السردي"، إذ تخلق هذه الروايات مساحةً لتحدّي التصوّرات السائدة.
ويضيف أنّ التعليم والبحث العلمي أداتين فعّالتين لتفكيك السرديات الاستشراقية من داخل المنظومة المعرفية ذاتها.
كما يدعو إلى التحالف مع الحركات المناهضة للاستعمار والرأسمالية، لأنّ هذه البنى، حسب رأيه، هي التي أسست أصلاً لفكرة المرأة العربية كضحية تحتاج إلى إنقاذ. ويختم بأهمية الانتقال من الخطاب الفردي إلى البنيوي، عادّاً أنّ القوة لا تكون في الصوت الوحيد، بل حين يتحوّل إلى أصواتٍ متراكمة تُشكّل وعياً جماعيّاً قادراً على التغيير.
النساء العربيات لسن قالباً واحداً، فلكل منهنّ رؤيتها وقيمها وتعقيداتها ومعاركها الخاصة. ولا يمكن الإنكار أن المرأة العربية في أوروبا تعامل أحياناً كأقل قيمةً من نظيراتها الأوروبيات. مع ذلك، لستُ من أنصار فكرة "الغرب الشرير"، فنحن جميعاً قد نقع في فخ إصدار أحكام مسبقة على الآخرين استناداً إلى تجارب محدودة. أؤمن بأن بإمكان النساء العربيات كسر هذه الصور النمطية وإعادة تشكيلها، فالأحكام المسبقة لا ينبغي أن تكون ذريعةً لغياب الاندماج أو تعطيل مسار التطور.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.