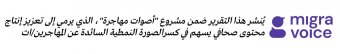
هذا المقال نتاج ورشة "مدخل إلى الكتابة الذاتية" التي نظمتها غرفة الكتابة مع الروائية نورا ناجي.
وقفت ذات يوم صيفي تحت شجرة عالية، تتمايل أغصانها المورقة مع الريح، وتظلّل النساء العربيات اللواتي اجتمعن في الحديقة مع أطفالهنّ، وانضممت إليهنّ كوافدة جديدة إلى هذه المدينة الإنكليزية الصغيرة التي لم يسمع بها أحد.
كنت وحدي على جنب، أتابع ابنتي ذات العامين تجري في المكان مع الآخرين. نادتني سيدة أردنية لا يقلّ عمرها عن الستين، وسألتني: "تشربي ميرمية؟". وافقت، فأنا لم أجرّب الميرمية من قبل. قدّمت لي السيدة غطاء التُرمس البلاستيكي الذي يقوم بدور الكوب أيضاً. نظرت إليه بين يديّ، ولم أميّز لون الشراب بسبب سواد الكوب، لكنه كان ساخناً، تتصاعد أبخرة الدخان منه، وعندما قرّبته من شفتيّ ودغدغ عبير الميرمية أنفي، شعرت بالدموع تندفع إلى عينيّ.
أخبرتني طفلتي أن بعض زميلاتها البريطانيات والأوروبيات تساءلن عن اختلاف ألوانهنّ، فحدثتها عن أن الله خلقنا بصور متعددة من الجمال
استدرت ومشيت ببطء وأنا أشاهد ابنتي ريثما أستجمع نفسي، أرتشف الميرمية الدافئة، أتذكر أياماً في الطفولة خُبزت فيها المناقيش بالزعتر ومعجنات السبانخ بالبصل والسماق، سُكب فيها زيت الزيتون على أطباق اللبنة وحبات المكدوس وأرغفة المسخن، وصَدح فيها صوت فيروز من جهاز الراديو بينما غلت القهوة في الكنكة على الموقد. أتذكر أيادي سميكةً انتشرت عليها التجاعيد الرفيعة، وأصابع صارت مسطحةً قليلاً بأثر العجين والغسيل، وهي برغم ذلك ناعمة رقيقة إذا لمستها. عدت إلى النساء اللواتي جلسن تحت الشجرة، وشكرت صاحبة الميرمية قائلةً لها إنها ذكّرتني برائحة بيت أمي وجدّتي الفلسطينية.
أرجعني كوب الميرمية إليهما، برغم شعوري بأنني بطّة عائلتي السوداء. ولكن هكذا تفاجئنا الغربة، تفكك من نكون وتترك القطع الممزّقة لنا. نصلحها، نعيد تشكيلها، أو نحملها بين أيدينا ونمضي بارتباك؛ لا توجد إجابة، ولا تكترث الغربة لمشاهدتنا نكدح لنرمم ما كسرته فينا. لطالما أحسست بأنني لم أحظَ في عائلتي بالدلال والصفح اللذين حظي بهما الآخرون، أنا الابنة الكبرى والحفيدة الكبرى، ومن المتوقع مني تفهّم الجميع، تحمّل آلام لم أختَر أن أتحمّلها، والاستماع إلى تعليقات تقال بيقين مثل: "هي لا تحتاج مساعدة"، و"هي ليست مثل هذه أو تلك"، فأصمت عن طيب خاطر، وكأنّها مديح. لماذا لا تربت الأيدي التي لطالما أحببت على كتفيّ؟
كانت أمّي أيضاً، أول مولودة وتغرّبت في شبابها (طفولتي)، وجدّتي الابنة الوحيدة وسط ثلاثة صبيان، عاشت ما لا نطيق فهمه في 1948، ثم تغرّبت مع زوجها سنوات طويلة، وأمّ جدّتي هاجرت وحدها من القاهرة إلى اللدّ وهي لم تبلغ العشرين من العمر لتتزوج وانفصلت عن كل ما تعرف. بدا لي أننا نورث الغربة والهم جيلاً بعد جيل. ولكنني أظنّ أنه ربما لو فهم أحد ما أشعر به -وهنا يتجلّى ما أحسّ بأثر سنوات من التربية أنه أنانية بحتة- لهان حزن غربتي قليلاً.
ألوان وقذائف
سألتني ابنتي مؤخراً، وقد صار عمرها ستة أعوام: "ماما، ما لوني؟".
قلت لها: "لونك خليط من لون بابا وماما، ما اسم هذا اللون في رأيك؟".
فردّت بالإنكليزية: "لون الخوخ"، ثم ضحكت.
سألتها: "هل سألك أحد عن لونك في المدرسة؟".
قالت لي: "نعم".
أخبرتني أنّ بعض بنات صفّها البريطانيات والأوروبيات تساءلن عن ألوانهنّ المختلفة لسبب ما، تلا ذلك حديث بيننا عن كيف خلقنا الله جميعاً في صور مختلفة من الجمال، وعن أننا كلنا واحد ولو اختلفت أشكالنا، والكل أصدقاء.
ثم قال لها زوجي: "إذا سألك أحد ذلك مرةً أخرى، قولي له: إنّ لوني أفضل لون".
ضحكت ابنتي وأكملت الثرثرة عن أمور مختلفة، أما أنا فتذكرت صديقةً مصريةً بشرة أولادها أكثر اسمراراً من ابنتي، حكت لي أنّ ولداً إنكليزياً قال لابنها في المدرسة: "لا أريد اللعب معك، لأنّ جلدك متّسخ"، فقلت لها إنّ عليها تقديم شكوى لمديرة المدرسة، ولكنها لم تفعل.
أنا اليوم غاضبة ومتعبة؛ من تجاهل تحيتي عند باب المدرسة، ومن وجوه متجهمّة في المتجر، ومخاطبتي بصوت عالٍ على افتراض أني لا أفهم اللّغة
في رمضان الماضي، صنعنا توزيعات بسيطةً لتعطيها ابنتي لأصدقائها في الصف، في محاولة لتعزيز فخرها بهويتها. وقفنا في نهاية اليوم الدراسي، وراحت تمدّ يدها الصغيرة لكل من زملائها بهديته، لكن لم يعِرني أيّ من أولياء الأمور انتباهاً بينما قمنا بذلك بإذن من مدرسة الصف. كلهم وقفوا يستلمون أبناءهم بلا تعليق، باستثناء واحدة اقتربت مني وسألتني عن السبب وراء هذه التوزيعات، فأخبرتها بأننا نحتفل بالشهر الكريم، وابنتي أرادت مشاركة أصدقائها ذلك. بهت لون وجهها تماماً، وحملقت فيّ للحظة كمن فقد النطق، ثم قالت: "شكراً" مسرعةً، وذهبت. لم أعرف حينها إن كنت قد دعمت ابنتي أو زدت عزلتها بين أصحابها. ابتلعت إحباطي وأخفيته، هلّلت لابنتي ومدحتها، وأخبرت زوجي في البيت كم كانت رائعةً، وكم أُعجبت بها معلمتها. ولكن كانت قطع الهمّ تسقط متيبسةً في صدري مع كل كلمة نطقتها.
أنا اليوم غاضبة ومتعبة جداً. تعبت من عدم الردّ على "صباح الخير"، عند بوابة المدرسة، ومن تجهّم موظفي السوبر ماركت في وجهي بعدما كانوا في قمة الابتهاج مع الزبون الذي سبقني، ومن المعاملة الدونية التي تلقّيتها من البعض في المكتبة العامة حيث عملت لفترة مؤقتة، وتعبت من افتراض من أحدّثه أنني غبية فيخاطبني ببطء وصوت عالٍ: "من أجل أن أفهم"، من مواقف عجيبة تتكرر كعندما سقطت على وجهي في الشارع فانقطع بنطالي وسال الدم من ركبتي، وكنت بجانب محطة أوتوبيس ولم يلتفت إليّ أحد، أو عندما كنت حاملاً في الشهر الثامن وانفرط كيس المشتريات من يدي على الرصيف ولم يتوقف لي أحد.
لم أعد أحبّ الذهاب مع أولادي إلى الحديقة، لأنني في اللحظة التي أنطق فيها ويعرف الموجودون أنني أجنبية، تبدأ نظرات التفحص والترقب، وكأنّ أولادي يحملون حزاماً ناسفاً حول أجسادهم الضئيلة، أو كأنني سأُخرج قذيفةً من بين الشطائر في حقيبة الطعام وأفجّرها في نفسي والجميع حتى ننتهي من هذا التخلّف.
مع مرور الوقت وقراءة تجارب مماثلة، أدركت أنّ الكثير من البريطانيين يعتقدون أنّ الأجانب يهملون في تربية أبنائهم، لذا يتوقعون من أبنائي مثلاً أن يلجأوا إلى العنف أو يفتقروا إلى مهارات الذوق في اللعب، كانتظار دورهم، أو أنني شخصياً سأتحول إلى غول وأنا أكلّم أولادي في الحديقة، وأرعب أطفال بريطانيا أبناء اللطافة والسماحة، هؤلاء الصغار الذين يسألون ابنتي عن لونها في المدرسة.
حرية ملتبسِة
تحركت في بداية قدومي إلى بريطانيا في الشوارع والمواصلات ورأسي هادئ تماماً، جسدي غير متيّبس تأهباً ليدٍ ستمتد إليه من حيث لا أرى، غير قلقة من سماع كلمة بذيئة في أي لحظة. كنت أمشي فقط. جسدي كله لي، وعيناي تتفقدان العالم المفتوح أمامي بحرية. مشيت كثيراً في كل مكان حينها، وأنا أستمتع بشعور أن لا أحد ينظر إليّ.
ولكنني أدركت مع مرور السنوات، أنّ قيداً جديداً يكبّلني في البلد الجديد. لم أكن حرةً لأعبّر عمن أكون. كشف العالم الرحب عن خداعه، وكأنه يقول لي: امشي كما شئتِ ولكن تيقّني من أن لا أثر لقدميك هنا، ولا تتمدّدي على العشب الأخضر كأنه إرثك، كوني ممتنةً لأنني آويتك تحت سمائي الغائمة، ولكن لا تتنفسي رائحة المطر متخيّلةً أنها تحمل لكِ أنتِ الراحة، ولا تخبري أحداً بذكرياتك الغريبة التي لا تليق بقصصي عن إمبراطوريتي العتيقة.
ربما هذه ليست تجربة الكلّ، ولكنها ما حدث لي، خاصةً عندما عشت خارج المدن البريطانية الكبرى، والتحقت بأماكن عمل تقليدية لا مساحة (ولا احتياج مادي) فيها للتعدد الثقافي. شعرت أنّ آرائي وقناعتي بلا قيمة، كما كان عليّ ابتلاع ضيقي، والتصرف بلطف دائماً، والتغاضي حتى عن الإهانة كي أبتعد عن المشكلات. ليس ذلك فقط، بل ألا أذكّر أحداً باختلافي؛ بأنّ لي لساناً آخر، ديناً آخر، ولغة جسد أخرى. كلما خبّأت، سارت الأمور بشكل أفضل. كان كل شيء أقوم به يُفسر من خلال عدسة "الجسد الأجنبي"، ولكن يتميز البريطانيون بإتقان عدم البوح صراحةً أبداً بذلك.
لم أعد أحب اصطحاب أطفالي إلى الحديقة؛ فبمجرد أن يُكتشف أنني أجنبية تبدأ نظرات الريبّة، كأننا خطرٌ داهم
اكتشفت أنّ الارتباك الذي يتملّكني يصيب الآخرين أيضاً عندما رأيت فيديو لنادية حسين، الطاهية البريطانية ذات الأصول البنغلادشية، التي حققت نجاحاً واسعاً هنا في السنوات الأخيرة. قالت إنّ تربيتها كابنة مهاجرين في بريطانيا ربّت فيها شعوراً بأنّ عليها ارتداء الامتنان كـ"اليونيفورم" حتى تعيش، وتبدي الامتنان الشديد بداعٍ ومن دونه، لمجرد أنها من أصول غير بريطانية، حتى لو كان ما يقدَّم لها عادياً ويحظى به الجميع، والأهم من ذلك لم يكن يحق لها الشكوى؛ كيف تجرؤ على ذلك؟ ألا يكفي أنها مسلمة ذات بشرة داكنة من أسرة مهاجرة وتسمح لها بريطانيا بالعيش فيها؟ تحدثت نادية بعيونها الدامعة عن الضغط الرهيب الذي لازمها طوال حياتها جرّاء هذه النظرة.
أنا لست ناشطةً حقوقيةً، ولا أريد أن أحارب بلا رجاء. أنا في الواقع خائفة طوال الوقت. وُلد الخوف في داخلي، وأنا مغتربة مع أهلي في طفولتي في أيرلندا عقب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، ولم يتركني أبداً، منذ أن رمى شباب مراهقون الحصى عليّ أنا وأمي وأختي ذات يوم في الشارع، منذ أن بصق رجل بكل قوته حيث خطوت أمامه على الرصيف، ومنذ عادت أمّي باكيةً إلى البيت ذات يوم لأنّ رجلاً صوّب يده تجاهها في علامة مسدس، إلى هذه اللحظة وأنا خائفة من أن أردّ على النادلة التي جلبت لي الطعام الخطأ في المطعم حيث جلست مع أولادي، وحدثتني بصوت عالٍ وقلة ذوق لمجرد أني قلت لها بهدوء: "عذراً، ولكنني لم أطلب هذا الطبق"، يسترق الناس نظرات باردةً لي، يشاهدني أولادي في صمت وأنا أحارب توتري، بينما أنا موقنة أنّ صوتي لم يكن ليهتز، فقط لو لم أكن في بريطانيا.
ظلال منسيّة
"ما هي مشكلة ريم؟"؛ تقول الكثيرات من المغتربات اللواتي أقابلهنّ، أنني أتحدث الإنكليزية بطلاقة، غير محجبة، ومرنة بسبب صغر سنّي، فما المشكلة إذاً؟ ماذا لو كنت أحتاج إلى دورات لتعليم الإنكليزية، وأرتدي الأثواب الطويلة والحجاب، وسافرت وسنّي أكبر بعدما يتعود الإنسان على نمط من الحياة يصعب تغييره، وإلى آخره من الصعوبات التي لم أعانِ منها. ما هي مشكلتي حقاً؟ لا أعرف ما هي مشكلتي.
أدرك أنني في نعمة كبيرة، عندي أولاد أصحّاء وبيت يؤوينا، مستورين نتكفل بكل احتياجاتنا، وهناك قانون يحمينا إذا حدث لنا أي شيء. كلها نعم، بل فيض من النعم. ولكني أطمع أحياناً في المزيد؛ أن أشعر بأنني أعيش، أتكلم وأضحك بلا خوف وأمزح وأغنّي، بأنني امرأة ولست جسداً أجنبياً، بأنني أمّ بقلب يخاف على أبنائها، بأنني إنسانة بتاريخ وعائلة وذكريات وافرة عن الأماكن والأصدقاء والأحلام... ولست جهازاً آلياً يكبت كل مظاهر آدميته ويمضي في الدور المطلوب منه من أجل اللقمة وباب البيت الموصد في الليل. أنا أعيش كالظلّ، كالشبح العابر، كمن يضع كل شيء مرتبط بمن يكون، وبماذا يشعر، وفي ماذا يفكر في داخل صندوق يُقفل ويجمع التراب في ركن بعيد، لا يراني أحد ولا يسمعني أحد، لا يعرفني أحد، بل لا يريد أن يعرفني أحد.
حين أنظر إلى نفسي في المرآة لا أعرفني. ربما انتزع تقدّم العمر وجهي منّي، تركت هزائم الحياة التي لا ندركها في العشرين أثرها على روحي، استنزفت الأمومة مني الصحة والوقت وأورثتني قيود الذنب والقلق... ولكن كل هذه الأشياء لا تعادل أعظم إخفاقاتي؛ هي لا تساوي عمق الألم الذي حفرته الغربة في قلبي. عندما أتخيّلني الآن، أرى كومةً وحيدةً في طرف الأريكة في نهاية كل يوم، أضمّ ركبتَيّ وأجلس بظهر مقوّس كصدفة سلحفاة، أغرق داخل نفسي. منهكةً، أتمنى أن أرتاح، ولا أعرف كيف نسى صدري أن ينفتح ويتنفس هبّات النسيم حتى أطير وأطير، يملؤني العبير حدّ الفرحة، حدّ الشفافية، وحدّ الحياة.
لم أعد أقول صباح الخير، ولا ألتفت إلى أحد في المدرسة أو غيرها، وتالياً لا أتضايق من الجفاف والصدّ، ولكنني أنكسر ويغمر الحزن قلبي عندما أتخيّل أنني قد أعيش بقية عمري هكذا؛ وحيدةً، ومنسيّة. أفكر كثيراً في الذهاب إلى محامٍ لكتابة وصية قانونية واجبة النفاذ، خوفاً من الموت هنا فجأةً. لا أريد أن أوصي بشيء سوى بنقل جثماني إلى القاهرة، ودفني حيث سيُدفن أبي وأمي بعد عمر طويل. أتخيّلني أقول لزوجي: لا تتركني هنا، لا تتركني. لا أريد النوم في الطين الرطب المغطّى بالعشب الأخضر، لن أرقد في البرد والظلام، أريد أن أبيت تحت التراب الجاف، تحت نور الشمس، حيث لا يسكت الصوت ولا تختفي خطوات الأقدام، حيث يدعو الكروان كل ليلة، حيث عرفتك وأحببتك، وحيث أعرف من أكون.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


