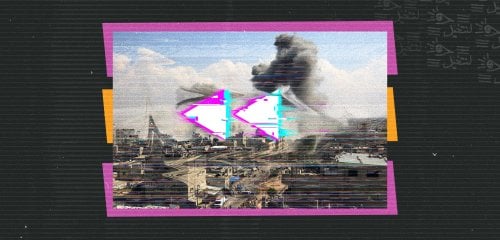في زحمة الخطابات المتصارعة حول المقاومة والهيمنة، ووسط الضجيج الذي تثيره شعارات "الممانعة" وتناقضاتها، تغيب الأسئلة الجوهرية التي ينبغي أن تُطرَح: هل ما نراه مقاومة فعلية أو استثمار سلطوي في الغضب؟ هل تُخاض المعارك باسم الشعوب أو باسم بقائها مُقيّدةً؟ إنّ نقد التجارب التي تتسلّح بالمظلومية لتبرير الاستبداد لم يعد خياراً ترفيّاً، بل ضرورة أخلاقية وسياسية في آنٍ واحد. فما نعيشه اليوم ليس مجرد إخفاق في تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، بل انهيار في المعنى، في البوصلة، وفي صدقية الخطاب ذاته.
هذه التدوينة ليست هجوماً على من اختاروا طريق المقاومة، ولا تبريراً لمشروع استيطاني قائم على السرقة والعنصرية، بل هي محاولة لتفكيك سرديات تتبادل الأقنعة، وتُعيد إنتاج القمع تحت أسماء مختلفة. إنها محاولة صادقة لإعادة التفكير في معنى التحرر: هل هو كسر للقيد فحسب أو أنّ هناك قيوداً أخرى، أكثر خفاءً، تعيد الإنسان إلى سجونٍ أوسع بينما يظنّ أنه حرّ؟
ليست المأساة الكبرى في إخفاقات محور "الممانعة" العسكرية أو التراجعات السياسية فحسب، بل في الانهيار الأخلاقي الذي صاحب هذا المشروع، حين حوّل القضايا العادلة إلى أدوات فارغة تُستخدم لتكريس سلطة قمعية، وأفرغ مفاهيم التحرر من معناها الإنساني الأصيل. إنه مسار جرّد القضية الفلسطينية من زخمها السياسي والشعبي، وفتح الباب أمام معادلة شديدة الخطورة بعد أحداث السابع من أكتوبر: سلام يُفرض بالقوة، لا يستند إلى عدالة تاريخية، ولا يعترف بحقّ تقرير المصير، بل يقوم على الإذعان والخضوع، ويهدد من يرفضه بالدمار الشامل.
هذه التدوينة ليست هجوماً على من اختاروا طريق المقاومة، ولا تبريراً لمشروع استيطاني قائم على السرقة والعنصرية... بل هي محاولة صادقة لإعادة التفكير في معنى التحرر: هل هو كسر للقيد فحسب أو أنّ هناك قيوداً أخرى، أكثر خفاءً، تعيد الإنسان إلى سجونٍ أوسع بينما يظنّ أنه حرّ؟
وُلدت "الممانعة" كخطاب مناهض للهيمنة، لكنها تحوّلت تدريجياً إلى أداة في يد أنظمة تسعى إلى ضبط الداخل بالقمع، وتدّعي المواجهة الخارجية كشعار يُبرّر سطوتها. وهكذا اختلطت مقاومة الاحتلال بممارسات داخلية تُعيد إنتاج الاستبداد ذاته، فصار الانتقاد ممنوعاً باسم "المعركة الكبرى"، وسُحقت أصوات المعترضين تحت وطأة التخوين.
في ذروة هذا التحوّل، فقدت القضية الفلسطينية أوراق ضغطها الأكثر فاعليةً: الدعم الشعبي العابر للحدود، الرمزية الأخلاقية، والخطاب الحقوقي المتّزن. تراجعت القدرة على بناء التحالفات، وتقدّم خطاب الغضب بلا أفق كبديل إستراتيجي. بهذه الطريقة، لم تُعطَ المبادرة ليد الاحتلال فحسب، بل رُسمت له صورة "المُتحكم العاقل" في محيط يتخبّط في خطاب متشظٍّ وردود أفعال غير محسوبة.
ومع خفوت بوصلة التحرر، بدأت بعض الأصوات تنجرف -بوعي أو من دونه- نحو الانبهار الخفيّ بقدرة المشروع الاستيطاني على "الإدارة" و"الفعالية"، حتى بات النظام القائم على القمع والعنصرية يُنظر إليه بوصفه نموذجاً فقط لأنه يُتقن السيطرة. هذا الإعجاب بآلة القمع، حين تكون فعّالةً، هو سقوط أخلاقي عميق: فالتفوّق التقني أو الأمني لا يضفي شرعيةً على مشروع يقوم على التهجير والعنف المنهجي؛ تنظيم أدوات الإبادة لا يجعلها أقلّ وحشية.
ويزداد المشهد التباساً حين يُطرح مثال محاكمة بنيامين نتنياهو كدليل على "تمايز ديمقراطي" لهذا النظام، وكأنّ مجرد مثوله أمام القضاء يُثبت نزاهة الدولة ومؤسساتها. لكن الحقيقة أنّ الرجل متّهم منذ سنوات في قضايا فساد واستغلال سلطة، ولم يُحاكم فعلياً حتى اليوم، بل ظلّ يتمتع بحصانة سياسية وفّرتها له تحالفات حزبية وتشريعات استثنائية، تُشبه إلى حدّ بعيد تلك التي تُنتقد في أنظمة المنطقة. بل إنّ نتنياهو، المطلوب بمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، لا يزال يتنقل بحرية بين عواصم ديمقراطية موقعة على نظام المحكمة، دون أن يُواجَه بأيّ إجراء قانوني. فهل تُقاس الديمقراطية بالشكل أو بالمضمون؟ وإن لم تكن هذه استنسابية القانون، فما تكون؟
ومع إدراك ذلك، يصبح ضرورياً التفريق بين نقد ممارسات فصائل "المقاومة" -حين تنحرف عن بوصلتها التحررية- وبين تبرير الاحتلال. نقد "الممانعة" لا يعني تبنّي خطاب النظام الاستيطاني، كما أنّ انتقاد القمع الداخلي لا يبيّض صورة القامع الخارجي.
في ظلّ هذا التراكم من الازدواجيات، تغيب الحقيقة الأهم: النظام الاستيطاني ليس وليد مؤسسات ديمقراطية نامية، بل تأسّس على بنية عنصرية متجذّرة، تقصي الفلسطيني بوصفه نقيضاً وجودياً. لا يمكن أن يُفهم هذا النظام على أنه "ديمقراطي بوجه قبيح"، لأنه في جوهره يختزل الإنسان إلى تهديد يجب إسكاته لا إلى شريك في المصير. لذلك، فإنّ مدحه تحت ذريعة "الفعالية" تبييض فادح لجوهره الإقصائي.
ومع إدراك ذلك، يصبح ضرورياً التفريق بين نقد ممارسات فصائل "المقاومة" -حين تنحرف عن بوصلتها التحررية- وبين تبرير الاحتلال. نقد "الممانعة" لا يعني تبنّي خطاب النظام الاستيطاني، كما أنّ انتقاد القمع الداخلي لا يبيّض صورة القامع الخارجي. الحرية ليست حكراً على نموذج ولا تُصنع بيد آلة حربية، بل تنبع من احترام الإنسان وكرامته.
المسألة، في جوهرها، ليست اصطفافاً سياسياً ولا خياراً أيديولوجياً، بل موقف أخلاقي لا يقبل الالتباس. كل مشروع يُقايض العدالة بالقوة، ويختزل البشر إلى أدوات في صراعاته، لا يستحقّ الدفاع عنه مهما علا صوته أو أتقن تنظيم صفوفه. لا شرعية لأيّ سلطة تُخضع الناس بالقهر، ولا مصداقية لشعارات تُرفَع باسمهم فيما تُنتهَك كرامتهم. وحده المعيار الأخلاقي الواضح يستطيع أن يمنح هذا النقاش ملامحه الحقيقية: أن نرفض القامع، أيّاً كان اسمه، وأيّاً كانت رايته.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.