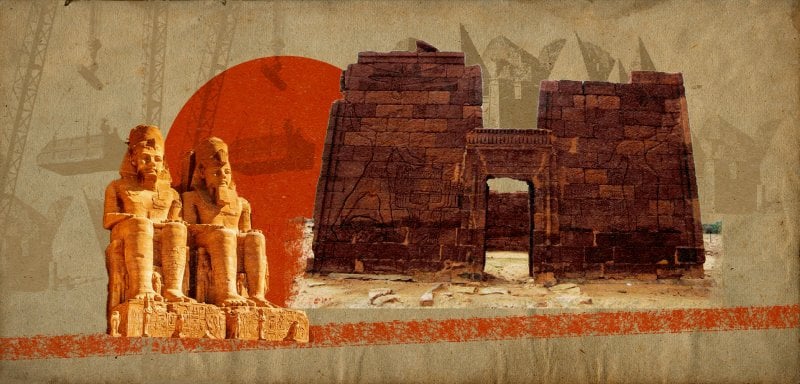في العام 1954، تزامن التفكير الجدّي في إنشاء السدّ العالي مع تعاظم القلق على الآثار المنتشرة في منطقة النوبة المجزّأة بين مصر والسودان، والتي تمتد بشكل عام من أسوان حتى الشلال الرابع.
فالبحيرة الصناعية الضخمة التي كان من المتوقع تكوّنها خلف السدّ، ستُغرق أرض النوبة السفلى من الشلال الأول حتى الثاني، وتخفي معالمها وتحيلها بكل ما فيها من آثار وبيوت وحياة إلى أنقاض مطمورة في أعماق الماء.
حينها أوفدت وزارة التربية والتعليم المصرية، التي كان يتبع لها مجلس الآثار الأعلى، بعثةً إلى بلاد النوبة لوضع تقرير عما يُمكن إنقاذه من الآثار.
في مطلع العام التالي، وضعت اللجنة تقريراً أوصت فيه بتنفيذ حملة واسعة لتسجيل الآثار المهددة ونقوشها، ونقل بعض المعابد والتماثيل، وكذلك نزع الرسوم المسيحية في معبد السبوع ومعبد أبي عودة. هذه الأعمال كلها كان مستحيلاً على مصلحة الآثار تنفيذها وحدها، بسبب ضآلة إمكانياتها الفنية والمادية، واحتاجت أن يتآزر العالم بأسره معها في هذه المهمة الثقيلة.
ما وراء النداء
لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها مصر لمثل هذا الموقف، وإن كانت أكثرها خطورةً. فوفقاً لكتاب "حملة اليونسكو وأضواء جديدة على تاريخ النوبة" للدكتور محمد غيطاس، فإنّ منطقة النوبة تعرضت لأخطار الانغمار بالماء منذ بناء سدّ أسوان عام 1902، والذي كان مخططاً له أن يحتجز خلفه 980 مليون متر مكعب من الماء في بحيرة صناعية امتدت جنوباً مسافة 140 ميلاً.
هذا الأمر دفع الحكومة وقتها إلى إرسال فرق من المهندسين لتقوية أساسات بعض المعابد المهددة، ومنها معبد فيلة ومواقع أثرية أخرى، كذلك جرت عمليات تهجير محدودة للنوبيين إلى مناطق أخرى أكثر ارتفاعاً دون أن يضطروا إلى مفارقة أراضيهم بشكل كلّي. أما هذه المرة، ومع خطط بناء السدّ العالي العملاقة، فإن الخطر كان أكبر من أن تتصدّى له مصر وحدها.
في 6 نيسان/ أبريل 1959، أطلقت مصر نداءً دولياً لمساعدتها في إنقاذ أهم آثارها القديمة، التي توقعت أن تغرق بعد الارتفاع المتوقع لمنسوب المياه في تلك المنطقة، كأحد تداعيات حجز الماء وراء السدّ العالي.
بعد 6 أشهر، وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، أطلق السودان نداءً -أقلّ شهرةً- لإنقاذ معابده هو الآخر من الغرق، ليعمل البلدان بالتنسيق معاً لحشد دعم دولي لإنقاذ آثار حضارتهما من الغرق.
قبل تدخل اليونسكو بسنوات، كانت وزارة التربية والتعليم المصرية هي من أرسلت أول بعثة إلى النوبة لوضع خطة إنقاذ للآثار المهددة بالغرق بسبب السد العالي. ولم تكن هي المرة الأولى التي تضطر مصر فيها لمواجهة خيار صعب كهذا، فقد حدث الأمر ذاته مع التخطيط لبناء سد أسوان في عام 1902
وبحسب المقدمة التي كتبها الدكتور محمود طاهر لكتاب "أسرار معابد النوبة" لكريستيان ديروش نوبلكور، فإنّ تلك التحركات خرجت في زمن عاشت فيه مصر علاقات متوترةً مع الغرب، في أعقاب العدوان الثلاثي عام 1956، وفي ظلّ رفض غربي لمشروع السدّ العالي.
لكن بفضل جهود الدكتور ثروت عكاشة، وزير الآثار آنذاك، نجحت مصر في لفت انتباه العالم إليها، وإقناع كثير من الدول بالانضمام إلى معركتها في الحفاظ على الآثار.
في آذار/ مارس 1960، تبنّت اليونسكو القضية، وقادت جهوداً دوليةً لبحث كيفية إنقاذ المعابد القديمة، وعلى رأسها معبدا "أبو سمبل" و"فيلة" بعدما شكلت لجنةً من صفوة خبراء الآثار والهندسة في العالم، ترأّسها غوستاف السادس ملك السويد.
بعد انتهاء هذه الحملة، استأثرت مصر وآثارها بالأضواء كلها، ربما حتى اليوم، لكن ما هو معروف بقدر أقلّ أنّ أضرار السدّ العالي امتدّت أيضاً إلى عدد كبير من المواقع الأثرية في شمال السودان، وأنّ مظلة حماية اليونسكو امتدّت لتنقذ بعضاً من هذه الآثار بينما تُركت أخرى لتلاقي مصيرها المحتوم؛ الغرق.
فماذا نعرف عن تفاصيل تلك التضحية الكبرى التي قدّمها السودان لمصر حتى تحظى بالسدّ العالي؟
تاريخ السودان في الأعماق
بحسب كتاب "إنقاذ آثار النوبة" الذي ألّفه نجم الدين محمد شريف، مدير مصلحة الآثار، فإنّ بلاده كانت على موعد مع التحدّي الأثري الأضخم في تاريخها بعدما أكدت الدراسات أنّ المنطقة السودانية المهددة بالغرق يصل حجمها إلى 113 ميلاً.
الأكثر خطورةً أن تلك المنطقة هي الأغنى أثرياً في السودان بُحكم لعبها دور الوسيط المستمر بين أصحاب الأرض والجارة القوية مصر، لذا فإن أرضها استضافت العديد من الحضارات القديمة بتاريخٍ يبدأ من العصر الحجري الأول ويصل إلى حملة محمد علي باشا في السودان عام 1820.
صحيح أنّ أغلب تلك المواقع ظلّت مهملةً إلى وقت طويل، وبعضها لم يقترب منه أثري مطلقاً، إلا أنّ ذلك أمر يُمكن تفهّمه في ضوء تأخر تكوّن دولة السودان المستقلة بمفهومها الوطني، والتي لم تحصل على استقلالها إلا عام 1956.
وفي تقريرها "النصر في النوبة: أعظم عملية إنقاذ اثرية على مر العصور"، الذي وثّقت فيه اليونسكو تفاصيل عملية إنقاذ معابد في السودان، تطرقت إلى أن منطقة النوبة السودانية، بخلاف النوبة المصرية، كانت غير معروفة عملياً؛، لذا فإنه حتى تلك اللحظة لم تكن قد دُرست بشكل شامل، وكان من غير المعقول أن تختفي منطقة بهذه الأهمية لتاريخ البشرية كلها دون إجراء بحوث أثرية دقيقة وشاملة فيها.
في عام 1960، استقبل السودان الأمير صدر الدين آغا خان، المستشار الخاص لمدير اليونسكو، لبحث كيفية إنقاذ الآثار السودانية.
أطلق السودان نداءً دولياً لإنقاذ معابده من الغرق في 1959، بعد 6 أشهر فقط من النداء المصري. لكنه لم يلقَ الصدى نفسه، رغم أن المنطقة كانت غنية بمئات المواقع التي طمرها الماء لاحقاً.
بعدها اتخذ السودان استعدادات جديةً لهذا الحدث، عبر تكوين لجنة محلية من خبراء الآثار لبحث كيفية تحسين جهود الإنقاذ، وتحسين الظروف أمام الجهات الدولية لتنفيذ مهمتها على أكمل وجه.
بحسب نجم الدين، فإنّه قبل تنفيذ أيّ أعمال نقل في الأراضي السودانية المهددة، قامت حكومة بلاده بتصوير جوّي لها بالكامل، ثم أُجريت أعمال مسح للآثار التي تقرر نقلها لتسجيل نقوشها وتصويرها بما يسمح بإعادة تشييدها لاحقاً.
4 معابد ومقبرة وأشياء أخرى
تحت إشراف المهندس المعماري الألماني فريدريش هنكل (Friedrich Hinkel)، انتقت هيئة الآثار السودانية 4 معابد ومقبرة تقرر نقلها إلى الخرطوم، بعدما جرت عمليات تقوية كيميائية لحجارتها، ثم أعيد بناؤها داخل ساحة المتحف القومي، والذي وُضعت خطة أخرى لتوسيعه هو أيضاً. وهذه الآثار هي:
معبد عكشة الذي شيّده الملك رمسيس الثاني، وكان متصدعاً فجرى العمل بحذر على فك حجارته طوال أيام شهر كانون الثاني/ يناير 1963، ثم نُقلت الحجارة إلى ميناء وادي حلفا عبر البواخر النيلية ومنها إلى الخرطوم بالسكك الحديدية، حيث أعيد تشييدها في الخرطوم عام 1968.
ومعبد بوهين، الذي بُني في عهد الملكة المصرية حتشبسوت وتحتمس الثالث، وكان أكبر معبد سوداني مهدد بالمياه واستغرقت عمليات نقله وقتاً طويلاً، بدأت في كانون الثاني/ يناير 1963 ولم تنتهِ إلا بعد 4 أشهر ثم نُقل بالطريقة عينها إلى الخرطوم، حيث بدأت عمليات إعادة بنائه عام 1967 وانتهت في أوائل 1969.
أيضاً في كانون الأول/ ديسمبر 1963، قامت مصلحة الآثار السودانية بقطع منحوتة تاريخية مهمة نُقشت على صخرة كبيرة في جبل شيخ سليمان على بُعد أميال قليلة جنوب بوهين، وهي التي أشارت إلى أنّ قدماء المصريين نجحوا في الاستيلاء على بلاد النوبة في عهد الملك دجر في أيام الأسرة المصرية الأولى.
جرى فصل تلك الوثيقة الحجرية في قطعة صخرية واحدة ونُقلت إلى الخرطوم وعُرضت في ساحة المتحف القومي في شهر نيسان/ أبريل 1969.
ساعدت في تلك الجهود بعثة إنكليزية برئاسة البروفيسور و. ب. امري (Walter Bryan Emery)، من جامعة لندن ممثلاً لجمعية البحث عن الآثار المصرية.
بعدها أتى الدور على معبدَي سمنة (غرب) وسمنة (شرق) اللذين جرت أعمال تفكيكهما وتركيبهما خلال شهري كانون الأول/ يناير، وتموز/ يوليو 1964، ثم نُقلا بالطريقة ذاتها إلى ساحة المتحف القومي.
بجانب هذه المعابد الأربعة، جرى نقل مقبرة الأمير جحوتي حتب المنحوتة في جبل في قرية دبيرة (شرق) على بُعد 22 كيلومتراً شمال وادي حلفا، والذي كان أمير تلك المنطقة خلال عصر حتشبسوت وتحتمس الثالث، واحتوت مقبرته على الكثير من النقوش والكتابات المهمة وكان لا بد من إنقاذها من الدمار.
تمكنت مصلحة الآثار السودانية من نقل المقبرة إلى الخرطوم عام 1963، وجرى تخزين أجزائها في المتحف حتى أعيد بناؤها في ساحته أواخر عام 1970.
وفي كانون الأول/ يناير 1964، نقلت مصلحة الآثار قطعاً من كتل صخور عليها كتابات فرعونية من جبل أبو صير في منطقة الشلال الثاني، كذلك انتُزعت لوحة نائب الملك المصري ستاو من الصخرة التي نُحتت عليها في كنيسة فرس.
كما نُقلت 5 أعمدة ضخمة من الغرانيت وعدد من رؤوس الأعمدة الضخمة وأشكال حجرية أخرى إلى ما سيُصبح لاحقاً متحف الخرطوم.
التضحية الكبرى
يُمكن ببساطة تلخيص ما جرى لمنطقة النوبة السودانية في عبارة كريستيان البليغة في معرض تعليقها على المشروع بقولها: "ها هي الأغلبية العُظمى من المعابد قد أُنقذت وبالرغم من ذلك فإنّ جزءاً لا يُستهان به من النوبة قد اختفى".
صحيح أنّ بعض المواقع ذات القيمة التاريخية الكبيرة قد أُنقذت، لكن تلك المنطقة العامرة بالتاريخ حوى باطنها من الآثار أكثر مما ظهر على سطحها، جزءٌ كبير من تلك الآثار المطمورة بقيت حبيسة التراب بعدما أغرقها الماء أيضاً فأصبحت رهينة المحبسين.
بجانب ذلك، فإن تلك المنطقة لم تكن أثريةً فحسب، بل سكنها بشر عاشوا وتنعّموا بخيراتها التي غابت عنهم بعدما دُفنت تحتها، فلم يبقَ لهم إلا التحسّر على ذكرى الأماكن الطيبة التي لم تكن أثريةً بما يكفي لتستحق خطة إنقاذ هي الأخرى، مثلما فعل عثمان أحمد نور في كتابه "ذكريات صياد"، حين حكى عن حمامات ساخنة مُعالِجة للناس من الأمراض الجلدية والروماتيزم وقعت بالقرب من دنقلا.
يحكي: "المشرفات على العلاج كنَّ نساء طاعنات في السن. يرقد الإنسان ويُهال عليه التراب إلا رأسه"، وبعدها كان الإنسان يبرأ مما يعاني منه على حد وصف عثمان.
وفي ختام حديث عثمان عن تلك العين الكبريتية الشمالية، يقول: "كان هذا قبل بناء السدّ العالي، أما بعده فقد غطت مياه السدّ كل هذه المناطق بالمياه، وبذلك فقدنا ضمن ما فقدنا منطقةً علاجيةً كان يشدّ لها الكثيرون الرحال".
في عام 1960، شكّلت اليونسكو لجنة دولية لإنقاذ آثار النوبة وترأسها ملك السويد غوستاف السادس. رجل تتبعه الدول والمنظمات الدولية والبعثات قاد بنفسه جهود إنقاذ معابد الجنوب قبل أن تختفي. مشهد نادر اجتمع فيه الملوك والمهندسون من أجل إنقاذ الرمال والتماثيل
فيما حكى متوكل أحمد أمين، في كتابه "النوبة: التراث والإنسان عبر القرون"، عن مدينة حلفا الواقعة قُرب الشلال الثاني والتي امتلكت منشآت تجاريةً وعسكريةً جعلت منها المركز الإداري الأول لبلاد النوبة السودانية، وهي المكانة التي تمتعت بها حتى القرن العشرين وحتى لحظة تدشين السدّ التي قلبت الموازين.
بحسب أمين، فإنّ حلفا عرفت نشاطاً كبيراً خلال الحرب العالمية الثانية بعدما كانت مركزاً لتجمّع المؤن والجنود الذين كانوا يُرسلون إلى شمال إفريقيا عبر السكك الحديدية أو عربات النقل أو بواخر النيل، ما دفع الإنكليز إلى شقّ طريق جديد غرب حلفا لضمان تدفق المؤن إلى القوات المحاربة شمال إفريقيا.
بعد الحرب عاشت المدينة في هدوء طويل أفاقت منه على وحي إطلاق حملة اليونسكو، وتوافد المئات من رجال الآثار والسياح الراغبين في زيارة آثار النوبة للمرة الأخيرة قبل أن تختفي المدينة بجميع معالمها أسفل الماء.
أما عن البشر أنفسهم، فقد تعرّض السكان النوبيون لعملية تهجير شهيرة تكرر الحديث عن مآسيها والأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها حكومتا البلدين خلال عمليات التسكين.
رحل النوبيون المصريون إلى منطقة كوم أمبو، أما إخوانهم السودانيون فهُجِّرت غالبيتهم إلى منطقة حلفا الجديدة في شرق السودان، وبلغ عددهم 53.7 آلاف نسمة بحسب إحصاء الحكومة وقتها وفقاً لما نقله أمين.
ويشير إلى أنّ النوبيين السودانيين صنعوا فناً شعبياً حزيناً، خلّدوا خلاله حالة الأسى التي عاشوها خلال الهجرة، وجرى غناؤها على مسرح حلفا الجديدة بعد تنفيذ عمليات الهجرة مباشرة.
ويُلاحظ أنّ خطوةً مشابهةً أقدم عليها الفنان النوبي المصري حمزة علاء الدين، الذي تعدّدت أغانيه التي ناقشت غرق بلاد النوبة والهجرة منها، وكثيراً ما غنّى تلك الأغاني في حفلات أحياها لأهالي النوبة.
ووفق كتاب "رحلة في زمان النوبة" لمحمد رياض وكوثر عبد الرسول، فإنّ تلك الهجرة حرمت النوبيين من العزلة النسبية التي عاشوها خلال مرحلة ما قبل السدّ، والتي كانت سبباً في بقاء اللغة النوبية حيّةً على ألسنتهم، وهو ما تغيّر تماماً بعد التهجير حيث فقد "النوبيون لغتهم الأصلية تدريجياً نتيجة المعاملات في مواطنهم الجديدة".
خلال وقت وجيز، أصبحت النوبية لغة ألغاز لا تفهمها إلا قِلة قليلة في مصر، وهو ما دفع الجيش المصري للاعتماد عليها كلغة مشفّرة خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
المكسب الوحيد تقريباً
قد تكون الحسنة الوحيدة التي ظفر بها السودان من كل هذه الظروف، هي تكثيف جهود عمليات التنقيب في مناطقه الشمالية قبيل تعرّضها للغرق، والتي نتج عنها اكتشاف آثار بالغة الأهمية تقرر إدراج بعضها ضمن خطة الإنقاذ ونقلها إلى الخرطوم هي الأخرى.
فلقد أظهرت دول كثيرة اهتماماً بإرسال بعثات أثرية وصلت تباعاً إلى أراضي السودان، بدأت بست بعثات في 1960، وازدادت حتى بلغت 22 بعثةً من 17 دولةً، وهذه البعثات جميعها تعيّن عليها العمل في زمن قياسي بعدما بدأت المياه بإغراق المنطقة بدءاً من عام 1964.
قبل تنفيذ مشروع السد العالي، قامت الحكومة السودانية بتصوير جوي شامل للمنطقة المهددة بالغرق، تلاه مسح أثري لكل معبد وصخرة ونقش. ما سمح بإعادة بناء بعض المعابد، بعد أن فُقدت الأرض وبقيت صورها.
بحسب نجم الدين، فإنّ هذا المجهود المكثّف "أدى إلى اكتشافات عظيمة تُلقي الضوء على كثير من المسائل التي كان يكتنفها الغموض في تاريخ السودان القديم، وجرى اكتشاف مئات المواقع الأثرية".
من بين هذه البعثات بعثة البروفيسور البولندي ك. ميكالوفسكي (Kazimierz Józef Marian Michałowski)، الذي قاد أعمال تنقيب في النصف الأول من 1961، أسفرت عن اكتشاف كنيسة مميزة وتحف أثرية قيمة ووثائق تاريخية ألقت الضوء على تاريخ النوبة خلال العهد المسيحي، وجرى نقلها إلى الخرطوم.
وكذلك بعثة جامعة غانا بقيادة البروفيسور ب. ل . شني (Peter Lewis Shinnie)، الذي عمل في منطقة دبيرة غرب على بُعد 14 ميلاً شمال وادي حلفا لمدة 3 أعوام بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 1961، وانتهت في آذار/ مارس 1964. أسفرت جهوده عن أطلال مدينة كبيرة يرجع تاريخها إلى العصر المسيحي، كما قامت بالتنقيب في بعض الجبانات الأثرية.
ونجحت بعثة يوغوسلافية في إنقاذ رسوم على جدران كنيسة قرية عبد القادر الواقعة على الضفة الغربية من النيل عند بداية الشلال الثاني، والتي نقلت جميع الصور من جدران الكنيسة وأجرت الصيانة اللازمة لها حتى باتت صالحةً للعرض ثم نُقلت إلى الخرطوم بنجاح.
أيضاً، تطرق الدكتور محمد إبراهيم بكر في كتابه "تاريخ السودان القديم"، إلى المجهودات الضخمة التي نفّذتها بعثة ألمانيا الشرقية بقيادة البروفيسور هنتزا (Fritz Hintze)، منذ عام 1957 وحتى عام 1970، وتولت مهمة تسجيل الرسوم والنقوش الصخرية من الحدود الشمالية لجمهورية السودان حتى شلال دال (140كم جنوبي وادي حلفا)، وكذلك في موقع يقع على بعد 25 كيلومتراً جنوبي وادي حلفا حتى شلال دال.
بفضل جهود تلك البعثة جرى تسجيل 40 موقعاً أثرياً، من بينها 13 موقعاً لم تكن معروفةً من قبل.
وبحسب كتاب "الختم الديواني في السوداني" لمحمد إبراهيم أبو سليم، فقد جرى اكتشاف وثائق تاريخية في أبريم خلال حملات التنقيب، كُتبت هذه الوثائق بالعربية والنوبية ولغات أخرى ساهمت في تحسين جهود الباحثين لمعرفة أصول الكتابة في السودان خلال فترات تاريخية متلاحقة.
بعدها، في عام 1968، نقلت مصلحة الآثار السودانية كتابات ونقوشاً صخريةً أخرى عُثر عليها المنطقة الواقعة بين سمنة ودال وجرى اقتطاعها من الصخور ونقلها إلى مكان آخر.
ووفقاً لكتاب "المتاحف في السودان: ذاكرة حية وتراث خالد"، فإنّ متحف وادي حلفا الذي جرى افتتاحه عام 1930، في إحدى المدارس وعُرضت فيه بعض مجموعات الآثار التي كشفتها البعثات الأثرية، تقرر نقله هو الآخر بعدما بات مهدداً بسبب السدّ العالي.
متاحف السودان القومية
بحسب تقرير اليونسكو، فإنّ الجلبة الكبرى التي رافقت الحملة لعبت دوراً كبيراً في تنامي الشعور القومي بين السودانيين بعدما علموا أنّ "لديهم ماضياً يحقّ لهم أن يفخروا به".
ولقد لعبت تلك الاكتشافات الأثرية المتتالية دور البطولة في ملء الموقع الجديد لمتحف السودان الذي تقرر بناؤه بدلاً من موقعه القديم، الذي كان مجرد قاعة صغيرة في كلية الآداب.
لذا جرى التخطيط لبناء مقرّ آخر للمتحف تضمّن صالات عرض ومكاتب إداريةً ومختبرات ومخازن، في داخله أقيمت المعابد التي جرى نقلها من منطقة النوبة بالإضافة إلى محتويات متحف وداي حلفا ومتحف مروي.
في 1971، افتُتح المتحف رسمياً بعدما أعيد تركيب الآثار المنقولة في حديقته الكبيرة حول حوض مائي يمثّل نهر النيل لتبدو للعيان وكأنها لم تُنقل من موقعها الأصلي.
في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الدكتورة غالية جار النبي، مديرة الهيئة القومية للآثار والمتاحف في السودان، أنّ ذلك المتحف المهم تعرّض للسرقة وأن بعض محتوياته نُهبت وبدأت تُعرض للبيع في الأسواق في جنوب السودان.
وبسبب ضخامة حجم المكتشفات، جرى توزيع بعضها داخل متحف كردفان لإثراء مجموعته، فضلاً عن إنشاء 3 متاحف إقليمية أخرى لعرض ما تبقّى من الآثار.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.