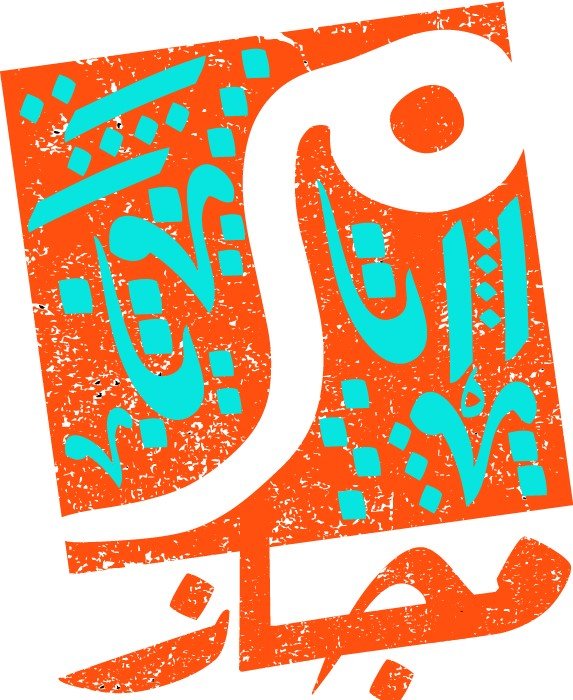
كانت الرحلات واحدة من الأنشطة التي تنظّم في المساجد، وذلك للترويح عنا أو لمكافئتنا على شيء ما. لم يوافق أهلي على ذهابي إلى تلك الرحلات بسهولة، لذلك لم أشارك إلا بعدد قليل للغاية منهم، وتعتبر رحلة "الضبعة" هي أهم تلك الرحلات بالنسبة لي، ففيها تكشّف وجه المشايخ الحقيقي للطفل الصغير. للمرة الأولى عرفت أنهم يخطئون، بل وأنهم قد يعطونك كل الأسباب حتى تكرههم وأنت لا تشعر بالقليل من الذنب .
قد يتوقف الكثيرون ممن يعرفون الإسكندرية عند كلمة "الضبعة"، فرحلات البحر بالنسبة لنا محدّدة ومعروفة، وبالطبع أولى لمن يذهب إلى الضبعة أن يتوقف ويذهب للساحل الشمالي، إلا إذا كان له مقصداً آخر كالسفاري مثلاً، خصوصاً وأن الساحل في ذلك الوقت كان مجرّد ماء ورمل، مكان طبيعي نذهب للاستمتاع فيه، قبل أن نحمّله الآن على طبقات ومزايا اجتماعية، ونجعله مكاناً يجب أن يسجّل في يومياتنا كل صيف أننا زرناه، لنتنفس الصعداء أننا ما زلنا ننتمي لهؤلاء البشر الذين لا نجدهم إلا هناك، أو كما يقول الدكتور عصام حجي، يتحول الساحل إلى مكان تلتقي فيه الطبقات الاجتماعية التي تعيش في الخارج، مجرد مقهى بآلاف الدولارات، ومكان لامع يخطف أنظار المصري العادي، الذي يظل يراقب مشدوهاً حتى تحترق أنظمته الداخلية، ويفقد القدرة على معالجة الأشياء حوله.
قبل تحول نظامنا الاجتماعي إلى تحفة سوريالية، قرّر الشيوخ أننا سنذهب للضبعة، لأننا لن نرى هناك نساء، للابتعاد عن هذا الذنب العظيم، تركنا الشواطئ المجهزة لاستقبال البشر، وذهبنا بعيداً وحدنا في الصحراء، لمدة ثلاثة أيام .
قرّر الشيوخ أننا سنذهب للضبعة، لأننا لن نرى هناك نساء، للابتعاد عن هذا الذنب العظيم، تركنا الشواطئ المجهزة لاستقبال البشر، وذهبنا بعيداً وحدنا في الصحراء، لمدة ثلاثة أيام... مجاز
*****
في المرحلة الثانوية كنت قد عرفت طريق الأدب، وعرفت الكتابة قبل القراءة، بغضّ النظر عن نوع وجودة ما أكتب، وكان وقتها الشعر هو الموضة التي أراها حولي في كل مكان. كان هناك محمد إبراهيم، وعمرو حسن، وهشام الجخ؛ هؤلاء الشعراء وغيرهم يحظون بشهرة كبيرة، ونجاحهم الذي يحصدونه يجعل المئات من المتحمّسين يودون أن يجربوا، فربما تستقبلهم الشاشات هم أيضاً، بل من الأمور المثيرة للسخرية في هذا الوقت، أن هناك مجموعة من الناس كانت تكتب الشعر مثل هشام الجخ، ويلقونه مثله، بلكنته الصعيدية، على الرغم من أنهم لا يعرفون عن الحياة إلا الإسكندرية وبحرها أو القاهرة وزحامها. وقعت أيضاً في هذا الفخ، وبدأت أقرض الشعر بشكل كان يعجبني وقتها على الرغم من تواضعه وبساطته، وبالطبع لافتقاره للشعر، بل وأتذكر حينما طلب معلم العربية النشاط الدراسي الذي سيضع عليه درجات "أعمال السنة" قصيدة أو نصاً نثرياً عن الفلاح. ذهبت وقتها للمنزل وأخرجت ورقة "full scape" وبدأت بكتابة قصيدة للفلاح، انتهت بعد أن قضيت على الأبيض في وجه الورقة وظهرها، ثم صنعت غلافاً للورقة وكتبت عليها "الشاعر محمد إبراهيم ". ذهبت للمعلم وقدماي بالكاد تحملني، والأرض غير ثابتة وكأنها قرّرت في هذا اليوم أن تهملني. كنت أتوقع أن يسألني عن الشاعر فأخبره بكل فخر: "أنا" . لكنه لم يفعل، وأمسك بها غير مبال وألقاها بعيداً في الحال، عرفت بعدها أن الدرجة تكتب بمجرّد تسلمه الأوراق، لا يهم ما نكتبه فيها.
بعد أيام ذهبت لأمينة المكتبة، وأخبرتها أني أبحث عن أي مسابقة للشعر. لبست نظارتها ثم أخبرتني أن الوزارة لم ترسل إلا مسابقة للقصة القصيرة. أخبرتها أني لا أجيد النثر أو القصة وهممت بالمغادرة، أوقفتني وهي لا تفهم من هذا التلميذ الذي دخل فجأة يسأل عن الشعر، وأخبرتني أن أجرّب كتابة القصة. كرّرت عليها مراراً وتكراراً أني بعيد عن هذا المجال، فأخبرتني أن أجرّب، وأن أنظر حولي بعين ثاقبة، أتابع قصة جار لي، أو حديث شيق في المواصلات.
بدأت شهوة القلم تتسلل إليَّ من كلامها، فأخبرتها أني سأجرب، وبعد أسبوعين عدت إليها مرة أخرى وفي يدي القصة الثانية عشرة، اثنتا عشرة قصة في أسبوعين فقط، ولم أتوقف عن الكتابة من بعدها قط. المثير للسخرية هنا أني كنت أعمل في مطعم للفول والفلافل والكشري وغيرها من الأكلات المصرية. في أحد الأيام، وقبل دخولي الصف الثالث الثانوي، وجدت القصص التي قدّمتها للمكتبة، وحين قرأتهم، أخذتهم معي جميعاً للمطعم في اليوم التالي للتخلص منهم بأسرع وقت.
*****
نزلت من السيارة في الضبعة وأنا أنظر لأعلى لا لأسفل. السماء صافية وشديدة السواد والنجوم تلمع وتظهر في جو مهيب تفتقر إليه المدن بسبب أنوارها. هنا يمكن أن تشير بيدك إلى مجموعة نجمية كاملة. السماء واسعة ومضيئة، والأرض صحراء ممتدة، في كل الاتجاهات، اللهم إلا من مربع حجري عرفنا أننا سنعيش فيه مدة بقائنا هنا. مربع في منتصف الصحراء، غرفة كبيرة بأعمدة. لم يكن لدي مشاكل تجاه المكان، كانت المشكلة أننا سنحيا كما يحيا البدو هنا، على كمية قليلة من الماء، سواء للشرب أو للاستحمام، بل قد نضطر لاستعمال زجاجة واحدة كبيرة 2 لتر فقط في اليوم.
دخلت الغرفة الضخمة وعرفت مكان نومي، وضعت حقيبتي وخلدت إلى النوم وفي الصباح سمعت الأناشيد الإسلامية والجهادية والتي لم تفارقنا لثلاثة أيام بقينا فيهم في هذا المكان. أخذت هاتفي وانطلقت خارجاً حتى ألحق تصوير شروق الشمس. كنت مأخوذاً بالطبيعة وأشكالها، فرمال الصحراء تتلألأ تحت أشعة الشمس، والهضاب الصغيرة والكثبان، دائماً ما تخفي الأسرار خلفها، والبحر بعيد كالحلم، يلتحم في آخره مع السماء، والحيوانات اتفقت معاً على الظهور بالترتيب لنتعرف عليهم واحداً بعد آخر، ففي البداية ظهر لنا قنفذ صغير، ثم ظهر لنا عصفور متوسط الحجم، لا أعرف نوعه إلى الآن، لكنه كان يحرك رأسه معنا بكل جدية والتزام، يمين يعني يمين، ويسار يعني يسار.
خلال ساعات كنت قد نسيت المبنى الحجري والماء، والبدو والمسجد ونفسي. كنت أهرول بعيداً دون أن يلاحظ أحد اختفائي، أصوّر كل شيء بحماس كبير، و أتصل بأهلي لأخبرهم آخر ما رأيته والحيوان الجديد الذي تعرفت عليه، وكما لم أنس الصحراء لم أنس الماء أيضاً، كنت ألقي نفسي في البحر لساعات، محاولاً تفادي الصراخ واللعب من باقي زملائي.
في اليوم الثاني خرجت من الماء، وقطعت الطريق الطويل إلى الغرفة الحجرية الكبيرة، أخذت زجاجة ماء للاستحمام، وفي طريقي للخروج عرفت أنهم قاموا بذبح خروف كبير، وأن الغداء سيكون أرزاً ولحماً. قرّرت وقتها أن أذهب لمراقبة الغروب وأن أكتشف عن الأرض سراً جديداً وأعود إليهم. وبالفعل أخذت هاتفي قبل أن يتم شحنه، وخرجت إلى كثيب مرتفع قليلاً، وقرّرت تصوير المنظر. أخرجت هاتفي وضغطت على زر التصوير، وإذا به يرد عليَّ برسالة مفادها أن الصورة لن تؤخذ قبل وضع بطاقة ذاكرة memory car، كانت الهواتف وقتها تصنع بذاكرة داخلية صغيرة، لذلك كنت تحتاج إلى بطاقة ذاكرة لفعل أي شيء.
هناك مجموعة من الناس كانت تكتب الشعر مثل هشام الجخ، ويلقونه مثله، بلكنته الصعيدية، على الرغم من أنهم لا يعرفون عن الحياة إلا الإسكندرية وبحرها أو القاهرة وزحامها... مجاز
تسارعت نبضات قلبي، وتوالت ومضات الأفكار في رأسي، وكنت أكذبها كي أتحمل الصدمة. دخلت إلى معرض الصور، فوجدته قفراً، فارغاً، أزلت غطاء الهاتف والبطارية بسرعة لأضبط بطاقة الذاكرة أو أعرف مشكلتها، وإذا بي لا أجدها من الأساس، لقد دخل أحدهم مكان شحن الهواتف ونحن في البحر وسرقها، كل الصور التي التقطتها ضاعت، كل الأشياء التي أخبرت أهلي أني سأريهم إياها لم تعد معي. منيت نفسي كثيراً بأني سأعيش سعيداً على هذه الذكريات، الآن في لحظة واحدة ضاع كل هذا. بعد دقائق لملمت شتاتي، وقررت أن أستعيد ما سُلِبَ مني مهما كلف الأمر .
*****
في المدرسة توطدت علاقتي مع أمينة المكتبة، وأصبحت أذهب إلى هناك في مواعيد غير مواعيد حصص المكتبة المحدّدة، كنت أتجوّل في مسرحيات شكسبير وروايات تشارلز ديكنز وغيرهم من الكتاب، تعودت وقتها على أن المكتبة هي المكان المثالي للقراءة وللهروب من الحصص التي لا أحبها ومن الطابور الصباحي.
للمكتبة عدة قوانين يجب أن تعرفها إذا قرّرت دخولها، الصوت المرتفع ممنوع، والطعام والشراب ممنوعان أيضاً، ولا يسمح لك بأخذ كتاب والخروج به خارج المكتبة إلا في حالة استعارته. كنت أتبع هذه القوانين، غير أن أمينة المكتبة سمحت لي بكسر قانون، وهو أخذ الكتب والخروج بها خارج المكتبة، وقد بدأت مشاكلي في المدرسة بسبب هذا الأمر، ففي أحد المرات أخذت الإنجيل وبدأت بقراءته، لم يستطع أحد أن يمرّ من جانبي وقتها دون أن يعلق على الأمر، ومع الوقت بدأ الطلاب المتدينون بالاحتشاد معاً ومحادثتي، في المدرسة وخارجها، فكان كلامهم كله مألوفاً ومبتذلاً عندي، فما يعرفونه عن الدين بالكلام، عشته أنا معظم حياتي، ولو جاءوا قبل عدة سنوات فقط، لوقفت أنا معهم ضد زميل يقرأ الإنجيل، ولأخبرته أن الأديان الأخرى لا يجب أن يخوض غمارها غير المختصين، فالشياطين تعرف كيف تدخل لقلوب المؤمنين جيداً، كما كنت سأحذره من تبدل الأحوال، وانقلاب الأيام.
لكن هذا الفتى الذي عاش في المسجد ونبت من سجّاده وصلى في محرابه، كان قد تغير كثيراً بسبب سؤالاً من صديقته "منة"، وبسبب ثورة يناير التي شكلت الحياة على صورة غير الحياة التي عرفناها، والتي وضعت المشايخ في خضم الواقع، واختبرت مبادئهم أمامنا، وقبل هذا وذاك، كانت هناك رحلة الضبعة التي مهّدت لكل شيء.
*****
تبقى يوم ونصف ونغادر من حيث أتينا. لا أعرف ماذا أفعل ولا أمل في شيء يُفعل، كل ما يمكن فعله هو التضحية بباقي الرحلة، مقابل أن أصل للشخص الذي سرق بطاقتي من الهاتف. حينما تركت الصحراء ورجعت للاندماج معهم، عرفت أن هناك واحداً من المشايخ سُرِقَ هاتفه، هذا بالإضافة إلى شاب صغير سُرِقت بطاقته أيضاً. كانت المشكلة الحقيقية أن عددنا كبير للغاية، ومعظم الأشخاص المتواجدين لا أعرفهم حتى أضعهم في خانة المشتبه بهم أم لا، وذلك لأن الرحلة لم تكن على مستوى مسجدي فقط، بل كانت لكل مساجد السلفية في الإسكندرية.
لقد جمعوا أشبال السلفية في مكان واحد، لكن ومع بعض الأسئلة التي طرحتها عرفت أن السرقة تحدث في الوقت الذي نذهب فيه للبحر، وبالتالي يمكنني تقليص عدد المشتبهين بهم، إذا انتظرت لليوم الثالث والأخير وتحجّجت أنا أيضاً ولم أذهب معهم، وبالفعل في اليوم التالي جلست مع عدد قليل من الشباب، وكنت أحاول التواجد مع كل واحد منهم لمدة، وفي مرة من هذه المرات استأذن الشخص الذي كنت أحدّثه للذهاب إلى المرحاض، وبعدما عاد جلسنا نتسامر فقد كان من مجموعتنا، وأثناء حديثنا هرول شخص غريب إلينا يسألنا عن هاتفه، فأخبرناه أننا لا نعرف عنه شيئاً، لكني خمّنت بسرعة أنه لم يغب عن نظري أحد إلا هذا الذي أكلمه وقت دخوله المرحاض، ما يعني أنه ذهب للسرقة ثم عاد إليَّ، تأكدت من أنه السارق لكن لا يجب أن تلقى التهم جزافاً، والحقيقة أني لم أكن أفكر في المسروقات أو السارق، بل الصور التي التقطتها فقط.
حاولت أن أدخل إليه من باب وجدته سيختصر الكثير من الطرق، وشرحت له بالتفاصيل أني أريد سرقة بعض الهواتف من هنا، وعند العودة إلى الإسكندرية سأقوم ببيعهم، وأخبرته أن لدي خطة ستساعد في هذا بشكل كبير. تحدثت وسمعني، وما هدفي من هذا إلا اختبار ارتياحه لحديثي عن السرقة والاستفادة منها، وبالفعل لم يعترض على شيء، بل وجدته استحسن الأمر قليلاً. عرضت عليه أن يساعدني، فلم يعطني جواباً نهائياً، لكننا قرّرنا أن نذهب إلى البحر، وفي الطريق أخبرته أن سأقسم المال الذي سأجنيه معه. تحمّس للأمر، فأخبرته سريعاً أن لدي شرطاً واحداً وهو الحصول على بطاقة الذاكرة الخاصة بي، حلف لي عشرات المرات أنه لا يعرف عم أتحدث، وحلفت لنفسي عشرات المرات أنه يعرف كل شيء، فالآن يوجد لدي دليل وهو اختفاؤه وقت حدوث السرقة الأخيرة، وقابليته لسماع حديثي المطول عن السرقة.
ذهبنا للبحر وأنا أحاول إقناعه بكل الطرق، أخبرته أن "الميموري" ليست مهمة بالنسبة لي فأنا سأسرق الكثير منها كما يعرف قبل أن نسافر، لكن ما يهمني حقاً الصور التي فيها، بل إنني لا يمكنني أن أهدّده حتى إن أردت، فهو الوحيد الذي سيعلم الليلة من سرق الهواتف حينما تبدأ الأسئلة.
في لحظة واحدة سقط كل شيء، أو بدأ بالسقوط، ظننت أن هذه آخر الخيبات السلفية، غير أن ثورة يناير كانت تلوح في الأفق... مجاز
يئست الشمس من محاولاتي وقفزت في البحر، وأتى الليل يتابع ما يسمع ويترقب ما سيحدث، وبدأنا في مغادرة الماء لنذهب ونستعد للعودة مرة أخرى. في طريقنا لغرفتنا الحجرية، أخبرني أنه سيعطيني البطاقة التي سرقها، بشرط أن يستفيد من السرقات التي سأقوم بها دون أن يشارك، فوافقت على شروطه وأخذت منه ما هو لي .
*****
في المدرسة الثانوية، كان لي أنا وأصدقائي صديق يسمى محمد راضي. راضي أكثر زميل لنا يعرف فتيات، وهو كثير الهزار والضحك. شعره أسود طويل، يحب الحياة ويقبل عليها. أخذنا العطلة الصيفية، وعدنا بعد ثلاثة أشهر، فإذا به حليق الشعر، طليق اللحية، هادئ الصوت، مختلف الطبع، لا يترك فرضاً ولا يترك فرداً يترك فرضاً، ولا يفرط في فرصة للنصح. ماذا حدث له؟ لا نعرف غير أن كلمة حرام التصقت بلسانه ولم يستطع شدها بعيداً بعد ذلك.
بعد قراءتي للإنجيل خارج المكتبة، تحدثت مع كثيرين، لكن راضي عيّن نفسه المسؤول الأول عن الأمر، وكان يحاول بكل الطرق أن يثبت لي لماذا الإسلام ولا شيء غيره، على الرغم أني لم أطلب منه نصحاً ولا إرشاداً. كان يتصل بي في المساء فيخبرني أن القرآن يقول "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه"، والمرأة فقط هي من تحمل، ما يعني أنها هي الوحيدة التي يمكن أن نرى بها احتمالية وجود قلبين في جوف واحد، هذا بالطبع بغض النظر عن الأشياء التي تروج في الغرب في وقتنا الحالي، وعن المتاهات الجندرية والجنسية، وعن مئات الرجال الذين يحملون قلبين في جوفِهم.
وفي يوم آخر كان يتصل ليتحدث حول سكين نسوة يوسف، وكيف اختار القرآن كلمة "سكين" وهي كلمة لا تستعمل سوى في مصر، فكيف عرف بها النبي في شبه الجزيرة؟ هكذا كانت لياليَّ بشكل شبه يومي، المثير للسخرية أني لم أقل إني أنكر الإسلام أو ما شابه، بل لأنه وجدني أمسك الإنجيل فقط.
*****
جاء وقت رحيلنا من الضبعة، ووصلت أنا بدوري لكل ما أريد أن أصل إليه، شعرت بالفخر لأن ما عجز عنه مئات الأشخاص وعشرات المشايخ فعلته أنا، وظللت أضع الخطة خلف الخطة حتى وصلت لما أريد وعرفت السارق. ذهبت لمشايخي وأنا سعيد أشد السعادة، لأنه حتى الأشخاص الذي سيعودون إلى منازلهم يحملون الحزن على ظهورهم سأخفّف عنهم وأرجع لهم أشياءهم، وبالفعل قلت للشيوخ إني أعرف من سرق كل الأشياء التي يبحثون عنها.
ذهبوا خلفي إلى الشاب الذي منيته بتقسيم المال بيننا، وفتحوا حقيبته فوجدوا كل شيء، أخذ الجميع أشياءهم وحلت المشكلة، وبعد ساعة تقريباً كان الشيوخ ينظموننا قبل الصعود للأتوبيس، وهنا وجدت الشيخ يدفع بي بعيداً ويعاملني بقسوة غريبة. ذهبت بعدها لشيخ آخر فوجدت منه معاملة لا تختلف تقريباً. صعد شيخ آخر بعدها ونظر لي باشمئزاز وهو يقول "فضحتنا". بعد وقت قصير عرفت ما حدث، يرى شيوخي أني فضحتهم بين الآخرين، وبين أبناء المساجد الأخرى في الإسكندرية، وقد أثبت أن السرقة منا لا من مجموعة أخرى، بعد يوم ونصف من المحاولات للوصول للسارق أصبحت أنا الفاضح لهم.
اسودت الحياة في عيني، وخانت الأرض أقدامي، ألقيت نفسي في مقعدي، ولأول مرة كنت أعرف أني على حق، وأن شيوخي مخطئون لا يعرفون قراءة موقف بسيط بهذا الشكل، كرهتهم جميعاً، وعرفت أن الأمور لن تعود بعدها كما كانت أبداً. لم أشعر أني الطفل المظلوم الذي يراه من حوله على غير حقيقته، بل شعرت أن من حولي ظالمين لا يستحقون التوضيح. في لحظة واحدة سقط كل شيء، أو بدأ بالسقوط، ظننت أن هذه آخر الخيبات السلفية، غير أن ثورة يناير كانت تلوح في الأفق.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


