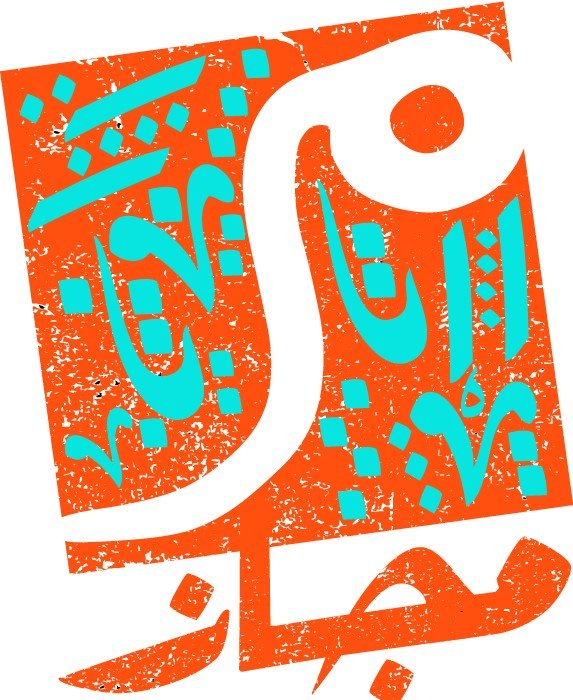
يخبروننا
إنهم سادة صناعة الموت
ورجال الحكايات الحزينة،
لا أعرف ماذا عنا
ومَن نحن
سوى أننا ننتزع من أفكارهم الثمينة
خططاً لمعارك ناجحة
وخراباً مثالياً
جثثاً أجمل
دون أن نكلفهم الوقت والذخيرة.
بيروقراطية لا بد منها
وقفت الحرب أمام موظفة السجل المدني، بوثائقها الكثيرة، وعينيها دامعتين، تريد استخراج بطاقة هوية، باسم يخصّها وحدها، تختاره هي لا تفرضه عليها الأحداث والمواقع والأسباب التي لا تعجبها، اسم من السهل حفظه والتبرّك به، بل من الفأل الحسن ذكره حتى قبل كل صلاة. كانت برغبتها هذه غاضبة من آباء كثر، وزعوا لحمها وعظامها بينهم، وتركوا روحها في العراء وحيدة، وسط العويل والدماء.
تبدو الآن كامرأة يائسة؛ ترتدي ألف أحجية، فلا يطيق الناظر إليها مغبة السؤال، وكل هؤلاء الأطفال المغبرين المحيطين بها، وقد ضاعت بصمات أصواتهم في ضجيج نحيبها، وهم يحملون أكفاناً بلا هوية، ويهربون من رصاص بلا هدنة، ومناديل أمهاتهم المغموسة في سواد الحداد... مجاز
بلا هوية أو أمان عاشت؛ لم يسألها أحد عن اسمها الحقيقي، ولونها المفضل، ماذا تحب أن تتناول على الغداء؟ هل هي جائعة حقاً؟ وأين موطنها الأصلي؟ ما هي مشاعرها الآن؟ أو ماذا تريد أن تصبح حين تكبر؟
لم تعرف أدنى معنى للحب أو الطمأنينة أو الجمال، كما أنه بات يزعجها مؤخراً ارتباط اسمها بالخوف والموت، وتناول الأمهات لسيرتها بكل شؤم وألم في الأسواق وعلى المصاطب، سمعتها صارت على المحك، وهي امرأة في النهاية، تحلم ببيت وأولاد ورجل يرعاها.
الشعور بالمواطنة
كانت تتلفّت حولها خائفة، تجرحها نظرات الواقفين خلفها في الطابور، لكنها على غير العادة تعاطفت معهم. ربما كانت أسماؤهم كريهة فعلاً. وجدت أنه من الصعب عليها تجربة هذه المشاعر كلها، مرة واحدة وفي المكان ذاته؛ الإحساس بألم الآخرين يضغط بثقله على الحنجرة، فلا تستطيع أن تتباهى بكلمة أسف أو تشارك هذا الجمع ذكرياتك مع ارتفاع الأسعار أو رأيك في الانتخابات الأخيرة، هذه اللحظات الدافئة بدأت تفتنها. ربما عليها أيضاً أن تجرب البكاء يوم الثلاثاء.
في وقفتها هذه، كمواطنة عادية، دون مجد أو شهرة أو تاريخ مخجل، كانت أشبه برماد يحلّق فوق ورق مبلل، أو فراشة تتغير ألوانها تبعاً لكل عطر مرَّ بها. بملابس رثة وحذاء ممزق، لن تعرف أبدا أنها تلك الفتاة التي تقتني العالم كقط جائع تحت سريرها، أو تراها في لافتة شاحبة تكنس وميض المصابيح كلها كي تثأر للظلام في الخارج.
تبدو الآن كامرأة يائسة؛ ترتدي ألف أحجية، فلا يطيق الناظر إليها مغبة السؤال، وكل هؤلاء الأطفال المغبرين المحيطين بها، وقد ضاعت بصمات أصواتهم في ضجيج نحيبها، وهم يحملون أكفاناً بلا هوية، ويهربون من رصاص بلا هدنة، ومناديل أمهاتهم المغموسة في سواد الحداد.
ثم ضحكت، ضحكت الحرب أخيراًحتى خلا فمها من الأنياب
سلاح البيروقراطية
في نظرة عابرة إلى هيئتها، سألتها الموظفة بلا اكتراث، عن اسمها الجديد وبلدتها الأولى، عن تاريخ ميلادها وعنوانها الحالي. لم تتقبل الحرب هذه الأسئلة الكثيرة في البداية. هي التي اعتادت أن تخيف الجميع، فلم يجرؤ أحد على التطلع إليها بكلمة أو التجول في عينيها بنظرة أو تجاوزها في حوار.
قوة البيروقراطية، سلاح جديد لم تختبره، عرفت عندها أن هذه الموظفة تمتلك سلطة هي الأخرى، وتسعى أن تكون سيدتها الجديدة ولو لبعض الوقت، لكنها على سبيل التغيير نظرت إلى المكان حولها، وهذه الغرفة الضيقة في المصلحة الحكومية بمكتبها المتواضع، التي لا يمكن أن تسع أكثر من قتيلين وخمس رصاصات؛ الموتى كانوا وسيلتها في القياس وسياستها الاستراتيجية في وصف الأماكن وإيضاح معالمها. أبدت شفقة حانية على الموظفة وامتثلت أخيراً لرغبتها وقالت: أريد أن يصبح اسمي الجديد "أمل". اسم حلو وملهم، وتعجبني خفته.
ستموت على كل حال
وأنا أحاول انتزاع اسمي
من فوق كل رصاصة
تتجه صوب قلبك
على الموت أن يلعب معنا
بحيل أكثر فتكاً
أو بالأسئلة التي لا تجد لها إجابة
سوى في عنق مئذنة
أو بين ذراعي صليب
أنا أهرب حين أجد نفسي
ضمادة لندبة مؤقتة
في عين أحدهم.
لستُ من الملائكة، ولم أكن يوماً نازحة من جهنم، لم أروض تمساحاً على نقل حبوب اللقاح، أو ضفدعاً على سرقة أرغفة النحل. لم أنفخ في البوق لمزج صليل السيوف بنحيب الثكالى؛ ليس على الموت أن يكون درامياً معي... مجاز
سيرة الحرب
مثل القصيدة ولدت، حجراً آخر في يد الحياة، البعض ولد رصاصة في يد سفاح، وآخرون ولدوا في مخيمات، يرتحلون أينما ولت وجهها عنهم السماء، دون مطر أو ونس وكهرباء، لا بصمات طلاء على الجدران، أو آثار أقدام نحو مزهرية تلفها بحرص نافذة؛ لتحدق دائماً تجاه الشمس والأمل.
لستُ من الملائكة، ولم أكن يوماً نازحة من جهنم، لم أروض تمساحاً على نقل حبوب اللقاح، أو ضفدعاً على سرقة أرغفة النحل. لم أنفخ في البوق لمزج صليل السيوف بنحيب الثكالى؛ ليس على الموت أن يكون درامياً معي. لي رائحة مُرة، وجه مريح، قط يتكور بين أصابعي، وساوس كثيرة تتصاعد مع أدخنة سيجارتي أو الحرائق التي أتركها خلفي، وأيتام يتبادلون الآباء على بابي كل شهر.
لم أفقد جناحي في الأيقونات الباردة عند مذبح الصلاة، ولم أنس كل الأرواح التي تلحق بي عند دكاكين النجارة والخياط، ليصنعوا لها عرائس ذات أقدار مدجنة وأدواراً عادية في تراجيديا الحياة.
تشبهني بلدة تؤجر قلوب أهلها للمسعفين على الطرق الحدودية، وإمعاناً في التخاذل، تشبهني كل شاحنات اليوم الأول لقوافل الإغاثة في الشوارع الموحلة بنزيف الخوف والغضب. أنا الألم المنحوت من طين وموت، الجسر المحفوف بالأشباح، والقطار الذي ترك النفق واستدار لينتظر الجنود العائدين من السماء القديمة، ليدهسهم.
كبرنا في هذه البلاد
لنجوع
ونقتل
ونسلك كل مسار يجبرنا على الرحيل
أغراباً
في توابيت مجففة من شجر الصمت.
حكمة الكبار
وأنا صغيرة، أخذتني أمي من يدي، وهي تجمع القطط النافقة من بين حديد القضبان. قالت: انظري، الخراف مسالمة، تمضغ روحاً واحدة طوال الوقت، لا بأس عندها لو جربت القمامة في وجبات كاملة، أو بعض فصوص البرتقال والتوت مرة في العمر، هذا لن يجعلها تمشي بخطى بطيئة إلى الموت؛ على الحياة أن تنجو بحرفتها في متاهة جريان الدم، وعلينا أن نقفز راضين حين نعثر على عيوننا الغائبة في وجوه الأحبة. القلب ظمآن والخطى ليست كلها حليب جوز الهند، الخطى أكثرها سراب، والحذر رفيقنا اللدود. لسنا أبناء الأسئلة الصعبة عن الحنين إلى الوطن وصرخة الميلاد، شفاهنا ثقيلة عندما تطفو الإجابة على الجرح، نحن ندوب شائهة لم يتوفر لها أطباء تجميل أو حنان مواساة.
في حياتي الأخرى، كنت سأحب عزرائيل وأجد حيلة شريرة لأجعله ينضج كرجل، يغني ويرقص معي، نلعب الاستغماية أو يسرق لي الحلوى والكتب، ويترك أرواح الناس تذبل في حالها، بدلاً من قطفها هكذا مثل ولد مشاغب... مجاز
مثل الآخرين، أرى وأتألم
في وحدتي، في طريقي إلى البيت، وفي مرضي أيضاً، أشعر أن الموت يلمسني، يقرب شفتيه من جسدي، يشم فيّ ما يشبه الدفء، يبتعد متأففاً أو يتجاوز جلدي بأنيابه ليتحرّى كيف هي نكهة الخوف، يلتهم جزءاً مني ويبعثر الأشياء التي لا تعجبه، أحتاج ما يقرب من اليومين كي أرتب نفسي من جديد، وأطلي الجزء المفقود مني باللحم أو عجينة الأعشاب والحلوى؛ لأعود حية.
أبسط أعمالي... أجملها
بالماء والصابون، أفتح قلبي على صرخة ترتجف، أنظف جيداً خوفها الثقيل، دمها المتقيح، ورائحتها المرعبة. أجفّفها برفق، أدهنها بزيت قرنفل، وأضعها في حلق طفل وديع قبل أن يطلقوا الرصاص، وأهرب بسرعة من الكمائن إلى سريري الدافئ، أمارس أحد طقوس الوحدة المعتادة بمتابعة نشرات الأخبار.
في حياتي الأخرى، كنت سأحب عزرائيل وأجد حيلة شريرة لأجعله ينضج كرجل، يغني ويرقص معي، نلعب الاستغماية أو يسرق لي الحلوى والكتب، ويترك أرواح الناس تذبل في حالها، بدلاً من قطفها هكذا مثل ولد مشاغب.
الوحدة آخر كل شيء
هكذا إذا ليس لدي قصائد عالقة، ولا غيمة تنتظرني حين أرحل خلف الباب. لا باب مغلق يزين جدران بيت، ولا بيت ملغم بالأهل، لا أهل يطلقون سبابهم نحوي حين أغني، ولا أغنية تلومني حين أخطئ في اللحن. لا لحن يختنق في عود غاب، ولا شجرة تحتج على الحرائق وغصنها المنكسر يطاردني في يد ناظر المدرسة، ولا حرائق...
لسنا قساة قلوب
نضرب الرمل
بغصن محترق يا...
انسوا الأمر لن أخاف أن تلتهم الحرائق أياً من هذه الأوراق: وثيقة ميلادي، الفيش والتشبيه، شهادتي الجامعية، وجواز سفري إلي المقابر التي تغفو فوق صدري، وتلك الموظفة لن تساعدني لأعرف نفسي إلى الناس، وأثبت طيبتي، أحببت الطوابير فعلاً لكني لن أصير جزءاً منها. ما أصنعه أجمل، خاصة تلك التي أمام شاحنات الإغاثة.
ثم ضحكت، ضحكت الحرب أخيراً
حتى خلا فمها من الأنياب.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


