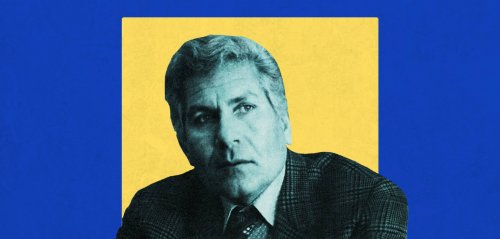في أحد الصباحات الشتوية من عام 1963، دخل الكاتب الصحافي يوسف الشريف منزلَ صديقه الشاعر والفنان زكريا الحجاوي، فوجده جالساً بجلبابه البلدي، محتضناً زوجته وأبناءه، وهم منخرطون في بكاءٍ مرير. كان المشهد صادماً وغريباً بالنسبة ليوسف الشريف الذي لم ير الحجاوي لمرة، دون الابتسامة التي تعلو وجهه، والضحكة الصاخبة التي كانت تهزّ جدران مقهى "محمد عبد الله" بميدان الجيزة. وقبل أن يهم الصديق بالسؤال، ناوله الحجاوي ورقةً حكومية "مشؤومة" تُنذر أصحاب المنزل بسرعة الرحيل وإخلاء البيت، حيث صدر قراراً من جهاز التنظيم والتخطيط بهدم المنزل الذي أصبح آيلاً للسقوط.
كان من الممكن أن يُستقبَّل هذا القرار من جانب الحجاوي بحزنٍ أقل من هذا لو أنه كان يمتلك ثمنَ بيت آخر لإيواء أسرته الكبيرة، أو لو كان هذا الرجل الذي أفنى عمره وحياته ومرتبه الضئيل في البحث والتنقيب عن الفنون الشعبية المصرية في القرى والنجوع والبراري لإنجاز ما سماه بـ"مسودة الحضارة"، نال جزءاً من التقدير والثمن الذي يستحقه، نظير ما قدم للثقافة المصرية وللفنون الشعبية على وجه التحديد، لما أصبح، على الأقل، مشرداً هو وأسرته في الشوارع في برد القاهرة.
لو كان هذا الرجل نال جزءاً من التقدير والثمن الذي يستحقه، نظير ما قدم للثقافة المصرية وللفنون الشعبية على وجه التحديد، لما أصبح، على الأقل، مشرداً هو وأسرته في الشوارع في برد القاهرة
وقبل الدخول إلى عالم زكريا الحجاوي، وحكاياته ووقائع مأساته مع صديقه رئيس مصر الأسبق أنور السادات، ربما علينا أن نوضح معنى ذلك المصطلح الذي سماه بـ"مسودة الحضارة"، حيث يكشف عن رؤيته للفن وللهوية المصرية. وكان الحجاوي يعني بإنجازه لـ"مسودة الحضارة" البحثَ في جذور الإنسان المصري وما خلفه من فن، ليُشكل مع "فن الحاضر" نسيجاً واحداً، من خلاله يُمكن فهم الأنثربولوجيا المصرية. وهذه الرؤية تنطوي على فهم عميق لما تعنيه كلمة "هوية"، حيث كان الحجاوي يرى أن الانفصال عن الجذور الثقافية لمصر، سيعزل المصريين عن هويتهم الحقيقية، ومن ثم يُصبحون في مهب موجات التغريب، التي تجتث الإنسان من جذوره وتخلق مجتمعاً غريباً ومشوهاً.
العراقيل كانت كثيرة أمام هذا الفنان والشاعر والملحن وكاتب القصة، فلم يكن يبدأ مشروعاً حتى يجد من يدق له المسامير في الطريق، بالإضافة إلى ما واجهه في بداية طريقه من الاستخفاف والتقليل من شأن ما يقوم به من جانب بعض المثقفين النخبويين الذين كانوا يتجنبون كل ما له صلة بـ"الفنون الشعبية" وكأنها ستُعفِّر ملابسهم الأنيقة، وتضعهم في طبقة أدنى من طبقتهم الاجتماعية.
لكن الحجاوي لم يكن ينتبه لمثل هذه الآراء المتشنجة؛ كان فقط مؤمناً برسالته، وبالفن الشعبي، كأحد أهم روافد الثقافة المصرية، فراح يجوب أرجاء مصر، باحثاً وجامعاً المفردات الحضارية المختبئة والمبعثرة على شفاه الرواة والمداحين والراقصات، والفنانين الشعبيين؛ يهرع نحو أي جمال تسمعه أذنه، وهو ما حدث مع المطربة الشعبية خضرة محمد خضر، فأثناء تجوله في قريتها سنباط بمحافظة الغربية، سمع صوتاً نسائياً قوياً وذا شجن، ينادي على ما يبتاعه من "خضراوات"، فأخذ يتتبعها، وذهب معها إلى والدها ليقنعه بأن يسمح لخضرة بالسفر معه إلى القاهرة للغناء في فرقة الفنون الشعبية، وهي أول فرقة من نوعها في مصر، تأسست على يديه، ومن رحمها خرجت جميع الفرق الأخرى، وفيها كانت خضرة النجمة الأولى.
وبجانب خضرة، اكتشف الحجاوي المطربين الشعبيين والمداحين: جمالات شيحة، محمد طه، يوسف شتا، الريس متقال قناوي، وغيرهم الكثيرين والكثيرات. وكان كذلك داعماً للشعراء والأدباء، ومنهم: يوسف إدريس، والشعراء: صلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، وصلاح جاهين.
السبب الحقيقي يكمن في أن السادات أراد أن يقتلع بأظافره من ذاكرة الحجاوي الصورة القديمة له، ومعها جميع الذكريات.
في الرابع من حزيران/يونيو عام 1914، ولد الفنان الشعبي زكريا الحجاوي بالمطرية بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر). نما الطفل في بيئة اجتماعية ذات تقاليد راسخة، يحترف أهلها صيد الأسماك من بحيرة المنزلة. وكان لهذه البحيرة وللصيادين بأغانيهم الشجية تأثير السحر في نفس الفتى الصغير، بالإضافة إلى الغرامافون الذي كان يصدح بشتى أنواع الطرب آنذاك.
أما سيد درويش فكانت له جاذبيته الخاصة لدى الفتى زكريا، فهو الذي غذى وجدانه بالغناء المصري الأصيل، وتفتح عقله وقلبه على أغنياته وأوبريتاته المسجلة على الأسطوانات، وكذلك كان الحجاوي مغرماً بالمداحين، فكان يلح على والده حتى يستضيف المداحين في ليلة من ليالي موسم الحج. هكذا كانت نشأة الحجاوي يحدوها الجمال من جميع الجهات، البحيرة وغناء الصيادين، الغرامافون، وسيد درويش، والطبيعة الخلابة التي تحيط ببحيرة المنزلة، والمداحين بما بثوه فيه من رؤى وما زرعوه في وجدانه من حب للفن الشعبي.
بعد المرحلة الابتدائية، انتقل الفتى للدراسة في المدرسة الأميرية ببورسعيد، وكان طالباً متفوقاً، حتى أنه حصل من الملك فؤاد الأول على بضع جنيهات ذهبية نظير تفوقه. وبعد بورسعيد اتجه إلى القاهرة، حيث التحق بمدرسة الفنون والصناعات الملكية. وفي العاصمة، تفتحت للشاب الحالم مواهب جديدة، وبدأ ينخرط في النشاطات السياسية والثقافية، حيث شارك في المظاهرات التي تهتف بجلاء الاستعمار البريطاني عن مصر، وكان دائم التردد على المسارح وصالات المنوعات والغناء في ذلك الزمان، وبدأ يمارس هواياته في التأليف والتلحين الموسيقي.
بدأ الحجاوي مشواره بالقاهرة وهو ابن الـ18 عاماً، برفقة عدد من أصدقائه: الشاعر الفنان عبد الرحمن الخميسي، الأديب محمد علي ماهر، الشاعر محمود حسن إسماعيل، الروائي سعد مكاوي، والكاتب المسرحي نعمان عاشور، وغيرهم الكُثر من نجوم الفن والأدب. في ما بعد سيلتقي زكريا الحجاوي برسام الكاريكاتير أحمد طوغان، والأديب الساخر محمود السعدني، وكذلك الناقد والكاتب أنور المعداوي، ويصبح مقهى "محمد عبد الله" بميدان الجيزة، هو المقر الدائم للحجاوي، حيث يلتقي فيه بمحبيه ومريديه، هو الحكاء البارع، والأب الداعم لكل صاحب موهبة حقيقية. وكان زكريا الحجاوي قد تنقل في الكثير من الوظائف، من مديرية الجيزة، إلى وزارة الثقافة، ثم عمل سكرتيرَ تحرير لجريدة "المصري"، وكانت أهم وأقوى الصحف آنذاك.
بعد قيام ثورة تموز/يوليو 1952، رأى مجلس قيادة الثورة، ضرورةَ تأسيس جريدة تكون صوتاً للثورة وتعبر عن السياسات المصرية الجديدة والتحولات التي يشهدها المجتمع. تولى الرئيس أنور السادات، رئاسة مجلس إدارة الجريدة، وانطلاقاً من الصداقة القديمة التي جمعته بالحجاوي، بالإضافة إلى جماهيريته وخبرته الصحافية الكبيرة، فقد عرض عليه أن يعمل معه في تأسيس جريدة "الجمهورية".
وافق الحجاوي على الفور لإيمانه الشديد بالثورة، وترك جريدته التي كان نجماً فيها، وراح يسهر الليالي من أجل هذا المشروع الصحافي الجديد، حتى جاءته الطعنة الأولى؛ ففي أحد الأيام، ذهب الحجاوي كعادته إلى الجريدة، فوجد في وجهه قراراً معلقاً على الحائط، بتوقيع أنور السادات: "يمنع منعاً باتاً دخول المدعو زكريا الحجاوي من باب الجريدة. فقد تم فصله فصلاً نهائياً".
هكذا انهارت أحلام هذا الرجل، وتمزق قلبه من هذا الفعل الغادر. ومن هنا قرر زكريا الحجاوي تركَ بلاط "صاحب الجلالة" بكل شرورها، واتجه إلى مشروعه الحقيقي في جمع وغربلة الفنون الشعبية، وحقق نجاحاً مبهراً في هذا المجال، وخاصة في الإذاعة المصرية، ساحته الأرحب التي استوعبت إبداعاته ومشواره المضيء، حيث قدم للإذاعة 72 ملحمة وأسطورة و120 مسلسلاً إذاعياً، من بينها: "أيوب المصري"، "سعد اليتيم" (كانت واحدة من اكتشافاته)، "أنس الوجود"، "ليالي الرشيد"، "ابن عروس"، "ست الملك"، "ليالي شهريار"، "الأرملة العذراء"، وغيرها الكثير.
ولا يجب أن ننسى أوبريت "ياليل يا عين" الذي كتب الحجاوي أغانيه، وبعض ألحانه. وكان هذا الأوبريت هو الأول الذي تؤديه فرقة الفنون الشعبية على مسرح الأوبرا المصرية، وقد حقق نجاحاً مبهراً. وبعد كل هذه الرحلة الزاخرة بالعطاء، صدر قراراً من الرئيس السادات –كان قد أصبح رئيساً آنذاك- بمنع جميع أعمال زكريا الحجاوي من الإذاعة المصرية، وقد تبع هذا قرار آخر بفصله من العمل بوزارة الثقافة.
وهكذا تم تنفيذ حكم الإعدام المعنوي لهذا الشاعر والفنان الملهم. لماذا وجه الرئيس أنور السادات هذه الطعنات لزكريا الحجاوي؟ هذا هو السؤال، وللإجابة عليه، كان علينا الاطلاع على العديد من المراجع والمصادر وكذلك شهادات أصدقائه من الكتاب والصحافيين، وجميعها نُشرت على صفحات الجرائد والمجلات منذ سنوات طويلة.
في حقبة الأربعينيات –حسبما يحكي الكاتب يوسف الشريف في كتابه "زكريا الحجاوي موال الشجن في عشق الوطن"، بدأت علاقة أنور السادات بزكريا الحجاوي عبر صديق مشترك هو الأديب محمد علي ماهر، حيث دخل السادات بصحبته إلى مجلس الحجاوي بقهوة محمد عبد الله، وكان السادات يرتدي قميصاً لونه كاكي، وجلس صامتاً لم يُشارك في الحديث وفي يده إحدى روايات الجيب واسعة الانتشار آنذاك".
ومنذ ذلك اللقاء توطدت العلاقة بين السادات والحجاوي، حتى صارت علاقة أسرية قوية. في ما بعد بدأت عملية تهريب السادات من السجن إلى مستشفى القصر العيني، ثم إلى منزل زكريا الحجاوي بالمطرية الذي ظل مختبئاً به، باسم "الأسطى إبراهيم" لعدة شهور. هذه الواقعة حكى تفاصيلها الأديب علي ماهر ليوسف الشريف، حيث كان ماهر واحداً ممن خططوا ونفذوا المهمة.
كان السادات ضابطاً مفصولاً من الجيش في تلك الفترة (الأربعينيات)، وكان مناضلاً ضد الاستعمار الإنكليزي لمصر، وتم إلقاء القبض عليه في عام 1945، بتهمة الاشتراك في اغتيال أمين عثمان باشا (وزير مالية مصر آنذاك).
تم التخطيط لعملية تهريب السادات من السجن بواسطة زكريا الحجاوي ومحمد علي ماهر، وطبيب شاب اسمه حامد حمدي إسماعيل، والدكتور ياسين عبد الغفار، وكان لكلّ منهم مهمة يُنفذها. روى محمد علي ماهر ليوسف الشريف أن السادات، وفقاً للخطة، كان قد طلب عرضه على طبيب السجن حامد إسماعيل، فقرر هذا الطبيب أن حالة السادات المرضية تستدعي نقله إلى مستشفى القصر العيني. واستجاب مدير السجن، وتم نقله للعلاج بالقسم الباطني الذي كان يُشرف عليه الدكتور ياسين عبد الغفار، وعن طريقه تم تهريب السادات وهو يرتدي زيَّ ممرض. وكان دور على ماهر، الذي كان يعمل معاوناً في المستشفى، هو تهريب السادات إلى قبو مهجور، ومنه إلى الشارع عبر ممرات وخبايا القصر العيني.
وفي شارع جانبي من حي المنيرة، كان بانتظارهم زكريا الحجاوي وابن شقيقه المتوفي عزت، وكان شاباً صغيراً آنذاك، ورجل الأعمال الضابط السابق حسن عزت (صديق السادات)، وكان متخفياً هو الآخر عن عيون رجال القلم السياسي في زي سائق لوري. وفي ظلام أحد الشوارع الجانبية خلع السادات ملابس الممرض وارتدى زي عامل صيانة، وجلس في صندوق السيارة التي اتجهت عبر إرشادات الشاب الصغير عزت إلى بيت زكريا الحجاوي بالمطرية.
امتدت إقامة السادات وحسن عزت شهوراً في منزل الحجاوي إلى حين توافر الأدلة القانونية التي تبرئ السادات من تهمة الضلوع في اغتيال أمين عثمان، لكن الغريب من أمر السادات –بحسب تعبير علي ماهر- "أنه ظل يأبى البوح علانية بفضل أصدقائه في تهريبه ثم إيوائه بالمطرية زهاء ثلاثين عاماً، حتى ولو بكلمة عابرة أو إشارة ضمنية في كتابه 'البحث عن الذات'".
ما زال السؤال قائماً: لماذا نكل السادات بصديقه زكريا الحجاوي؟ وعلينا هنا أن نُكمل السؤال أو نصيغه بشكل آخر: لماذا تنكر السادات لأفضال زكريا الحجاوي؟ لماذا دهس الصداقة بهذه القسوة، وكلمة "القسوة"، تجعلنا نقفز على حادثة فصل السادات للحجاوي من "الجمهورية"، إلى حادثة هدم البيت التي ذكرناها سابقاً، اُغلقت جميع الأبواب في وجه زكريا الحجاوي، ولم يستطع العثور على شقة.
فنصحه أصدقاؤه (محمود السعدني، ويوسف الشريف، وغيرهم)، بالتوجه إلى السادات وكان آنذاك رئيساً لمجلس الأمة 1963، وبعد أن رفض الحجاوي رفضاً قاطعاً، وافق على مضض، وذهب إلى مكتبه. وعندما أخبر مدير المكتب أن زكريا الحجاوي جالساً في الخارج ويريد مقابلته، ثار السادات ثورة عارمة، كما حكى الحجاوي ليوسف الشريف: "هو الراجل دا عاوز ايه مني، خليه يمشي". وهذا كان ردّ الجميل من جانب أنور السادات للرجل الذي أخفاه عن أنظار البوليس في بيته لعدة شهور، علاوة على تحمله لمخاطر تهريبه.
كان فقط مؤمناً برسالته، وبالفن الشعبي كأحد أهم روافد الثقافة المصرية، فراح يجوب أرجاء مصر، باحثاً وجامعاً المفردات الحضارية المختبئة، والمبعثرة على شفاه الرواة والمداحين والراقصات، والفنانين الشعبيين
نأتي لواقعة الفصل من جريدة الجمهورية؛ في إحدى حلقات "ذكريات العمر" التي رواها الكاتب الصحافي والناقد رجاء النقاش للكاتبة الصحافية فريدة الشوباشي، حكى النقاش تفاصيل هذه الواقعة التي كان شاهداً عليها. فالحجاوي هو من عين رجاء النقاش مصححاً في جريدة الجمهورية، وهو لا يزال طالباً في كلية الآداب، وكان يناديه بـ"أبي".
كان النقاش آنذاك صغيراً، غير أن الطعنة التي أخذها أبوه الروحي، جعلته يبحث ويُفتش في الأسباب التي دفعت السادات لفصل صديقه من الجريدة. وتوصل هذا الصحافي المخضرم، إلى أن السبب الحقيقي يكمن في أن السادات أراد أن يقتلع بأظافره من ذاكرة الحجاوي الصورة القديمة له، ومعها جميع الذكريات. ومن ثم كان يريد من الحجاوي أن يُدرك الوضع الجديد وأن يضع في اعتباره أن عهد الصداقة انتهى.
وبحسب ما حكى النقاش فإن السادات كان ينزعج من أن الحجاوي يُناديه باسمه بلا ألقاب، ويزيل أي رسميات، ومن ثم قرر الإطاحة به، ليس من الجريدة فحسب، بل من وزارة الثقافة ومن الإذاعة في ما بعد، ليجد نفسه في مهب الريح، بلا عمل. فيقبل عرضاً للعمل في وزارة الثقافة والإعلام بقطر، ويسافر، ليواصل مشروعه هناك في البحث والتنقيب عن الفنون الشعبية الخليجية، وبعد أقل من ثلاث سنوات قضاها هناك وشبح الموت لا يُفارقه بعد كل هذه الطعنات التي تلقاها في حياته، جاء إلى معشوقته مصر، ليُدفن في ترابها، حيث توفي في قطر في السابع من كانون الأول/ديسمبر عام 1975.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.