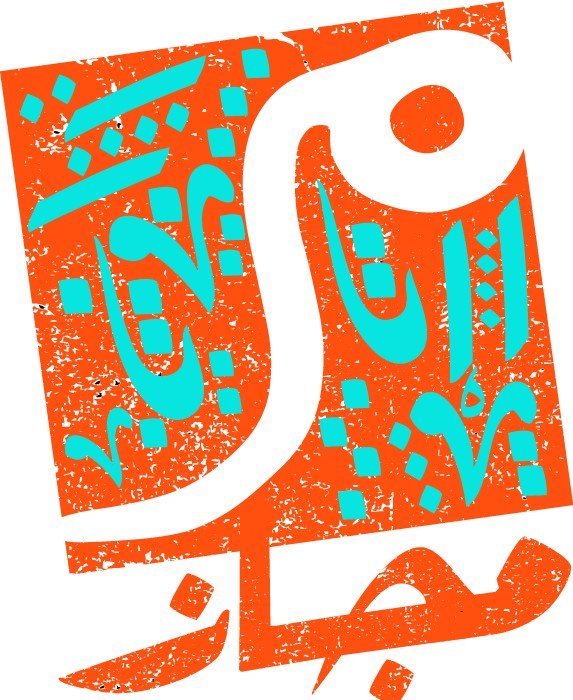 نوستالجيا خفيفة
نوستالجيا خفيفة
طقوس كثيرة نفعلها للتحضير لسهرة مثالية أمام الشاشات، بداية من اختيار الفيلم، وإن كنّا سنشاهده فرادى أو وسط مجموعة.
لكني اخترت فيلم السهرة، بل طالما اخترته خلال فترات مختلفة من حياتي، دون إكماله كل مرة رغماً عني. ستحدث المشاهدة التي تأخرت 25 عاماً، وإكمالاً للطقوس، انتظرت نوم ابني وجهزت الفشار اللازم للسهرة مع القناة التي تعرض فيلمي المؤجّل، بمناسبة مرور 25 عاماً على طرحه في دور العرض، وهي نفس المدة انتظاري "تايتانيك"، عن مشاهدته كاملاً.
*****
كانت المرة الأولى التي أسمع فيها عنه، مع الحمّى التي انتابت البلد بانتشار إعلاناته في التليفزيون والشوارع، وأغنيته التي تصدح من كل المحال، تلك الأغنية كانت بداية معرفتي بالأغاني الأجنبية، والتي ستصاب مطربتها بمرض عصبي نادر بعد أكثر من عشرين عاماً ليبعدها عن الغناء.
انتشرت البوسترات والبطاقات أمام أبواب المدارس، وسادت تلك الحالة الرومانسية في الأجواء. بطلا الفيلم، جميلا الشكل، يمثلان الزوج المثالي لخيالات المراهقين وخيالاتي الشخصية عن الحب والولع، مع اعتبار الشكل هو معياري الوحيد للحكم على الشخصيات. يجذبني الجمال، لذا كان الثنائي يشعّ بالمشاعر من حوله مثل المثل الشائع: "الحب في الهواء".
كنّا في أواخر التسعينيات، والحب بالنسبة لي هو تلك المشاهد الملونة والمليئة بالمشاعر بين بطلين جميلي الشكل. كنا في الصيف نتجه لفسحة ليلية معتادة بمنطقة المعمورة، وهناك داخل السيارات، تصدح أغنية الفيلم أمام مطعم ماكدونالدز الجديد.
هناك، كنت أراقب الثنائيات تختلس القبلات أو تنتشي على أنغام الأغنية العالية، يجمع الجمال بين تلك الثنائيات، وأنا في عمر محير بين الطفولة والمراهقة، منتظرة وجبة من المطعم أو طبقاً من الزلابية الساخنة من المحل المجاور له.
في وسط تلك الحمّى الرومانسية، اصطحبني والدي مع أخويّ لدخول السينما وقتها، في الطريق كنت أمنّي نفسي بمشاهدة قصة الحب التي يتحدث الجميع عنها، وقبل السينما اتجهنا لماكدونالدز الذي كان قد افتتح فرعه في محطة الرمل قبل شهور قليلة، وبمناسبة الافتتاح، تم صرف هدية مع وجبة الهابي ميل: كرة قدم أًصلية.
الهدية صارت من نصيب أخويّ، وانصرفت عن الوجبة الصغيرة وركزت على الفيلم الذي أتمنى مشاهدته، لم تهمني السفينة وكيف يؤرّخ الفيلم لغرقها، بل قصة الحب بين البطلين الوسيمين في أجواء السفينة المبهرة ذات الديكور الفخم والفساتين الأنيقة والحفلات. منيت نفسي بكل ذلك حتى نسيت جوعي.
كنّا في أواخر التسعينيات، والحب بالنسبة لي هو تلك المشاهد الملونة والمليئة بالمشاعر بين بطلين جميلي الشكل. كنا في الصيف نتجه لفسحة ليلية معتادة بمنطقة المعمورة، وهناك داخل السيارات، تصدح أغنية الفيلم أمام مطعم ماكدونالدز الجديد... مجاز
لكننا توجهنا لنشاهد الفيلم العربي "صعيدي في الجامعة الأمريكية". كان عقلي منفصلاً عن عيني، أفكر في الفيلم الذي أردت مشاهدته فأغيب في خيالي، وفي الاستراحة وقفت خارج الحمام، بين طابور الفتيات، أستمع لمشاهِدات "تايتانيك" يعلّقن على كل شيء، ملابس الأبطال ووسامتهم البادية. كطفلة تنصت جيداً وصاحبة خيال جامح، كنت أكمل قصة الحب تلك مثل قطع البازل في خيالي. تخيّلت هوس المحبين في عيون الثنائي، ورقصهما سوياً مع الأزياء الفاخرة والديكور المنمّق للسفينة التي تشبه القصور، مثلما وصفتها إحدى المُشاهدات، وحينما عدت لإكمال الفيلم العربي، كانت تشلّ ذهني خيالات مرتبة وصورة شبه مكتملة عن قصة الحب، تلك التي لن تنتهي نهاية سعيدة مثلما يخبرنا الكليب الخاص بالفيلم، والذي كان يعرض قبل الفيلم العربي مع فقرة الإعلانات.
*****
في بداية الألفية، غزا الدشّ البيوت المصرية، لكنه لم يدخل بيتنا لغلوّ سعره وسمعة القمر الأوروبي السيئة، إلا في مرحلة متأخرة. اقتنت قريبة لنا الدشّ الجديد، ودعتنا لسهرة بمنزلها احتفالاً بدخول الدشّ الغالي بيتها.
انقلبت السهرة لجلسة عائلية بلا تليفزيون، فالتقطت الريموت كنترول متحركة بين القنوات الكثيرة، كطفلة من ذلك الجيل الذي تربّى على الاختيارات المحدودة على شاشة التليفزيون، لم أعرف كيف أتوقف عند القناة المناسبة. مع التقليب السريع فوجئت بمشهد من "تايتانيك"، حين فاز جاك بتذكرة ركوب السفينة التي ستُبحر للعالم الجديد، حيث يتوقع هناك فرصة بداية جديدة.
وظللت ساعة ونصف مُسمّرة أمام شاشة التليفزيون مع غياب الكبار عن المشهد، لمحت جسد روز العاري كي يرسمها البطل "جاك"، وكانت تلك المرة الأولى التي أشاهد جسداً عارياً يتحرّك بمشاعر الحب الفاتنة التي تطغى على المشهد، لأفكر في البهاء الذي يطل من عيون حبيبين ومن جسدين ملتصقا ببعضهما.
وبينما أتابع ذلك الحب على الشاشة الغارق في الرغبة، تلفتت حولي لأجد عيون الكبار محدقة بي والغضب يعلوها، سحبوا الريموت من بين يدي، وقلبوا القناة بسرعة، ساخرين من الموقف الذي حدث للتو من شدة إحراجهم، ومن الجسد العاري الذي كان محرماً عليّ رؤيته.
علمت بعدها بسنوات أن الفيلم تم عرضه كاملاً في البداية، ومع اندفاع الناس لمشاهدة المشاهد العارية، التفتت الرقابة ليقرّر مقصّ الرقيب حذف تلك المشاهد، ويخيب أمل المشاهدين الذين تزاحموا لرؤية تلك المشاهد .
ذاب قلبي في الترام، حينما أمسك رجل عجوز بيد زوجته كيلا تقع. تلك النسخة من الحب هي التي أصبحت أنبهر بها
في ذهني دارت ملايين الاحتمالات حول نهاية الفيلم واجتماع الثنائي سوياً رغم غرق السفينة التي نعرف من المشاهد الأولى للفيلم أنها ستغرق لا محالة. استمرت حمّى الفيلم لسنوات، فانتشرت البطاقات والأكواب والبوسترات للبطلين، ومن فرش أمام مدرستي الإعدادية اكتفيت بشراء إحدى البطاقات خوفاً من تعليق البوسترات على حائط غرفتي، ورقابة والديّ اللذين يحذراني من خطورة قصص الحب، وعدم الانسياق وراء مشاهد الحب الحرام في الأفلام.
بالنسبة لي، كنت دخلت للتو المدرسة الإعدادية، ووعيت على الصبية المترصدين على سور المدرسة، عرفت كيف تتهادى الفتيات في مشيتهن أمام الصبية كي يحصلن على اهتمام العيون من حولهن، عرفت الكثير من قصص الحب ولكنني لم أختبره بعد، وظل مفهومي ذاك للحب على وضعه لسنوات طويلة.
مع الوقت، ورغم دخول وصلة الدش بيتنا، وهي بديل للدش غير المضمون بالنسبة لأسرتي بما يعرضه من أفلام نجسة، إلا أنني لم أشاهد الفيلم قط.
آل جلال كانت العائلة المسؤولة عن الوصلة في شارعنا، وهي مكونة من الأم وثلاثة أولاد شباب، هم محمود وأحمد ومحمد، مع غياب الأب الذي لا نعرف هل هو متوفى أم تخلى عن أسرته.
خمسة وعشرون عاماً لم يغيروا من مظهر الأبطال الذين أشاهدهم الآن في عنفوان شبابهم، ولكن أنا من تغيرت. لم أعد تلك الطفلة بعد الآن، فأنهيت الفيلم باستعادة تلك الذكرى ونمت... مجاز
اشترى آل جلال 15 ريسيفراً، وكل ريسيفر يعمل على قناة واحدة، ليكون مجموع القنوات 15، تتنوع بين أفلام ومسلسلات عربية، وأفلام أجنبية، ودينية، وإخبارية. وخلال شهور قليلة صار لكل بيت بشارعنا وصلة، وذاع صيت آل جلال في الشوارع المجاورة، ومع أول كل شهر يمشي حودة، الأصغر بآل جلال، ليجمع من كل بيت 30 جنيهاً، قيمة الاشتراك الشهري.
مع الوصلة، تجدّد حبي القديم للتليفزيون وقنواته، فوجدت التنوّع الذي مكّنني من مشاهدة الكثير من الأفلام التي أحبها ومتابعة الممثلين الأجانب الذين حفروا مكانتهم في قلبي ككراشات للمراهقة. ثم علمت أن إحدى قناتي الوصلة للأفلام الأجنبية ستعرض "تايتانيك" بعد فيلم شغال، وبينما أمّني نفسي بمشاهدته كاملاً بعد سنوات من الانتظار، مرّت والدتي من أمام الشاشة لتلمح فتاة عارية تجري من الكادر، لتكون نهاية وصلة آل جلال في بيتنا، وتضيع فرصة المشاهدة.
أصبحت هناك مشكلة كبيرة أمامنا بسبب تلك القنوات التي لا تحذف المشاهد، فيلغي والدي اشتراك الوصلة، فعدنا لتبادل السيديهات لنشاهد الأفلام على جهاز الكمبيوتر.
*****
ظلت علاقتي بالتلفزيون متأرجحة بين قنوات الدش، الذي أصبح رخيصاً ومتاحاً في بيتنا، والاتجاه لتحميل الأفلام من على الإنترنت من خلال التورنت، كانت علاقتي بالتلفزيون تتآكل كلما استعرت فلاشة أو هارد ديسك لأوصله باللابتوب الخاص بي، وأشاهد الكثير الأفلام.
كنا في زمن آخر نختار ما نريد مشاهدته دون أن يقرّر الوالدان ما يجب علينا ولا يجب، فأضحى المجال مفتوحاً أمامنا لتبادل الأفلام وتحميلها دون الاكتراث بمشاهدها غير المحذوفة وما كانت تسببه منذ سنوات من أزمات لوالدي ،كل واحد منا صار لديه جهازه الشخصي ليستخدمه مثلما يريد، فامتلأ جهازي بالأفلام والمسلسلات ،ومن خلال عملي توطدت صداقتي بصديق مخلص للسينما، ليصبح بعد ذلك مصدري الوحيد لمشاهدة الكثير من الأفلام الأوروبية والإيرانية وأفلام المهرجانات والكلاسيكيات.
صنّف صديقي الأفلام وفقاً لمخرجها والأثر النفسي الذي تتركه، ففي نوبات اكتئابي الشديد كان يعطيني ملفاً باسم "يُنصح بها في حالات الاكتئاب الشديد"، وحينما أغرق في أفكاري كان يعطيني ملفاً "لهواة الأفلام الخفيفة"، وهكذا ظل صديقي خلال ثلاثة أعوام أو أكثر هو مسؤول الترفيه الأول بالنسبة لي، والسبب الأساسي الذي جعلني أنفض عن متابعة التلفزيون، مع استثناء متابعة مسلسل رمضاني كعادة لم أتخلص منها بعد.
سنوات طويلة مرّت لابتعد عن التليفزيون أكثر واقترب من الحب أكثر، فلسنوات ظل مفهومي عن قصص الحب الدرامية يشبه كثيراً الفيلم الذي لم أتمكن من مشاهدته كاملاً قط.
دخلت منصات الاشتراك مصر وكانت نقلة في تاريخ مشاهدتي للتليفزيون. أصبح مسخّراً بالكامل لمنصة الاشتراك، بعيداً عن قنواته المملة والتي رغم الاشتراك في باقة قنوات خاصة لم تسليني بالقدر الكافي، لأتعرف على منصات الاشتراك.
في تلك الفترات، ورغم الإتاحة لكل شيء كنت أفتقد مَن يختار لي ما أشاهده، ربما كوني من جيل اعتاد من يختار له بداية من التليفزيون والدراسة حتى الزواج والحياة، ورغم تمردي سريعاً على اختيارات الكبار، إلا أنني كنت أستسلم أحياناً للتليفزيون، فأدير قنواته وأمسك الريموت بيدي وأتحرّك عشوائياً بين القنوات.
لذا حينما شاهدت الإعلان عن "تايتانيك"، قررت مشاهدة الفيلم حتى النهاية للمرة الأولى في حياتي، كي أستعيد ذلك الشعور الذي رافقني منذ مراهقتي، ودهشتي بقصص الحب غير المنتهية ووسامة أبطالها، فكرت أنني حظيت أيضاً بقصة حب درامية تجعلني أشعر بالقرب من أبطال قصص الحب ذات النهايات الحزينة. على الشاشة يتحرّك بطلاي المفضلان بعيداً عن الموت، يحاولان مقاومته لكنني أعلم أنهما ينجحان.
ثنائية الحب والموت مقرّر مصيرها منذ البداية، لكنني أتعجّب من البطل الذي يضحي بحياته الثمينة من أجل فتاة قابلها للتوّ. أحببت أيضاً وكنت على استعداد لمقايضة حياتي من أجل الرجل الذي أحببته، لكنه لم يكن شخصاً عرفته للتو. يحتاج الحب للوقت والتفكير كي تذوب الحدود بين طرفيه، لم يحظ البطلان بجلسات هادئة للقراءة سوياً وللمزيد من الأحاديث البسيطة، فكيف لهما أن يعرفا الحب بتلك السرعة؟
انبهرت النسخة المراهقة مني بذلك الحب الخاطف وإلتقاء نظرات العيون في ولع، لكن النسخة الأنضج مني فضلت علاقات هادئة دون الكثير من الأكشن. قبلها بأيام ذاب قلبي في الترام، حينما أمسك رجل عجوز بيد زوجته كيلا تقع. تلك النسخة من الحب هي التي أصبحت أنبهر بها .
*****
خمسة وعشرون عاماً لم يغيروا من مظهر الأبطال الذين أشاهدهم الآن في عنفوان شبابهم، ولكن أنا من تغيرت، فلم أستطع استعادة مشاعري في لحظات انبهاري بحمّام السينما، بجسم قصير وعين متسعة وقلب متلهّف للحصول على الحب. لم أعد تلك الطفلة بعد الآن، فأنهيت الفيلم باستعادة تلك الذكرى ونمت.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


