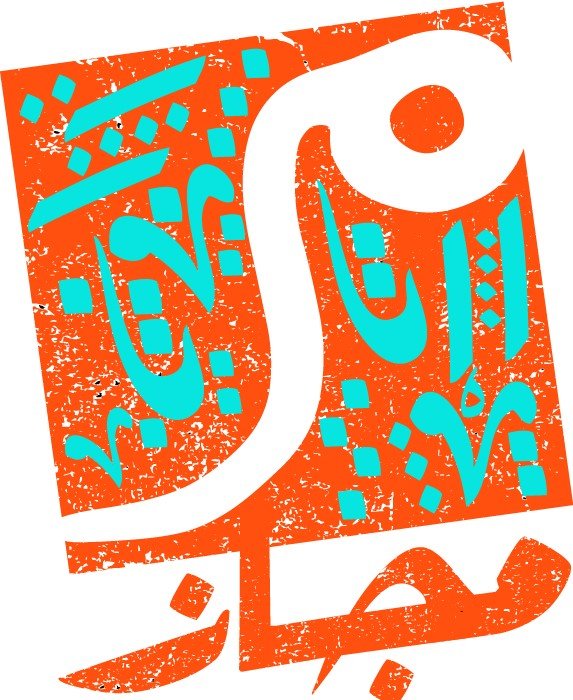 حياكة الكلام
حياكة الكلام
الساعة: الواحدة بعد منتصف الليل، المكان: غرفتي المطلة على المقابر.
عُدت للمنزل للتو بعد يوم عمل شاق بدأ ظهراً، مضيت في إنهاء طقوس دخولي للبيت، من تناول وجبة العشاء والاطمئنان على صحة الولدين وتفقد الأمتعة والأروقة، ومن ثم خلعت رداء الإرهاق على عتبة باب الغرفة، وأغلقت الستار خلفي كمن يغلق على نفسه قبره.
استلقيت على الوسادة مستسلماً للفراش، وفردت ذراعي اليسرى وأمسكت بـ"زوربا"، صديقي اليوناني الذي اشتريته ليؤنس أيامي من أحد باعة الكتب منذ أكثر من شهرين، وأخذت أقرأ بنهم، وفي الخلفية صاحبتني موسيقى البرنامج الأوروبي عبر أثير الراديو.
شعرت بالملل. رميت بـ"زوربا" في نهاية المنضدة وتجرعت كوباً من الماء، ومن ثم تفحصت مستجدات المقاطع الموسيقية على هاتفي، وأغمضت عيني للاستماع، وحين تعبت أذناي استأذنت السيد "راجح داوود" لإعداد فنجان قهوة على نار هادئة كالحياة التي أعيشها.
دقائق حتى غلت القهوة وعدت ثانية للفراش بصحبة الفنجان، حيث أحاطته يدي اليمنى بينما أمسكت الهاتف بالأخرى للاطلاع على ما آلت إليه أوضاع الكوكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اندمجت في تصفح منشور ما، خبر، قصة قصيرة، وحين ضجرت انتقلت للاطمئنان على حال أصدقائي، من خلال مشاركتهم على خاصية القصص القصيرة عبر تطبيقي واتساب وماسنجر. وهناك وجدت أحدهم يشكي ضجره، وآخر يتناول يومياته، وأخرى تقف أمام مرآتها صباحاً تبتسم للعالم عبر الكاميرا، وحينما يهل الليل، تعكس مرآتها عليها لون الحياة في السماء.
أما أنا، فحينما وصلت لأخر قصة قصيرة، أطللت بعيني على مدونتي، ومددت يدي لتقربها شيئاً فشيئاً دون أن يشعر "زوربا"، ومن ثم تحسّست أوراقها قبل أن أبدأ في ترتيب مهندم ومنمق لأحزاني.
الآن أكتب عن اليوم اللامعدود في الوحدة، فالكلمات السالف ذكرها كانت كخطوات الوصول إلى أعلى نقطة فوق أحد الأبراج الشاهقة، أما القادم فسيكون بمثابة القفز. إنها الوحدة، انتحار "لا شعوري" يقودني لأفكر في الأمس وأغوص في مياهه العكرة، فما لأحد نقاء في البارحة.
شرعت في الكتابة عن المشاعر التي انتابتني في نهار ذلك اليوم، كأم تلضم الإبرة بالخيط وتحيك ببراعة جروح السراويل والقمصان حتى تُعيدها لرونقها الأول. شارفت على استخدام الصفحات الأخيرة للمدونة، ولم تحك كتاباتي جروح الماضي، ما زالت الشخصيات الغارقة في نهر الذاكرة تطاردني ليلاً، وتغمز لي وتمد أيديها من المدونة المشؤومة الساكنة بجانب وسادتي.
التمست في عينيه مشاعر الموتى ليلة استقبالهم لأحد الآدميين القادمين من الحياة
أوقفت الحبر عما أكتب، وألقيت بالمدونة التي يرتسم على غلافها الرقصة المولوية الصوفية بجانب "زوربا"، تلك التي أهدتني إياها خريف أيامي، نسيم صباحاتي ومهد كتاباتي، الآنسة (...).
الآن أفصل الراديو عن موجاته الترددية، وأوارب النافذة حتى تكفي لإدخال ضوء القمر الذي صاحب نظراتي المقلقة تجاه المدونة المشؤومة. أرخيت يدي المرتجفة وأمسكت بغلافها كمن ينساق للذنب، أزحت عنها الأتربة وبدأت في دخول صفحاتها بخطى المنتكسين.
******
1 يونيو 2019، ليلتي الأولى بصحراء جبل "ع". كانت الساعة تشير للثامنة في ساحة مقر الفرقة، حيث تم توزيع دفعتي على السرايا والألوية ولم يتبق سواي. أخبروني أن المسؤول عن السرية التي سألتحق بها على مشارف الوصول. سيطرت الظنون على أفكاري، وظللت في حيرة من سؤالي: لماذا بقيت وحيداً كالحافلة التي أصابها عطب؟ وبينما أنا أتساءل في نفسي أتى القائد "ر"، ووقف بدراجته النارية أمام مخلتي وتفحصني بنظرات مبعثرة صاحبتها ابتسامه مشوهة، وكلمات سكب بها الزيت على نار القلق بداخلي: "أنت هتروح معايا أهدى مكان في العالم".
أكتب عن اليوم اللامعدود في الوحدة، فالكلمات السالف ذكرها كانت كخطوات الوصول إلى أعلى نقطة فوق أحد الأبراج الشاهقة، أما القادم فسيكون بمثابة القفز. إنها الوحدة، انتحار "لا شعوري"... مجاز
حملت مخلتي وحقائبي مجبراً، واستقليت الدراجة خلفه وانطلق بنا نحو الغموض. كنا كمن يتركان الحياة ويتجهان صوب الآخرة. كان الليل يشبه السرمد لا أرى شيئاً من الطريق سوى إضاءة الدراجة التي كشفت لي عن مساحات شاسعة من الصحاري، وعبارات تحذّر من الانتحار. لا أفهم. كانت لحظات أقسى من القسوة وأصعب من الصعوبة، تخللها انزلاق زجاجة المياه الغازية من يدي المرتعشة على الطريق، وكأنها تُعبّر عن الفزع الرهيب في نفسي.
مرت الدقائق حتى وصلنا لبوابة خالية من الحراسة، اقتحمناها بالدراجة التي أوقفنا محركها أمام غرفة مبنية من الطوب اللبن، يشعّ من أعلاها ضوء خافت، وقف على بابها شاب قصير القامة، هزيل البنية، لديه شارب يحكى عن أصوله الصعيدية ويدعى "ع". استقبلني بترحاب لم أعهده من قبل، وحمل عن كاهلي المخلة والأمتعة، وقادني لمائدة الطعام التي كان يعدها قبل مجيئنا، وهناك التمست في عينيه مشاعر الموتى ليلة استقبالهم لأحد الآدميين القادمين من الحياة.
لقّنني القائد بعض النصائح خلال تناول الطعام، وحاول أن يمنحني نبذة عن قاموس الحياة الصحراوية، ومن ثم أمر "ع" باصطحاب "المستجد" لغرفته من أجل الاستراحة. نهضت بتأن، وخطوت بجانبه صوب الغرفة بثقل عبّر عن الإرهاق في عقلي. كانت لحظات حاول خلالها الجندي السوهاجي استدراجي في السؤال كملائكة القبور، على ضوء كشاف هاتفه الصغير بديل أعمدة النور في الصحاري. سؤال، اثنان، إلخ قابلتهم جميعاً بتلعثم وتخبط أوحى له بتوجّسي من المشهد الذي انتهى أمام الغرفة، حيث طرح مخلتي أرضاً مُعلناً أن وقت الحساب قد جاء.
*****
غرفة شبه معتمة، تحيطها الصحاري والجبال من كل جانب، لا باب لها، غير آمنة، آيلة للسقوط، كالبيوت المهدّمة والمحلات الخربة. وجمت واقفاً وأنا أوزع نظراتي بقلق، وتتحرك عيناي بسرعة في الأنحاء، حين رأيت الفئران والثعابين تمرح بين أرجائها وفوق أسرّتها.
تغلفت بالخوف واستنكرت عذاب الآخرة وتمتمت بكل ما أحفظ من دعاء، ورحت أتوسل إليه ألا يتركني وحيداً، فعاملني بمشاعر ملائكة الرحمة وراح ينقل فراشه من حجرته الآمنة التي تحوي سريراً واحداً، وبقى بجانبي وحاول بثّ الطمأنينة في نفسي حتى هدأ الذعر وتبدّد القلق، ورحت في النوم وحلت الكوابيس.
استيقظت في العاشرة صباح اليوم التالي، كنت مرهقاً للغاية من حالة الهلع التي أصابتني، كمن ذاق العذاب في ليلة قبره الأولى، لم أجد "ع" في السرير المجاور، فنهضت مسرعاً وخرجت من الغرفة المنكوبة ورحت أتجوّل بعيني في الصحاري والجبال أبحث عن الآدميين.
قلت في نفسي: ما هذه السذاجة؟ انتهى الحساب وذهب "ع" للسماء، أنت الآن في حياة البرزخ، انتهت الحياة البلهاء. لم تقنعني الفكرة ورحت أتسكع في الصحاري، حتى وقعت عيناي على مسجد لا يتعدى الـ20 متراً، توجهت صوبه بخطوات سريعة، خشية أن يكون سراباً أو خيالاً، وما إن وصلت حتى طرقت بابه الهزيل بعنف وارتميت على الأرض متكوراً باكياً بصمت، وأدركت حينها أنني أفلت من الموت.
وما بين ضجيج الغضب والبكاء، حاولت التماس الصبر وبناء حوائط مقاومة واهية لاستكشاف الحياة هناك وبدأت الحكاية. ودارت الأيام وتعرفت على الـ15 فرداً، قوة السرية، أولئك الذين كانوا يقضون إجازتهم وقت وصولي، وينقسمون في غرف متفرقة في الصحراء الشاسعة، ويجتمعون في أول ضوء للنهار لوضع خارطة ساعات اليوم التي لا تمر، وبمجرد غروب الشمس وحلول المساء لا يرى هؤلاء من الحياة سوى بزوغ القمر في السماء.
هناك كنت أشعر بأن عقارب الساعة تحتاج لمن يدفعها للمضي قدماً، لا هاتف ولا وسائل تواصل، لا راديو، لا شيء سوى تلفاز نشاهد خلاله ما يدور في الخارج في حال كان محرك الكهرباء غير معطل.
سأخبرك كيف كان لصورتك الفوتوغرافية في جَيب الثوب مفعول الأنس في الصحاري، وسأدعوك لتناول فنجان قهوة ونحن نتسكع كالمراهقين بين شوارع وسط المدينة... مجاز
ما دون ذلك، كان أولئك يجتمعون حول العسكري "ب" عشية كل مساء، حيث عرف بينهم بأنه صاحب النكات الجنسية المسلية، والذي بدا وأن تناوله للمخدرات بشراهه قبل الخدمة صنع منه مهرجاً طريفاً، فكان يجلس وينفث السيجار ويتحدث عن علاقاته الجنسية بفخر، حتى تنفد سجائره ويثمل في فضاءات الخيال.
وهكذا أمضيت وقتي في الصحراء وحيداً بالقراءة والكتابة، باستحضار من أرغب في التحدث معهم لوحدتي، والاستماع للحكايات المسلية، والتي كان من بينها قصة أحدهم الذي قطع عقلة سبابة يده اليمنى من أجل إثبات ادعائه بأنها إصابة عمل أثناء تنظيف الذخيرة، ليمنحه ذلك رفت طبي ينهي خدمته، وبرّر ذلك بأنه استوحش الحياة هناك للحد الذي قاده للإقدام على هذا الأمر، وبالفعل مرت الشهور وبعد محاولات عدة وصل لمبتغاه، وفدى وحدته بعقلة إصبعه.
كانت حكايته تمهيداً لما سمعته فيما بعد من قصص تتناقل بين ثعابين الصحاري، عن انتحار أحدهم في السرايا المجاورة بين الحين والآخر، لأسباب تختبئ كالسم في جوف الطريشة، لكن كافة التفسيرات أوحت لي بأن العلاقات المبتورة هناك هي مفتاح خزانة الصندوق الأسود لهذا المكان المشؤوم.
أنهى "ع" مدته بعد مرور 6 أشهر من التحاقي بالخدمة، بعد أن أصبح بمثابة الأمان لي، وتركني أكثر وحدة في الصراع الذي يدب بين الجميع، وتنتشر الضغائن وتمكر المكائد ويختصم أولئك حتى الاحتراب.
*****
تدرين يا عزيزتي: لم أتمرد على الحزن بعد، مازال يسكنني وكأننا أبرمنا عقداً طويل الأمد
كرّ شريط الأحداث نفسه حتى وصلت لنصف المدة، 5760 ساعة، 240 يوماً و8 أشهر رأيت خلالهم من فوق جبلنا المستوحش ظلمات يونس، وشعرت باشتياق يعقوب، وحاولت الاستسلام للمكتوب كيوسف، توهماً بأنه الصبر الجميل، كابوس يتبقى على انتهائه 180 شمساً وليلاً، وصفته رسائل إحدى صديقاتي حينما كتبت: "وجعك يشبه وجع حماماتي قبل المغرب وهما داخلين الغية، وعلى حب نن عينهم الغروب، صدقني بيدخلوا وهما متأكدين من طلوع الصبح".
حاولت تحسس صباحي الملكي كما نصحت، وكتبت في أحد صفحات المدونة: "أتخيل في سينما وسادتي حينما أحدق في نجوم السماء شكل الحياة بالخارج كيف أصبحت، الانعزال لفترة تتجاوز الثلاثين يوماً ليس بالأمر الهين. اليوم انزلقت بعض القطرات من جفني، لا أدري أهذا بفعل الوحدة أم هي الذكريات. انزلقت، لكن أناملي أوقفتها لأنه لا يجوز أن تثور العيون على حكامها، ليس لأنهم طغاة، ولكن لأن ذلك سيؤدي لإثارة القلب وفي ثورته سقوط للعقل. حينما يأتي موعد حريتي سأقوم بالتحديق في الشوارع وأوجه الناس كمن عاد له بصره، سأعنفهم إن أسرفوا في الماء وإن تركوا بقايا الطعام، سألغي التاريخ والساعة وبعض المصطلحات الأخرى من القاموس المحيط، سأبتسم وأغضب في آن، سأعلمكم الشيزوفرينيا حقاً، من الجائز أن تكون هذه الشطحات مجرد خرافات إن استيقظت ووجدتني لا زلت في غرفتي، أداعب الكُتب والأغنيات ومن أحب، لن أسأل حينها أي شيء، سيكفيني أنني استيقظت من هذا الكابوس".
*****
انتهيت من كتابة الرسالة وطويت صفحات المدونة، وحاولت أن أتواصل مع أحد أصدقائي عبر الهاتف الصغير، بعد أن انتقلت لغرفة "ع" المؤمنة بالأسلاك والأبواب الموصدة عقب رحيله، وما إن اجتمعت الشبكة حتى جلست على ركبتي فوق السرير، حيث كنت أعلق الهاتف في سقف الغرفة لالتقاط الشبكة.
سأزرع وردة البائعة المتجولة بين خصلات شعرك الطفولية، وسأبتسم لك دون إيحاء أو افتعال، وسأنتظر على ساعديك كمن يعشش في حضن رمانة، وسأترك أناملي تلتمس في وجنتيك رعشة الأغنيات... مجاز
كان عقرب الساعة يخطو نحو الثانية عشر مساء، في ليلة الخميس تلك. أخذت أجول بعيني في الصحراء دامسة الظلام، واندمجنا معاً في الحكايات، وما إن اطمأن قلبي، حتى لمحت عيناي من بعيد ثعبان "الكوبرا" وهو يركض صوب غرفتي. فقدت صوابي وشعرت أنني في رجفة الموت. حام حول الغرفة واختفى أثره في بضع ثوان. أغلقت المكالمة الهاتفية ومعها إضاءة الغرفة، ودخلت في حالة من التشنج والارتجاف، ولعنت في سري الزمن الأغبر الذي أراني حياة الموتى قبل أوانها.
*****
أتساءل في نفسي: لم تنقضّ الأفكار علي في هجمات شرسة، حيث يتذمر الشتاء في زيارته السنوية، ويدرك أن المواجهة الفردية لعواصفه تُضعف، فكيف إن تكرر الأمر لسنوات، والتهمت نيران الوحدة الانطوائيين أمثالي، وظللتُ عالقاً في دائرة الخوف والفقد والضياع؟ أرتب الأمنيات وأهيم في أحلام اليقظة، حيث أسير بين الغابات وتتسائل الأزهار عني والهواء يسايرها والطيور تغرد تلبية لإلحاح الطبيعة حتى ينزعج الكون من هوجة قاطنيه.
أزدادُ صمتاً إيماناً بأن وتيرة العواصف لا تهدأ بالمواجهة، بل بالاستسلام والانصياع والسكون، حتى تخطو بي الأيام لحافتها، وهناك، وبينما أوشك على السقوط سأستدعي لذهني أنت.
سأخبرك كيف كان لصورتك الفوتوغرافية في جَيب الثوب مفعول الأنس في الصحاري، وسأدعوك لتناول فنجان قهوة ونحن نتسكع كالمراهقين بين شوارع وسط المدينة، وننسى أن هناك دُنيا وآدميين، وأنا الذي لم تمنحه الأيام سوى التسكع وحفنة مشاعر لا تواكب ركض الحياة.
ما رأيك إن استدرجت في شغف المُحب بابتسامة ثغرك وبريق عينيك وأمهلتني لحظات لأعيد لك أحب أغنيات الشيخ إمام إلى قلبنا، مدندناً: "سهرت وحدي اتونست بيك، هربت منك لقتني فيك، غُلب حماري وتاه سبيلي"، ومن ثم اصطحبتني صوب النهر لأحكي لك دون حياء عن ليالي أخريات أرغمتني فيها الوحدة على البكاء، حتى تنفد خزائن ذاكرتي من هواجس الأمس، بالاحتراق، الغرق، الإعدام، لا يهم وسيلة الموت.
تدرين يا عزيزتي: لم أتمرد على الحزن بعد، مازال يسكنني وكأننا أبرمنا عقداً طويل الأمد، لكن حتماً سينتهى هذا الاتفاق بالتراضي، إلا لو كانت الوحدة تجد عندي الراحة والسلام. حينها سأزرع وردة البائعة المتجولة بين خصلات شعرك الطفولية، وسأبتسم لك دون إيحاء أو افتعال، وسأنتظر على ساعديك كمن يعشش في حضن رمانة، وسأترك أناملي تلتمس في وجنتيك رعشة الأغنيات حتى يغدو الليل لأغرب معه بلا شروق آخر.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





