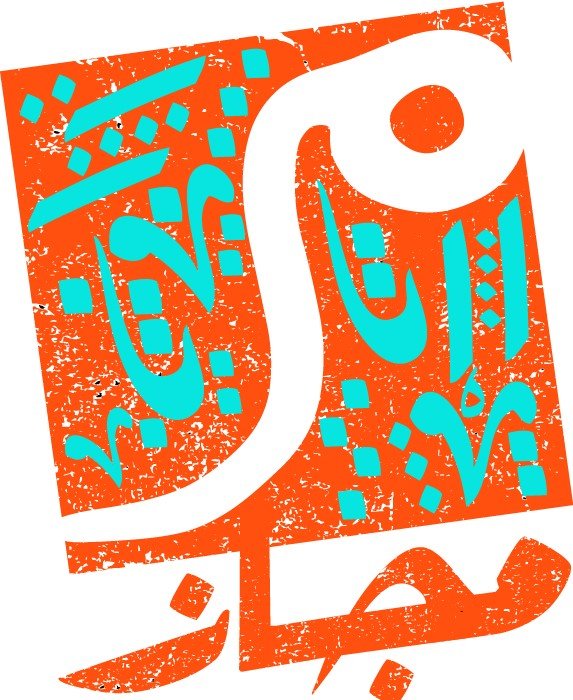 حياكة الكلام
حياكة الكلام
كنت الراكبة الأخيرة في حافلةٍ تشبه مسرحاً متنقلاً و تتجه نحوه، نحو الله. أظن أننا جميعاً في رحلةٍ إليه. لكنّ الأشياء تضيع مني بين الحلم و اليقظة، فهل بإمكاننا البحث عنها سوياً؟
أذكر أنني استقبلت طرداً كبيراً، لو كان صغيراً لفتحته، لكنه كبير، ما يعني أني لست بحاجةٍ إليه، فحتى رأسي أوشك أن أهديه للأصدقاء. أظنهم سيرحبون بالهدية، لكن لن يعترفوا بها.
وضعته خلف الباب مباشرةً، وذهبت أشتري ما ينقصني كي أتحضر للرحلة.
كل الوجوه التي تضجّ بها الأحياء، أعرف مذاقها، و كأن لي مع كل وجهٍ قصّة.
يا إلهي، منذ سنتين كنت لا أخرج أبداً، و لا حتّى في نزهةٍ، فمتى عرفت هذه الوجوه كلها؟
اللحظة صامتة، و المشهد ثابت، ثابت بعض الشيء، ساعتان، ثلاث ساعات مثلاً، و بعد ذلك تبدأ قصة أخرى. هنا لا أحد يسمع سوى التيّار.
أريد أن أصمت قليلاً كي أسمعني، و أن أتكلم كثيراً كيلا أسمع.
هناك نظرات تلاحقني طوال الطريق، منذ ان تصادمت أعيننا، فأرتبك. جميعهم الآن أصدقاء الطريق، و كأن نظراتهم كانت تنذرني بأن لنا رحلة معاً، نرى فيها من سيصل. البعض يبتهل، يسبّح ويقرأ المعوذات، والبعض ينط في الحافلة ويرقص، فيذكرني هذا بجوزيف غريمالدي، أمّا البعض الآخر، وأنا منهم، فنتأمّل الطريق كيلا يذهب ثمن البطاقة سدى.
يطلب منا السائق الهدوء إلى أن نقطع حاجزاً مرورياً. يوقفنا قائلاً : "الإله قد مات، عودوا إلى بيوتكم". ترتسم أمامي لحظتها ملامح الغضب التي أظهرها والدي عندما حرق كتابي الذي أحب "هكذا تكلّم زرادشت"، قائلاً بأنني أكفر حينما أقرأه، على الرغم من أنني كنت قد خبّأت مصروفي لشهرين كاملين كي أحصل عليه. يحذرني دائماً من الاسراف والتبذير، وأنا أسرفت في الحقيقة.
كنت كلما جاء للمنزل أشغل الراديو على "لحن جنائزي حزين" ليوهان ريخت، والدي كان يسمعه قسراً لكنه لا يعلم بأن اللفظ ظاهر في النشيد أيضاً.
الأصوات في الحافلة كلها خافتة بفعل الخوف، كان الخوف من وجود الإله، وأصبح الخوف في موته، لأن الخوف هنا كامن في الخروج من قفص التوقع.
كان الخوف من وجود الإله، وأصبح الخوف في موته، لأن الخوف هنا كامن في الخروج من قفص التوقع... مجاز
الآن، على كل واحد أن يكون إله نفسه، و خطير هذا الانفلات على مسجون، لكننا بارعون في خلق إله جديد وفي ادعاء النبوءة، إلى أن يصبح إيماننا كرفاناً.
تربّت يد على كتفي فألتفت، تسألني عجوز: "وين كنا رايحين؟". أجيبها: "إلى السماء". فتقول: "وليه لنروح نحن وهي فوقنا؟ بيكفي نرفع راسنا ونشوف، ويلي رقبته مشنجة، ما في داعي".
أصاب بضحكٍ هستيريّ: "يا حجّة، بدنا نعمل حصر إرث".
أضع يدي على صدري و تلمع عيناي شماتةً، فالإله الذي مات تمثال من شمعٍ، منحوت بدقة على قياس الفكرة، أمّا الله الذي أعرف، فهو الفكرة.
طوال طريق العودة ينشد الأصدقاء:
"الأبدية لنا
ما دامت السماء فوق رؤوسنا فارغة
الأبدية لنا
ما دامت الأرض من تحتنا عقيمة
الأبدية لنا
ما إن سقط هذا النظام
سقط هذا النظام
سقط
الأبدية لنا".
النظام لا يسقط، وسقوطه الفكريّ أشبه بنظامٍ جديد. لا أخفي أنني أشكّ أحياناً بأنّ الأبدية ملك للأكثرية، فحتى وإن ماتوا، نحن من نحييهم مجدداً عندما نذهب برحلةٍ للسماء. إلّا أن صوتاً ما يقول لي بأن الأبد مصطلح فارغ.
كلّ وصل لبيته. وأنا الراكبة الثرثارة الأخيرة.
في وجه السائق غيم وضباب. ألتفت لأسأله: "مات إلهك؟". يجيبني: "نفسه بالسما". فنضحك سوية، وتتقد عيناي من فطنته.
أعود للبيت كالهارب من صوته، فأنام على تعويذةٍ لم أعرف بعد من يتلوها لي. لكنه صوت جميل على أي حال.
أستيقظ فلا أجد صوتي، ولا الطرد الذي كنا نبحث عنه.
أحاول أن أفصل ذاكرتي، بين المشهد الثابت و المتحرك، فلا أراني. أفتّش في الأصوات، لا أذكر سوى صمتي.
أغيب عن المشهد بعد انغماسي فيه، فيحجز على إقامتي. ما هذا العيب التقنيّ للوجود؟
متى أعود للمسرح؟
لألقى حتفي، وأخلع عني هذا الرداء الذي يشبه حقيقةً أصابتني بالنفخة حين ابتلعتها.
لا شيء حقيقي أبداً بين الأرواح التي قتلها الضجر. يقتل معها الحقيقة، مع ذلك، بدلاً من التفتيش عنها أحاول أن أفهم تلك النهاية المعدّة مسبقاً التي تريح الرؤوس المؤمنة.
الله نار في الرأس. فأين أنا من النهايات التي لم تحدد بعد؟ و كيف تكون نهاية رأسي الذي تأكله النار؟
لا أخفي أنني أشكّ أحياناً بأنّ الأبدية ملك للأكثرية، فحتى وإن ماتوا، نحن من نحييهم مجدداً عندما نذهب برحلةٍ للسماء. إلّا أن صوتاً ما يقول لي بأن الأبد مصطلح فارغ... مجاز
أجلس على حافة السرير و أتذكّر:
عند بداية الربيع، اشتريت بعض شتلات الزهر والصبّار. لم أعتن بهم. كنت أمرّ بحالة نفسيّة شديدة السوء، والأسوأ من ذلك أنني "زهرة"، فقرّرت أن نذبل معاً في الرّبيع، لأنّ المياه، التي أعتبرها حلّاً لكلّ شيء، كانت تغرقنا حتى يختفي النفَس. لم نكن بحاجة للمياه، و لكن من يسقي نبتةً ليدخل الجنة أغرقنا كي يحصل على تذكرة، واحترقنا في شمس تمّوز.
أقول لوهلةٍ: "هل صحيح بأنني اشتريت بعض شتلات الزهر و الصبّار؟".
فتحت النافذة. نعم، كانت شتلات زهرٍ وصبّار وغدت أعشاباً مجفّفة.
على كل حال، أنه شرابي المفضل. وكاستراحة من البحث الطويل، أحضّر كوبين، لي وله.
حضّرتهم، وبقيت طوال اليوم أتأكد بأنني أطفأت الغاز. غفوت أمامه بينما أحدّق بزرّه المقفل.
استيقظ لأجد كوباً واحداً ممتلئاً، فأفهم بأنّه غاضب مني.
هل السبب بذلك إرهاق البحث وضعف ذاكرتي والنسيان؟ أم شرابي المرّ؟ هذا الشراب قربان للزهر، أمّا بالنسبة للذاكرة، فأنا أنسى لكثرة ما امتلأت بالذكريات. كان عليّ أن أتذّكر كل شيء كيلا أخطئ وكي أخاف بالأكثر.
ما زالت الأصوات تتردّد في مسامعي، رغم غيابها عن حيّز الواقع الذي حاولت مراراً محوه بطرف قميصي، لكنه غاب دون جهدٍ مني، هذا ما قد يكون أحياناً هدية الطبيعة. صوت والدي، العائلة، معلمي، أصوات الأمر و النهي و التحذير من أن أنسى وإلّا أعاقب وأحرم. جميعهم الآن ماتوا، ورغم سيرهم على كل ما رسموه لي، حرموا من الرحلة و كنت وحدي من حضرت.
يقال بأن الأموات يروننا ويسمعوننا، ليرى والدي الآن ويسمع: الآن لي رحلاتي الخاصة التي لم يكن ليحلم بها. أريد اليوم أن أنسى حتى ما أشغلت الله في البحث عنه، فعندما نسيت أصبحت حرّة بالكامل. بإمكاني أن أحادثه وأصطحبه لنزهاتي في الحقلٍ تحت الشمس، وفي أغنية عند الليل، نرقص و النافذة مفتوحة بالكامل.
لقد لحقت به قبل أن أصاب بالروماتيزم.
الآن أصبح بإمكانه أن يحضر لي حافلةً خاصة، برقمٍ خاص و مقعدٍ واحد، والراديو يذيع التعويذة، فنجتاز الحاجز مع غمزةٍ ونذهب في نزهة بريّة، نزور المقابر حيث الأصوات تعلو وتعلو، لنقول: "فاتتكم الرحلة".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


