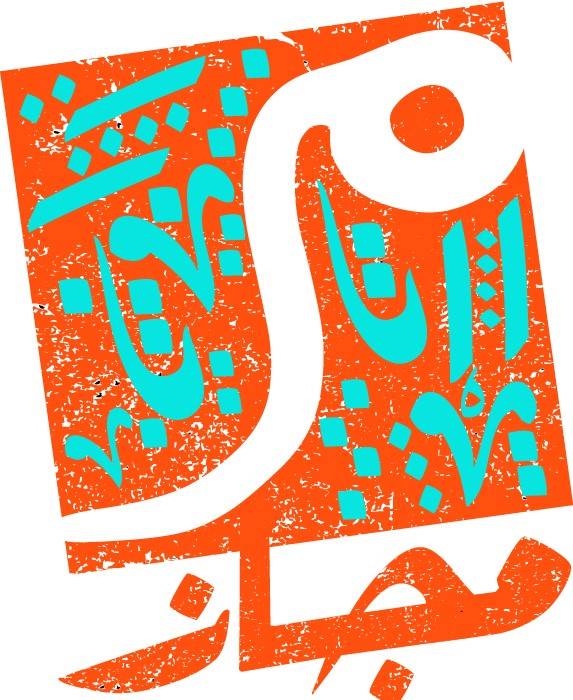 في ليلة عرسي
في ليلة عرسي
لسنوات كنت أرتدي الجينز، حتى أني نسيت متى كانت آخر مرة استبدلته بنوع آخر من الملابس. كنت أتراجع عن الذهاب للحفلات والأفراح لأنني لا أستطيع أن أحشر نفسي بداخل فستان أي كان، ولا يمكنني ارتداء أي شيء آخر سوى الجينز. حتى قدمي لم أجرب منذ سنوات أن أضعهما داخل حذاء نسائي فاتن. أختار دائماً الكوتشيهات الكونفرس المحايدة، أو السليبر المحايد ذا الأبزيم الجانبي والنعل الطبي.
لسنوات تكاثرت داخل دولابي البنطلونات الجينز وقمصان وتي شيرتات اليوني سيكس الخالية من أي ملمح أنثوي، فقدت رغبتي في التجمل تماماً، لا أدوات تجميل، ولا أقراط أو أساور أو خواتم، لا شيء يمكن أن يشير إلى أنني أنثى، حتى الساعات كنت أختارها من قسم الرجال.
عندما نعتاد أمراً ما لا نفكر فيه، وأنا دون وعي اعتدت تلك الاختيارات التي تسلبني كلَّ ملمح أنثوي، و تجرّدني تماماً من أنوثتي ولم أدرك ذلك، بل حاولت على مدار سنوات فلسفة الأمر ليبدو كأنه اختياري الشخصي، حتى أقنعت نفسي تماماً أن أيّ ملمح أنثوي هو تصنّع، وكل رغبة أنثوية في التجمل هي محض تكلف.
علم اجتماع الملابس
عندما قرّرت تتبع الحكاية، اكتشفت أنه تاريخ طويل من التخويف من الجسد بشتى الطرق، ليس التخويف من الجسد فقط، لكنه التخويف من كوني أنثى، سواءً كنت طفلة، مراهقة، شابة، أم امرأة ناضجة، هناك إجماع مجتمعي على إبقاء الجسد الأنثوي سراً، والتعامل معه كأنه كأس مقدسة يجب أن تبقى دائماً تحت الحراسة.
بعد أن تصالحت مع جسدي وأيقنت أنه ليس سبّة أو لعنة أو به ما يشين، أدركت أن المشكلة ليست فيّ، ولكن في المتحرّشين والمتشدّدين، وفي المجتمع الذي يقتصّ منا كفتيات ونساء حتى لو لم نكن مذنبات في الأساس... مجاز
انصعت منذ الصغر لتلك الفكرة عن الحراسة، و اعتدت سماع كلمة "عيب" بسبب ودون سبب، كل ما أفعله يمكن أن يصبح عيباً بطريقة أو بأخرى، لم أسمع كلمة "غلط" أو "حرام"، لكن اعتدت كلمة "عيب"، وهي غالباً كلمة تخصّ الجسد أو ما يمكن أن نفعله به أو فيه، ذلك الجسد الذي لا نملكه من وجهة نظر الجميع، لذلك يجب أن نتحرك ونرتدي ونمشي كما يقول كتالوغ المجتمع.
كنت أظن أنني أختار ملابسي تبعاً لذوقي لشخصي في الألوان والأشكال والموديلات، لكن الأمر أعقد من مجرد اختيار واع، ربما هناك أيضاً أسباب غير واعية لاختياراتنا في الملابس، لكن كيف يحدث ذلك؟
كيف نختار ملابسنا؟
بداية من القرن التاسع عشر بدأ عدد قليل من علماء الاجتماع دراسة الملابس وعلاقتها بالثقافة والأفراد والجماعات، بالإضافة إلى دراسة تعديلات الجسم أو مكمّلات الجسم، مثل التسمير والوشم والثقب وجراحات التجميل، بالإضافة إلى الملحقات، مثل النظارات والسماعات، وبحلول خمسينيات القرن الماضي استخدمت نظريات علم الاجتماع مع نظريات علم النفس لدراسة العلاقة بين السلوك البشري والملابس، وركزوا غالباً على تأثير الملابس على تكوين انطباع ما حول الشخص، بالإضافة إلى تأثير الملابس على سلوكه وصفاته وإدراكه لذاته.
مع مرور الوقت أصبح الأمر أكثر تحديداً، وبحلول الثمانينيات اهتم الباحثون بملابس النساء الكاشفة والمثيرة، وأطلقوا عليها اسم "الملابس الاستفزازية". يجب هنا أن نتوقف قليلاً لنتساءل لماذا تعدّ ملابس استفزازية؟ ومن أي وجهة نظر تعد كذلك، وجهة نظر الرجال أم النساء؟
عيب... عيب... عيب، كلمة عيب لم تفارق أمي أبداً
وجدت الدراسات أن تصنيفات النساء اللواتي ارتدين ملابس مثيرة كانت أكثر سلبية من تصنيفات النساء اللواتي ارتدين ملابس غير مثيرة، بالإضافة إلى تصنيف صاحبات الملابس المثيرة على أنهن أكثر جاذبية جنسية، أقل إخلاصاً في الزواج وأكثر عرضة لاستخدام الجنس لتحقيق مكاسب شخصية، وأكثر عرضة للمضايقات الجنسية. أصدر الرجال والنساء تصنيفات مماثلة رغم أن الرجال كانوا أكثر تطرفاً، ومع تطور البحث في التسعينيات بدأ الباحثون في التعمق أكثر في أفكار العقل الجمعي التي تتلقى ملابس النساء، ليكتشفوا أن ملابس المرأة الكاشفة أو المثيرة حمّلت من ترتديها من النساء مسؤولية التحرّش والاعتداءات الجنسية، لنتأكد أن تلك النظرة التي تحمل المرأة مسؤولية أفعال الرجل ليست حكراً على المجتمعات العربية فقط، لكنها تمتد إلى كل العالم، حتى تلك الدول التي نعتقد أنها تحترم المرأة.
تقول ماري ولستونكرافت في كتابها "دفاع عن حقوق النساء": "يعلمونها منذ الطفولة أن الجمال هو صولجان المرأة، ويصوغ العقل نفسه وفق الجسد، وحائماً حول قفصه المذهب لا يبحث إلا عن زخرفة سجنه".
يعني منذ بداية الحياة والجمال مرتبط بالمرأة، ومع تطور الحضارات تحولت المرأة إلى أداة لعرض الجمال، وأصبح الجمال هو المكسب الأهم للمرأة، وبعد أن صدقت المرأة وترسخت تلك الفكرة التاريخية والاجتماعية في عقلها، بدأ الجميع يحاسب المرأة على رغبتها في الجمال، تلك الرغبة التي زرعها الجميع بداخلها. تحولت المرأة إلى واجهة لعرض الثروة والدلالات الطبقية، ومع مجيء عصر النهضة تحول الجسد العاري للمرأة إلى رمز الجمال، ولم يعد جمالاً هزيلاً أو شاحباً أو سماوياً كما في الفنون التي سبقت عصر النهضة، لكنه جمال شهواني مثير، يشير إلى المعنى المتعارف عليه عن الجمال.
وبقى الأمر على هذا الحال لأن المرأة كانت جزءاً من المجتمع العالمي الذي يمجّد البرجوازية والطبقات الحاكمة والسلطة، وبالتالي لم يكن للمرأة وجود مستقل، وكانت تتبع الموضة التي كانت تشبه ديكتاتوراً مسلطاً على النساء، يقولبهن جميعا داخل النمط: ثديان بارزان مدببان، خصر نحيف، لا سراويل للنساء، فساتين بأربطة مشدودة، تنانير منفوشة، يمكن أن نقول إن الملابس كانت تصنع المرأة، إلى أن ظهرت النسوية التي أطلقت العنان لفردية المرأة وشجعتها على ارتداء ما تفضل وما يتفق مع الطريقة التي تحب أن تقدم بها نفسها، حرّرت النسوية المرأة من القوالب النمطية التي حبست فيها لقرون.
مالي طب وانا مالي؟
لم أعرف كل ما سبق أثناء طفولتي بالطبع ولا مراهقتي، لكنني عندما أستعيد تصرفاتي بأثر رجعي وأحاول تفكيكها، أذكر التحولات التي مرت على ملابسي ووطريقة اختياري لها على مدار عمري. في طفولتي كنت أرتدي ما تختاره لي أمي: فساتين ملونة ومنفوشة، تظهر سيقاني الصغيرة الرفيعة وذراعي الرقيقتين، طفلة صغيرة ترتدي كما ترتدي كل الصغيرات وهن مطمئنات للعالم، لكن الاطمئنان لم يدم؛ كانت أول حادثة تحرّش في سن السادسة أو السابعة. كنت أرتدي فستاناً فيروزياً بزهور ملونة وحمالات رقيقة تُربط بفيونكة من الأكتاف.
كنت سعيدة بالفستان وأشعر أنني طفلة جميلة بالفعل، عندما حاول شابٌّ فكّ رباط الحمالات لاعناً من تركني أخرج بهكذا فستان من البيت بشتائم قذرة. ابتعدت عنه بسرعة ولم يتمكن من فك رباط الفستان، لم أعرف حتى الآن في ما كان يفكر عندما أراد أن يفك رباط فستان طفلة في السابعة، لكن أغلب الظن أنه كان يحاول عقابي على ذنبي الذي لا يغتفر.
هناك إجماع مجتمعي على إبقاء الجسد الأنثوي سرّاً، والتعامل معه كأنه كأس مقدسة يجب أن تبقى دائماً تحت الحراسة... مجاز
لم أحك لأمي عن الحادث أصلاً، لكنه كان سبباً في تحول كبير في طريقة اختياري للملابس، خاصة أنني كنت قد بدأت أقرر اختيار ملابسي بنفسي إلى حد ما، فتحولت إلى الملابس الأكثر احتشاماً: لا فساتين مفتوحة، لا تنانير قصيرة، ملبس أقرب لملابس الأولاد. هكذا بدون قرار مسبق. لا أرغب في لفت النظر إليّ أبداً. أسير في الشارع مثل نملة صغيرة ملتصقة بالجدار، حتى شعري كنت أطلب من أمي أن تقصه لي كلما طال قليلاً.
دخلت في طور المراهقة، ولم يتغير شيء بل ازداد الوضع تعقيداً، لأن كلمة "عيب" لم تفارق أمي أبداً، حتى دون أن أفعل شيئاً، عيب... عيب... عيب، لمجرد التحذير من الوقوع أي خطأ يخصّ جسدي، خاصة مع المتغيرات الشكلية التي تطرأ على جسد المراهقات.
مع تكرار حوادث التحرش وعنفها وصلافتها، ابتعدت نهائياً عن التنانير والفساتين، وبدأت في ارتداء الجينز المحكم حول جسدي، والأحذية عالية الرقبة. كنت أظن أنني أرتديها لأنني أفضل هذا الشكل الأقرب لستايل "tomboy" وهي الفتاة الغلامية التي تتشبه بالرجال في السلوكيات وطريقة اللباس.
استمرت هذه الطريقة معي لما يقرب 25 عاماً، ولم أدرك تماماً لماذا اخترت هذا النمط من الملابس والسلوك سوى وأنا على مشارف الأربعين، بعد أن تصالحت مع جسدي وأيقنت أنه ليس سبّة أو لعنة أو به ما يشين. أدركت أن المشكلة ليست فيّ ولكن في المتحرّشين والمتشدّدين، وفي المجتمع الذي يقتصّ منا كفتيات ونساء حتى لو لم نكن مذنبات في الأساس. شعرت بجسدي ككيان يخصني وحدي، دون تحكم من أحد، ودون إملاءات اجتماعية أو عائلية، وتحرّرت من الخوف وتمكنت بعد مجهود كبير من قبول نفسي كما أنا. تخليت تدريجياً عن الجينز والأحذية عالية الرقبة، وجربت الفساتين دون خوف ودون رغبة في الاختفاء داخل الجدران.
الفستان الأول
كان للفستان الأول رهبة كبيرة عندما ارتديته، كلما تحركَ انتبهتُ خوفاً من أن يكون هناك من يحركه، رغم أنه كان فستاناً طويلاً ومحتشماً إلى حد كبير، وفوقه كارديجان بكم طويل، لكن جسدي كما لو كان قد اعتاد على الحبس داخل الجينز المصمت، كان مندهشاً من ملمس الساتان الناعم، ثم مفتنناً به بعد الاندهاش.
بعد الافتتان يبدو أن الأمر تحول إلى إدمان، اشتريت فساتين تكفيني لسنة قادمة، زرت البوتيكات المخصصة للفساتين بعد أن كنت لا أنظر إلى فتارين الفساتين أصلاً، أخذت صوراً لنفسي بفساتين مختلفة حتى لو لم أشترِها، كأنني أتعرف على نفسي من جديد، حتى شعري توقفت عن قصه بطريقة "boy cut"، وأصبحت أرجوه أن يطول سنتيمترات قليلة كل صباح.
لا أعتقد أنني سأتوقف تماماً عن ارتداء الجينز أو الأحذية عالية الرقبة، لكنني أصبحت أدرك تماماً الفارق بين أن نختار ملابسنا بعقلنا الواعي أو نختارها بالعقل الباطن وتحت ضغط المخاوف والهواجس والتوجيهات الاجتماعية.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


