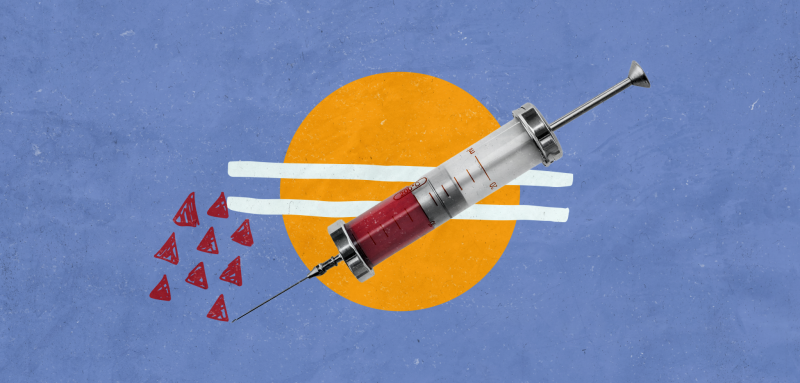المضطرب
المضطرب
لا يتطلّب الأمر سوى خيط مطاطي يضغطُ على ذراعك، فينحبس الدّم في زاوية ضيقة، وإبرة دقيقة لا تكاد تُرى، تمتصُّ بضع قطرات من دمك الذي يخرج سلساً غير آسف من جسدك للأبد. تُراقب امتلاء القارورة بدمكَ، غير متخوّف من أن يجري في أوردة إنسان آخر، غريب تماماً عنك، وعنه، وغير مرتعب من الإبرة الهزيلة.
تراقب الدم وهو يندفع إلى الأنبوب الزجاجي، وأنت لا تشعر بالفراغ أو الجفاف من دونه، بل كأنّ لا شيء يحدث. إنّه مجرد عصير غزير داخلك، يمكنك الاستغناء عن جزء منه بسهولة، ثم تعود إلى حياتك، فهناك الكثير من حيث جاء.
أثناء ذلك، يوشك أحدهم على فقدان آخر قطرات دمه، ينتظر أن تعيد له قطراتك الجاحدة الأمل في الحياة، وتمدّه بأسبابها. يختلط دمك بدمه ويعيشان في ثبات ونبات. أنت الذي أطعمته وسقيته حتى أصبح قطرات دم محترمة وصحّية وغنية بالكريات البيضاء والحمراء، والخلايا والمعادن والفيتامينات. بل بالدليل القاطع يمكن أن تدافع عنه إلى آخر نقطة، وتقول إنه ليس دماً خفيفاً مثل لَبن مُزج مع الماء، أو خاثراً معقداً مليئاً بمرارة الحياة وحموضة أيّامها، لا، لا، إنّه دم محترم يعرف ما له وما عليه، لا يأكل مال اليتامى أو طعام المساكين. إنه دم "مودرن" لا يُكثر من الطّواجن وقَصْريات الكسكس والولائم، بل يحاول تناول الأكل الصحي، قدر الإمكان، رغم حنينه إلى البيتزا وبقية العائلة الدّهنية اللّذيذة.
من جهة أخرى
هناك من يعجز عن تقديم قطرة واحدة من دمه، حتى لو رغب في ذلك. أنا منهم، بقدر ما أرغب في ذلك، بقدر ما أفشل. فمن مخاوفي الكبيرة التي لا أعرف كيف نبتت، سُحب الدم من ذراعي. كلما سمعت عن شخص يحتاج دماً من فصيلتي، أفكّر جدّياً في الموضوع وأتمنّى المساعدة، لكني أسترجع الفوضى التي أُحدثها عندما أجري تحليل دم، وتتسارع دقّات قلبي، كأنني سأقدم قلبي على طبق من بلاستيك.
لم يمرّ وقت طويل على تجربة حديثة عصيبة مرّت بي، بعدما بقيت أكثر من خمس عشرة سنة بدون تحليل دم، بسبب الخوف نفسه. خلال هذه السّنوات لم تكن هناك حاجة طارئة، لذا تعايشت مع الوضع، وأمراض الحساسية التي كانت تزورني بين الفترة والأخرى لم تحتج لهذه التحاليل، بقيّة الأمور أعالجها بتركها، وعدم التوجّه كثيراً إلى الأطباء الذين يعتمدون على تحاليل الدم كمؤشر وحيد لتشخيص مرضك. في آخر فترة قلت لطبيبة المعدة: ليس ضروريّاً أبداً تحليل الدم، بل إنني أؤكد لك أنه لن يمنحك أي معلومة، هو دمي وأنا أعرفه. عديم المعرفة بأحوال جسدي، متبعاً حكمة الجبناء "هْبل تربح"، أي تظاهر بالجهل لتنجو من العمل الشاق.
تقول إنه ليس دماً خفيفاً مثل لَبن مُزج مع الماء، أو خاثراً معقداً مليئاً بمرارة الحياة وحموضة أيّامها، لا، لا، إنّه دم محترم يعرف ما له وما عليه، لا يأكل مال اليتامى أو طعام المساكين... مجاز
فوبيا سحب الدم
لكن منذ صيفين أو ثلاثة، انتابني شعور دائم بالتعب والدوخة، فشخّصتُ نفسي بالغدة الدرقية، هكذا وفقاً لمؤشر الأعراض، فأنا صرتُ طبيبة نفسي منذ زمن بعيد، ووضعتُ الأطباء على دكّة الاحتياط. بقي أن أذهب إلى طبيب ليؤكّد الأمر، عبر التحليلات.
رغم معاناة طبيب المختبر من ورطة عويصة ليستخرج منّي بضع قطرات من الدم، بالكاد تكفي، رغم أنني أصررت أن يقوم رئيس المختبر وصاحبه نفسه بالعملية بدل الممرضات. لكن النتائج لم تُظهر أي خلل، ولعل المعاناة التي مر منها دمي ليخرج إلى العالمين أدت إلى فقدانه الخصائص الجينية، ولم يعد يقدم لي أي خدمة بعدما استخرجته بشق الأنفاس.
فطلب طبيبي المعالج تحاليل أخرى بعد أسبوع، ولأن التحليل الأول كان حديثاً فقد عانيت بشكل عجيب لأجل التحليل الثاني، ومعي الممرضين والأطباء والإبر والمرضى الآخرين في مركزين. كان يُغمى علي بمجرد أن تحاول الإبرة جر الدّم من عرقٍ يجدونه بصعوبة بالغة. فعروقي بالغة الصّغر، ويهرب منها الدم بمجرد أن تدخل الإبرة، فأشعر أنهم يستخرجون عروقي من الألم. من هناك نبتت الفوبيا، من عدم تمكن الممرضات من إيجاد عرق لسحب دمي. كنت أطلب الاستلقاء على الأرض لا السرير الطبي، فالالتصاق بالأرض يمنحني ملاذاً من الدوخة وشعور من سيقع من ناطحة سحاب.
ينشف دمي داخلي، كلما سمع كلمة "إبرة". وعندما أسمع تعبير مذبحة دموية، يحيلني عقلي مباشرة إلى مشهد الممرضات يتعرّقن حولي، وجسدي يقوم بكل ما يستطيع ليقول: لا
أُغادر المركز بعد أن نفقد صبرنا جميعاً. أجرجر دوختي، وأعود مهزومة. ثم أتجه للهدف نفسه بعد عدة أيام، ومعي ابنتي، لتساعدني في الطوارئ. أجلس على الكرسي المريح، أحاول أن أفتح أبواباً خفية في ذهني، أتصوّر غاباتٍ أركض فيها، وأنهاراً أغطس فيها، وشواطئ لا نهائية من الزرقة... لكن بمجرد أن تدخل الإبرة ذراعي، أدوخ، وتلفّ بي الأرض في دورة مجنونة، رغم أنني لا زلت في الغابة، أشاهد الأشجار دائخة، وأفكر في الاستلقاء تحت إحداها.
خذوا كلماتي لا دمي
أخافني ذلك أكثر: ماذا سأفعل بقية حياتي من دون تحاليل؟ المهم بعد فضائح كثيرة لا تليق بامرأة راشدة، نجح الطبيب في استخراج بعض الدم، وكان الأمر أشقّ من استخراج الذهب، لدرجة أنه ترجّاني وهو في الستين أن يسلمني لممرضة شابة، قال إنها مثله بالضّبط في الحنان والصبر، لكنني رفضت تماماً: لا أحد غيرك. سبب تعلّقي به أنه أحن طبيب على وجه الأرض، حسب ظني العاطفي، كل كلمة من لحظة اللقاء به، فيها أبوّة هائلة، لعل كل منا تتمنى أباً مثله، هو رجل نحيف لذا أصابعه دقيقة، لكن مراعية، فبالكاد تشعر بها وهي تشد الوثاق البلاستكي حول ذراعك. لذا كان أملي الوحيد في أن يشعر دمي بالأمان ويخرج إلى المعركة بشجاعة المؤلّفة قلوبهم على الأقل.
الوصية الوحيدة التي أجد أنني سأكتبها: لا تضعوا جسدي على الآلات، لا تسحبوا دمي، لا تحقنوني. دعوا هذا الجسد الجبان يرحل بسلام، ليندسّ في الأرض كاملاً غير منقوص... مجاز
لكنني عانيت كل ذلك بلا فائدة، لأن الطبيب المعالج لم يجد شيئاً غير التعب والإرهاق، ونصحني بالعطلة والراحة والابتعاد عن الأوغاد في كل مكان، مع تغيير العتبات. وكان أن معاناتي كلها لم يكن لها داع. وعدتُ لأحلف للأطباء أن تحاليل الدم غير مهمة، ويكفي أن ينظروا إلي، ويسمعوا تحليلاتي للآلام ليعرفوا ما بي. في النهاية أنا أعيش في الكلمات، منها، ولها، أكثر مما أعيش على الدم. عليهم أخذ الكلمات لتحليلها، وتشخيص مرضي.
أول إبرة في التاريخ
ينشف دمي داخلي، كلما سمع كلمة "إبرة". وأتذكر أول إبرة في التاريخ. وعندما أسمع تعبير مذبحة دموية، يحيلني عقلي مباشرة إلى مشهد الممرضات يتعرّقن حولي، وجسدي يقوم بكل ما يستطيع ليقول: لا لسحب الدم. وفي آخرها يغمى عليّ مثلما حدث أول مرة. حينها أَرجع الطبيب ذلك للحمل. لكن بعدها بسنوات، استلقيتُ أمام ممرضة حاولت سحب الدم، مثلما تفعل عشرات المرات في اليوم. لكن لا، كان الأمر مختلفاً، لأنّني شعرت أنها تسحب أوردتي وعروقي، لا الدم، فهي قد جفّت وهجرها صاحب اللون القاني. لكنها لأن الممرضة مجتهدة، و"متعوّدة" على استخراج الدم بالعنف أو العطف، بإصرار، مثلما يُستخرج البترول من أرض جافة، واصلتِ السّحب، فكان على جسدي أن يتفاعل بالإقياء والإغماء... كأنه يقول: لن تهزمني الأصابع الغليظة للممرضة السمينة، مهما عصرت ذراعي وأوردتي.
مرة أخرى، أصابتني الجرعة الثانية من أسترازينيكا بآثار جانبية رهيبة. جاء المسعفون إلى البيت، فسحبوا الدم من العرق الوحيد غير المتضرر، الذي أوصتني طبيبة بالحرص عليه ما حييت، لأنه العرق الوحيد الذي يستجيب.
بعد هذه التجارب، كيف سأكبر بهذه الأوردة الجبانة؟ ما الذي سأفعله لاحقاً عندما أشيخ ويتداعى جسدي ويحتاج لتحاليل وتركيب موصلات السّيروم بأنواعها المختلفة؟ والأهم أنني تخليت عن رغبتي في التبرع بالأعضاء، فالجسد البخيل بدمه، لن يجد طريقة لمنح أعضائه. التبرّع يعني أن يتم توصيل الجسد بالآلات، عندما يموت المرء إكلينيكياً. الآن الوصية الوحيدة التي أجد أنني سأكتبها: لا تضعوا جسدي على الآلات، لا تسحبوا دمي، لا تحقنوني. دعوا هذا الجسد الجبان يرحل بسلام، ليندسّ في الأرض كاملاً غير منقوص.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.