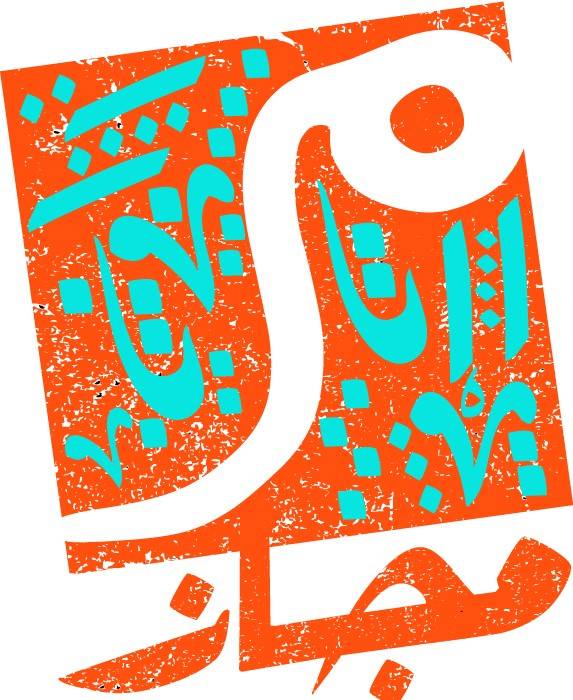 يعيش أهل بلدي
يعيش أهل بلدي
قالت مريم: "إيه البتاع اللي معاك ده؟"
يا الله، إنها تتحدث إلي بعد كل دهور الهجر والعذاب من تجاهلها المفتعل.
كنت في الصف الثاني الابتدائي، أتذكر جيداً، وكانت مريم هي جميلة الصف، بل جميلة القرية، والكون كله بالنسبة لي وقتها. شعرها الأسود الناعم كما ذيل مهر صغير، عيناها الواسعتان السوداوان جداً، ووجهها المدور كرغيف أمي الشمسي الطازج. وعِندها الطفولي الغبي، وكبريائها كأنثى تعرف قيمتها تماماً.
كانت "مريم" لا تحب اللعب مع الأولاد وأنا منهم، لكني الولد الوحيد الذي كان يحرقه هذا الرفض.
البرشا- شتاء 85
تجرأت مريم أخيراً وكلمتني، فقط من أجل رائحة ساندوتش "المرتديلا" الذي أقضم منه بفم فخور بما يفعل، وكلي اعتزاز أمام أقراني الذين لا يعرفون ما بداخل الرغيف الذي بيدي، فقط يرون حواف قطعة لحم رقيقة، حمراء اللون، مدورة، وشهية الرائحة.
كان ذلك منتصف ثمانينيات القرن الماضي بإحدى القرى الواقعة تحت سفح الهضبة الشرقية لمحافظة المنيا المصرية، ولم يكن أحد يومها في قريتي يعرف "المرتديلا"، كما لم يعرفوا الكثير مما يحضره أبي معه من مدينة العجائب أسيوط، بحكم تجارته والسفر لها بشكل أسبوعي عادة. لكن قبل أن نلتهم سوياً الكثير من قطع المرتديلا التي حلمنا بها معاً، سافرت مريم مع أسرتها إلى القاهرة ولم تعد أبداً، تاركة في قلبي غصة لم تنمح لأمد بعيد.
دير أبو حنس- 90
ظل أبي يحب تربية الماعز سنوات طويلة، بعد أن فقد بقرته السمينة فجأة، بعد ما غفلتنا وابتلعت إبرة من المعدن عن طريق الخطأ، فمزقت أحشائها، ماتت في ليلة شتوية ضبابية، رأيت أمي فيها تبكي كما لم أرها هكذا منذ موت "خالي/شقيقها" الشاب. أذكر بقرتنا الصفراء الضخمة هذه، لكني أحببت "السخلان/صغار الماعز" أكثر، لقدرتي على اللعب معها وحملها، ولحب السخلان للعب كطفل غجري طوال الوقت، لكني كنت أتحاشى "الجديان" منها، بعد أن تكبر، ويخصيها أبي ويسمنها لتذبح كنذر سنوي في عيد الشهيد مار جرجس.
كل القصص المتعلقة بالخنازير في الإنجيل لا تجعلنا نتعاطف معها، ولكن لي قصة أخرى معاكسة مع مريم ونحن نأكل المرتديلا... مجاز في رصيف22
في تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، يكون الاحتفال السنوي بمولد "أمير الشهداء" مار جرجس، بالنسبة لأهالي قريتي البرشا وكل القرى المجاورة، بالتواجد في المولد المنصوب باسم الشهيد في صحراء "أنصنا" بقرية "دير أبو حنس"، وذبح الأضحية من "الجديان" على صخرة شهيرة هناك، يظن البسطاء أنها الصخرة التي قطعت فوقها رأس أمير الشهداء، ويطلقون عليها "حجر مار جرجس".
كنت أخاف من زيارة دير أبو حنس في طفولتي، وأفضل الاحتفال في كنيسته بمدينة ملوي، التي كانت تقيم احتفالاً سنوياً بمنطقة "الملكية البحرية"، وتسهر مدينة الباشوات لمدة خمسة عشر يوماً متتالية، تتلألأ شوارعها بعناقيد اللمبات الملونة وورق السلوفان الزاهي، وأيقونات الشهيد يمتطي حصانه الأبيض. قبل أن يتم إلغاء الاحتفالات في طفولتي، خوفاً من العمليات الإرهابية للجماعة الإسلامية التي استهدفت المسيحيين وكنائسهم ومحلاتهم التجارية في مدينة ملوي، طوال سنوات التسعينيات.
نبع خوفي وعدم حبي لمولد قرية دير أبو حنس بسبب انتشار "الحلاليف" في كل شوارعها، فقد كانت القرية تشتهر بتربية الخنازير طوال عمرها، وكان ينافسها في هذه العادة الغريبة على باقي القرى، قرية أخرى تقع على الضفة المقابلة لدير أبو حنس على نيل ملوي، وهي قرية "البياضية"، القرية التي ولدت فيها الفنانة المصرية الراحلة سناء جميل. لا أعرف لماذا أو متى بدأت تربية الخنازير في هاتين القريتين تحديداً، ولماذا لم تنتقل العادة إلى قرى مجاورة، سكانها من المسيحيين أيضاً، مثل "دير الملاك" أو "دير البرشا" وغيرها. لكني أعرف متى اختفى هذا المشهد.
لا أعرف متى تصالحت مع "الخنازير"، هل بعد المذبحة التي تعرضت لها في مصر، أم قبلها بكثير، أم عندما تصالحت مع أشياء كثيرة كنت أرفضها لأي سبب؟
من فوق سيارة نصف نقل تحملني بصحبة أسرتي ومعنا "الجدي" الذي سنضحى به، أتأمل وأراقب الطريق في الصحراء الممتدة أمامي وعلى جانبيها من ناحية الشرق الهضبة، أو كما نطلق عليه "الجبل"، ومن جهة الغرب شريط زراعي يحاذي النهر. طوال نصف ساعة تقطع السيارة طريقاً رملياً طويلاً من الجنوب إلى الشمال، ممهداً منذ آلاف السنين لربط القرى ببعضها، الواقعة بطول شريط الهضبة.
نمر أولاً بقرية "نزلة البرشا"، قرية صغيرة أغلب سكانها من عرب الصحراء، ومن ثم ندخل قرية "دير البرشا"، التي كان يعيش فيها القديس الراهب الأنبا بيشوي، حبيب المسيح، وبعد عدة كيلو مترات تلوح من بعيد قرية دير أبو حنس.
تظهر أولاً أكوام القمامة ومن فوقها تنتشر الخنازير، تأكل منها بنهم وتتدافع بوحشية، من حولها صغارها، كان مشهداً غريباً على كل من هم من خارج القرية، وبالنسبة لي كان مشهداً يثير رعبي واشمئزازي. لاسيما مع انتشار القصص حول وحشية هذه الحيوانات التي من الممكن أن تلتهم الأطفال. وما ساهم أكثر في تخزين تلك الصورة بمخيلتي، هي رؤيتي لطفل قضم خنزير أصابعه، جاءت به أمه لعيادة طبيب كنت أنتظر دوري للكشف فيها أيضاً.
ومن يومها يصيبني الرعب من شكل وذكر "الحلوف"، كل ذلك خلاف ما ارتبط به كحيوان "نجس"، يأكل الفضلات والقمامة ويحلو له النوم في برك القاذورات، ويحتوي جسده على "الدودة الشريطية" الشريرة.
كانت أمي تغضب من خالي لأنه يحب أكل لحم "الحلوف" ويفتخر بذلك، رغم عدم تحريم أكله بالنسبة لمعتقدات أمي المسيحية الأرثوذكس، لكن يبدو أن كل القصص المتعلقة بالخنازير في الإنجيل لا تجعلنا نتعاطف معها، فذات مرة، أمر المسيح الشياطين الساكنة في جسد إنسان، أن تخرج منه وتدخل إلى قطيع خنازير يرعى، فجن جنون الحيوانات وهوت من فوق جرف عال.
من المؤكد أيضاً أن ثقافة أمي تأثرت بجاراتها المسلمات، وتخشى شماتتهن فيها بأكل أولادها للحم الحلوف، تصرخ أمي "يا دي الجُرسة".
بينما كان "خالي" يحب أن ينظف لحمه السمين بنفسه وينقعه في الخل والليمون ليوم كامل، ويقوم بشيّه جيداً على الفحم في الحقل بالليل، صحبة أصدقائه في الصيف، أو مطهواً كطاجن بالأرز والطماطم والليمون والزعتر والثوم.
كانت أمي ترى في ذلك فضيحة، فـ"لا يأكل لحم الحلوف سوى البني آدم الحلوف"، هكذا كانت تقول أمي، وذات مرة كادت أن تطرد أخي عندما كان مراهقاً، بعد أن عاد من بيت خالي وأخبرنا أنه جرب طعم لحم الحلوف وأعجبه، وعندما سخرت منه، صدمني بمعلومة كنت أجهلها حتى ذلك الوقت، عندما قال لي: "ما المرتديلا اللي أنت بتاكلها دي معمولة من لحم الحلوف"، لم أصدق أخي يومها، لأنني ظللت أعشق المرتديلا، وأرفض أي شائعات تخوض في سمعتها.
البرشا-القاهرة (شتاء2006)
"لم تعد مقالب الزبالة مُطوَّحة خارج المدن، فى الهوامش، بل صارت مقالب الزبالة داخل المدن، فى المتن. أما الخنازير، فأرى الكثير منها يجلس على كثير من المقاعد، وفى يد كل منهم عصا، والناس فى زحامهم الخانق يجرون أمامهم فى حلقات دوارة عجيبة، كل منهم يجري لمجرد أنه يظن أن من يجري أمامه يفر من خطر داهم، فيقدِّمون على هذا النحو أنفسهم لضربات العصي، مهرولين فى طأطأة عمشاء.
تحول بيع المرتديلا في القاهرة (وهي المعدة من لحم الخنزير) إلى أمر سري، وتباع بكود، ويُطلق عليها "رمسيس"، هكذا فعل التجار للحفاظ على زبائنهم المسلمين... مجاز في رصيف22
كنت وصلت لهذا الجزء من قصة للكاتب المصري "محمد المخزنجي" بعنوان "خنازير قديمة.. وأخرى جديدة"، في صحيفة محلية أتصفحها، وأنا جالس في "سهراية" صباح شتوي في إجازة العيد، أمام بيتنا في الصعيد، عندما سمعت صوت أختي الكبرى من خلف الجريدة، تقول: "دي أم شنودة دي؟".
أشارت أختي على صورة، وأكملت بعدما بدا على وجهي أني بلا ذاكرة الآن: "أم شنودة دي تبقى مريم اللي كنت بتلعب معاها وأنت صغير". الآن تذكرت كل شيء، قبل حتى أن أقلب الجريدة وأتمحّص بالصورة بارتباك طفيف لم تلحظه إلا حواف الجريدة.
امرأة شابة تحمل رضيعها على كتفها، منكوشة الشعر، تتشاجر مع أحد موظفي الحكومة المصرية، التابع لحملة الطب البيطري لإعدام الخنازير في منطقة "منشية ناصر" التي يقطنها جامعو القمامة في القاهرة الكبرى، ويطلقون عليه بمنتهى الحقارة الإنسانية، "حي الزبالين".
الصورة انتشرت في الصحف المصرية، في عام 2006، عندما اتخذت الحكومة المصرية ظهور فيروس "إنفلونزا الخنازير" عالمياً ذريعة للتخلص من "الخنازير" في مصر، حتى قبل وصول الفيروس إلى البلاد. بعدها اعترفت الحكومة بخطأ قرارها، الذي اعتبره البعض قراراً يحمل طابعاً طائفياً وكراهية للخنازير، لأسباب دينية، لاسيما أن مربي الخنازير في مصر من المسيحيين.
من المؤكد أيضاً أن ثقافة أمي تأثرت بجاراتها المسلمات، وتخشى شماتتهن فيها بأكل أولادها للحم الحلوف، تصرخ أمي "يا دي الجُرسة"... مجاز في رصيف22
وكانت تقدر الثروة الحيوانية وقتها من الخنازير حوالي نصف مليون رأس، أغلبها بحي "منشية ناصر"، وكانت تتغذى على الفضلات العضوية من القمامة التي يجمعها سكان الحي من القاهرة الكبرى، ومن ثم فرزها والتخلص منها. وتسببت "مذبحة الخنازير" في تراكم أقوام القمامة في شوارع القاهرة.
ملوي 2020
لا أعرف متى تصالحت مع "الخنازير"، هل بعد المذبحة التي تعرضت لها في مصر، أم قبلها بكثير، أم عندما تصالحت مع أشياء كثيرة كنت أرفضها لأي سبب؟ وقد كافأ "الخنزير" الإنسان مؤخراً، بعد أن أكل ملايين الخنازير البريئة الصغيرة، وأعدم غيرها بالآلاف، بأن منح الخنزير أعضاءه للإنسان ليعيش بها، بعد نجاح أول عملية لزراعة كبد خنزير لإنسان.
"ما عدش فيه حد بيبيع يا أبو عمته دلوقت خلاص"، قال لي ابن خالي، الذي يعمل سائقاً في مدينة ملوي، وبخبرة العارف ببواطن الأمور، ككل سائقي العالم، أردف بغمزة عين: "بس أنا أعرف أجيبلك"، ظننت أني طلبت منه ممنوعات، بسبب ملامحه التي تبدلت لثعلب سمين في طرفة عين. وكل ما ابتغيه أنا "بقال يبيع مرتديلا في المدينة".
لم تعد المرتديلا تباع في محال البقالة والسوبر ماركت في مصر كما كان الأمر عادياً حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي. في القاهرة، كنت أذهب إلى حي شبرا للحصول عليها من محل شهير هناك يحمل اسم "مرقص"، ويعرض كل منتجاته من لحوم الخنزير. لكني لم أظن أبداً أن المرتديلا اختفت من ملوي ذات الأغلبية المسيحية، وأغلب محالها التجارية مملوكة لأقباط، حتى مع المد السلفي للمدينة وقراها، وشهرتها بأعمال العنف ذات الأبعاد الطائفية.
ما أخبرني به قريبي السائق كشف لي السر، فقد تحول بيع المرتديلا إلى أمر سري، وتباع بكود، ويطلق عليها اسم مستعار هو "رمسيس"، وهذا الابتكار تفتق عنه ذهن التجار في الغالب، حتى لا يخسروا زبائنهم من المسلمين، وفي نفس الوقت يوفر سلع زبونه المسيحي.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


