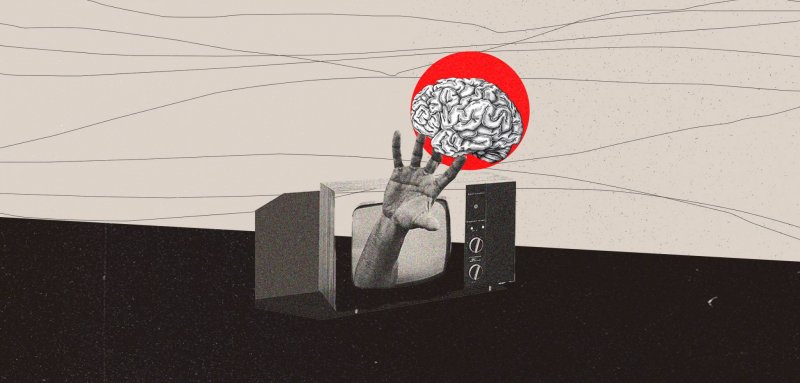نستطيع جمع المعلومات من حسابات أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، بمجرد متابعته قليلاً لاكتشاف عادات حياته اليومية. كانت الدول في السابق تعتمد على أجهزتها الأمنية لاكتشاف المعلومات السرية التي يحتفظ بها المواطنون، والآن أصبحنا نقدمها طواعية، تحت غطاء الود والرغبة والقوة الناعمة في مواقع التواصل، كما أن كارثة طبيعية أو بشرية قد تحصل في الولايات المتحدة وأوروبا يتم تداولها بسرعة البرق في محطات التلفزة العربية كأنها حصلت في أحد أحياء دمشق، بيروت أو القاهرة.
المعرفة السائلة
لقد ابتكرت "الحداثة السائلة" كما يسميها زيجمان بومان، طرقاً جديدة لحرماننا من الحرية باتخاذ القرارات بطريقة لم يحلم بها أعتى الأنظمة الشمولية. وأصبح مجرد التشكيك في سيلان هذه المعلومات وتداخلها أمر معقد بشكل خاص ويثير الكثير من التكهنات بنمو نظريات المؤامرة والجماعات الكبرى التي "تتحكّم" بالعالم.
يقدم بومان تشخيصاً للتآكل الذي تدعمه باستمرار "العولمة" السلبية، خصوصاً ما يتعلّق بالطريقة التي تتطور بها العلاقات بين الذات والآخر، بتأثر الذات هذه بحركيات "التميّع"، بحيث يبدو العالم اليوم، كشبكة أنابيب ضخمة، تنتقل عبرها "التفاهة"، حسب تعبير آلان دونو، من مكان لآخر بسرعة، متجنبة في هذه الأثناء، المناطق الفقيرة، مخيمات اللاجئين والبلدان التي تجري فيها حروب أهلية.
يقدم بومان تشخيصاً للتآكل الذي تدعمه باستمرار "العولمة" السلبية، خصوصاً ما يتعلّق بالطريقة التي تتطور بها العلاقات بين الذات والآخر، بتأثّر الذات هذه بحركيات "التميّع"، بحيث يبدو العالم اليوم، كشبكة أنابيب ضخمة، تنتقل عبرها "التفاهة"
المناطق المفرّغة من "المعنى السائل"، هي الدول التي لا تساهم بإنتاجه (بلداننا العربية، والأخرى "العالمثالثية" كما اصطلح على التعريف في السابق) تصبح بهذا المعنى بلداناً غير قابلة للثبات أو الاستقرار تحت مسمّى ما، فهم ليسوا بدواً وليسوا مستقرّين، هم في حالة غير مستقرة خارج "الحاويات" التي يتنقّل فيها الاقتصاد والإنتاج و"المعنى" المصاحب للعولمة.
رغم أننا نظن أننا منخرطون في "الترندات" العالمية، واهتماماتنا تتعدى حيّزنا الجغرافي، إلا أن شبكة أنابيبنا لا تتقاطع مع شبكة أنابيب العالم، فيكون إنتاجنا لـ"التفاهة" غير ذي جدوى ومحكوم بـ"المحلّية"، نستهلك ما ننتج من "تفاهة" دون إمكانية "تصديرها" أو مشاركتها مع العالم، المنتج الحقيقي للمعرفة المائعة ذات الثمن.
في المجتمعات السائلة هذه، الحديثة والمتحكّم بها، يصبح الناس عبيداً بشكل طوعي، وهذا لا يعني أن المجتمعات الأخرى، خارج التصنيف تمتلك حريتها، طالما هي خارج منظومة السيلان المعرفي للتفاهة، لكنها قوى إنتاج هامشية، تحلم بالانضمام للشبكة العالمية لكنها لا تجد سبيلاً لذلك، تقدّم كل ما هو مطلوب منها ورغم ذلك لا تجد "سوقاً" عالمياً يقبل "تفاهتها" المبتكرة، لا لعلّة في إنتاجها، فهي منتجة جيدة ورخيصة الثمن وتقبل تقديم "تفاهتها" مجاناً، لكنها لا تمتلك "المقاييس المعيارية للتفاهة".
هي تنتجها في حيّز خلفي، كحديقة خلفية أو معمل صغير في قبو، لا تصلح للاستهلاك العالمي، لأنها لا تجد منفذاً إليه، وبالتالي، تصبح "تفاهتنا" الخاصة، أدبنا، فلسفتنا، شعرنا، روايتنا، رسومنا، مسلسلاتنا، قصص حبنا، خيباتنا وانتحارنا، بلا قيمة سوقية، لأنها تتحرك خارج المنظومة العالمية للمعرفة السائلة.
حرية بنطلون الجينز
لم يعد علماء الاجتماع يستخدمون كلمة "فقير" لوصف شخص ما أو فئة ما، أصبحت التسمية "طبقة عاملة"، لأن التسمية الجديدة تخفي البعد المالي للطبقات، وراج الآن مصطلح أكثر تعميماً، تحت غطاء احترام خصوصية الأفراد وعدم إرهاق حساباتهم البنكية، فأصبح الجميع "مستهلكين"، وأصبح الاستهلاك أهم "هوية" يمكن تعريف الناس بها، وإذا كفّ الناس عن الاستهلاك لا يعودون لتموضعهم السابق، إذ اختفت الحركات الماركسية الآن، بل يصبحون خارج "السوق"، خارج الأنابيب التي تتبادل السلع والخدمات والتجارة السائلة.
المناطق المفرّغة من "المعنى السائل"، هي الدول التي لا تساهم بإنتاجه، تصبح بهذا المعنى بلداناً غير قابلة للثبات، هم في حالة غير مستقرة خارج "الحاويات" التي يتنقّل فيها الاقتصاد والإنتاج و"المعنى" المصاحب للعولمة
تبدو الحرية (النسبية طبعاً) التي نشأت مع الازدهار الاقتصادي من الخمسينيات إلى السبعينيات في أوروبا، ومن التسعينيات حتى الوقت الحالي في البلدان العربية السابقة، حرية الانضمام إلى "الاستهلاك المنفلت من عقاله"، لم يعد الفقراء مجموعة منفصلة اجتماعياً وثقافياً، تمّ ترتيبهم في "المولات" وحشر مؤخراتهم في سراويل الجينز الضيقة، لم يعد الإنتاج ما يحدد طبيعة العلاقات في المجتمع وطبيعة القوى وتوازنها حسب المفهوم الماركسي، بل أنماط الاستهلاك.
أوهمتنا الحداثة والليبرالية الحديثة أننا نمتلك الآن من الحرية ما يكفي لتقديم أنفسنا كما نرغب، أن نعرّف أنفسنا، أن نحدّد مجال تعريفنا لأنفسنا: نحب السينما الأميركية، الفاست فود، الملابس الأوربية، والأدب الذي ينال اعتراف المؤسسات الكبرى، ونتابع نيتفليكس لـ"نرى".
يستطيع أي منا أن يرسم صورة له على مواقع التواصل ليتم من خلالها تحديد حتى عمره، نظن بهذا أننا تخلصنا من المحددات الرسمية التي كانت تتحكم بصورتنا، الحكومات والوظائف والمؤسسات ذات الأبنية العتيقة، البيروقراطية والشمولية، لكننا وقعنا في شرك آخر: ما نعرّفه ليس نحن، إنما خيارات غير ديمقراطية نقاربها بما نظن أنه نحن، على شاكلة الأسئلة التي يقدمها تطبيق "تيندر" على سبيل المثال: أنت رجل، امرأة، غير ذلك!... لا يسمح لك بتعريف نفسك خارج الخيارات المعطاة، حتى لو كنت "غير ذلك".
المجتمعات السائلة هذه، لا تجد سبيلاً لدخول "الشبكة"، تقدّم كل ما هو مطلوب منها ورغم ذلك لا تجد "سوقاً" عالمياً يقبل "تفاهتها" المبتكرة، لا لعلّة في إنتاجها، فهي منتجة جيدة ورخيصة الثمن وتقبل تقديم "تفاهتها" مجاناً، لكنها لا تمتلك "المقاييس المعيارية للتفاهة"
حتى لو تمّ الاعتراف بحقّك أن تكون خارج التعريف الجندري الأساسي، لا خيار لك إلا ما يمليه عليك التطبيق أو الاستبيان، تقارب ما تظن أنه تعريفك ليتطابق مع ما يفضّله التطبيق، وأنت تظن أنك تنسجم بهذا مع القواعد وتعرّف نفسك كما تعرف، بينما أنت تخسر تعريفك لنفسك وتتبنى تعريف المؤسسة لك، وإذا امتلكت للحظة وعياً نوعياً بتعريفك لنفسك ستجدها خارج "الأنابيب" التي تنقل السيولة، ستجد نفسك في "مكبّ" لا يتواصل مع النظام المتحرك والذي يضج بالحركة والمعرفة.
الاشتراك في الكوارث
الفيروسات والأمراض التي عرفناها مؤخراً، مثل أنفلونزا الخنازير، جنون البقر ومؤخراً كورونا، هي أيضاً من "المعرفة السائلة" التي تنسال عبر الأنابيب التي تصل البلدان بسهولة، عدم الإصابة بها يعني أنك خارج "الخزّان"، خارج الشبكة المنتجة للمعرفة ولو كانت معرفة سامّة.
فالحكم الأخلاقي على طبيعة "المعرفة" هنا لا يستقيم، المعرفة بدون تقييم أخلاقي، بدون درجة أعمال جيدة أو جيدة جداً، هي معرفة مجردة كان يُحكم عليها بنتائجها في السابق، كمعرفة مفيدة أو غير مفيدة، أما الآن فهي معرفة لا محددة، "معرفة مميتة" ومع ذلك يتسابق الجميع لاقتنائها، الحصول عليها وإنتاجها إن أمكن.
تسابقت الدول لإعلان عدد إصاباتها بكورونا وتحديد حجم مشاركتها في "المعرفة المميتة"، لأن عدم تواجد إصابات يعني عدم وجود قنوات للتواصل مع العالم، يعني أنك معزول و"متخلّف" عن الركب، حتى لو كان الأمر مفيداً لناحية عدم وجود إصابات بين مواطنيك، وما يمكن أن يزيح من العبء على الكادر الطبي لدى الدول الفقيرة، لكن أيضاً يعني أنك "منبوذ" من الطرف الآخر، المهيمن، المنتج للأوبئة والأمراض، فلا يهمّ هنا الفائدة التي تتيحها هذه العزلة، بل ما يهمّ هو الاندماج، التقاطع مع الشبكة، إيجاد فتحة مناسبة في الأنابيب تلك، وضع وصلتك فيها، وتلقّي "التفاهة" والفيروسات، لتنتمي إلى العالم.
"صفحة الحوادث" اليومية التي تتيحها نشرات الأخبار العربية، الرسمية وشبه الرسمية لا تهدف بالدرجة الأولى لـ"حرية تداول المعلومات" ولا لإظهار التعاطف أو طلبه أو التدليل على الجهد المبذول من قبل الحكومات لدرء المخاطر وإنقاذ الأرواح، هو تشارك عبثي في منظومة عالمية كاملة من الكوارث السائلة التي تنتقل من مكان لآخر، وتشاركها من قبيل الانخراط في الصيغة العالمية لاستهلاك المعلومات، إنتاجها وتوزيعها. كأن كلاً من المؤسسات الإعلامية العربية، ومن خلفها الحكومات، قامت بعمل "subscribe" واحد في موقع وحيد، تبثّ منه كل ما من شأنه ألا يهمّ أحداً.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.