بعد رحلة شقاء طويلة بدأت في حوران، ترسّخت في لبنان، وحطّت في ليبيا، في نهاية شهر أيار/ مايو 2021، يستمر حسام (21 عاماً) في معايشة القلق والترقب منتظراً أن يساعده القدر على بلوغ الشاطئ الأوروبي.
خرج الشاب السوري الجنسية من بلدة منشئه، حوران، لاجئاً إلى لبنان، هرباً من الحرب، عام 2014، ووصل برفقة عائلته إلى شمال لبنان. وقتها كان يبلغ من العمر 14 عاماً. رغم صغر سنّه، وجد نفسه مضطراً للعمل والمشاركة في إعالة أسرته. ترك تعليمه على مضض، وتحت وطأة العوز، وانخرط في سوق العمل مقابل 15 ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي عشرة دولارات في ذلك الوقت.
مع تحسن الأوضاع جزئياً في سوريا، عاد أهله إلى حوران، عام 2020، بينما بقي هو في لبنان "خوفاً من الاختطاف أو التجنيد الإجباري الذي يمتد لمدة سنة وتسعة أشهر، مع قابلية التجديد أو التمديد اللامتناهي". سبب إضافي لبقاء فرد عامل من العائلة خارج سوريا هو تأمين قوت باقي أفرادها. "كانت تصلنا أخبار من أصدقاء وأقارب في سوريا بأن لكل فرد حصة رغيفان من الخبز يومياً"، يروي حسام لرصيف22.
بقي الشاب اليافع سنة إضافية في لبنان. ولكن في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، لم يعد بإمكانه إعالة نفسه وعائلته ولو "بدولارين يومياً". عندها فقط قرّر شدّ الرحال نحو أوروبا.
يروي الشاب كيف جمع أخواله له ثمن تذكرة سفر بالدولار الأمريكي ليتمكن من مغادرة مطار بيروت بصورة نظامية. سارت الأمور على ما يرام إلى أن وصل إلى بنغازي حيث وقع في شباك مجموعة مسلحة. يقول: "زُركنا في عربة واحدة سارت بنا لمدة 23 ساعة في الصحراء، لم نحصل خلالها حتى على الماء". هذه الرحلة العصيبة كلّفت حسام 1100 دولار. أخيراً، وصل مع رفاقه إلى العاصمة الليبية طرابلس التي تشكل له محطة انتظار جديدة ريثما تتاح له الفرصة لإكمال رحلته نحو إيطاليا، ثم من هناك إلى ألمانيا فإلى وجهته في المملكة المتحدة.
أتى حسام إلى لبنان قبل انتقال الحكومة اللبنانية من سياسة الأبواب المفتوحة مع السوريين إلى تبني شروط جديدة تفرض على الهاربين نيل إقامة قانونية للسماح لهم بالدخول إلى لبنان.
ورقة واحدة تحدد مستقبل أسرة
مع الدخول في طور فرض إجراء معاملات كثيرة على اللاجئين السوريين الذين تقدّر الحكومة اللبنانية عددهم بحوالي المليون ونصف المليون شخص، عام 2015، أقصي هؤلاء إلى الهامش، بكل ما تحمله الكلمة من دلالات على عدم القدرة على العيش بالحد الأدنى الإنساني واللائق.
يترك امتناع الحكومة اللبنانية عن إقرار سياسة متكاملة للتعامل مع قضية اللاجئين السوريين مئات الآلاف عرضة لشتى أنواع الانتهاكات الحقوقية.
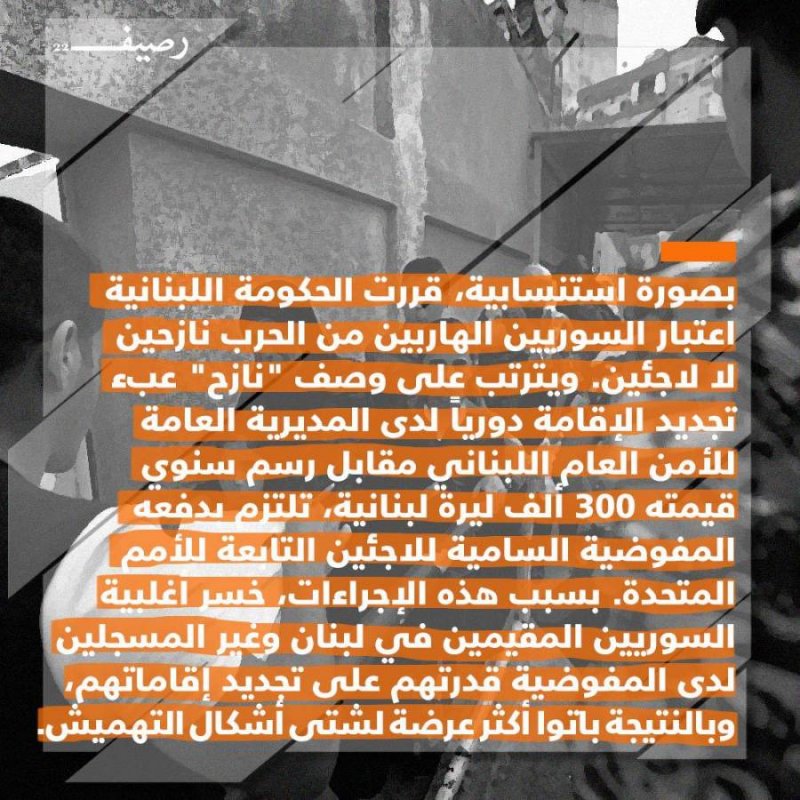
تمتُّع اللاجئين السوريين بحقوقهم الدُنيا في لبنان لا يحتاج في الكثير من الأحيان إلا إلى قرار إداري واحد وبسيط. يشهد جاسم صعبي (49 عاماً) على الفروقات التي يمكن لقرار من المديرية العامة للأمن العام أن تحدثه في حياة أسرة هاربة من الحرب.
في قصة جاسم، أتاه الفرج من بوابة الأمن العام، عندما سمح بصورة استثنائية بتجديد الإقامات السورية بواسطة إخراج القيد الإفرادي، بدون الاضطرار إلى إبراز جواز سفر لا يمتلكه كثيرون، الأمر الذي مكّنه من استخراج إقامة قانونية لابنته، لتتمكن من متابعة تحصيلها العلمي.
يروي جاسم لرصيف22 أنه عندما وصلت ابنته إلى صف الشهادة الثانوية، تبيّن أنها بحاجة إلى تجديد إقامتها لدى الأمن العام كي تتمكن من تقديم الامتحانات الرسمية. وعندما تقدّم الوالد بالأوراق اللازمة لإتمام المعاملة، تبيّن أنها بحاجة إلى جواز سفر حديث أو هوية، كونها تجاوزت الـ18 عاماً، فيما يحوز السوريون على هوياتهم منذ عمر الـ14.
قصَدَ جاسم السفارة السورية في لبنان للاستحصال على جواز سفر لابنته، فتفاجأ بأن الرسوم المحددة لهذه المعاملة هي 320 دولاراً، ولا يُقبل سدادها بأي عملة أخرى، وهو ما يعجر عن توفيره.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها العائلة هكذا مشكلة، فابنته الكبيرة "توقفت أيضاً عن الدراسة لأنها احتاجت إلى جواز سفر جديد من أجل تجديد الإقامة، ولم نفلح في ذلك".
لكن في المرة الثانية، "جاء الفَرَج من بوابة الأمن العام عندما سمح بصورة استثنائية بتجديد الإقامات السورية بواسطة إخراج القيد الإفرادي الذي يبيّن الحالة المدنية للمواطن، ويمكن الحصول عليه بواسطة معقب معاملات أو وكيل قانوني"، يروي جاسم.
مسارات مختلفة
المسار الليبي-الإيطالي الذي سلكه حسام ليس الوحيد الذي يعبره الناس تحت رحمة المهرّبين للوصول إلى أوروبا. قبله، اشتهر المسار التركي-اليوناني الذي نشط بكثافة بين عامي 2014 و2018، ومؤخراً انطلقت محاولات متفرّقة من لبنان إلى قبرص.
وصل ضياء الحمصي (اسم مستعار لعسكري سابق في الجيش السوري) إلى لبنان بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله في سوريا على خلفية رفضه تنفيذ "الأوامر العنيفة" ضد المواطنين، حسبما يروي لرصيف22.
ولكن معاناة العسكري السابق لم تنتهِ بخروجه من المعتقَل، فقد استمر بالتعرّض للتهديدات بخطفه وتسليمه للنظام السوري. وتحت وطأة هذا الخطر والقلق الدائمين، "اضطررت للانتقال من مسكن إلى آخر وتغيير هاتفي مراراً، لكنهم دائماً ما كانوا يعاودون الوصول إليّ، ولم يعد أمامي خيار غير الهرب إلى قبرص".
"يهرب أحدنا من أجل إرسال مئة دولار تسند أهله، أمه وأبيه... بكل صراحة، إذا توفّرت لي فرصة الهروب لن أتردد في الخروج رغم كل الصعاب، والوضع المادي وعدم توفر رسوم التهريب هو ما يحول دون مغادرة الناس"
جمع ضياء مبلغ 1500 دولار عبر الاستدانة من إخوته، ثم تولى نسيبه التنسيق مع مهرّب في شمال لبنان، واستقل، برفقة ابن أخيه الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، واحداً من قوارب الصيد التي تنطلق من لبنان إلى قبرص، في أيلول/ سبتمبر 2020.
انطلق القارب من شاطئ ببنين في عكار، شمال لبنان، ليشهد عليه "فيلماً تراجيدياً مدته ثمانية أيام. بدأت المأساة لحظة انقطاعنا من الماء والطعام والمحروقات في عرض البحر. بقينا على هذا الحال ثمانية أيام إلى حين إنقاذنا من قبل قوات تابعة لليونيفيل"، أي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
"عايشنا وابن أخي الموت ثلاث مرات"، يقول. يتذكر الشاب عبد اللطيف الذي رمى بنفسه في البحر بعد وفاة طفليْن على متن القارب بسبب الجوع والعطش. "رُبط الطفلان بالقارب من أجل تسكين قلوب أهاليهم، وكانت تُخرج جثتيهما عند كل صباح من أجل عرضهم على والدتيهما لتقبيلهما". بين الركاب أيضاً كان هناك شاب من الجنسية الهندية: "ما زلت أتذكر مشهد وفاته بعدما حاولنا كل ما يمكن لإنقاذه". يقطع ضياء حبل الذكريات الأليمة، ويقول: "كانت أصعب اللحظات، عندما تُضطر لرمي إنسان متوفٍّ في البحر".
اليوم وبعد مرور بضعة أشهر على نجاة ضياء وإعادته حياً إلى لبنان، عادت تراوده فكرة الهجرة، "بأي طريقة كانت، شرعية أم غير شرعية، لتغيير حياتي إلى الأفضل".
في ظل الظروف الراهنة الخانقة اقتصادياً، لم يعارض ضياء "انطلاق ابن أخيه مجدداً في رحلة غير شرعية إلى قبرص في أيار/ مايو الماضي، ما لبثت الدولة القبرصية أن أحبطتها قبل استقرار المحاولين هناك". يقول: "يهرب أحدنا من أجل إرسال مئة دولار تسند أهله، أمه وأبيه"، ويضيف: "بكل صراحة، إذا توفّرت لي فرصة الهروب لن أتردد في الخروج رغم كل الصعاب، والوضع المادي وعدم توفر رسوم التهريب هو ما يحول دون مغادرة الناس".

ليست أمام ضياء خيارات كثيرة: "أنا لا أفكر أبداً بالعودة إلى حمص بسبب انتشار الشبيحة (في إشارة إلى المسلحين الموالين للنظام السوري وعناصر الجيش) وعدم توفّر العودة الآمنة للشباب".
هناك مَن ينتظر، ليعود
89% من اللاجئين السوريين في لبنان عبّروا عن نيتهم العودة إلى سوريا في نهاية المطاف، في استطلاع أجري عام 2017. وعاد فعلياً 32272 لاجئاً بين بداية 2016، و2019.
منير الحلبي (50 عاماً)، أب لثلاثة أولاد، ويعمل في أحد مصانع منطقة الجديدة، ويتقاضى مليوناً ونصف مليون ليرة لبنانية. لم يَعُد هذا المبلغ كافياً من أجل تأمين حاجات العائلة الأساسية إثر انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي في لبنان، إذ بات يساوي نحو مئة دولار بعد أن كان يساوي ألف دولار.
منذ سنوات، تحاول العائلة الهجرة بالسبل الشرعية الآمنة، عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. محاولات لم تفضِ إلى النتيجة التي يتمنونها، لذلك بدأ منير يتطلع للعودة إلى سوريا.
تواصَل مع عائلته المقيمة في إعزاز في الشمال السوري. أخبروه أن "المنطقة أصبحت أكثر أمناً بعد دخول العامل التركي في تأمين المنطقة". لكن عودته أيضاً اصطدمت بسيطرة المهرّبين، فالانتقال من المناطق الخاضعة للنظام إلى تلك الواقعة تحت سلطة المعارضة تحصل عن طريق التهريب. يقول: "لا سبيل إلى العودة إلا باللجوء إلى مهربين، وقد طلب منّا هؤلاء دفع مبلغ 2000 دولار". لذلك لا يستطيع الذهاب وينتظر توفير عودة منظمة وآمنة للاجئين.
طبقة إضافية تعمّق الهشاشة
تشير تقرير نُشر في آخر عام 2017 إلى أن 80% من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان كانت تضم فرداً واحداً على الأقل لديه حاجة خاصة بحلول نهاية 2017.
وتشمل الحاجات الخاصة بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأطفال المعرضين للخطر، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المتقدمين في السن والمعرّضين للخطر، والعائلات المنفصلة، والأشخاص الذين لديهم حاجات حماية قانونية وجسدية محددة، والأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والحالات الطبية الخطرة، والوالد(ة) العازب(ة) والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر)، والناجين من التعذيب، والنساء المعرضات للخطر".
"لم تعد أي صعوبة قادرة على صعقنا، بعدما عشنا أياماً كثيرة في الظلمة، دون ماء، أو كهرباء، أو طعام، كنّا نتغذى من كسرات الخبز، ونبيت في الظلمة، ونتجوّل بين الجثث... لم نعرف شيئاً من حياة الطفولة، لا دراسة نظامية، ولا لعب، ولا حياة آمنة"
تعاني مروة الحميد (12 عاماً) من تشوه خلقي ونقص في نمو الدماغ والجهاز العصبي. لجأت عائلة مروة من منطقة معرّة النعمان في سوريا مع بدء الحصار على إدلب، إلى قضاء بشري في شمال لبنان.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، استعادت العائلة تجربة التهجير، بعد إجلاء كافة السوريين من بشري إثر جريمة قتل اتُّهم فيها رجل من الجنسية السورية، في واحدة من حالات العقوبات الجماعية المتعددة التي تعرض لها اللاجئون في لبنان على خلفية أحداث مختلفة. حطت العائلة منذ ذلك الحين رحالها في منطقة العيرونية الواقعة بين زغرتا وطرابلس، في مبنى في طور الإنشاء.
يعاني أغلب اللاجئين السوريين من ظروف سكن غير لائقة. وبطبيعة الحال، مساكنهم غير مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن تصنيف أماكن إقامة السوريين إلى ثلاث: مجموعة تقطن المخيمات العشوائية التي قدّرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عام 2014 عددها بـ1100 مخيم عشوائي موزّعة على الأراضي اللبنانية، ويعيش السوري فيها ظروفاً مأساوية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الصحية؛ مجموعة أخرى تقطن في مخازن ومحلات غير مهيأة أصلاً للسكن؛ فيما يقطن آخرون في شقق سكنية عادية.

محرومون من دولارات المفوضية
يشكو شحادة الحميد، والد مروة، والذي يعمل بصورة متقطعة لرصيف22 من أن "مبلغ الـ400 ألف ليرة لبنانية التي تقدّمها مفوضية اللاجئين كمساعدة شهرية لأسرتي لا تكفي لتأمين الحاجيات الأساسية للعائلة العادية، فكيف بعائلة ابنتها تعاني من ظروف صحية دقيقة؟".
العلاج التقليدي لحالة مروة لم يَعُد مفيداً بسبب حالتها. يروي والدها أنها "تحتاج إلى عملية مكلفة للغاية والعائلة غير قادرة على توفير نفقاتها". تقدّمت العائلة بطلب إلى مفوضية اللاجئين لإجراء العملية، وهي لا تزال في انتظار الرد.
أزمة الأسرة، وهي تقريباً تمثل حالة نموذجية لأسر اللاجئين السوريين في لبنان، تتفاقم في ظل تراجع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار بما يزيد عن 80%. يقول شحادة الحميد: "نشتري القليل لتأمين قوتنا اليومي، زوجتي وأبنائي الخمسة، فكيف لنا أن نهتم بعلاج مروة؟".
على الصعيد الصحي أيضاً، لم يصل اللقاح الخاص بفيروس كورونا إلى اللاجئين السوريين بنفس نسبة وصوله إلى اللبنانيين. فعندما نظمت الدولة حملة تلقيح تحت عنوان "ماراتون فايزر"، في 12 و13 حزيران/ يونيو، فقط 2.3% من إجمالي الملقحين كانوا سوريين، حسبما أفاد به وزير الصحة حمد حسن، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحد من تفشي المرض على صعيد الدولة بصورة عامة، وفي المخيمات والأماكن المكتظة بصورة خاصة.
التسرّب المدرسي... حسام ليس الوحيد
حسام أصبح اليوم في ليبيا، وقد فاتته سنوات التحصيل العلمي. تجربة الأطفال هي الدلالة الأعمق على كيف أن معاناة الحرب لا تتوقف، بل إنها تستمر بالتفاقم.
بلال قاسم (17 عاماً) واحد من الشباب السوريين الذين قادتهم الأزمة باكراً إلى ساحة المواجهة. يختصر تجربته بالقول لرصيف22: "لم تعد أي صعوبة قادرة على صعقنا، بعدما عشنا أياماً كثيرة في الظلمة، دون ماء، أو كهرباء، أو طعام، كنّا نتغذى من كسرات الخبز، ونبيت في الظلمة، ونتجوّل بين الجثث". يستعيد هذه المأساة من ذاكرته وهو طفل لم يكن يتجاوز السبع سنوات، ويضيف: "لم نعرف شيئاً من حياة الطفولة، لا دراسة نظامية، ولا لعب، ولا حياة آمنة".
بلال من أسرة كانت تقيم في حي بابا عمرو في حمص. هناك عاش السوريون أصعب أوقاتهم قبل اللجوء، وشهدوا مأساة تتلخص بثلاث كلمات: "الدمار، الجوع، والحرب". طوال شهرين، كان أزيز القذائف رفيق الصباح والمساء، فيما انقطعت الخدمات الأساسية عن الأهالي خلال الحصار. اجتمعت العائلة الكبرى في بيت واحد: "كنا نأكل وجبة واحدة في اليوم دون أن نشبع". هربت العائلة إلى لبنان عام 2012 ظناً منها أنها ستعود إلى الحياة بعد أشهر من الخوف والحرمان.
في لبنان، انضم بلال إلى مقاعد الدراسة، لكنه سرعان ما اضطر إلى ترك المدرسة والانخراط في سوق العمل في سن العشر سنوات مرغماً: "لأن برقبتي عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص، كما أن والدي تقاعد عن العمل لأن لديه جلطة سببت له الشلل"، يروي.
يجد بلال نفسه منذ نعومة أظافره بحاجة إلى المفاضلة بين الحاجات الأساسية أو الحصول على بعض الرفاهية: "في أكثر الأحيان، نتنازل عن حاجاتنا الشخصية، لأن هناك أشياء أهم من شراء كنزة أو بنطلون".
يتحدث بلال عن خوفه من العودة إلى حمص: "لي عمّان اعتُقلا عام 2012، وضاع أثرهما داخل سجون النظام". تلقت العائلة معلومات أنهما توفيا، ولكن "لم نستلم أي جثة".
شحادة الحميد أيضاً يتحسّر على مصير أولاده. يقول: "ابني توقف عن التحصيل العلمي منذ أمد، هو كان يدرس في سوريا، إلا أنه لم يلتحق بالدراسة في لبنان، وهو حالياً يبيع الخضار على بسطة من أجل إعانتنا".
أما بناته، فـ"كنّ يتعلّمن في المدرسة في بشرّي قبل طردنا مع باقي السوريين من مساكننا. بعد خسارة مقاعد الدراسة، ومع انطلاق التعليم عن بعد، أصبحت مسألة إكمال التحصيل العلمي مستحيلة للفتيات. حرمنَ من التعليم بسبب عدم توافر أجهزة الحواسيب وشبكة الإنترنت".
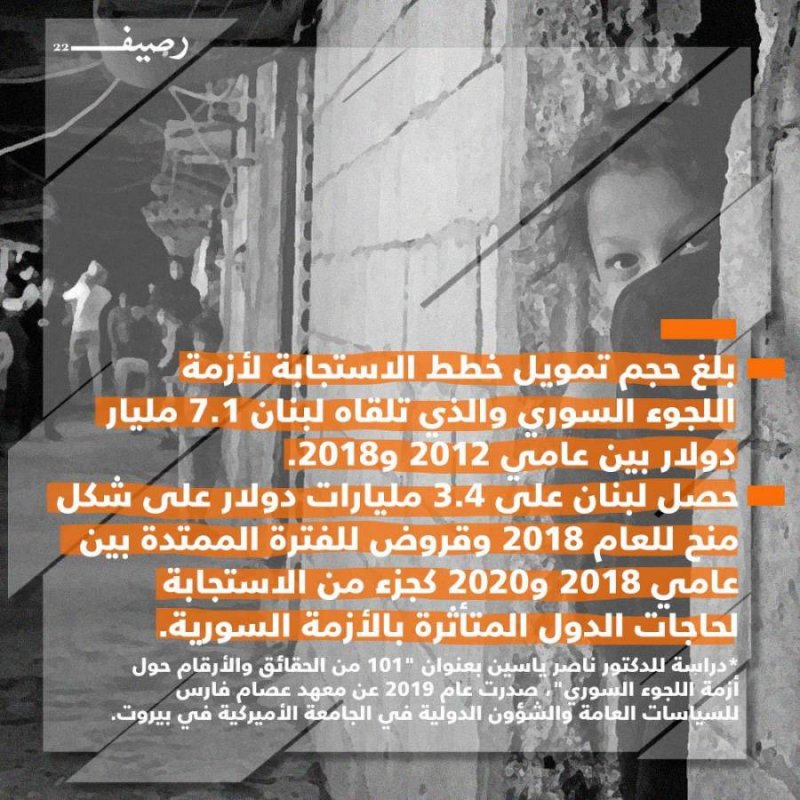
تشير أرقام اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في كل من لبنان والأردن والعراق ومصر، إلى أن 51% منهم هم من الأطفال دون الـ18 سنة. وبحسب أرقام المفوضية لعام 2018، كان عدد الأطفال السوريين في سن الدراسة 490 ألفاً، 220 ألفاً منهم فقط، أي أقل من النصف، يحضرون الدروس.
بعد تفشي كورونا وما ارتبط به من إغلاقات وقيود، أسهم التعليم عن بعد في زيادة تهميش الأطفال السوريين في المجال التربوي. أضيفت عوائق جديدة تمنعهم من إكمال دراستهم إلى العوائق المادية الموجودة أساساً وإلى وقوف تعقيدات إدارية أمام حقّهم بالتقدّم للامتحانات الرسمية ونيل الشهادة الثانوية، كما في حالة ابنة جاسم صعبي.
توضح رئيسة دائرة الامتحانات في وزارة التربية أمل شعبان لرصيف22 أن الوزارة تقبل طلبات الترشيح للطلاب السوريين المقيمين بصورة غير شرعية، إلا أنها لا تمنحهم بصورة آلية إفادات. وتقول: "ترسل الوزارة قائمة بأسماء الطلاب إلى مجلس الوزراء الذي تأتي إجابته بالرفض لمَن هو مقيم غير شرعي عموماً".
ما توضحه شعبان يتطابق مع نصوص القانون تماماً، لكنه يطال فئة واسعة من الأطفال السوريين المجرّدين من القدرة على الحصول على إقامة، والذين لا تملك الحكومة لهم أي سجلات بسبب استمرارها في الامتناع عن إقرار أي آلية تنظم إقامة وعيش السوريين في لبنان إلى حين عودتهم بصورة آمنة.
هكذا، يبقى مصير هؤلاء الطلاب معلقاً على المزاج السياسي لوزير التربية، فمثلاً "الوزير السابق أكرم شهيب سبق له أن أصدر قراراً بمنح الإفادات على خلاف قرار مجلس الوزراء سابق الذكر، أما بالنسبة إلى هذا العام فإن الصورة غير واضحة ونحن بانتظار إنجاز الامتحانات المقرر إجراؤها في موعدها (12 تموز/ يوليو للشهادة المتوسطة، و26 تموز/ يوليو للشهادة الثانوية)، ليتبين بعدها مَن سيحصل على إفادات"، بحسب شعبان.
جيل مكتومي القيد
أمجد (26 عاماً) تعود قصته مع اللجوء إلى 13 آذار/ مارس 2012، عندما خرجت أسرته تحت وطأة التنكيل من ريف حلب. وقتها، كان لم يتخطَّ الـ18 من عمره، أي لم تجب الخدمة العسكرية عليه بعد، وهذا ما سهّل خروجه من سوريا.
عند وصوله إلى لبنان، اتّبع أمجد في زواجه الصيغة الرائجة في أوساط اللاجئين، أي عقد الزواج في المحكمة الشرعية السنّية في لبنان، من دون إنهاء معاملة تسجيل الزواج رسمياً. اليوم، وبعد ثماني سنوات من الزواج، أصبح أباً لخمسة أطفال.
يشير الوالد إلى أن "الأولاد غير مسجلين في سوريا، ولا يمتلكون قيوداً رسمية هناك، لأني لم أقم بتثبيت الزواج في سوريا بسبب ضعف قدراتي المالية". تبعاً له، فإن تثبيت الزواج في سوريا يتطلب توكيل محامٍ، و"الأمر مكلف".
وينص القانون اللبناني على مهلة سنة لتسجيل الولادة إدارياً، وتصبح هذه المعاملة بحاجة إلى قرار قضائي في حال مرور سنة من دون تسجيل الطفل لدى دائرة النفوس.
لا تصطدم مسألة تسجيل الأطفال بالبيروقراطية فقط، بل بقدرة اللاجئين على إتمامها لسببين أساسيين: الأول يتعلق بعدم حيازة معظم اللاجئين على إقامة شرعية بسبب التعقيدات التي تفرضها المديرية العامة للأمن العام، وثانياً بسبب الكلفة المالية لجهة تحصيل إقامة أو لجهة القدرة على تحمل كلفة المصادقات في السفارة السورية التي تطلب منهم دفع الرسوم بالدولار الأمريكي حصراً.
وتلافياً لتحمّل الدولة اللبنانية وزر وجود عدد كبير من الأطفال مكتومي القيد على أراضيها، سارعت في الثامن من شباط/ فبراير 2018 إلى إصدار قرار يسمح بتسجيل كل الأطفال المولودين في لبنان منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2011 بصورة إدارية ومن دون الحاجة إلى قرار قضائي، أي أنها أعفتهم من مهلة التسجيل، بالإضافة إلى إعفائهم من شرط حيازة الإقامة لإتمام هذه المعاملة.
ساهم هذا القرار في حماية حق الأطفال بالهوية، على الأمد البعيد. لكنه بالمقابل، لا يزال غير كافٍ لجهة تمكن الأهل من تسجيل أبنائهم في سوريا واستخراج أوراق رسمية لهم هناك، لأن عقبات كثيرة تُركت بلا حل، وتتعلق بإكمال معاملة الزواج نفسه، فهذه المعاملة لا تعفى من شرط حيازة أحد الزوجين على إقامة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





