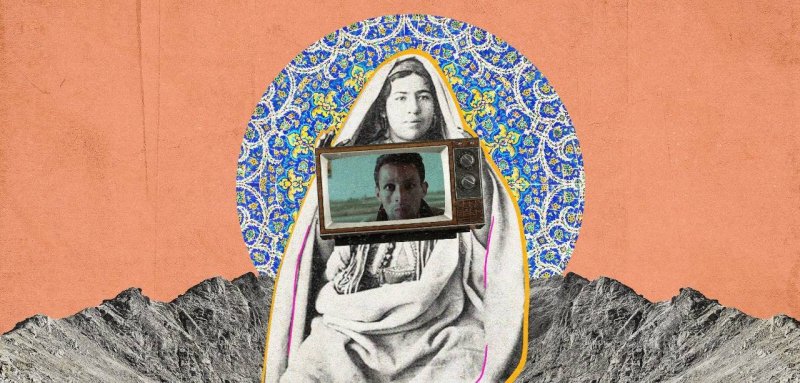على عكس الفيلم المغربي الطويل الذي يحقّق حضوراً مستمّراً ملحوظاً وتنوعاً في الأساليب والرؤى والهواجس، ينجح -بعضها على الأقل- في عبور الجغرافيا المغربية وتمثيل المغرب في مهرجانات عالمية.
ليس هناك تجارب كثيرة يمكن العودة إليها عند الحديث عن فيلموغرافيا الفيلم القصير، اليوم كما في بداية الألفية، وذلك رغم الإنتاج الكبير الذي تحرّكه عجلة الدّعم الحكومي في المجمل (مئة فيلم سنوياً).
ولعلّ الوجه الذي تقدّم به هذه الأفلام نفسها يجعلها غير قادرة على ترك أثر فني قوي خارج المغرب، سواء في المهرجانات المخصّصة للفيلم القصير أو المهرجانات متعدّدة المسابقات، إلاّ في مناسبات نادرة، وتصبح بالتالي غير قادرة على المنافسة حتى داخل المغرب، في المسابقة المفتوحة على مشاركات دولية، كما هو الحال في المهرجان المتوسطي للفيلم القصير.
صحيح أنّ جيلاً جديداً بصم على تجارب مهّمة، تحرّكها هموم فنية تعكس قلقه وهواجسه الخاصة، ينجح الكثير منها في اختيار طريقه، لكن دون أن يصل إلى نهايته لسبب تقني أو فني. لكن هذه النتيجة لا يتحمّلها صانعو الأفلام وحدهم، فهناك شبه تواطؤ على تصوّرٍ اختزاليّ للفيلم القصير باعتباره تمريناً يسبق المهمة المنشودة (الفيلم الطويل).
تُكرّس سياسية الدّعم نموذج اشتغال يؤدي في النهاية إلى نتائج متشابهة، وتزيد من حدّة الأزمة القوانين المؤطّرة لمنح رخص التصوير، أو انتقاء الأفلام للمشاركة في المهرجانات التي تُعلي من قيمة الجانب التقني المتعلق بجودة الصورة أساساً، وتتنكر لجوانب أخرى، كالتجريب ومعالجة الموضوع والمغامرة في ابتكار وسائل تعبير.
وهكذا يشتغل الجميع داخل منطقة آمنة تقنياً وغير موفّقة فنياً، هذا التصوّر المعطوب جعل من الفيلم القصير باباً لا يدخله بالضرورة من تحرّكه هواجس السينما، بل هموم أخرى كثيرة، كالحصول على لقب مخرج بعد إنجاز ثلاثة أفلام قصيرة (وهو إطار تنظيمي قانوني)، طبعاً هناك الكثير ممّن يأتون إلى الفيلم القصير بشغف فني صرف، لكنهم قلّة أمام طوابير الحالمين بلقب مخرج!
رغم نجاح بعض الأفلام المغربية الطويلة في عبور الجغرافيا وتمثيل المغرب في مهرجانات عالمية، ليس هناك تجارب كثيرة يمكن العودة إليها عند الحديث عن فيلموغرافيا الفيلم القصير، وذلك رغم الإنتاج الكبير بدعم حكومي (مئة فيلم سنوياً)
إنها أزمة في غاية التعقيد والمساهمون فيها كثر، ولن تزول إلا بزوال هذه المسبّبات. ومع كثرة الإنتاج يصبح النقد، إمّا غير قادر على المواكبة أو غير مبالٍ بمنجز ضخم يقترب في السنين الأخيرة من 100 فيلم سنوياً، تصل منها تجارب قليلة جداً إلى برّ الأمان.
نختار هنا أفلام مغربية قصيرة تنتمي إلى الربع قرن الأخير، وكلها تشكّل معالم مهمّة في فيلموغرافيا الفيلم المغربي القصير، يجمعها قاسم واحد وهو استمرار تجارب مخرجيها في حصد النجاح والعمل من داخل تصوّر فني، وتطويرهم لمشاريع بصرية تنطلق من الواقع المغربي وتتمثل خصائص الفيلم القصير. ولعل تتبع مسار هذه الأفلام يشبه مقاربة سوسيولوجية للتعبير بهذا الجنس البصري، وهو أمرٌ يساعدنا كثيراً على فهم أزمة الفيلم القصير اليوم.
فيلم: "مولود بدون زلاجتين في القدمين، 1996" لنور الدين لخماري
أدّى انفتاح المشاركة في المهرجانات الوطنية على المخرجين المغاربة المقيمين خارج المغرب عام 1995، إلى تعّرفنا على تجارب سينمائية مهمّة كانت مقصية بفعل قانون لا معنى له، منها نور الدين لخماري، الذي نجح في الانطلاق من موقعه كمغترب لمعالجة موضوع الهوية، وهو الذي عاش مدّة طويلة خارج المغرب، يجد منفذاً لهذا الموضوع الملتهب عبر التراجيكوميديا،
نتعرف من خلال الفيلم على شاب مغترب يحاول الاندماج في احتفالات النرويج بعيدها الوطني، فيصبغ شعره ويرتدي ملابس لائقة، لكن سرعان ما كانت هويته تقفز في كلّ مرّة رغماً عنه، معلنة أنّ اللباس وصبغ الشعر لا يغيران شيئاً، الفيلم استعاري بشكل ملفت، ينجح في خلق فائض في الدلالة والمعالجة أيضاً.
فيلم "الحافة، 1998" لفوزي بن سعيدي
تبقى تجربة المخرج فوزي بن سعيدي أنجح ما حقّقته السينما المغربية عبر الفيلم القصير، سواء في تمثيل المغرب في أهم المهرجانات العالمية: كان، فنيس، قرطاج... أو معالجتها الفنية الموفقة، ولعل أهمّ ما يبديه فيلم "الحافة" (حصل على 23 جائزة عالمية) هو التمثّل الصحيح لبنية الفيلم القصير كوسيلة تعبير، فهو ينطلق من فهم الموضوع والبحث عن شكل أنسب للتعبير عنه، وحسّ المغامرة الذي يبدأ بالتعبير بدون لون عن عالم بلا معنى، اقتصاد كبير في الحوار والجمع بين المتناقضات.
تجربة المخرج فوزي بن سعيدي أنجح ما حقّقته السينما المغربية عبر الفيلم القصير، سواء في تمثيل المغرب في أهم المهرجانات العالمية أو معالجتها الفنية الموفقة، ولعل أهمّ ما يبديه فيلم "الحافة" (حصل على 23 جائزة عالمية) هو التمثّل الصحيح لبنية الفيلم القصير كوسيلة تعبير
وضمن هذه الخيارات الجمالية، تأتي قصة بسيطة عن طفلين صغيرين يعيشان وسط عالم متناقض في كل شيء، لذلك يسايران هذا العبث بالبحث بكل السّبل من أجل الحصول على قوتهما اليومي، فهما يجمعان زجاجات الخمر (المدنس) و يعملان في نفس الوقت في دهن القبور باللون الأبيض (المقدس) من أجل الحصول على بضع دراهم، لا تمنعهما قساوة العالم من الحفاظ على عالمهما الطفولي.
فيلم "الحيط... الحيط، 2000" لفوزي بن سعيدي.
فيلم "الحيط… الحيط"، مبني على وحدة المكان، يجد المشاهد نفسه قبالة حائط مصبوغ بلون أبيض، تمرّ عليه شخصيات متعدّدة كما لو كان مزاراً. أمام هذا الفضاء المحدود، كاميرا ثابتة ترصدُ فترات زمنية مختلفة من اليوم. يصبح الحائط ورقة بيضاء صامتة ومفتوحة أمام الناس تراقب عنفهم اتجاهها واتجاه أنفسهم. لا تقاوم، فقط تراقب، يصبح الحائط شاهداً على فقدان المجتمع لرشده، صليباً نعلّق عليه أخطاءنا.
وفي جو مشحون باللامبالاة، تتطوّر خطايا الناس بمرور فترات اليوم (سرقة، قتل شعوذة...) وتنتقل "وظيفة" الحائط من وسيلة ستر إلى وسيلة فضح وكشف… ينجح هذا العمل في الانطلاق من فلسفة الفيلم القصير كبنية زمنية قصيرة تستدعي موضوعاً عميقاً، وتفتح أفقَ تأويل غير منته، وهو ما لا تفعله أفلام مغربية كثيرة اليوم، حيث تفكّر سردياً في قصّة طويلة أثناء إنجاز فيلم قصير.
فيلم "200 درهم، 2002" لليلى مراكشي
فيلم "200 درهم، هو الفيلم القصير الثاني لليلى مراكشي، بعد فيلمها الأوّل "الأفق المسدود". تسيطر عليه فكرة الهجرة كما في عملها الأوّل، لكن في قصّة مختلفة، ففي قرية مهمشة على الطريق السريع، يجد طفل يرعى الغنم، اسمه علي، مئتي درهم.
يفرح بها لدرجة كبيرة، لكن هذا الحدث الصغير سيقلب حياته، ويحاصره الجميع، إمّا للبحث عن مصدر هذا المبلغ أو من أجل الفوز به، ويساهم هذا الحدث البسيط في بناء صراع يبرز تناقضات المجتمع ودفع العلاقات في القرية إلى العنف من أجل الفوز بهذا المبلغ، ينجح الطفل في النهاية في الهجرة نحو المدينة، تاركاً وراءه كل شيء حاملاً معه 200 درهم.
فيلم "لا يهم إن نفقت البهائم، 2020" لصوفيا العلوي
"لا يهم إن نفقت البهائم" هو آخر نجاح حقّقه الفيلم المغربي القصير، فقد فاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم، في الدورة 36، 2020، لمهرجان ساندانس، ثمّ توالت نجاحاته، كحصوله على جائزة سيزار للدورة 46 لأفضل فيلم قصير، وضمن المشاركة في أهم المهرجانات العالمية مثل كليرمون فيران.
نتعرف في العمل على أسرة تعيش في جبال الأطلس، وهي أماكن نائية معزولة، ونتبع عبد الله الابن في سفره إلى القرية المجاورة بحثاً عن الكلأ للماشية، لكنه أثناء وصوله يكتشف أنّ الجميع هاجروا خوفاً من ظاهرة كونية نورانية غريبة.
في الفيلم حسّ مغامرة كبير جداً، أي الانفتاح على الخيال العلمي، لكن المخرجة تنجح في تطويع هذا النوع لفائدة قصّة بسيطة. المشكلة أنّ هذا الفيلم خرج خالي الوفاض في الدورة 21 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، أي أنه لم يتوّج محلياً. وهذا قد يُبرز لنا وجهاً آخر من وجوه الأزمة: عدم تثمين حسّ التجريب.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.