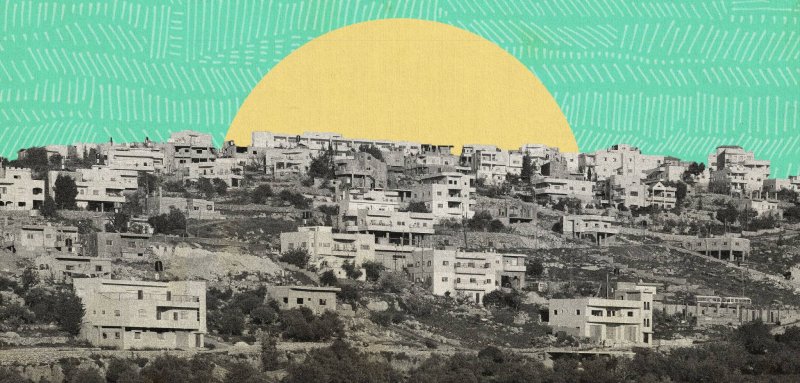الحياة مشروع مقاومة في الضفة الغربية، وفي غزة، وفي كل مكان يحتفظ ببقايا الهوية الفلسطينية التي يستميت الاحتلال في شرذمتها.
لكنَ الأمر مختلفٌ بالنسبة إلى أبناء مدينة غزة الذين يقطنون في الضفة، علماً بأن المسافة بين المنطقتين تقدَر بحوالي 40 كيلومتراً. وما يعاني منه سكان الضفة بشكل معقول، يعانيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. كأنهم يجرون معاناتهم التي يعيشونها في غزة أينما ذهبوا.
يضطر معظمهم للخروج من غزة، غالباً الرجال كون عدد كبير من النساء لا يملكن للأسف قرار خروجهن لوحدهن، وذلك إما عن طريق التسلل أو التنسيق الرسمي إن كانوا مرضى. وفي كلتا الحالتين قد تتحول العودة إلى غزة مستحيلة. فتُصبغ حيواتهم بالحنين إليها والوحدة والحاجة المادية الملحة التي تدفع جزءاً منهم إلى التسول.
35 ألف غزي في الضفة الغربية ممن غادروا بتصريحٍ طبيٍ أو دعوةٍ لندوة أو تنسيقٍ رسمي منذ عام 2006 حتى اليوم.
35 ألف غزي في الضفة الغربية ممن غادروا بتصريحٍ طبيٍ أو دعوةٍ لندوة أو تنسيقٍ رسمي منذ عام 2006 حتى اليوم. يخرجون بشكلٍ قانونيٍ من معبر بيت حانون المعروف لدى الإسرائيليين ب "إيريز". أو يتسلَلون إلى الداخل الفلسطيني للعمل والفرار إلى الضفة (لا يُمكنهم دخولها إلا من خلال المرور بالداخل الفلسطيني) منهم من ينجو ومنهم من تلتقطه العيون الإسرائيلية فترحله أو تُطلق عليه النار على اعتبار أنَه (من السكان غير الشرعيين)، أو تترك كلابها البوليسية تنهش جسده فيذهبون بما تبقى منه إلى أقبية السجون للتحقيق والوقوف على أسباب هذا الهرب.
يقول نيتشه: "إن البطل هو الذي يعرف كيف يموت في الوقت المناسب والمكان المناسب." يبدو أنَ أبناء غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية على معرفة ووعي كاملين بهذه العبارة، حتى أنَهم يطبقونها في حياتهم اليومية التي لا تخلو من تكرار مريع يُسقطون صعوبته على ملامحهم وعباراتهم، وطريقة حياتهم اليومية.
مقيمون بلا إقامة
لا تستطيع إسرائيل إعادة المخالفين من أبناء غزة إليها، خاصة أصحاب التصاريح الطبية، فهذا يعتمد على التنسيق الرَسمي بين الجهتين الإسرائيلية والفلسطينية. لكنَها في المقابل تحرمهم من العودة بشكلٍ طبيعي، فمن كانوا يعودون إلى غزة عن طريق حاجز قلنديا (الذي يفصل القدس عن رام الله) وقت التنسيق الأمني باتوا ينتظرون أياماً طويلة على أبواب مكاتب الارتباط المدني للحصول على تصاريح عودة، خاصةً بعد وقف التنسيق الأمني بين الطرفين مؤقتاً، قبل عودته في الثامن عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر 2020.
في عام 2013 غيَرت إسرائيل للمرة الأخيرة هويات وعناوين السكان القادمين من غزة إلى الضفة. ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم وهي تحرمهم من تصريح الإقامة الذي يتجدَد سنوياً.
يقيمون في الضفة ولكنَهم يُحسبَون على غزة. السلطة الفلسطينية تعجز عن مساعدتهم لأنَها لا تسيطر على تغيير العنوان، فسجل السكان تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي. على الرغم من أنَ الشؤون المدنية ترفع كتباً رسمية لتغيير العناوين، لكن انعدام التنسيق وعدم وجود حل سياسي يقفان عائقاً أمام حصولهم على الإقامة أو تأمين صحي وحقوق أساسية أخرى.
يضطر معظمهم للخروج من غزة، وذلك إما عن طريق التسلل أو التنسيق الرسمي إن كانوا مرضى. وفي كلتا الحالتين قد تتحول العودة إلى غزة مستحيلة. فتُصبغ حيواتهم بالحنين إليها والوحدة والحاجة المادية الملحة التي تدفع جزءاً منهم إلى التسول
ما بين الضفَتين
ليسوا شخصيات في روايات كلاسيكة من الأدب الخالد، بل مجرَد أرواح تحاول جمعَ شتاتها بالحصول على حقوقها الدنيا، لتكون سلَماً تصل به إلى حياة كريمة وإن كانت أقل من عادية. العثور على عمل هو شيءٌ في غاية الصعوبة، إذ نادراً ما يحتفظ المرء بعمله هنا.
يقول محمد (32 عاماً) لرصيف22: "أعمل في مجال الصحافة المكتوبة، قصة مجيئي إلى الضفة شائكة بعض الشيء. جئتُ هنا لأدرس الماجستير، اضطررتُ إلى العمل لتوفير قوت يومي ولإرسال ما أقدر عليه من المال لإعالة أسرتي. البداية كانت شديدة الصعوبة، عملت في أكثر من مهنة، حتى أنني عملت مرافقاً لأحد الوزراء في السابق. اعتمدت على تكوين شبكة علاقات ضخمة علَها تسندني وقت ضيقي. الناس هنا عدة أنواع، وهم لا يختلفون كثيراً عن الذين تركتهم خلفي في غزة، منهم الطيب الذي يساعدك دون مقابل، منهم من يساعدك شرط خدمته، ومنهم من يلتفت إليكَ ويراك محتاجاً، ولا يساعدك".
الذين يذهبون للدراسة يحصلون على منحٍ دراسية إذا كانت معدلاتهم عالية، أما البقية فتكاليف دراستهم وعلاجهم تقع على عاتقهم الشخصي.
لا تزال المرأة الفلسطينية تُعاني من القيود التي وضعها المجتمع بعاداته وتقاليده، فحتى الحاجة المُلحة إلى توفير القوت لا تعتبر عذراً كافياً للخروج من غزة.
ويضيف محمد: "الصحافة المكتوبة مهنة جيدة، تسدد لي حوائجي، وإن كانت لا تكفيني. أكتب في أماكن كثيرة، وفي عدة مواقع، صحفي حر، شيء من هذا القبيل. في أزمة الرواتب كنتُ أحصل على 500 شيقل (حوالي 150 دولار) لشهر كامل. وفي الحالة الطبيعية يصل 2000 شيقل (حوالي 600 دولار) أرسل نصفه وأكثر إلى عائلتي في غزة، وأكتفي بما تبقى لشراء الطعام والمواصلات وإيجار الشقة، قميصي هذا اشتريته قبل سنتين، أرتديه في المناسبات الرسمية وغير الرسمية. أستبدل الكنزة أحياناً، لديَ هذه السوداء وواحدة زرقاء وأخرى رمادية".
لا يهتم محمد بالطريقة التي تبدو عليها ملابسه، فتوفير المال له ولعائلته هو غايته الأسمى، واختلاف الأولويات بينه وبين كثيرين ممَن يعيشون في الرقعة الجغرافية ذاتها أمر مثير للعجب.
فيما يقول عبد الرحمن (24 عاماً) لرصيف22: "أعمل نادلاً في مطعم شعبي قريب من هنا. لا أجني الكثير من هذا العمل، لكنَه يكفيني. ليست لديَ التزامات كبيرة، أدفع إيجاراً لسكني وطعامي وعلب سجائري. لا أخرج من هذه المدينة وسكني قريبٌ من مكان عملي. أعود إليه مشياً على الأقدام. أذهب إلى المدينة لشراء الطعام، أو حين يتصل بي أصدقائي. كنت أُعيل أمي في ما مضي، وجئت إلى الضفة بعد أن ماتت. لديَ شقيقٌ واحدٌ متزوجٌ هناك في غزة". فرص العمل في غزة تكاد تكون معدومة، أما هنا، فالأمل موجودٌ رغمَ المعيقات التي لا تنتهي.
ملاذ من لا ملاذ لهم
السَكن الجامعي هو الملاذ الأوَل للطالب القادم من غزة، حتى لو لم يكن طالباً في إحدى الجامعات القريبة. يقول محمد لرصيف22: "أسكن في مدينة رام الله، وهذه المرة الثالثة التي أنتقل فيها من شقة إلى أخرى. في المرة الأولى كنتُ في منطقة أم الشرايط، وفي المرة الثانية سكنتُ في البلدة القديمة، بقيت فيها ولكنني أسكن في شارع مختلف. أحمل صندوقي معي كلما انتقلت، ملابسي قليلة، وهذه ميزتها الوحيدة؛ أنَها لا تكلفني الكثير من الوقت والمساحة حين أضطر إلى تغيير مكاني".
ويتابع: "لديَ غرفةٌ واحدةٌ تخصني، وهي الغرفة التي أنام فيها، أما الصالة والمطبخ والمرحاض والشرفة فهي أماكن مشتركة بيننا جميعاً، نحن ستة أشخاص. أدفع 250 شيقلاً (حوالي 75 دولار) تقريباً لهذا السكن، إلى جانب التزامات أخرى كالكهرباء والماء والطعام، نتبادل الأدوار لتخفيف التكاليف. في عملي يوزعون علينا أحياناً الطحين والسكر والملح، أي هذه الأساسيات البسيطة، أجلبها إلى الشقة وأتقاسمها مع الشبان الآخرين".
الاشتراكية هي المذهب الجديد الذي اكتشف محمد وآخرون جدوى الالتزام به، فهو يوفر عليهم الكثير من التكاليف، ويساعدهم على الوصول إلى شهر جديد بقرشين قادرين على شراء الشاورما أو ربطة الخبز. لم يعد محمد يضع صور عائلته في إطارات، فمن ضمن الأشياء التي يفرضها عليه الترحال الكثير هو إجلاء الصور الثابتة من مكانها على الرفوف والجدران، إلى مكان مختزل في ذاكرته، أو محفظته الممزَقة. هناك متَسعٌ صغيرٌ لصورة شخصية كتلك التي توضع في الهوية بخلفية زرقاء، فتنظر إليه بجمود ورسمية.
يقول عبد الرحمن: "أعيش مع شابين آخرين. انتقلتُ مرةً واحدةً فقط، كل من يعرفني من غزة يحسدني على هذا المكان، لأنه ذو إطلالة جميلة. نتشارك الكثير من الأشياء، نحن عائلةٌ واحدة. في المرة الأولى حين شعر أحدنا بالانزعاج وأراد مغادرة المكان، غادرنا معه. من الصعب على شخص وحيد مثلي أن يستغني عن الناس".
يتنازل عبد الرحمن عن منصبه من المساحة الداخلية مقابل أن يحظى بإطلالة جميلة يُحسد عليها. لعلَ هذه الإطلالة النقية التي تشرف على مجموعة من العمارات والطرقات والسُحب، تمثل ملاذه الذي حُرم منه في غزة.
أبطال نيتشه يموتون مئات المرات في الضفة الغربية، ولأسباب غاية في البساطة. عودة سريعة إلى الماضي، رائحةُ عطر أو طعام ما، شكل زقاق يتشابه مع الزقاق الذي اعتادوا المرور منه في غزة، ملامح النساء اللواتي يشبهن الوالدة الميتة، أو التي لا تزال تنتظر عودتهم. تشكل التفاصيل الصغيرة عالماً من الحنين بالنسبة إلى ابن غزة في الضفة الغربية.
يعترف محمد لرصيف22: "مات أبي قبل أشهر قليلة، خلال جائحة كورونا إثر إصابته في حادث سير. عشتُ شهراً كاملاً من الحزن الذي لم ينقطع ولو لثانية واحدة. العجز هو الشعور الذي لا يزال يرافقني حتى اليوم. لم أحظ برؤيته للمرة الأخيرة. كانت آخر مرة رأيته فيها قبل سبع سنوات. بشيب أقل في شعره، وبتجاعيد أقل عمقاً. أحن إلى أشياء كثيرة تركتها في غزة، منها ما يصعب البوح به".
يقترنُ الحنين بالحزن في ذاكرة محمد وغيره من أبناء غزة، في ما يشتاق عبد الرحمن إلى البحر، وإلى أصدقائه وحارته القديمة، فبيتُ العائلة بات فارغاً لا يُسمع فيه صوتٌ لأحد.
ما بين مطرقة المرض وسندان الإهمال الحكومي
السؤال الذي تقتل إجابته الحياة اليومية الباحثة عن حياة طبيعية وأساسية هو "على من تقع مسؤولية المرضى والباحثين عن لقمة العيش القادمين من غزة إلى الضفة؟" يلجأ بعض القادمين إلى التسول، بالاعتماد على التصاريح الطبية التي جاؤوا على إثرها إلى هنا. فالظروف الصعبة التي عايشوها في غزة أجبرتهم على المجيء إلى الضفة طلباً للمال والمساعدة. يغيب دور الحكومة الفلسطينية بشكل كامل عن هذا المشهد، فيما تُدَر أموال طائلة في أمور أخرى. ويتساءل البعض مستنكراً: إذا لم يجد ابن فلسطين مكاناً له داخلها، فلماذا يُلام حين يبحث لنفسه عن مكان يحفظ له كرامة نفسه ويكفيه قوته؟
يقول أحمد (50 عاماً) لرصيف22: "انعدمت السُبل أمام أهلنا الذين يأتون من غزة. المرضى منهم يذهبون إلى مستشفى المطلع في القدس، أو المستشفى الوطني أو العربي في نابلس. وآخرون يبحثون عن سُبلٌ يحصلون من خلالها لقمة العيش. لديَ صديقٌ اتصل بي قبل فترة وطلب مني مالاً أرسلته مع سيدة عجوز كان قد أعطاني اسمها وعنوانها. نسندهم ويسندونا، لكن الحياة التي نحياها ليست حياةً بالمطلق. قد يؤثر الاحتلال الإسرائيلي على طريقتنا في عيش الحياة، لكنه لا يستطيع منعنا من المقاومة. ما نريده هو أن تسندنا الحكومة، حكومتنا، فتعالج المريض وتعطي الُمحتاج. الظروف في غزة قاهرة، وهنا لا تختلف المعاناة كثيراً، لكنَها أرحم، وفرص النجاة منها أكبر".
الاغتراب حالةٌ وجوديةٌ دائمة
نتحدَث عن الطبيعة الفلسطينية التي أوجدت لنفسها فلسفةً خاصةً حتى على صعيد المسافات. وفي فلسفة المسافة يبدو أن كلَ الطرق التي ينشدها الفلسطيني ستؤدي بالضرورة إلى عذاب لا ينتهي. فمن لا ينجح في الحصول على تصريح طبي أو لا يأتي للدراسة، يفر عبر "الشيك" الحدودي، واضعاً روحه على كفه، فلا يفصل بينه وبين الموت إلا مجموعة من الأسلاك الرَمادية. فيما يفر البعض الآخر إلى دول أوروبا، فيواجه موتاً محتماً داخل البحر. كثيرون هم من ماتوا في طريقهم إلى الخارج أو ضلوا طريقهم فلم يُعرف لهم خبر.
يقول محمد لرصيف22: "لديَ أصدقاء من غزة يعيشون في تركيا، وآخرون في ألمانيا ودول أخرى. فكرت في الهجرة لكنني لم أخاطر، لدي عائلة ومسؤولية. شقيقتي تدرس في الجامعة، أخي لم يتزوج بعد، بالإضافة إلى أمي. أنا لا أفكر في نفسي كثيراً، ربما لهذا السبب أضع هذه المسؤولية نصب عيني باستمرار، تعلَمت أنَ حياتي ليست شيئاً يخصني وحدي، وقرار وضعها على المحك ليس من حقي".
ويضيف: "أتساءل طبعاً عن مصيري، هذا سؤال يمر في خاطري كل ليلة، ولا أعرف إجابته. سأُنهي دراستي طبعاً وسأحصل على شهادة الماجستير، لكن هل ستتحسن مهنتي؟ هل سأكون في مكان أفضل؟ هل سأعود إلى غزة؟ لا أعرف".
محمد يُعتبر موظَفاً في المحافظات الشمالية، ولكنه يُحسَب على غزة، متى ما عاد إليها قطعوا عنه راتبه. المجهول هو ما ينتظرونه، فالمسافة التي يقطعونها والمعارك النفسية والجسدية التي يخوضونها لن تذهب بهم إلى أماكن أفضل.
"قد يؤثر الاحتلال الإسرائيلي على طريقتنا في عيش الحياة، لكنه لا يستطيع منعنا من المقاومة. ما نريده هو أن تسندنا الحكومة، حكومتنا، فتعالج المريض وتعطي الُمحتاج. الظروف في غزة قاهرة، وهنا لا تختلف المعاناة كثيراً، لكنَها أرحم، وفرص النجاة منها أكبر"
غياب العنصر النسائي عن المشهد
التصاريح الطبية هي السبب الوحيد الذي قد يدفع فتيات غزة للمجيء إلى الضفة الغربية. حتى الجوع والأوضاع المادية السيئة لا تشكل دافعاً مقبولاً لمجيء الفتيات لوحدهن. ومن تأتي منهن للدراسة يرافقها شقيقها أو أحد أقربائها من الدرجة الأولى. العجائز هي الفئة الأكثر قابليةً للمجيء لوحدهن بمعية التَعب الذي لا يخلو من أمل طفيف.
لا تزال المرأة الفلسطينية تُعاني من القيود التي وضعها المجتمع بعاداته وتقاليده، فحتى الحاجة المُلحة إلى توفير القوت لا تعتبر عذراً كافياً للخروج من غزة. أما بالنسبة إلى من قُضي أمرهم فهم يعرفون أنَ الانتقال من ضفة إلى أخرى ليس بالشيء الصَعب أو الشجاع، لأنَه لن يكلفهم إلا حياة بأكملها.
أبطال نيتشه ينتقون أماكن موتهم بحذر، فليست قلة فرص العمل، ولا الاغتراب، ولا الحواجز ولا صعوبة العثور على شقق سكنية بأسعار معقولة هي ما يقتلهم. بل الحنين، والبحث الذي لا ينتهي عن الإنسانية والأمل.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.