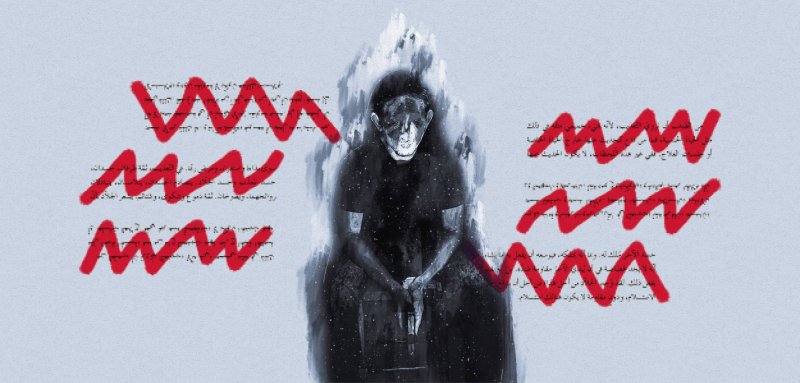إن الكتاب الحقيقي يرتبط ارتباطاً مباشراً ببياض الكفن حيث زوال العلاقة، وتعليق المعنى، والبكم المطلق للموت". عبد الفتاح كيليطو.
تمثل الجريمة واحداً من أهم العوالم التي تتغذى منها الآداب والفنون، ففي مجال الآداب مثلاً، لن تحتاج إلى قراءة الرواية البوليسية والرواية السوداء وروايات الجريمة لتتعثّر بالجثث، فيمكنك أن تعانق جثثاً كثيرة في روايات رومنسية واجتماعية وحتى وجودية، بل لن تفلت من تهاطلها عليك حتى من روايات الخيال العلمي وروايات الفنتازيا، فالجريمة في كل مكان، والدماء تتدفق من إطلاق الرصاص وسحب الخناجر وشهر السيوف والسكاكين. كان هناك دم أسود منذ الصخرة الأولى التي هشم بها قابيل رأس هابيل، عرّاب القتل.
وتبدو عملية الكتابة نفسها تعويضاً عن ارتكاب الجرائم، فالكاتب المزدحم بالفانتزم في عزلته، يعمل طوال الوقت على التخلص من الآخر الذي فيه، من الكائن الواقعي الذي حمل اسمه عندما ولد، وظل طوال الوقت هذا الكائن الجديد الذي اسمه الكاتب، يعمل على إذلاله ومحوه: نظرية يدافع عنها الكاتب كارلوس ليسكانو في كتابه "الكاتب والآخر"، فالكتابة عملية تحرر من الآخرين بمحوهم ومحو الواقع برمته واستبداله بعالم جديد وأناس آخرين.
فمن العادي جداً أن تضبط كاتباً يقلب ملفات أمنية لجرائم شهيرة بنية تحويلها إلى رواية، وقد يدفع مقابل ذلك الكثير من المال للوسطاء حتى يصل إلى تلك الملفات، فالجرائم التي تحدث حولنا تمثل مادة أساسية لكتاب رواية الجريمة في العالم. يقول الايطالي ماسيمو كارتلو: "لست مهتماً بفوز الطيبين وخسارة الأشرار، أنا مهتم بالواقع، وهذا واقعي، لم أقم ولو مرة باختراع جريمة قتل، فكل جريمة قتل في كل ما أكتبه ترتبط بجريمة قتل حقيقية، جريمة قمت بالفعل بقراءة تقرير التشريح الخاص بها ودرست وثائقها".
ولكن تلك الأصابع الطرية التي تقلب أوراق ملفات الجرائم والجنح هل هي بريئة كل البراءة؟ ألم تتلوث بهذا التاريخ الأسود للبشر؟ هل ظل الكاتب بعيداً عن الدم وهل صحيح أن الكاتب لم يقف خلف القضبان إلا من أجل الحق والدفاع عنه؟
كتّاب خارجون عن القانون
صحيح أن الكتاب في الأنظمة الديكتاتورية، كما يقول خوان غويتيسولو ساخراً، عوملوا معاملة المذنبين. لقد استفاد الكتّاب الإسبان، أو على الأقل البعض منهم، من هذا الامتياز المحمّس: كانوا يقارنون باللصوص، بالخارجين عن القوانين، برجال العصابات، بالمغاوير، بالشريرين، ويعتبرون كالغجر والمشردين، والأشخاص المسيئين، وكل المنغصات في هذه المقولة الجنائية الشاسعة وغير المحددة المسماة خطراً اجتماعياً، وكان غويتسولو نفسه يكنى بـ"وغد القلم" وأنه "كان معروفاً في مخافر الشرطة أكثر من المكتبات"، كل ذلك بسبب ما كتبه ويكتبه هؤلاء، والذي تصنفه السلطة باعتباره فعلاً إجرامياً.
فالكتابة مهدّدة تماماً، مثل الكلاب السائبة في الطريق ومثل فكرة البغاء، لأنها تثير شهوة العامة، ويجب معاقبتها بخلع سمة الهبوط عليها وحبسها في زنزانة، لأنها ممارسة تعتدي على القوانين والنواميس التي ضبطتها السلطة وتبناها المجتمع بإرادته أو مكرهاً، باعتبارها قوانين تحولت بدورها إلى نواميس أخلاقية لا يسمح بتخطيها، ويستشهد خوان غويتسولو بمن سماه بالمجرم السابق أوندري سينيافسكي الذي يقول: "اذا كان الفن مثل السرقة والجريمة، فلأن له قيمة، إنه شيء واقعي، وهل الفن شيء آخر غير جريمة ضد المجتمع والحياة نفسها؟".
هذا التناول الساخر للأدب باعتباره فعلاً إجرامياً يجرّنا إلى إعادة تركيب السؤال من جديد: هل فعلاً ظل الكاتب بعيداً عن ارتكاب الجريمة، وهل ظلت الجريمة بعيدة عن الكاتب؟ ألم نعرف فعلاً مجرمين ارتكبوا الكتابة؟
عندما دعت الإذاعة الفرنسية الكاتب الفرنسي المنشق جان جينيه للحديث عن طفولته الآثمة، يقول إن رغبته كانت أن "يُسمع صوت المجرم، لا أقصد شكواه بل نشيد مجده، استنكرت الجرائد في ذلك الوقت بأن يسمح بوضع مسرح تحت تصرف لص، وبذلك لم أتمكن من التحدث والميكرفون الوطني أمامي".
هذه المواجهة الشرسة بين المجرم الذي أصبح كاتباً مشهوراً والمؤسسة الوطنية التي تمثل القانون، تعتبر مواجهة نموذجية، لأن المؤسسة، رغم يقينها أن صوت جان جينيه أقوى وأبعد من صوت إذاعتها، لم تسمح له بتلك المواجهة وذلك الشرف، فهو في نظرها سيبقى المذنب واللص والخارج عن القانون، وهي تعلم أنه إن أعطي ذلك الحق سيصبح قديساً، فالقديس وحده يمكن أن يروي جرائمه على أنها معجزات، واستفاد من ذلك بعض الزعماء السياسيين عبر التاريخ. إن ما يعترف به الزعيم أمام الميكرفون يكتسي طابعاً قدسياً وتتحول الجرائم إلى فروسية وبطولات، كذلك يفعل الشاعر الذي يعدد في قصيدته تفوقه على القانون.
يفسر جان جينيه الجريمة التي يرتكبها الصبية المجرمون قائلاً: "ما يدفعهم إلى ارتكاب الجريمة هو الشعور الحالم: يرغبون في أن تتمثل ذواتهم داخل أروع وأجسر وأخطر الحيوات". وهنا أيضاً نكون أمام شعرية الفعل الإجرامي باعتباره توقاً للوجود الحر والراقي. إن هذه الحياة الحالمة بالتحقق عبر الشر باعتباره قيمة هي التي جعلت جان جينيه اليائس من نظام الاصلاح القمعي يكتب: "ولدت في الطريق، وعشت في الطريق، وسأموت في الطريق".
الشنفرى القاتل المتسلسل
إن أشهر قاتل متسلسل في تاريخ الثقافة العربية هو ثابت بن أواس المعروف بالشَّنْفَرَى، وهو من أهم الشعراء الصعاليك ويصنف من فحول الطبقة الثانية. ولئن عرف الشنفرى بالعدّاء لسرعته، فإنه عرف كقاتل متسلسل أرعب بني سلامان، فبعد أن خلعته قبيلته، انتقم الشنفرى بقتل تسع وتسعين رجلاً منها قبل أن يقتله بنو سلامان. وكان الشنفرى قد أسس عصابة من العدائين الشعراء منهم تأبط شراً، السليك بن السلكة، عمرو بن البراق وأسيد بن جابر، وكانت هذه المجموعة تغير على القبائل. ومن ثم فإن الشنفرى لم يكن مجرد قاتل فقط بل كان رئيس عصابة دموية في الجاهلية.
وبقليل في التأمل في تأويلية القتل عنده يبدو لنا أن القتل يتحول من انتقام للشرف، استناداً للواقعة التي دفعته لقطع وعد على نفسه بقتل مائة رجل من بني سلامان، إلى تعهد بالدفاع عن الفحولة الشعرية ذاتها القائمة على الفخر، فالقتل هنا، في عرف الشعراء الصعاليك، المعادل الواقعي للشجاعة والتي تغنى بها الشنفري في قصيدته المسماة بلامية العرب.
الكتب المقدّسة كسبت جزءاً من قوتها عبر خطابها القوي الغاضب المذكِّر ببطش القائل وقوّة الواضع، فالله المبتكر هو أيضاً المذلّ المميت، المهيمن، القهّار، الجبّار، الضارّ، المتعال.
مازال في داخل كل كاتب شخص يشبه الماركيز دي ساد، يتجول في رأسه باحثاً عن نساء جميلات للإذلال والانتهاك، مازال في كل رأس كاتب وكاتبة لوتريامون يسلخ الجثث ويخنق الرضع، ومن حظ البشرية أن الكتابة والفنون كانت تصعيداً وإعلاء، كما أقر ذلك سيغموند فرويد، لنتخلص من تلك الجرائم بالرأس عبر ارتكابات فنية
القاتل المأجور
لا يكتسب الشاعر فحولته إلا بتجاوز الخطر الذي تحدده الضوابط، لذلك يصبح شعره أكثر وقعاً إذا اختلط بحياته الخطرة، فخرق النظام وإرباك الطمأنينة في الصورة الشعرية لا يكتمل إلا إذا عاضدته سيرة خطرة تعلو بالنص والذات إلى مستوى القداسة، فالكتب المقدّسة كسبت جزءاً من قوتها عبر خطابها القوي الغاضب المذكِّر ببطش القائل وقوّة الواضع، فالله المبتكر هو أيضاً المذلّ المميت، المهيمن، القهّار، الجبّار، الضارّ، المتعال.
هنا يمكننا أن نذكر "القتّال" وهو لقب عرف به العديد من الشعراء، لكن أشهرهم القتّال الكلابي، فهو شاعر وقاطع طريق من العصر الأموي اسمه عبادة بن المضرحي، عرف بلقب القتّال لكثرة ما ارتكب من قتل، كان أول ضحاياه ابن عمه الذي جاء يدافع عن أخته التي كانت على علاقة بعبادة، واسمها العالية بنت عبيد اللّه، فقتله هذا الأخير ومن يومها تحول إلى قاتل مأجور، فكان إذا سئل لماذا يفعل ذلك يقول: "والله ما أقتل أحداً ظلماً إنما يجيئني الرجل فيقول: إن فلاناً ظلمني وقد جعلت لك على قتله كذا وكذا فأقتله". وقد هرب بعد ذلك إلى الجبال حتى استأنس نمراً صار يعيش معه ويشاركه ما يصطاد فتوحش أكثر وازداد بطشه، ويروى أنه عندما قُبض عليه قتل سجانه وهرّب كل المساجين معه وسكن الشعاب حتى مات في السبعين.
قد نسأل: لماذا لم نعد نسمع عن المثقف المجرم والمبدع الخارج عن القانون في الثقافة العربية؟ ولئن بدأنا نسمع بحوادث الاغتصابات والاتهامات التي توجهها النساء لنجوم الفن، كالمغربي سعد المجرد مثلاً أو لوجوه فكرية كتلك الاتهامات التي يواجهها المفكر الاسلامي طارق رمضان.
أعتقد أنه تراجع الحديث عن الظاهرة بعد ظهور الدولة، أي مع ظهور الإسلام واستقرار الحكم، هذه الدولة كانت دولة دينية ورسولها جاء ليتمم مكارم الأخلاق، ووقع تحويل طاقة العنف إلى طاقة "إيجابية" من وجهة نظر السلطة عندما انطلقت الفتوحات، وهكذا وقعت شرعنة العنف بما فيها عنف الشعراء، حتى أن بعضهم أصبح صوت هذه الجماعية بالتحول من الفخر إلى المديح كحسان ابن ثابت، ومع الخلافة الراشدة استحوذ الساسة الطامعون في الحكم على استعمال العنف، لذلك قتل أغلب الخلفاء وارتكبت الفظائع وابتكرت أغرب أشكال التعذيب، وكان العقل الذي يضعها عقل مزدهر بالتخييل.
ولكن إجرام الكتّاب تراجع بسبب تغير مفهوم الكاتب نفسه، فبانتهاء الحماسة وتوقف الحديث عن الفحولة وتراجع غرض الفخر في دين ينبذ الفردية ويمحو كل نزوع فردي، تحول الكاتب والشاعر تحديداً إلى كائن ناعم يتقلب في المتروك له من الأغراض.
وأصبح مشكلاً رسمياً للصالونات والبلاطات، فظهر شعراء الكدية، وظهر أخيراً المتنبي، أيقونة المديح الذي يُقتل هارباً لتتغير صورة الشاعر تماماً.
في الثقافة الغربية
ارتبط الإجرام بالطبقات المهمشة وعالم الهامش، لذلك تزدهر الجريمة بأشكالها في ذلك الفضاء. فقد شهد المشهد الثقافي الأمريكي في الخمسينيات بروز جماعة "البيت جينيريشن"، ومثّلها أساساً ألن غينسبرغ، ويليام بوروز وجاك كيرواك إلى جانب تأثر الأجيال اللاحقة بهم، ككين كيسي صاحب "طيران فوق عش الوقواق"، وظهور ما عرف بجماعة الواقعية القذرة ريموند كارفر، ريتشارد فورد، جين آن فيليبس، آن بيتي..
يتميز عالم هؤلاء الكتاب بالعنف، وربما هذه "الحياة الوحشية" من إدمان وكحول وقمار هي التي قادت الروائي الأمريكي، عراب جماعة البيت وليام بوروز، إلى قتل زوجته في لعبة الرماية والقمار، ولئن كان القتل يبدو غير مقصود فإن الواقعة حدثت وغيرت حياة الكاتب الذي ترك الولايات المتحدة ليصل إلى المغرب الأقصى. فهل كان التخلص من الجسد الأنثوي باعتباره سكناً وأمراً يشد إلى الأرض والثبات، ولو في اللاوعي، سبيلاً إلى الخلاص والتحرر؟ هل قتل لاوعي وليام بوروز زوجته جوان لكي يتحرر؟ وهل كان ذلك التخلص طريقاً للإلهام؟
يقول بوروز إن حضور جوان وغيابها كان مسألة حاسمة لحكاياته السيرذاتية في تلك السنوات التي تلت الجريمة، لقد كان قتلها نقطة مفصلية في تكوينه الأدبي.
الروائي الفاشل يقتل زوجته ليمسك بالإلهام
وكثيراً ما قيل إن الرواية جريمة، لكن أن تكون هذه العبارة تخلو من كل مجاز فهو أمر يثير الرعب. فالكاتب الهولندي ريتشارد كلينهامر كان مضطراً، كما يقول، لارتكاب جريمة ليكتب رواية. ولم تكن ضحيته سوى زوجته التي قتلها بدم بارد ودون ذنب كما ورد في التحقيقات بعد ذلك، فقط ليكتب رواية تروي قصة قتل زوج لزوجته. كان ذلك سنة 1991، وبعد أن دفنها أعلم الشرطة أن زوجته اختفت، فذهب الظن أنها هربت مع رجل آخر، إلى أن باع ريتشارد البيت واكتشف السكان الجدد جثة مدفونة في الحديقة، واتصلوا بالشرطة التي قبضت على رتشارد الذي اعترف بدوره فوراً بارتكابه الجريمة ليكتب رواية، بعنوان "الأربعاء.. يوم اللحم المفروم"، رواية كانت توصيفاً دقيقاً للجريمة. حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات خففت الى سنتين قضاها رتشارد يكتب رواية أخرى عن قتله لزوجته، وقد تحقق حلمه في أن يصبح كاتباً مشهوراً، وظل إلى وفاته 2016 محل حديث الصحف والتلفزيونات، ويتحدث بكل فخر عن الجريمة التي صنعت مجده وشهرته.
هنا نحن أمام كتابة بالدم، كتابة تستلزم قرابين تذبح ودماء تسيل وأعضاء تقطع ولحم يفرم وجمجمة تدفن في حديقة. إنها شعرية الانتهاك، انتهاك الجسد الأنثوي الهش الموجود في مرمى سكين الكاتب المرتبك أمام بياض الورقة التي تحتاج أن تتلطّخ بقوة.
ريتشارد الذي كان يشتغل بالجيش ويجد في حياته العسكرية القديمة معيناً لإلهامه، أراد أن يبحث عن دافع جديد للكتابة، ولم يجد سوى تخريب ذلك الاستقرار العائلي في الحياة الزوجية، ليقبض من جديد على الإلهام الذي تركه. يذكر أنه قتل زوجته بشكل بشع وأتلف قسماً كبيراً من جسدها عبر فرم لحمها. وهذه الطريقة للقتل تحيلنا ليس فقط على الرغبة الكبيرة لهذا الكاتب في ارتكاب جريمة، بل في ارتكاب جريمة فظيعة مثيرة، ومن ناحية أخرى هو يريد أن يمحو العائق الذي يحيل دون الكتابة وهو الاستقرار الذي تمثله زوجته.
الروائي الغيور القاتل
في بولندا سنة 2007، حكم على الروائي كريستيان بالا، صاحب رواية آموك (2003)، بالسجن لمدة 25 سنة لتورطه في ارتكاب جريمة شبيهة برواية رتشارد، حيث كشفت التحقيقات أن الروائي قتل رجل أعمال بولندي كان عشيق زوجته السابقة. رواية آموك تتحدث عن جريمة قتل امرأة بعد تعذيبها لم يكن في الحقيقة إلا عشيق طليقته، وهو بذلك يصعد الجريمة لينتقم من الاثنين، العشيق في الواقع والزوجة في الرواية "سُعار القتل". هنا القتل يأخذ بعداً استعارياً تحويلياً مركباً في خيال الروائي، حيث ينفذه على العشيق أي الشخص الخارجي الذي اقتحم الحميمي، بينما يدفع بالحميمي نحو قتل تخييلي مؤكداً عشقه الكبير لطليقته، وأن تحذيره لها من ربط علاقة مع غيره منطلقها حب تملكي مرضي، يخرج بدوره عن إكراهات القوانين التي تعتبر أن العلاقة انتهت بالطلاق وانتهاء مؤسسة الزواج. فالطلاق نهاية خطر الجسد والشهوة وعودة العفة، وبعودتها تعاد اللعبة من جديد: لعبة الملاحقة، الرغبة والموت.
اهتم بهذه القصة أكثر من مخرج عالمي، وظهرت أفلام مستوحاة من هذه الحادثة، منها فيلم آموك للبولندية كاسيا أداميك، والمخرج ألكسندر أفراناس قدم فيلمه "جرائم الظلام " بطولة الممثل جيم كاري.
وغير بعيد عن هؤلاء القتلة، حكم على الروائي الصيني ليو يونغ بياو، بالإعدام بعد أن اكتشف أنه قتل عائلة من أربعة أشخاص في فندق، بعد أن أوسعهم ضرباً وتعذيباً، ثم كتب روايته "سر المذنب" 2010 المستوحاة من تلك الجريمة الفظيعة التي ارتكبها سنة 1995.
المطالبة بإعدام المرتكب هو النهاية المثلى للخارج عن النظام، لتطهير الساحة من دم الانتهاك، ومحو الجريمة بالتخلص من مرتكبها، لمحو الإحساس بالذنب الذي سيعلق بالجميع، بما في ذلك قرّاء الكاتب.
ولعل أبشع التهم تلقاها الشاعر والقائد الصربي البوسني رادوفان كرادزيتش، الذي كان مجرم حرب وحكمت عليه محكمة لاهاي الدولية بأربعين سنة سجناً، بعد أن وجهت له اتهامات بالقتل الجماعي لحوالي ثمانية آلاف مسلم في مدينة سريبرنيتسا. ووجهت له تهم أخرى سنة 2016، كارتكاب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وإبادة جماعية، واتهم سنة 2019 بجريمة إبادة جماعية.
مازال في داخل كل كاتب شخص يشبه الماركيز دي ساد، يتجول في رأسه باحثاً عن نساء جميلات للإذلال والانتهاك، مازال في كل رأس كاتب وكاتبة لوتريامون يسلخ الجثث ويخنق الرضع، ومن حظ البشرية أن الكتابة والفنون كانت تصعيداً وإعلاء، كما أقر ذلك سيغموند فرويد، لنتخلص من تلك الجرائم بالرأس عبر ارتكابات فنية، لذلك لم يكن جورج باطاي يبالغ عندما قال: "الأدب ليس بريئاً وعليه أن يعترف بذنبه".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.