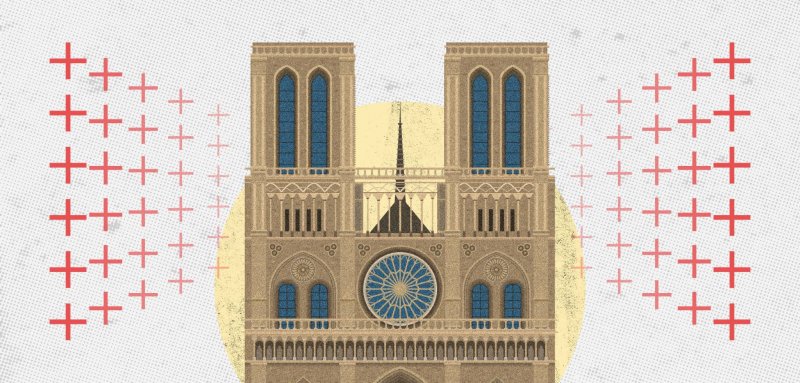السؤال الذي جعله عالم السياسة الفرنسي اوليفييه روا عنواناً لكتاب صدر له مطلع هذا العام "هل أوروبا مسيحية؟" عاد ليطلّ برأسه غداة الحريق الذي نشب في كاتدرائية نوتردام القوطيّة وسط باريس.
ليس بديهياً تحديد هوية الصرح الذي استهدفه هذا الحريق الذي استبعدت فرضية كونه عملاً متعمّداً. هل نحن أمام حريق اندلع في صرح ديني بالدرجة الأولى، وبالتالي يعني جمهور المؤمنين الملتزمين الكاثوليك قبل سواهم؟ أم نحن أمام صرح ينبغي أن ينظر له بالدرجة الأولى إذا مساهمته في صناعة الذاكرة القومية الفرنسية، وهذا يعود بدوره ليطرح مسألة الجذور المسيحية للأمة؟ أم نحن أمام صرح بات ينتمي بالدرجة الأولى إلى التراث المعماري الحضاريّ للبشرية ويفترض أن يعني جميع البشر على قدم وساق، مثلما ينبغي أن يعنيهم بالقدر نفسه الحفاظ على اهرامات الجيزة في مصر، أو على مجمع "تاج محل" في الهند؟ هذا مع لفت النظر إلى أن "تاج محل" في آغرا، الذي يشكّل ضريح ممتاز محل، زوجة السلطان المغولي شاه جهان، والمبني في منتصف القرن السابع عشر، يثير هو الآخر جدلاً حول هويته في الهند، بخاصة مع صعود القومية الدينية الهندوسية، اذ ثمة اليوم من يطالب بتحويله إلى معبد هندوسي، إما بمزعم أنّه بني على أنقاض معبد، وإمّا بشطح من قبيل أنّه كان في الأصل ذلك المعبد، وثمة في الوقت نفسه حكومة ولاية اوتر براديش التي يتولاها القوميون الدينيون والتي تتبع لها مدينة آغرا، والتي أقصت المعلم الأثري الحضاري الأبرز للهند عن نشرتها السياحية العام الماضي! في عصر "سياسات الهوية" العاصفة شرقاً وغرباً، لا يكفي القول بأن نوتردام أو تاج محل ينتميان إلى التراث الحضاري العالمي. السؤال واجب حول كيفية المواءمة بين العنصر الديني وبين العناصر الأخرى التي صنعت وتصنع تاريخ هذا الصرح أو ذاك.
ماذا يعنيه الكلام عن "الجذور المسيحية" لأوروبا؟
ثمّة بالتأكيد أنواع هزلية لإثارة الإشكالية الدينية – الحضارية المقترنة بهذه المعالم، من نوع اعتبار الحريق رسالة إلهية لعلمانيي فرنسا بأن توبوا إلى دين المسيح، أو اعتباره عقاباً إلهياً على سماح فرنسا بزواج المثليين، ولهذه الخزعبلات مكانها في أقاويل شريحة من الناس. لا يلغي ذلك أنّه منذ الثورة الفرنسية تكثّفت الصراعات الناشئة على خلفية الموقف من الثورة، حول مآل هذا الصرح. فمع الثورة، وتحديداً في ظلّ روبسبيير، سيجري صرف الكاتدرائية عن الكثلثة والمسيحية وتحويلها إلى "معبد العقل"، وبعد إطاحة روبسبيير ستتحول إلى مستودع، ولن تعود كاتدرائية إلا بعد تسع سنوات انقطاع، وبفضل نابليون الأول. لاحقاً، في فترة كومونة باريس 1871 سينقسم المنتفضون بين دعاة هدم الصرح وبين المدافعين عن الحفاظ عليه لقيمته الفنية الثقافية الإنسانية. لقد تشرّبت الكاتدرائية كل هذا التاريخ السجالي حولها. تحوّلت إلى معلم تخزيني للذاكرة الصراعية المحتدمة للأمة. وهي إذ تجسّد فكرة الجذور المسيحية للأمة يحصل ذلك على قاعدة التمييز بين هذه الجذور وبين واقع حال الإيمان والممارسة الدينية. ماذا يعني ربط الجذور الثقافية بديانة انحسرت ممارستها؟
في مقابل اضمحلال التديّن المسيحيّ تصاعدت أهمية الهوية المسيحية. لم تعد الكلمة للإيمان إنّما للهوية. لكن هل يكفي ذلك للقول بأن أوروبا اليوم لا تزال قارة مسيحية؟ هل يمكن أن تستمر الهوية الثقافية المسيحية فاعلاً مطوّلاً بعد أفول الإيمان الديني المسيحيّ؟
التشديد على "الجذور المسيحية لأوروبا" هو عنوان جامع بإزاء تحسس مضاعفات ومخاطر "اسلام المهاجرين".. صحيح انه قامت حضارات اسلامية على البر الاوروبي، كالاندلس... لكن اوروبا "ذات الجذور المسيحية" تقوم اساساً على فكرة ضمنية وهي انه، في حمأة مواجهة التهديدات الآتية من شرق الحوض المتوسط وغربه المطلة برأسها تحت رايات الاسلام، تشكلت الهوية المشتركة الاوروبية
في كتابه "هل أوروبا مسيحية؟" التي تصادفت قراءته مع هذا الحريق المشؤوم، يشدّد اوليفييه روا على دور "المسيحية اللاتينية" في بناء المشترك ليس فقط الحضاري، بل أيضاً الانثروبولوجي، بين مجتمعات أوروبا الغربية، اذ يميّزها كمسيحيية مهجوسة بالخطيئة الأصلية وبجعل مرتكب الخطيئة يقرّ بخطيئته، في مقابل "المسيحية الشرقية"، البيزنطية، المهمومة بتمجيد الرب، أكثر من اهتمامها بتظهير بؤس الإنسان. وعلى الرغم من عناية روا بعمق الإنقسام الكاثوليكي البروتستانتي في أوروبا، بدءاً من القرن السادس عشر، الى أنّه يحذّر من الوقوع في مغبّة تحويل هذا الإنقسام إلى قطيعة جوهرية يفسّر بها كل ما أتى ما بعدها، ويذهب إلى أنّ أهم ما يستقى من هذا الإنقسام هو أن الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتسانت هي التي أدّت، تاريخياً، إلى تقدّم السياسة على حساب الدين في أوروبا، تحديداً بسبب من عجز الدين عن صناعة السلام، بما اضطر الدولة إلى أن تفرض بنفسها "سلام الدين"، من خلال تنظيم محلّ الدين في المجتمع، وهو ما تمثّل بداية باتباع مبدأ الرعايا على دين ملوكهم. منذ معاهدة وستفاليا 1648 صارت الدولة دنيوية، بما أنّها هي التي تحدّد وظيفة الدين وفضاءه، وإن لم تكن بعد علمانية، بما أنّها لم تكن فصلت بين مؤسساتها وبين المؤسسات الدينية. وهكذا، أخذت الدولة تتعامل مع نفسها شيئاً فشيئاً على أنّها من يرسي المعايير الأخلاقية وتبعاتها القانونية، وشيئاً فشيئاً حلّت أحكام القانون محلّ سرّ الإعتراف، ولم تتردد الدولة في تجريم التسوّل والدعارة، ولم يكن هذا التجريم مطروحاً يوم كان الأمر للكنيسة في المجتمع. أساس التحوّل من دولة في خدمة الدين إلى دولة الدنيا التي تكلّف نفسها تحديد موقع الدين من الإعراب بالنسبة إلى المجتمع وبالنسبة لها، هو أنّ الدولة هي التي غدت تتولى تحديد الفضيلة، وأخذ مسألة الخير والشرّ على عاتقها.
علاقة العلمنة بتراجع الممارسات الدينية
البعد التاريخي الآخر الذي يبرزه اوليفييه روا هو أنّه مع الإكتشافات الجغرافية الكبرى والموجة الأولى من التوسع الإستعماري لم تعد أوروبا "تحتكر" المسيحية. بعد أن كانت المسيحية منتشرة في نطاق حوض البحر المتوسط ثم توثقت رابطتها مع أوروبا، "تعولم" هذا الدين على محك التوسع الإستعماري، ثم لعب دوراً أساسياً في بث الحركات التحررية في المستعمرات التي شهدت اعتناقه، واليوم، لئن كانت أوروبا تستمر في النظر إلى نفسها كمسيحية، فإن المسيحية لم تعد أوروبية إلا على الهامش. يعود روا فيطرح السؤال بهذا الشكل: "لم تعد أوروبا قلب المسيحية، لكن هل ما زالت المسيحية قلب أوروبا؟".
بعد أن اشتهر روا بكتبه حول العلاقة بين الديني والسياسي في الإسلام المعاصر، يكرّس هذا الكتاب الأخير للخوض في حقيقة ما بقي من "مسيحية أوروبا" بعد موجات "نزع المسيحية" عنها في الأزمنة الحديثة، وهو يفرّق بين علمنتين، واحدة مبنية على استقلالية المستوى السياسي، بما يقود الى فصل الدولة عن المؤسسات الدينية، أو إلى سيطرة السياسي على الديني. أما العلمنة الثانية، فترتبط بتراجع الممارسة الدينية نفسها، وأفول محورية الدين في الحياة الاجتماعية والثقافية، وهو ما يدخل "نزع التمسحن" من أوروبا في إطاره.
العلمنة بالمعنى الأوّل لا تفترض العلمنة بالمعنى الثاني، لكن ما حصل أنّ المسارين ترافقا في تاريخ أوروبا. هل يمكن، مع ذلك، رغم انحسار الممارسات الدينية، اعتبار أن ما جرى هو تحديث وعصرنة لقيم هي في الأساس مسيحية؟ هل "ما بعد المسيحية" هو الشكل الحديث للمسيحية؟
اضمحلال التدين المسيحي
عندما بدأ مسار التحكم الدولتي – الدنيوي بالدين كانت أوروبا لا تزال مسيحية مؤمنة. بدأت بعدها مسارات "اضمحلال التمسحن"، إما بتراجع متواصل، وهذه هي الحالة الفرنسية منذ ما قبل الثورة، وإما بهبوط سريع متأخر، وهذه هي الحالة الإيرلندية. في حالة فرنسا، وكذلك الكيبيك، حصل الإنحسار النهائي للتديّن في منتصف الستينيات، وهذا يعني أن هناك جيلاً كان لا يزال يمارس دينياً وتوقف عن ذلك. أما في ايرلندا، فثمة جيل ممارس دينياً تبعه الجيل الحالي غير المتديّن. عام 1983 يوم كانت الحظوة للتديّن، صوّت 63 بالمئة من الإيرلنديين لمنع الإجهاض. أما عام 2015 فصوّت 62.07 بالمئة من الجيل الحالي للزواج المثلي، وصوّتت أكثرية 68 بالمئة لتشريع الإجهاض.
وحتى في بلدان ينظر لها كملتزمة دينياً كبولونيا، يلاحظ اوليفييه روا أنه اذا كان عدد الكهنة ازداد فيها بعد سقوط الشيوعية، فإن عدد المواظبين على حضور القداديس انخفض من 57 بالمئة عام 1982، أي في فترة الحكم الشيوعي (وهي نسبة عالية مرتبطة بظاهرة البابا البولوني يوحنا بولس الثاني)، إلى 36 بالمئة عام 2016. يجازف روا بالقول بأنّه لا عودة إلى الوراء في موضوع اضمحلال التديّن المسيحي في المجتمعات الأوروبية. هل هذا بسبب اصلاحات مجمع الفاتيكان الثاني؟ بالأحرى العكس. هذه الاصلاحات انطلقت من تحسّس ظاهرة العزوف عن الإيمان والممارسة السابقة عليها، سواء أفلحت في الحدّ من مساحة هذا العزوف أو لا. أيّاً يكن من شيء، عدد الممارسين المسيحيين بشكل منتظم في أوروبا الغربية اليوم أقل من نسبة العشرة بالمئة.
من "الايمان" الى "الهوية"
في مقابل اضمحلال التديّن المسيحيّ تصاعدت أهمية الهوية المسيحية. لم تعد الكلمة للإيمان إنّما للهوية. لكن هل يكفي ذلك للقول بأن أوروبا اليوم لا تزال قارة مسيحية؟ هل يمكن أن تستمر الهوية الثقافية المسيحية فاعلاً مطوّلاً بعد أفول الإيمان الديني المسيحيّ؟ ما يبني عليه اوليفييه روا أن فكرة فرضت نفسها حتى منتصف القرن العشرين، وهي فكرة أن الثقافة المهيمنة على أوروبا هي "مسيحية معلمنة"، لأنّ وحدة في "النظرة الأنثروبولوجية" إلى العائلة ظلت مشتركة بشكل أو بآخر بين الكنيسة وبين المتحمّسين للعلمانية. من الثورة الفرنسية حتى منتصف القرن الماضي، دار الصراع بين الدينيين واللادينيين في أوروبا حول السلطة وحول الأساس الذي تبنى عليه القيم، أي حول الحقيقة. كانت الانعطافة في الستينيات. فمن جهة، جاء مجمع الفاتيكان الثاني 1965، بمثابة اعلان انسحاب للكنيسة من الصراع على السلطة وعلى الحقيقة، أو بمعنى آخر التزامها العلمنة الذاتية في علاقتها بمسألتي السلطة والحقيقة. لكن ما يجري، في الغالب اغفاله، أنه، بعد ثلاثة أعوام من هذا المجمع الإصلاحي الكبير، دشن البابا بولس السادس الصراع الجديد، من خلال رسالته "عن الحياة البشرية"، الرسالة التي تحظر كل ممارسة جنسية ليس هدفها الإنجاب، وتعيد الاعتبار لمقولة "الحياة الزوجية العفيفة". هذه مفارقة أساسية: "في اللحظة التي آثرت فيها الكنيسة التكيّف اللاهوتي مع الحداثة، خرجت في حرب ضد القيم الجديدة لهذه الحداثة". في اللحظة نفسها التي أخذت فيها حبوب منع الحمل تنتشر في السوق الأوروبية، تحوّلت الجنسانية و"الدفاع عن قدسية الحياة" إلى محور الصراع.
الجذور المسيحية لأوروبا: ما للأسطورة وما للتاريخ
التشديد على «الجذور المسيحية لأوروبا» هو عنوان جامع بإزاء تحسس مضاعفات ومخاطر «اسلام المهاجرين» في القارة العجوز. صحيح انه، جغرافياً، قامت حضارات اسلامية على البر الاوروبي، كالاندلس والتجربة العثمانية التي كانت محتسبة بتاريخ الامد الطويل بلقانية اكثر منها اناضولية، وفرضت هيمنتها على معظم حوض الدانوب طويلاً، وصحيح ان امم اوروبية كالارناؤوط (الالبان) والبوشناق تبنوا الاسلام بغالبيتهم، لكن اوروبا «ذات الجذور المسيحية» تقوم اساساً على فكرة ضمنية وهي انه، في حمأة مواجهة التهديدات الآتية من شرق الحوض المتوسط وغربه، المطلة برأسها تحت رايات الاسلام، تشكلت الهوية المشتركة الاوروبية. طبعاً في هذه الفكرة الضمنية منسوب كبير من الأسطرة، الا ان فيه ايضاً رصيداً كبيراً من تاريخية الامد الطويل. المشكلة الاساسية في هذه الفكرة التقليل من اهمية الصراع المسيحي الوثني الذي كان بشكل اجمالي عملية «تنصير» وسط ثم شرق وشمالي القارة انطلاقاً من جنوبها وغربها، هذه العملية التاريخية المريرة والطويلة التي ما كان لها ان تحسم الغلبة للمسيحية الا على قاعدة تكيف الاخيرة مع جزء اساسي من الثقافات الوثنية الفلاحية، بمثل ما تكيفت في الموازاة، مع جزء اساسي من الثقافات الوثنية المدائنية الاغريقية والرومانية. اوروبا كفكرة، هي بنت انتصار المسيحية على الوثنية، وبنت احتضان المسيحية لتركات الوثنيات المختلفة، كما انها بنت الصراع بين المسيحية والاسلام، مع كونه في الوقت نفسه صراعاً داخلياً، ليس فقط نظراً للوجود المسيحي في اوروبا، بل ايضاً لان مملكة كاثوليكية كفرنسا كانت حليفة السلطنة العثمانية في مواجهة عدو مشترك، هو الامبراطورية الكاثوليكية لآل هابسبورغ.
الاسلام بشرط عدم بناء "مساجد كاتدرائية"
بالعودة الى كتاب اوليفييه روا، اهميته تكمن في انه يتابع بشكل فَطن هذا التناقض بين دائرة الايمان الديني وبين دائرة الهوية الحضارية ذات الرموز الدينية. فهو يذكرنا بأنه عندما طرح موضوع ادراج الجذور المسيحية في مقدمة الدستور الاوروبي برز الانقسام بين ثلاث فئات. الكنيسة وجماعات الايمان: يؤيدون ادراج بند الجذور، ليس اكتفاء به، بل لانه يخدم معركة القيم، او «النموذج الانثروبولوجي» الذي يحاولون احياءه. يظهر روا هنا كيف ان المقولة الاكثر رواجاً داخل الجماعات المؤمنة الممارسة المسيحية اليوم هي الاقتناع بأن المسيحيين عادوا ليشكلوا اقلية في اوروبا، كما كانت الحال ايام الوثنية، وذلك لان الوثنية عادت في شكل حديث، وهي العدو الاول، وليس الاسلام. اما بالنسبة لليمين المتطرف والشعبوي، فهو قليل الاهتمام بالايمانيات والتدين، ويهمه الدفاع عن الجذور المسيحية، لكن ايضاً عن التقاليد والرمزيات الوثنية، الاساسية لفرز الامم الاوروبية بعضها عن بعض. اما بالنسبة للعلمانويين، فان بينهم من يقر بالجذور المسيحية لصناعة المشترك الاوروبي، لكنه يشدد اكثر منه على المشترك التنويري الانساني، وينظر الى المشكلات التي يطرحها الاسلام في اوروبا اليوم من وحي تصدي التنويريين قبل قرون للانغلاق الديني في شكله الكاثوليكي.
جاءت محنة كاتدرائية نوتردام لتذكر بهذا التشديد، منذ شاتوبريان في «عبقرية المسيحية او بهاء الدين المسيحي»، على «اوروبا الكاتدرائيات» كهوية حضارية قائمة بذاتها. الطريف في المقابل، عند قراءة كتاب روا المهم هو تمييزه بين كيفية تعاطي اليمينيين المتطرفين غير المتدينين والمتدينين الممارسين المسيحيين مع مسألة بناء مساجد في اوروبا اليوم. في حين يقف الاوائل عموماً ضد كل مظاهر اسلمة الفضاء والعمران، لا تصنف الكنيسة الكاثوليكية نفسها ضد بناء المساجد، بل ضد بناء مساجد «كاتدرائية» ضخمة وبقباب ومأذن عالية، لمصلحة التسامح مع «مساجد الأحياء».
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.