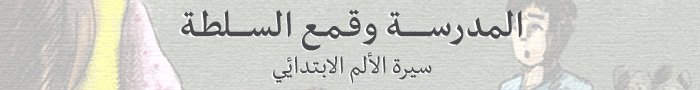لا أذكر أي صورة رأيت، ولا أي صوت سمعت، ولا أي رائحة تلك التي جذبتني نحو حدائق الكتابة. غالباً ما يتبع الطفل ظلاً أو موسيقى، أو عطراً يقوده ماكراً ببراءته نحو أشياء يجهلها، فيتحول الشعور نحوها، يوماً بعد يوم، ويتشكل بالتدرّج، إلى أن يصير ما يشبه الحب.
وجدت نفسي هكذا أكتب. ربما كان هناك سبب ونسيته لأني ضعيف الذاكرة. ثم، ليس من الضروري أن يكون هناك سبب لكل ما يقع على هذا الكوكب؛ فهناك أشياء كثيرة تحدث بالمصادفة. لكن حبي الأول للوطن لم يكن كذلك. لعل وراءه تلك الأناشيد التي كانوا يلقّنوننا إياها في الروضة وفي سنوات الدراسة الأولى. لعلّ وراءه، أيضاً، تلك الصور والكلمات التي كانت تخرج من التلفزيون في نشرة الأخبار التي تأتي بعد حصة الرسوم المتحركة. ثم إن صورة الملك الراحل المعلّقة فوق رأس والدي بوَرشتِه كانت تملأ عينيّ كلما زرته هناك منتظراً نصيبي من السكاكر و الحلوى. كان أبي يقول، مثلما كان معظم الآباء يقولون لأبنائهم، إن الملك قد ظهر لهم في القمر أيام المحن!
كنا، نحن الأطفال، في الدرب نركض بحماسة زائدة في لعبنا العنيف، ونسبّ كل شيء، إلا الملك. سمعنا مرة أن أحدهم بصق على الدرهم الذي يحمل صورته فأخفوه للأبد، وسمعنا أن من يسبّ الملك أو يعصه يذهبْ لجهنم. بعد ذلك اكتشفنا، حين كبرنا، أن جهنم كانت قريبة منّا، واسمها "تازمامارت". هناك أخفى الملك في سجن سري مهجور أولئك الذين حاولوا إزاحته من على كرسيّه الأثير، والذين لم يحاولوا أيضاً.
في عامي السابع، كتبت على ورقة صغيرة مجتزأة من مذكرة، شيئاً يشبه الشعر عن امرأة مرمية في الصحراء عُنّفت كي تقول إن الصحراء غير مغربية فرفضت. كانت كلماتي تلك دفاعاً مني عن أرض المغرب في الجنوب، نكاية بالإسبان وبجبهة البوليساريو. لا أعرف كيف انتبهت باكراً إلى هذا الصراع حول الأرض. كانت تلك الأناشيد التي أحفظها قادرة على تحويل طفل إلى جندي مدرّع. فالوطن يكون حاراً في دماء الأطفال وفي حلوقهم، مثلهم مثل الثوار تماماً، وليس كأهل السياسة الذين ينظرون إليه كقطعة ثلج مذابة في كأس خمر. "وجهها مثل تفاحة صفراء"، هذا هو المقطع الوحيد الذي أتذكره مما كتبته على تلك الورقة، و لعلّه لا يختلف كثيراً عما أكتبه اليوم.
في عامي العاشر، حصلت على جائزة أفضل تعبير في مسابقة بالمدرسة. سرّني كثيراً أني حصلت على آنية كبيرة من الفخار: مزهرية زرقاء جميلة ظلت معي طوال سنوات الطفولة، كنت أنفرد إليها من حين لآخر كي تذكرني بنجابتي. كان موضوع المسابقة هو عيد العرش، الثالث من مارس، اليوم الذي جلس فيه الملك الحسن الثاني على "عرش أسلافه المنعمين"، كما كان يقول المذيع القديم في التلفزيون. كنت أحضر مع الفقهاء قراءة الحزب بعد صلاة المغرب، وغالباً ما أسمع تلك الآيات التي تتحدث عن عرش الله، وأسأل نفسي عن عرش الملك: كيف استطاع الملوك أن يصنعوا عروشاً على الأرض تشبه عرش الإله في السماء؟ ومع مرور السنوات اكتشفت أنهم آلهة، لكن من نوع آخر. الدستور المغربي السابق كان يصف الملك بأنه مقدَّس.
قبلها بفترة، كان الملك يلقي خطبة غريبة. بدا غاضباً و حاداً في ما يقول. سمعته يتوعد الشعب ويصف الذين خرجوا منهم للتظاهر بـ"الأوباش". لم أكن أعرف معنى هذه الكلمة، لكنها بدت لي نشازاً، فهو الذي تعودنا أن نسمع منه في كل الخطب "شعبي العزيز". على أية حال، حينها لم تكن كل هذه الأشياء تهمّ طفلاً نجيباً حصل على مزهرية زرقاء كبيرة.
أطفال "الخيرية" كانوا يلبسون زيّ العساكر ويحملون سلاحاً من خشب في أعياد العرش "المجيدة" و أعياد "الشباب" و"المسيرة الخضراء"، ونحن كنا نحمل الرايات ونهتف بالأناشيد في الساحات وفي الشوارع، ونمجّد الرجل الأول في البلاد بتلك الجملة التي ما زالت تملأ أفواه الفقراء: "عاش الملك".

في عامي الخامس عشر، كتبت قصيدة على البحر البسيط تسخر من الوزراء والولاة الذين يركعون للملك كل عام حين يبايعونه، وهو راكب على حصانه وفوق رأسه مظلة كبيرة يرفعها خادم "أسود". لم تكن هذه الصورة تشبه صور أبطالي في الرسوم المتحركة ولا في الأفلام العربية القديمة التي بدأتُ في تلك الفترة أشاهدها بحب ربما لن يتكرر. أبطالي طيبون: توم سوير، فقير وطيب رغم كسله ورغبته الدائمة في الهروب من المدرسة؛ ماوكلي الذي ربّته الذئاب؛ سالي، الفتاة الحزينة التي أصبحت خادمة بعد أن أفلس والدها ومات، وبيتر صديقها الذي كان سائقاً خاصاً لها في أيام العز ثم صار يحمل عنها الأثقال أيام العناء؛ ونحّول وزينة اللذان يرعيان الحب في مدقات الأزهار؛ والصياد الماهر الذي يقف طويلاً على ضفة النهر باحثاً عن سمكة؛ رعد الذي كان عملاقاً، لكنه كان يحارب الأشرار؛ وبسيط المغامر الضخم الذي يطلب النجدة من أشواك القنفذ الصغير؛ ودبدوب الموسيقار الذي يقضي النهار تحت أشجار الغابة متعقّبا الألحان. أبطالي الآخرون هم السنافر، الشناكل، الأقزام، سنبل، عبقور، وداي الشجاع ونقار الخشب وصاحب الظل الطويل. لم يكن أحد من أبطالي يجبر الناس على الوقوف في الشمس بجلابيب بيضاء و الركوع لحصان.
ولأن الخوف هو السحابة التي تملأ سماواتنا، فقد كتبت القصيدة بلغة سرية، حيث كنت أكتب الجملة من اليسار نحو اليمين، و أضع للحرف ذي النقطة الواحدة اثنتين وللحرف ذي النقطتين واحدة. أطلعت أحد أصدقائي عليها فخاف وأخافني. دسست تلك القصيدة في مكان سرّي في البيت، ومزقتها لاحقاً.
سأفهم، وأنا أتقدم من طفولتي نحو الشباب، أنه يصعب في مغربنا أن تقول الحقيقة، أن تتنفس رأيك في هواء عليل دون أن تكتم يدٌ سوداءُ أنفاسَك. ربما لهذا السبب قال الأرجنتيني ماركو دينيبي في قصته القصيرة جداً: "أعطوني أسرع حصان، لقد قلتُ الحقيقة للملك".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.