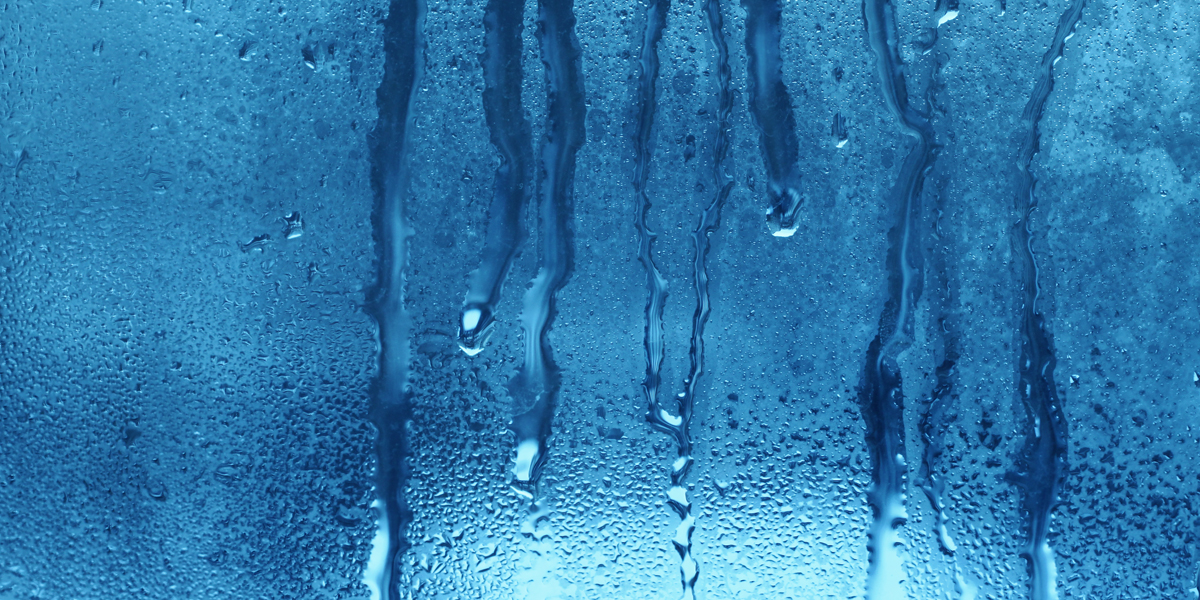كنت صغيرة عندما أخبرنا أبي قصة عن أصدقاء قدامى للعائلة من البدو، كانوا يسكنون في القرى المجاورة لبلدتنا، وقد ترددت هذه القصة على مسامعنا كثيراً في ما بعد. بغض النظر عن الأحداث التي تدور في القصة، فهي تنتهي بأن يخبر بطلها امرأةً مسنّة بلهجته البدوية، الحقيقة التالية: "نحنا منحب البتشي يا خالة، نزعل نبتشي، نفرح نبتشي"، وتعني: "نحن نحب البكاء يا خالة، نحزن فنبكي، نفرح فنبكي أيضاً".
يبدو الأمر طريفاً أو مبالغاً فيه للوهلة الأولى، لكن في تلك الجملة القصيرة توصيفاً حقيقياً للميل العربي التاريخي إلى الحزن، لا بل للاستمتاع به، وكأنه شعور جماعي موحد يغلب على المنطقة، ما ينعكس بشكل طبيعي على كل الإنتاج العربي الفكري والثقافي، وعلى العلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد، فيبدو الحزن طابعاً عاماً يدخل في أعمق تفاصيلنا، إليكم بعض مظاهر المازوشية النفسية والحزن العربي، وقد لا تجدونها في مناطق أخرى من العالم.
بدءاً بالموسيقى
ثمانية مقامات موسيقية شرقية رئيسية، أربعة منها حزينة، هي الصبا، وهو أكثرها حزناً، والنهاوند، والكورد، والسيكا. ومع أن الأخير يمكن أن يمزج الحزن وانطباعات شعورية أخرى، فالانطباع الذي يتركه لدى السامع يميل إلى الحزن. ثلاثة مقاماتٍ محايدة تترك آثاراً مختلفة في نفس السامع، حسب اختلاف الإيقاع الذي يلعب دوراً مهماً جداً، لكنها تملك القدرة أن تكون حزينة جداً، كالبيات والحجاز، مقابل مقام واحد فرح هو العجم. في النتيجة، ومع المجال الكبير الذي يمكن للموسيقي أن يراوغ به، فالفوز محسوم في لعبة المقامات الشرقية، والتي كانت تقوم عليها وحدها الموسيقى العربية ولمدة طويلة، لصالح المقامات الحزينة، ما يفسر الحزن الهائل الذي يغلب على أغاني ما يعرف بالعصر الذهبي، عصر أم كلثوم ورفاقها، عندما كانت الموسيقى العربية شرقية بحتة.
وقد لحقت الموسيقى العربية في ما بعد ركب الحداثة وأدخلت ثقافات أخرى غير الشرقية عليها، إلى أن وصلنا في مرحلة ما بين تسعينيات القرن الماضي، والسنوات الأولى من الألفية الجديدة، إلى ما يعرف بالـpop music العربية. وجاء عصر عاصي الحلاني وراغب علامة وعمرو دياب ونانسي عجرم، وغيرهم، فأصبحت الإيقاعات أكثر سرعة، وقصر وقت الأغاني وبرزت آلات غربية عديدة، لكن كلمات تلك الأغاني حافظت على حزنها ومرارتها وبؤسها: "عمرك شفت شي باب عم يبكي؟". هذه الجملة مثال بسيط فقط من الاستمتاع بالحزن. وأخيراً وصلنا إلى موسيقى الـUnderground فبرزت أنماط جديدة تماماً كالراب والروك العربي. لا بد من الاعتراف بأن الأغاني أصبحت أخفّ وطأة على قلب السامع، إلا أنها حافظت بشكل كبير على المضمون الحزين، فغدت الكلمات أكثر سلاسةً، لكن الموضوع ما زال محصوراً إما بالوطن المحروق، أو بالحبيب المسافر، الذي كسر قلب حبيبه قبل أن يذهب ويختفى.
لا يصح التعميم طبعاً، فنحن أيضاً بلاد الدبكة والهوارة والـ"الأوف وأبو الزلف". المشكلة في المحتوى العام، فيقابل كل أغنية خفيفة مبهجة ألف أغنية حزينة تبالغ في وصف المأساة.
نموت مع الموتى ونبكي في الأعراس
ترتدي النساء في بعض مناطق العراق واليمن ثياباً سوداء حزناً على رجالهن الراحلين سبع سنوات بعد وفاتهم. ولم يمض وقت طويل منذ توقفت هذه العادة في بعض الأرياف السورية واللبنانية والأردنية. وما زالت معظم مناطق العراق تستعين بنساء يعملن في مجال ندب الموتى، يطلق عليهن اسم "النواحات"، يتم استئجارهن للندب والنواح على جثة الميت قبل دفنه، فتبالغ النواحات وتعلو أصواتهن لحظة إخراج الميت من البيت، وتخفت لحظة ذكر الميت من قبل أهل بيته، وقد يصل بهن الأمر أبعد من ذلك إلى تمزيق ثيابهن والضرب على رؤوسهن. هذه كلها خدمات يدفع أهل الميت أجرها، لحفظ اسم الميت ورفع ذكراه بعد موته، فيقول الناس إن فلاناً كرمه أبناؤه بعد وفاته، وجلبوا له النواحات الجيدات.
أما في المغرب، فتختلف الأمور قليلاً، إلا أنها تبقى في نطاق المغالاة والاستمتاع بالحزن. فعلى المعزي أن يسلم على الجميع، المعزين وأهل الميت، لكنه يخصّ أهل الميت بالعناق. وإذا ذرف دمعة أو اثنتين فذلك خير ما يفعل، أما النساء فأمر آخر تماماً، إذ تدخل المرأة بيت العزاء وعليها أن تسلم على الجميع أيضاً، ولا يجوز أن تمشي واقفة، بل تمر بالمعزيات ونساء الميت وهي تجلس القرفصاء، ويجب أن تضع رأسها على رأس كل واحدة من قريبات الميت بشكل متجابه، ويتباكيا.
لو انتهى الأمر في طقوس الحزن المبالغ فيها في مراسم الموت لكان لا بأس به، إلا أن ذلك يتجاوزه إلى طقوس الأعراس، فيبكي أهل العروس على فراق بنتهم كما لو أنها تفارق الحياة وليس في يوم فرحها. في سوريا مثلاً، ففي اللحظة التي يصل فيها أهل العريس بيت أهل العروس ليخرجوا عروستهم، يبدأ طقس غريب من البكاء غير المبرر، لأنهم يسلمونها إلى رجل غريب عن العائلة. ومع اختلاف العادات طبعاً بين مدينة وأخرى، فالفكرة العامة السائدة عن تسليم الأب ابنته إلى رجل آخر تتشابه كثيراً. أليس من المفترض أن تكون الأعراس مناسبات سعيدة؟
أخيراً عصر الـSocial Media
كان متوقعاً أن تغير مواقع التواصل الاجتماعي شيئاَ من الحزن الجماعي العربي، لأنها تفتح الثقافات بعضها على بعض، إلا أنها لم تفعل. فمقابل بعض الصفحات الفكاهية، التي قد تغير المزاج، هناك آلاف الصفحات التي تصف الحزن وتتعمق وتتلذذ في ذكره. فإذا كتبتم في مربع البحث على موقع Facebook كلمة "الحزن الصامت" أو "القلب الحزين"، فستجدون آلاف النتائج بين صفحات وحسابات شخصية وهمية، ومنشورات تتضمن تلك الكلمات. في جولة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن إثبات النزعة الاجتماعية العربية إلى البقاء في غيمة سوداء، كأن تلك البيئة الحزينة هي المنطقة الآمنة بالنسبة إليهم، فإذا خرجوا منها خسروا شيئاً من تكوينهم. جملة طريفة من جولة البحث عن الحزانى تلك: "هناك أوجاع تكبت ولا تكتب"، صورة شخصية لحساب على تطبيق Whatsapp.
 Screen Shot 2016-01-26 at 7.00.12 PM
Screen Shot 2016-01-26 at 7.00.12 PM
 Screen Shot 2016-01-26 at 7.04.14 PM
Screen Shot 2016-01-26 at 7.04.14 PM
في النهاية، لا بد من محاولة الإنصاف في هذا الأمر، وليس بمقدورنا أن نحلل الأمر بشكل أعمق، لأن دراسة ظواهر كتلك تحتاج إلى المختصين الاجتماعيين. لكن لا بد لنا أن نحاول استجداء بعض الأسباب، فقد مضى وقت طويل منذ بدأت المنطقة العربية، تدور في حلقة مفرغة، فما إن تخرج من حرب حتى تدخل أخرى، والحرب تسحق نفوس أهلها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدين أهل المنطقة ودخول الدين في تفاصيل حياتهم، يعززان الأمر، فالديانات تحمل في معظمها بعداً تعذيبياً للنفس، إلا أن العرب ما زالوا يقفون عند ذلك البعد من أديانهم، ويستمتعون في ذلك.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.