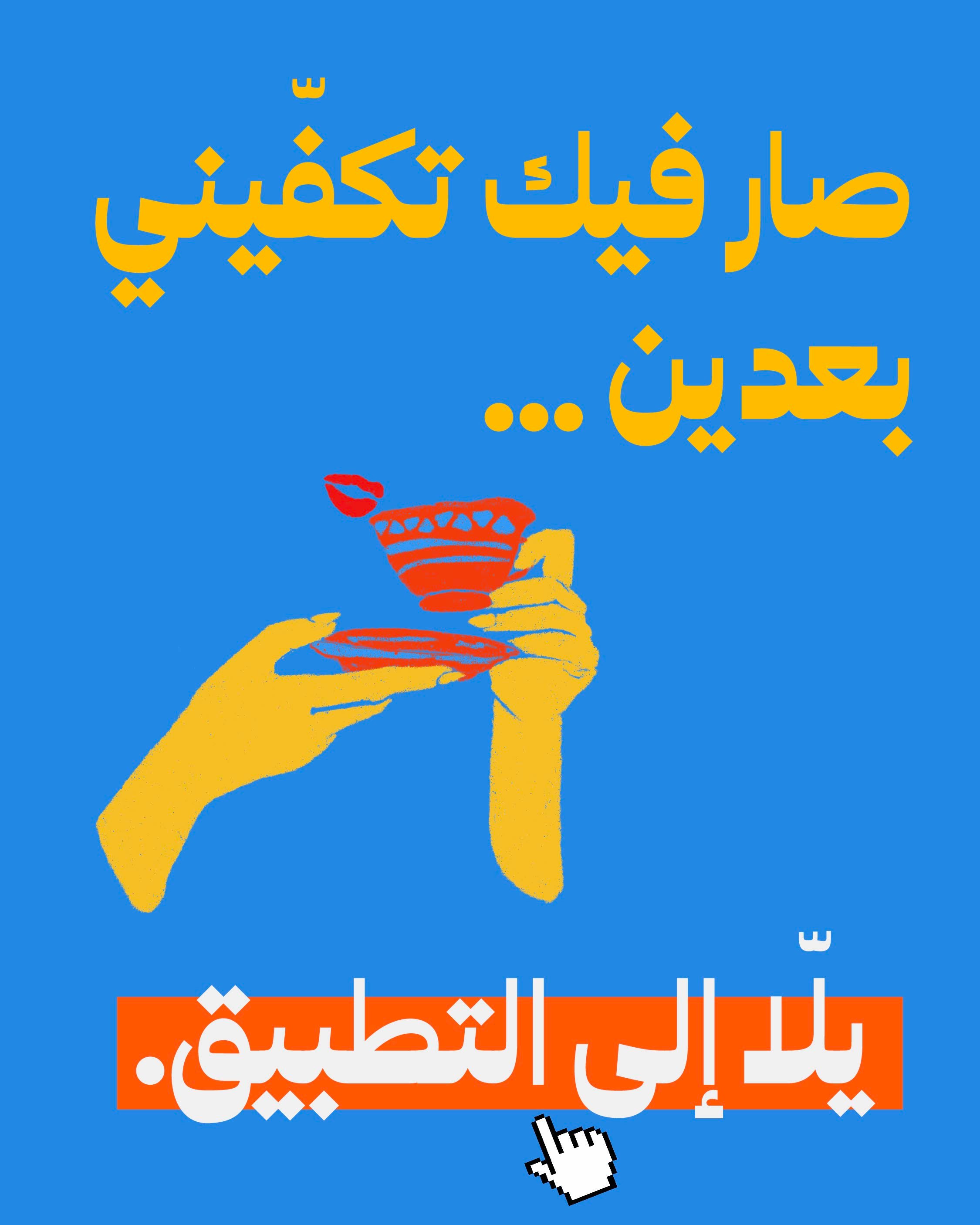بين صمت الماكينات المتوقفة في المدن الصناعية السورية وأبواب الورش المغلقة، تكمن حقيقة أعمق من مجرد آثار الحرب. فالانهيار الذي تتكشف ملامحه منذ أكثر من عقد ليس وليد القذائف وحدها، بل هو محصلة تراكمية لسياسات قتلت القطاع الصناعي ببطء، قبل أن تأتي الحرب لتضع علامة الموت النهائية.
اليوم، يقف المصنعون والعاملون على حافة الخسارة، لكنهم لا يواجهون نتائج الحرب فحسب، بل يواجهون إرثاً ثقيلاً من القرارات الخاطئة التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي. سياساتٌ جعلت الصناعة الوطنية عاجزة عن النهوض حتى عندما توقف دوي الانفجارات.
في هذا التقرير، يتوقف رصيف22 عند كيف تحولت السياسات الاقتصادية من أداة لدعم الإنتاج إلى سلاح ضد الصناعة المحلية. نستعرض مع الخبراء والصناعيين مسيرة الانهيار الطويلة: من سياسات التأميم التي شتتت رأس المال الوطني، إلى سياسات الطاقة التي خنقت المصانع، مروراً بالسياسات الجمركية التي فتحت الأبواب للإغراق، وصولاً إلى سياسات "التحرير" المشوّه التي أنهكت ما تبقى من مناعة الصناعة السورية.
نحاول الإجابة عن السؤال المحوري: لماذا استمرت الصناعة السورية في النزيف حتى بعد توقف القتال؟ ومن المستفيد من بقاء هذا القطاع الحيوي في غرفة الإنعاش؟
سياسات متراكمة وعقود ضائعة
يرجع الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الجلدية، يوسف سعد، التراجع الصناعي في سوريا إلى مسارٍ طويل من السياسات الخاطئة والقرارات الارتجالية التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، مروراً بمراحل متعاقبة تسببت في تآكل البنية الصناعية وتراجع ثقة المستثمرين.
ففي المرحلة الأولى، مثّل التأميم نقطة الانكسار الأبرز، إذ تم تجريد الصناعيين من ملكياتهم واتهامهم بالاستغلال، مما دفع برؤوس الأموال الوطنية إلى الهجرة، وأفقد الصناعة السورية قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً.
ثم جاءت مرحلة ما بعد حرب تشرين 1973، حيث تدفقت الأموال الخليجية وأُنشئت مصانع كثيرة بلا دراسات جدوى حقيقية، وسط شبهات فساد وغياب الكفاءة الإدارية، مما جعل أرباحها قائمة على الحماية ومنع الاستيراد لا على جودة الإنتاج.
يرى صناعيون أن الانهيار الصناعي في سوريا لم يكن وليد الحرب، بل نتيجة تراكم سياسات خاطئة منذ الستينيات، بدأت بالتأميم الذي هرب برؤوس الأموال الوطنية، واستمرت بقرارات ارتجالية وفساد إداري حوّل الصناعة من رافعة اقتصادية إلى قطاع مترنّح عاجز عن النهوض
أما مع بداية الألفية الجديدة، فقد تعمّق التدهور مع هيمنة الاقتصاد الريعي واحتكار الاستيراد لمصلحة فئة ضيقة من التجار، فيما تراجعت الصناعات الوطنية أمام المنتجات التركية الرخيصة التي أغرقت السوق المحلية.
وبعد عام 2011، جاءت الحرب لتكمل حلقة الانهيار، إذ نُهبت المصانع وتعرض الصناعيون للابتزاز، فهاجر رأس المال الصناعي ومعه اليد العاملة الماهرة، تاركًا وراءه قطاعًا ينزف من دون حماية.
ويشير سعد خلال حديثه لرصيف22 إلى أن ما يُعرف بـ"العهد الجديد" الذي حاول فتح المجال أمام الاقتصاد الحر، لكن الفهم المغلوط لهذا المفهوم جعل الصناعة الوطنية تواجه منافسة غير متكافئة مع المنتجات الأجنبية من دون أي تحضير أو دعم، فكانت النتيجة معركة خاسرة سلفاً.
ويرى أن إصلاح الصناعة لا يمكن أن يتحقق من دون معالجة الملفات الأمنية والسياسية والتشريعية المتراكمة، توازياً مع إعادة صياغة سياسات الطاقة، فارتفاع سعر الطاقة يزيد من أسعار الخدمات وأسعار الحاجات المنزلية اليومية وتالياً يضغط باتجاه ضرورة رفع الرواتب والأجور التي تزيد بدورها من تكاليف السلعة وهكذا، كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء دون زيادة دخل الفرد سوف يؤدي إلى انكماش شديد في الأسواق وضعف القوة الشرائية التي ستؤدي إلى كساد المنتجات وتفاقم الخسائر.
ضحايا الواقع: مصانع تُغلق وعمالة تُسرّح
هذه السياسات التاريخية التي يتحدث عنها سعد لم تبقَ حبيسة الكتب، بل تجسدت على أرض الواقع في مصانع أُغلقت وخبرات تبعثرت. ومن الأمثلة البارزة على التحديات التي تواجه الصناعة السورية ما حدث مع مصنع "الحجار للنسيج" الذي أغلق مؤخراً وينتج خيوط الأكريليك ويُعدّ أحد أهم منشآت إنتاج المادة الأولية للألبسة التريكو.
فقد اضطر صاحب المصنع إلى إقفاله بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية، حيث أكد خلال لقاء له أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بأكثر من 50%، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تقارب 35%، واحتكار حوامل الطاقة، إضافةً إلى سياسة حبس السيولة في المصارف التي رفعت قيمة الليرة بشكل وهمي وأضعفت القدرة على التصدير.
بعد حرب تشرين 1973، أنشئت مصانع كثيرة بلا دراسات جدوى، وارتبطت أرباحها بالحماية الجمركية لا بالكفاءة الإنتاجية، فيما أدى الاقتصاد الريعي إلى تهميش الصناعات المحلية أمام غزو المنتجات التركية الرخيصة.
كما ساهم فتح باب الاستيراد بجمارك منخفضة في إغراق الأسواق ببضائع رديئة ورخيصة، ما أدّى بحسب الحجار إلى تراجع الطلب على المنتج المحلي وتوقف خطوط الإنتاج. وقد نتج من الإغلاق تسريح نحو 360 عاملاً، في مؤشر واضح على حجم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي خلّفته سياسات الطاقة والاستيراد على القطاع الصناعي الوطني.
هروب رأس المال: صناعة بلا وطن
وإذا كانت مصانع الداخل تدفع الثمن، فإن رأس المال السوري يبحث عن ملاذات آمنة خارج الحدود. فقد تصدّر الصناعيون السوريون قائمة المستثمرين العرب المؤسسين لشركات جديدة في مصر خلال السنة المالية 2024–2025، بعد تأسيس نحو 4800 شركة، وفق تصريح تلفزيوني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، وبحسب وثيقة حكومية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.
هذا التفاوت لا يُعبّر فقط عن هجرة رؤوس الأموال، بل عن الفارق الكبير في بيئات العمل، حيث لا تزال سوريا تحاول النهوض من تركة اقتصادية ثقيلة تراكمت عبر عقود من السياسات الريعية والعقوبات والحصار، بينما تسعى الحكومة الحالية لإدارة بلد أنهكته الحرب ومحاولة إعادة تشغيل ما تبقى من بنية الإنتاج.
تشخيص الواقع… أرقام صادمة وبنية تحتية منهارة
في مواجهة هذا الواقع المرير، يقدّم الصناعي محمد الشاعر قراءة شاملة لأسباب تراجع الصناعة الوطنية، مؤكداً أن ما تمرّ به الصناعة السورية اليوم هو نتيجة تراكمات طويلة تفاقمت بفعل الأزمة السورية والحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية التي دمّرت البنية الإنتاجية وأضعفت سلاسل التوريد والشبكات الاقتصادية والاجتماعية.
ويشير الشاعر إلى رصيف22 إلى أن حجم الأضرار التي طالت البنية التحتية كان بالغاً، ترافق مع تراجع الاستثمارات الإنتاجية وهجرة المستثمرين والكفاءات الصناعية، الأمر الذي أدى إلى تقلّص النشاط الاقتصادي بنسبة تقارب 90% مقارنة بعام 2010، وانخفاض الصادرات السورية بنحو 92% خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2023، في حين تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 93% خلال المدة ذاتها.
ويضيف أن الصناعة كانت من أكثر القطاعات تضرراً، إذ خرجت مئات المنشآت العامة والخاصة عن الخدمة، وارتفعت تكاليف الإنتاج نتيجة الحصار وغياب الطاقة وارتفاع الرسوم والفساد الإداري، مما أدى إلى خسارة جزء كبير من السوق المحلية لصالح المنتجات المستوردة والمهرّبة، وتراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين. كما انخفضت نسبة العاملين في القطاع الصناعي العام بنحو 30%، وفي القطاع الخاص بنحو 50%.
ويرى أن مرحلة ما بعد التحرير لم تكن خالية من التحديات، إذ سُمح بدخول بضائع مستوردة دون رقابة، وتوسعت منافذ التهريب، وارتفعت أجور النقل والطاقة.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات إيجابية مثل إعادة تأهيل المدن الصناعية وتحسن التوريد الكهربائي، ويختم بالقول إن الصناعة السورية اليوم بين صعود وهبوط، لكنها تظلّ قادرة على النهوض مجدداً إذا ترافقت الإرادة السياسية مع تشريعات محفزة وبنية تحتية متماسكة.
رؤية نقدية… فشل الإدارة وغياب التخطيط
بينما يقدم الباحث الاقتصادي والصناعي عصام تيزيني رؤية أكثر تشاؤماً، معتبراً أن الفريق الاقتصادي الحالي فشل في إدارة الملف الصناعي، وأن قراراته المتخبطة عمّقت أزمة الإنتاج المحلي بدلاً من أن تسهم في معالجتها.
ويرى تيزيني أن ارتفاع أسعار الكهرباء شكّل واحداً من أبرز العوائق التي تواجه المعامل السورية، إذ انعكس بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، في وقت لا تتوافر فيه الطاقة الكهربائية بشكل كاف إلا داخل المدن الصناعية، بينما تبقى بقية المصانع تعاني من الانقطاعات الطويلة وارتفاع كلفة التشغيل.
ويُرجع تيزيني جذور الأزمة إلى نهج اقتصادي قديم كرّس الاقتصاد الريعي التجاري على حساب الاقتصاد الإنتاجي، موضحاً أن تراجع الصناعة الوطنية ليس وليد السنوات الأخيرة، بل بدأ منذ مطلع الألفية، حين تخلّت السياسات الحكومية عن دعم الصناعات الحيوية كالغذائية والدوائية، واكتفت بالصناعات التحويلية محدودة القيمة المضافة. \
منذ عام 2011 وانهيار الصناعة السورية مستمر، بداية من تدهور البنية الصناعية، والنهب، والابتزاز، ونزوح رؤوس الأموال والعمالة الماهرة، وسياسات "التحرير" الاقتصادي المشوهة التي أطلقت منافسة غير متكافئة، ما جعل الصناعة السورية تخسر حتى بعد توقف المعارك بسبب غياب الدعم والطاقة وارتفاع التكاليف
كما ينتقد بشدة سياسات منع الاستيراد التي لا تراعي حاجة السوق أو طبيعة الاقتصاد المحلي، مبيناً أن أغلب المنتجات السورية تعتمد أساساً على مكونات مستوردة، ما يجعل قرارات المنع غير منطقية وتؤدي إلى اضطراب السوق وارتفاع الأسعار.
انخفاض مساهمة الناتج المحلي الإجمالي
في السياق ذاته، يرى مستشار غرفة صناعة حلب، الدكتور سعد بساطة، أن القطاع الصناعي السوري يعيش واحدة من أصعب مراحله منذ عقود، إذ انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 25% قبل عام 2011 إلى أقل من 8% في عام 2024، نتيجة الحرب الطويلة والحصار الاقتصادي وتدمير البنية التحتية الصناعية.
هذا الانكماش لم يقتصر على توقف الإنتاج، بل طال سلاسل العمل الداعمة له، وصولاً إلى الصناعات الزراعية والغذائية التي تعتمد على التصنيع المحلي.
ويشير إلى أن العقبات الأساسية التي تواجه القطاع تتمثل في نقص المواد الأولية والطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهجرة الكفاءات الصناعية، وغياب سياسات دعم واضحة، مما جعل البيئة الصناعية طاردة وغير قادرة على المنافسة. ويؤكد بساطة أن مواجهة الإغراق الصناعي من دول الجوار تتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تشمل فرض رسوم حماية جمركية على السلع المنافسة، دعم البحث والتطوير، وتوفير التمويل للمشاركة في المعارض الدولية وفتح قنوات تصدير جديدة، إلى جانب تفعيل المناطق الصناعية وبرامج التدريب والتعاون الأكاديمي لتأهيل العمالة الوطنية وفق حاجات السوق.
كما يشير إلى أن رفع تسعيرة الكهرباء كان من أكثر الإجراءات تأثيراً على تنافسية المنتج المحلي، إذ أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الداخل والخارج، لتصبح سوريا من بين الدول الأعلى تكلفة في الطاقة بالمنطقة.
مقترحات الإنقاذ بين الحماية الذكية والتشجيع التصديري
وفي ظل هذا التشخيص القاتم، يقدم الخبير الاقتصادي في إنعاش الصناعة السورية الدكتور فادي عياش باقة من الحلول العملية، مع التأكيد على كون المرحلة دقيقة وتتطلب معالجة جذرية وشاملة.
ويشير إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا شكّلت العائق الأكبر أمام انسياب حركة التجارة واستيراد مستلزمات الإنتاج، ما انعكس سلباً على تنافسية المنتج السوري في الداخل والخارج، كما يلفت إلى أن ضعف البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والكهرباء أسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب غياب التمويل وضعف الاستثمارات التي حدّت من فرص التطوير الصناعي.
تقلص النشاط الصناعي بنسبة 90% مقارنة بعام 2010، وتراجعت الصادرات 92%، والناتج النفطي 93%، وانخفضت العمالة الصناعية العامة 30% والخاصة 50%.
ويضيف أن هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة مثّلت ضربة قاسية للقطاع الصناعي، الأمر الذي جعل الحاجة إلى رؤية إنقاذية واقعية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
ويطرح الدكتور عياش من خلال حديثه مع رصيف22 مجموعة من الحلول والمخرجات العملية التي يمكن أن تشكّل مدخلاً لتعافي الصناعة، أبرزها تبنّي مفهوم "الحماية الذكية" عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 40% على السلع المستوردة التي يتوافر لها بديل محلي، بما يتيح حماية المنتج الوطني دون تعطيل حركة السوق، كما يدعو إلى تحويل الدعم من مدخلات الإنتاج إلى مخرجاته، بحيث تُوجَّه الحوافز للصناعيين المنتجين والمصدّرين الفاعلين، من خلال تخفيف الضرائب ورسوم الطاقة والتمويل.
وفي موازاة ذلك، يؤكد ضرورة دعم الصادرات السورية بوسائل واقعية تشمل تمويل دراسات الأسواق الخارجية، والمشاركة في المعارض الدولية، وإعادة تفعيل اتفاقية "EURO 1" مع الاتحاد الأوروبي.
كما يشدّد على أهمية تقديم إعفاءات ضريبية موجّهة وتسهيلات ائتمانية مخصصة للإنتاج حصراً، مع تبسيط الإجراءات وتبنّي مفاهيم جديدة مثل “منافسة الدولة” و”العلامة التجارية الجغرافية” لتعزيز هوية المنتج السوري في الأسواق العالمية ورفع قدرته التنافسية.
غياب الإرادة… القطاع الذي لم يجد من ينقذه
أما الباحث الاقتصادي وعضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر، فيقدّم رؤية نقدية حادّة تكمل الصورة، ويشير في حديثه مع رصيف22 إلى أن القطاع الصناعي في سوريا لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه كقطاع قيادي داخل الاقتصاد الوطني، رغم عشرات الدراسات والخطط الإصلاحية التي أُعدّت لتطويره وبقيت حبيسة الأدراج.
ويرى بكر أن المرحلة التي تلت التحرير كشفت عمق الأزمة، إذ ازدادت الضغوط على الصناعيين نتيجة غياب الاهتمام الحكومي الفعلي بمعالجة المشكلات المتراكمة، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وبخاصة حوامل الطاقة، إضافة إلى فتح الأسواق أمام المنتجات المستوردة والمهرّبة، خصوصاً من الشمال السوري، ما أدى إلى إغراق السوق المحلية ببضائع رخيصة وضعيفة الجودة أضعفت قدرة المنتج المحلي على المنافسة وأجبرت العديد من المصانع على التوقف أو الإغلاق.
ويشير إلى أن المستفيد الأكبر من هذا الواقع هم اقتصادات الدول المجاورة التي أغرقت السوق السورية ببضائعها، بينما الخاسر الحقيقي هو الصناعي والمستهلك السوري على حد سواء.
صناعة تبحث عن مستقبل
تتركّز الصورة النهائية للصناعة السورية عند مفترق طرق حاسم؛ فمن جهة، هناك تاريخ طويل من السياسات الخاطئة، وتراكم الأزمات، وانهيار البنية التحتية، وهجرة رأس المال والكفاءات، ومن جهة أخرى، تبرز مقترحات عملية وتشخيصات دقيقة من الخبراء والصناعيين قد تشكّل خارطة طريق للإنقاذ.
الواقع يؤكد أن الصناعة السورية لم تمت، لكنها في غرفة إنعاش تنتظر قراراً سياسياً جريئاً، وحماية ذكية، ودعماً حقيقياً ينتشلها من دائرة العجز والإغراق. السؤال الذي يظل معلقاً: هل ستكون هناك إرادة كافية لتحويل هذه المقترحات إلى واقع، أم ستظل الصناعة الوطنية حلماً ينتظر التحقق بينما تستمر الماكينات في الصمت؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.