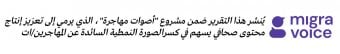
في اليوم الثالث لمهرجان "برلين أتونال" التجريبي الكبير، وفي قلب محطة كهرباء مهجورة، كنا نحن الفلسطينيين/ ات، المادة التجريبية! في هكذا مهرجان توضع أمام الجمهور شاشات عملاقة لحيوانات في الغابات تركض، أو لصوت تراطم الأمواج على بحر ما. أما في نسخة هذا العام من المهرجان، فتدفع تذكرة دخول لا تقلّ عن 250 يورو، لتشاهد صور جدّك وجدّتك يركضان من بيتهما في النكبة أو في اجتياح بيروت مع موسيقى إلكترونية تجريبية وملصقات باللغة العربية فقط لأنها "إكزوتك" ومثيرة.
تدخل إلى المكان الكبير المريب لتسمع أصواتاً تعلو من كل مكان. الموسيقى الإلكترونية لا تتوقف طبعاً مكملّةً المشهد الفني "البرليني"، فضلاً عن الأضواء الكثيرة والمتلاحقة في جوّ معتم.
كل ما حولك تجريبي. أنت موجود/ ة هنا لتحاكي حواسك وتخضع لتجربة حسّية سمعية بصرية لم تكن فيها قبلاً، حسب قولهم/ نّ.
شاشات عملاقة، أصوات وروائح، وصور لا تنتهي إلى درجة أنك لا تعرف في أيٍّ مكان وأيِّ زمان أنت، وكل الناس ترتدي الأسود لأنه "كوول" وغامض.
كل هذا يبدو ممتعاً للكثير من البرلينيين الذين يتغذون على هذا النوع من الفنّ، الذي ببساطة وفي كثير من الأحيان لا يحرّك شيئاً فيك ككرسي مكسور وفوقه قطعة بلاستيك، أو شعاع قادم من بعيد على لوحة مفاتيح الكترونية. في أحيان كثيرة تتوقع وتسأل نفسك: هل أنا الوحيد المجنون في هذا الصرح الكبير أو أن الكل فقد عقله؟ تنظر إلى الوجوه فتعرف أنّ الكل فقد عقله فعلاً! ولا تجرؤ على قول ذلك بصوت عالٍ لأنك ستبدو المتخلف الوحيد في هذا المزرعة.
تبدأ الجولة بملصق كبير باللغة العربية: "لماذا تبيدونهم/ نّ؟".
شاشات هائلة، أصوات وروائح وصور تربك الحواس، قد تبدو التجربة ممتعة للبعض، لكنها فارغة، تدفعك للشك بعقلك وسط جمهور مأخوذ بهذا العبث
دون ترجمة لهذا السؤال إلى اللغة الألمانية أو حتى الإنكليزية، أخاطب صديقي: ربما كلمة "إبادة" مسموحة فقط باللغة العربية؟
على حائط كبير مضاء تصدح خلفه الموسيقى العالية، ويترنّح كثيرون أمامه، صورة تشعّ بالأبيض والأسود. أقترب منها أكثر، لأرى تجسيداً لبيت مهدّم، وسطه شخصان يحضنان بعضهما بعضاً. ربما هما طفلان.
مع ازدياد حدّة الموسيقى، تزداد وتيرة الرقص أمام الحائط وكأنّ ما يرونه صورة للموناليزا أو صورة لبيت ريفي في سويسرا.
ولكن لا، إنها صورة لبيت مهدّم، ربما في فلسطين، في سوريا، أو في اليمن. صورة لطفلين يحتضنان بعضها بعضاً قبل النفس الأخير. صورة ربما لهند رجب تعانق محمد الدرّة أمام ما يحصل في غزة.
ولكن الموسيقى والإضاءة والناس وكل ما حولك تشير إلى أنّ الموضوع عادي "تجربيبي". "يا خي شو مالك؟ "إكسبرمنتال"!
حمّالة صدر وبطيخة
في آخر الممر، وفي غرفة كبيرة سوداء معتمة، تتوسط المشهد شاشة كبيرة وعلى أرضها العديد من المخدّات حتى يستطيع الزوار أن يستلقوا وهم يشاهدون ما يتم عرضه. أقتربُ أكثر لأرى نساءً تصرخ، أطفالاً تبكي، جيش الاحتلال يضرب ويعتقل ويقتل.. نعم، إنها صور حقيقية من فيلم "عمل فدائي"، الفيلم الذي يوثّق نهب أرشيف مركز الأبحاث الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي عام 1982.
شاهدت الفيلم قبل سنتين وكان يقدّم خطاباً بصرياً؛ أذكر مشهداً منه يظهر فيه عسكري يسرق كرة طفل فلسطيني وهو يلعب، من دون تعليق، لتسليط الضوء على العنف اليومي الذي يمارسه الاحتلال، بالإضافة إلى العديد من الصور البصريّة عن المستوطنين وتهجير السكان الأصليين من بيوتهم.
أما اليوم، فالفيلم يُعرض كخلفية بصرية في مهرجان برليني تجريبي في غرفة معتمة، لا تسمع فيها سوى موسيقى غريبة وكل من حولك كأنما فقدوا عقولهم. تشاهد صور أهلك وأحبابك يصرخون ويهربون ويُعتقلون، والجمهور مستلقٍ على الأرض منتشياً ببعض العقاقير يشاهد ويحاول محاكاة ذاك الواقع مع كأس ويسكي أو فودكا، مُقدّم من "البارتندر"(الساقية) السيكسي التي ترتدي كوفيةً كحمالة صدر وتضع أقراط بطيخة.
أسأل نفسي: أين أنا كفلسطيني/ ة من كل هذا المشهد؟
هل كل هؤلاء مهتمون حقاً بي وبقضيتي؟ هل يعرفون أي شيء عن قصتي؟ عن تاريخي؟ عن المجاعة التي تفرضها إسرائيل الآن وفي هذه اللحظة في غزّة؟
طب ماذا يعني أن تكون فلسطينياً في كل هذا العراء الأخلاقي؟ وماذا يعني أن تشاهد كل هذه الجموع من الناس يحلبون قضيتك كما تُحلب بقرة عاقر ليُخرجوا منها مواد ينتشون بها ويعيشون لحظات تجريبيةً لم يعيشوها في حياتهم/ نّ؟
الحقيقة بـ"الصدمة"
هل يعرفون ماذا يعني أن تكون فلسطينياً في المطارات؟ في العمل؟ في استراحات الغداء عندما تمسك "هيلغا" بشطيرة الجبن وتضع رجلاً فوق رجل وتأخذ أول لقمة وتسألك: "لماذا تقولين عن حالك إنك فلسطينية وإنتي ما عشتي بفلسطين؟".
أضطر إلى أن ألغي نصف الساعة الوحيد للاستراحة لأشرح لـ"هيلغا" بلغة "حسّاسة" عن معنى النكبة والنكسة والانتفاضتين والاجتياح والأسر والقتل والمجازر والمجاعة… والإبادة، دون المساس بتاريخها الحافل.
هل تعرف تلك الساقية أنّ لبس أقراط البطيخة لا يعني شيئاً بالنسبة لي كفلسطيني/ ة؟ وأنّ كلمة حبيبي/ تي -التي لا تعرف غيرها من لغتي- لا تعني لي شيئاً، ولا شكر على الجهد؟
هل يعرف الأصدقاء غير الفلسطينيين/ ات أنهم/ نّ أحياناً غير حساسين؟ لماذا ينشرون محتوى لقضايا غيرهم/ نّ؟ وأنّ نشر صورتك على البحر مع تاتو عن المقاومة المسلحة لا يضيف لقضيتي شيئاً!
أنا آسفة! هل صدمتك؟ ربما يجب على أحدنا أن يقوم بذلك.
ولكن بجدّية! هل ارتداء البكيني على شكل بطيخة على شاطئ البحر هو تضامن مع القضية الفلسطينية؟
يقول البعض، هؤلاء الناس أفضل من غيرهم. على الأقل يتكلمون عن موضوع غزة وليسوا صامتين كالآخرين. أقول إن عدم احترام قضية شعب وثقافته لتحقيق مكاسب معيّنة؛ مادية أو اجتماعية، لا يُعدّ تضامناً إنما هو تسليع وركوب أمواج.
أن تكون فلسطينياً يعني أن تدحرّج كتلة من الأسئلة على شكل صخرة ثقيلة، تُجبر خلالها على اجترار تاريخ ألمك كلّه
هل كان مثلاً صعباً على "باميلا الكيك" أن تصمت في مهرجان "بياف"، وهي تضع الكوفية على كتفها وترتدي فستاناً أسود، بدلاً من اللمسات البراقة والفستان والخطابات الرنانة عن التضامن؟
إذا كان الهدف هو إظهار التضامن مع الفلسطينيين، فلماذا لا نقوم بالتضامن بشكله الصحيح؟ أو أنّ هناك أهدافاً أخرى من سانت ليفانت وحتى باسم يوسف؟
بالعودة إلى برلين المدينة التي أعيش فيها، منذ بداية الإبادة في غزة والمظاهرات لا تنطفئ فيها، على الرغم من الضرب والاعتقالات.
برلين مدينة تعيش فيها أكبر جالية فلسطينية في أوروبا، إذ تشير التقديرات إلى أنه يتواجد فيها نحو خمسين ألف فلسطيني تقريباً.
ومن شارع الزونن، المعرف بـ"شارع العرب"، ما إن تصرخ "فري بالستيان" حتى يصبح لصوتك صدى يعود إليك ولا ينتهي. التضامن في هذا الشارع محسوس وغير استعراضي، حتى الكتابات على الحائط تخاطب العرب فقط. هؤلاء العمّال في المطاعم، النساء اللواتي يجررن عربات الخضروات صباحاً، والجدّات اللواتي يجلسن في ساحة هند رجب (هيرمان بلاتس سابقاً).
المتقاعدون/ ات الذين/ اللواتي تحكي تجاعيد وجوههم/ نّ عن حياتهم/ نّ كلها، هؤلاء جميعهم لا يحتاجون إلى الاستعراض. هم موجودون هنا منذ حرب المخيّمات في لبنان، أغلبهم فلسطينيون/ ات ومعهم أشقاؤهم العرب الذين انضموا بعد حرب العراق وثم الهجرة السورية وتوالت الأحداث ليصبح هذا الشارع صوتاً واحداً. تضامن حقيقي وموجود.
"أنا من الطنطورة، على البحر. أكيد سمعانة بمجرزة الطنطورة. بس أنا بعمري ما رحتلها. أبوي إجا عاللادقية لأنّو كان صيّاد وما بيقدر يكون بعيد عن البحر. بعد النكبة ضلّينا بسوريا. وهياتني ببرلين بعيد عن البحر وعن فلسطين. بقعد كل يوم بهالساحة بتفرّج عالناس وبواسي حالي بإنو وضعي أحسن من الناس".
هكذا قال لي أبو محمود، الذي أراه يجلس كل يوم قرب عربة القهوة في الساحة. أبو محمود أيضاً لا يبدي اهتماماً بكل ما يحدث في ألمانيا. وفق رأيه، "راح كل شي يا عمي وهدول ما بيعرفوا شي عنا أو ما بدهم يعرفوا. بتعرفي، يمكن هيك أحسن".
يصفعني أبو محمود في كل مرة أتذكر فيها كلماته، وأعود لأفكر في برلين "مدينة الحريّات"، وهو الوصف الذي لم يعد صالحاً بمجرد أن ترى كل تلك الصور والفيديوهات التي تأتي من المظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية في الشارع.
كلب بكوفية
نعم يا عزيزتي القارئة ويا عزيزي القارئ، هذه البلاد التي تنادي بالحريات والديمقراطيات تنهار عند أول هتاف: "فلسطين عربية من الميّة للميّة"، ولكنها مسموحة إذا كان القائل نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى إسرائيل.
في مدينة الحريات المنتهية صلاحيتها، تنتابني الكثير من الأسئلة مؤخراً ولا إجابات عنها. أشعر بأنني قنبلة موقوتة ستنفجر بوجه أي أحد على الطريق، كذاك اليوم عندما رأيت كلباً يرتدي كوفية.
رؤية كلب يرتدي كوفيةً في المترو ذلك اليوم، كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. القشة التي جعلتني أذهب إلى صاحبة الكلب وأقول لها: أنا أعلم أنك تريدين التضامن مع القضية الفلسطينية، ولكن هل تعلمين أنّ هذه الكوفية كان يضعها أجدادي على رؤوسهم وأكتافهم؟ هذه الكوفية ارتداها جدّي في الأردن ولم يسمح لجدّتي بأن تغسلها عندما عاد إلى حلب بعد أيلول الأسود.
لم تفهم المرأة نصف ما قلته، وكانت مستغربةً جداً من قولي هذا. أجابت: أوه، لم أقصد أن أزعجك ولكن اشتريتها لكلبي "بوبو" الأسبوع الماضي من سوق متنقل، وشعرت بأنها ستكون "كيوت" عليه. الجميع يصرخ ابتهاجاً عندما يرون كلبي مرتدياً الكوفية، ولم يهاجمني أحد كما تفعلين أنتِ الآن.
لم أعرف ماذا، ولا من أين أبدأ، أو أين أنتهي، أو كيف أصبحت فجأةً الشخص المذنب في القصة. مشيت وأنا أفكر في كل الصور التي نراها لجنود الاحتلال وهم يرتدون ملابس داخليةً لنساء فلسطينيات كنّ قد عشن في منزل مهدّم.
مشاهدة كلب بكوفية في المترو أعادتني لصورة جدّي لما تعنيه هذه الكوفية بالنسبة لهُ ولي... كاستعارة للألم المتوارث
فكرت في زميلتي الألمانية التي قالت لي مرةً إنني في موقف لا أُحسد عليه لأنني فلسطينية وأشعر بالناس هناك، أما هي فلا شيء يعنيها من هذا كله.
فكرت في ذلك الشاب الذي يعدّ نفسه مناضلاً مرّاً ينشر كل يوم مئات الستوريات على إنستغرام عن الوضع الإنساني في غزة، ولكنه يذهب مساءً الى نادٍ ليليّ مموّل من "الأنتي دويتشه"، وهو تيار يساري ألماني يؤمن بحق إسرائيل في الوجود حتى بالقوّة، وبأنّ أيّ عداء لاسرائيل معاداة للسامية.
فكرت في كل تلك الصور التي يجلس فيها الجنود في أسرّة أطفال كانوا قد عاشوا وتمت إبادتهم في تلك البيوت.
سألت نفسي مرةً ثانيةً وثالثةً ورابعةً: لماذا هذا كله؟
حريّة منتهية الصلاحية
في ألمانيا، مع بداية حرب الإبادة على غزّة، لم تكن لدى الجميع القدرة على التعبير عن رأيه. كان الكلّ يخاف من وضع حتى "لايك" على "بوست"، حتى لا يتسبب ذلك في طردهم/ نّ من البلاد.
كثيرون من الناس الذين خرجوا في المظاهرات تعرّضوا للضرب من قبل الشرطة الألمانية، وبعضهم/ نّ تمّت محاكمتهم/ نّ لأسباب تبدو غير مهمّة، ولكن أثّرت في ما بعد في ملفاتهم كمهاجرين/ ات، مع تقييد حريّة الرأي في كل مكان وفي وجه أي شخص يقول إنه متعاطف مع الفلسطينيين/ ات.
كنا نقدّر أيّ أحد يقوم بحمل كوفية أو رفع علم أو ربما حتى رسم بطيخة على الحائط. كان شعوراً تضامنياً في المدينة يقول لك بأنّك لست وحدك مع كل هذا التخاذل العالمي.
ولكن الآن وبعد كل هذا الوقت، هل ما زال شخص لا يعرف ماذا يحصل في غزة؟
إذاً، لماذا يرتدي "سانت ليفانت" خريطة فلسطين المرصّعة بالألماس المزيف -أو الحقيقي- في فيديو كليب لأغنية مليئة بالإيحاءات الجنسية؟ ولماذا ترتدي فنانة استعراضية برلينية العلم الفلسطيني كفستان وترقص به على أغاني المقاومة؟ لماذا في برلين أصبح ارتداء الكوفية على المؤخرة تضامناً؟
لماذا تنشر تلك "الإنفلونسر"، "تشي غيفارا الإنستغرام"، صورةً لنفسها وهي تبكي لأنها رأت صورةً لطفل فلسطيني جائع، وفي الستوري التالية صورة لها وهي تستلقي على أحد الشواطىء، ثم تصف معاناتها منذ أن بدأت بنشر صور شعبنا؟
لماذا آلامنا مستباحة إلى هذه الدرجة؟
لماذا أصبح تسليع الموت شيئاً عادياً؟
مرةً أخرى أسأل: ماذا يعني التضامن ومتى تصبح القضايا سلعةً؟ ومتى يمكن للناس أن تسمع الضحايا، وأن تسمح لهم ولو لمرة بالتحدث عن ألمهم، عن هويتهم، وعن حياتهم!
منذ عام 1948 إلى الآن، ونحن الفلسطينيين أرقام، إما على كارت أزرق في خزائن الأونروا أو على شاشات الأخبار. لا يستطيع العالم أن يرانا بشكل آخر ولا يريد أن يسمع منا أيضاً.
متى كانت آخر مرة سألت صديقك الفلسطيني فيها: كيف حالك؟ كيف عائلتك؟ ما رأيك بكل هذا الهراء الذي يحصل؟ هل جرّبت مرةً أن تسأله كيف تستطيع المساعدة دون إقحام رأيك السياسي وانتظارك لتبريراته لتتضامن معه؟
اسأله عن قصته، عن بيت جدّته الذي يحلم بالعودة إليه يوماً، قبل أن تبدأ بتكوين آراء عنه وعن أهله وعن شعبه، وتحلل قضيته وكأنها مشاع، ثم تذهب إلى نادٍ مليء بالكوفيات تسمع أغنية "أنا دمي فلسطيني"، لتشعر بأنك قد فعلت شيئاً.
أنا آسفة مرّةً أخرى. هل أوجعتك؟ بالمناسبة: أنت تقوم بذلك لنفسك فقط!
تسألني فتاة ألمانية ترتدي الكوفية ويبدو لي أنها من جماعة " أنا دمي فلسطيني"، وتقول: "ليش ما بتلبسي كوفية كل الوقت؟"، أين كنتِ طوال الثلاثين سنةً من حياتي وأنا بلا جنسية، أتوقف من مطار إلى آخر لأنّ لا أحد يفهم سبب عدم حملي جنسية بلد عربي وُلدت فيه؟ أين كنتٍ عندما صرخ بي الأستاذ في الجامعة: وين مفكرة حالك بفلسطين؟ ما في شي اسمه فلسطين بح! عندما كنت أقدّم بحثاً عن أدب السجون. أين كنتِ عندما كان جدّي يقف في طابور استلام الإعاشة من الأونروا ليستطيع إطعام أولاده وبناته؟ أين كنتٍ وأنا أقول لموّظف مديرية الأجانب في ألمانيا: أنا فلسطينية، فيقول حطين في إسرائيل ليست في فلسطين وفي الأوراق السورية أنتِ بلا وطن! أين كنتِ وأنا أصرخ في وجه الجندي التركي كي يدخلني أنا وعائلتي إلى تركيا عندما كان السوريون يدخلون "عالهوية"، أما نحن الفلسطينيين المطرودين من الرّحمة فكان علينا أن ننام في حقل ونركض بإشارة من المهرّب قبل أن نُصاب بإحدى رصاصات الشرطة التركية الحدودية الطائشة؟ أين كنتِ في النكبة والنكسة والانتفاضة الأولى والثانية و و و؟".
أبتسم وأقول لها: أنا دمي فلسطيني!
ما هو التضامن؟ ربما أحياناً أن نصمت فحسب.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





