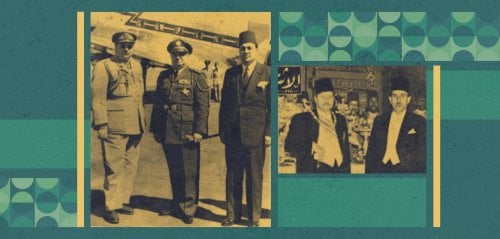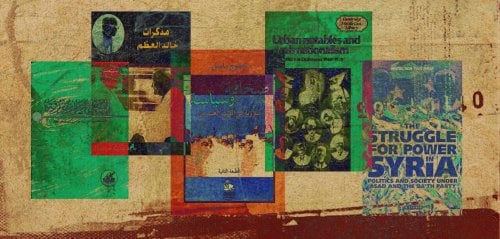على مدار تاريخها، مرت مدينة السويداء السورية بمنعطفات عديدة، فازدهرت في فترات، وعانت من الإهمال فترات أخرى وآل أمرها إلى أرضٍ خربة ومنفى للمغضوب عليهم، إلى أن قدم إليها الدروز واستوطنوها وعمروها، وأصبحت بؤرة للثورات في وجه القوى الخارجية.
السويداء في العصر الإسلامي
كانت السويداء أرضاً عامرة قبل الفتح الإسلامي لبلاد الشام. يذكر إسماعيل المُلهم وآخرون في موسوعة "سويداء سورية/موسوعة شاملة عن جبل العرب"، أنه حين تقهقرت الجيوش البيزنطية إثر اندحارها في معركة اليرموك عام 636هـ، قدِم الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب من المدينة المنورة إلى الشام بصحبة نخبة من كبار الصحابة، ليشرف بنفسه على تنظيم البلدان المُحررة في جنوب بلاد الشام، فولى الأمير مالكَ بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي، الملقب بـ"شهاب"، إمارة المنطقة الجنوبية من سوريا، أي سهل وجبل حوران التي تقع بها مدينة السويداء، وأوكل إليه رعاية الحج وحماية القوافل التجارية، واستمر الجبل جزءاً من الدولتين الأموية والعباسية.
وفي العصر الفاطمي، امتدت سلطة الفاطميين إلى الجبل، حيث وُجدت آثار تدل على ذلك في قلعة صلخد بالسويداء، وهي تعود إلى أيام المستنصر بالله الفاطمي (427-487هـ).
من أسباب انتقال الدروز من مناطقهم إلى السويداء في جبل حوران، الحملات العثمانية المتكررة، وبطش الأمراء، ما دفع كثيراً من الدروز إلى الهرب والتمرد، والرغبة في تشكيل منطقة استقرار جديدة
وحين بدأت الحروب الصليبية كان سكان الجبل يصدونها، وتمركز الأيوبيون فيه وبنوا الحصون والقلاع، وكان لصلاح الدين بصمات بارزة في مدينة صلخد بعد نصره في معركة حطين عام 583هـ، حيث أقطعها لابنه الأفضل علي (من 592-597هـ)، بحسب ما يروي المُلهم وآخرون.
وازدهرت صلخد حين أقطعها عيسى ابن الملك العادل أبو بكر الأيوبي لقائده عز دين بن أسامة عام 608هـ، والذي ترك آثاراً مهمة، منها المئذنة والمسجد والخان في منطقة سالة، شرقي السويداء، كما أسس في بلدة "عيون" قرب صلخد مسجداً.
ثم انتقلت صلخد عام 644هـ إلى الملك الصالح نجم الدين بن أيوب، وورثها من بعده ابنه طوران شاه، ثم استقرت تحت حكم الظاهر غاز عام 658هـ، إلى أن وقعت بعد ذلك بيدي كتبغا المغولي الذي هدمها، ولكنها حين آلت إلى الظاهر بيبرس أصلحها وجدد فيها، ثم انتقلت إلى يد ولده السيد بركة خان، وحين تخلص المماليك من خطر الصليبيين والمغول أُهملت المنطقة لتصبح منفى للمغضوب عليهم، بحسب المُلهم وآخرون.
توطين الدروز في جبل حوران
وفي مرحلة لاحقة قدم الدروز إلى جبل حوران من مناطق وادي التيم وجبال لبنان، والجبل الأعلى بقرب حلب، وكذلك جبال الكرمل في فلسطين، لكن لا توجد تواريخ محددة لهذا القدوم، حسبما يذكر برجيت شيبلر في كتابه "انتفاضات جبل الدروز- حوران... من العهد العثماني إلى دولة الاستقلال 1850- 1949".
ويوضح شيبلر، أن سجل الضرائب العثماني لسنة 1596م لا يُفصّل ما إذا كان بين دافعي الضرائب دروز أم لا، كما أن موسوعة "الأشرفاني"، وهي مصدر درزي قديم في وصف مساكن الدروز في النصف الأول للقرن السابع عشر، لم تذكر أيضاً قرى درزية في حوران.
لكن بحسب الرواية الشفهية في الجبل نفسه والمسجلة لدى مختلف المؤلفين في هذا القرن، فإن تاريخ الدروز في جبل حوران بدأ مع سنة 1685، حيث قدم إلى جبل حوران الأمير علم الدين المعني ومعاونه حمدان الحمدان على رأس حملة من مائة إلى مائتين فارس، ولما عاد المعني إلى لبنان أوكل حمدان مكانه، بحسب شيبلر.
وبعد مدة، التحق خليل الحمدان بابن عمه حمدان آتياً من بلاد صفد على رأس حملة، فقوي حمدان به وأسسا مشيخة "آل الحمدان" التي تمتعت بنفوذ قوي حتى أسقطها آل الأطرش سنة 1869. وبحسب شيبلر، قيل كثيراً إن الدروز الأوائل الذين دخلوا إلى جبل حوران قد وجدوا هناك وجوداً درزياً، ولكن هذه الروايات تفتقد إلى مصادر موثقة.
ويبدو أن هجرة الدروز الثانية قد تمت سنة 1711 بعد معركة عين دارة بين قبائل القيسية واليمنية، حيث هُزمت اليمنية بزعامة الأمير علم الدين المعني، فنزح اليمنيون إلى جبل حوران.
كذلك كانت من نتائج المعارك التي قادها أحمد باشا الجزار حاكم إيالة صيدا، والذي كان يسعى إلى السلطة في لبنان في تسعينيات القرن الثامن عشر، قدوم مهاجرين جدد من الدروز إلى حوران.
ويقال إن الأمير بشير الثاني الشهابي، أحد أمراء جبال لبنان، أبعد سنة 1803 بعض أعدائه من المنطقة، فاستقروا في جبل حوران أيضاً. وفي سنة 1811 نزحت نحو 1500 عائلة من الجبل الأعلى في حلب بعد أن طردهم حاكم جسر الشغور طوبال علي وجنوده من منازلهم، ويقال إن قسماً منهم قد حل في جبل حوران، حسبما يذكر شيبلر.
الهروب من بطش العثمانيين
ومن أسباب انتقال الدروز من مناطقهم إلى السويداء في جبل حوران الحملات العثمانية المتكررة، وبطش الأمراء، ما دفع كثيراً من الدروز إلى الهرب والتمرد، والرغبة في تشكيل منطقة استقرار جديدة، كما يذكر شوكت غرز الدين في دراسته "تكوين السويداء السياسي 1516- 1927… سياق تشكيل النزعتين المحلية الدرزية والقومية العربية".
واختار هؤلاء الدروز منطقة السويداء لأنها ملاذ آمن، لكونها منطقة وعرة لا يصل إليها العثمانيون بحملاتهم إلا بصعوبة، وهي منطقة خربة ليس فيها دفع ضريبة، كما أنها كانت معروفة وقريبة نسبياً بالنسبة إليهم وتشبه المناطق الجبلية التي فرّوا منها، وربما تساعدهم على شيء من الاستقلال والاكتفاء الذاتي نتيجة تراخي قبضة العثمانيين على مثل هذه المناطق.
على كلٍ، أخذت قرى جبل حوران القديمة تعمر بهؤلاء المهاجرين، وأرضه البركانية الحمراء تُزرع بأنواع الحبوب والبقول والفاكهة، بعد أن أوقف البدو الرحل نشاطهم العدائي وغزواتهم على سهل حوران، وأخذ هؤلاء المهاجرون يعيشون كمجموعات عشائرية في القرى التي أعادوا بناءها بجانب الخرائب القديمة. لكن هذا لا يعني سيادة الأمن والطمأنينة، ففي عام 1811 خاضوا صراعاً مسلحاً مع الوهابيين الذين حاولوا الوصول إلى دمشق عن طريق جبل حوران، كما أن المناوشات بينهم وبين البدو كانت مستمرة، وفق ما يذكر المُلهم وآخرون في كتابهم المذكور آنفاً.
ظهور النزعة الدرزية في السويداء
هذا الاستقرار الدرزي في جبل حوران، والذي سُمي في ما بعد بجبل الدروز، أدى إلى نشوء نزعة محلية درزية تعلي شأن عدد من القيم، مثل التضحية بالنفس دفاعاً عن العرض والأرض والدين. وبحسب غرز الدين في دراسته المذكورة آنفاً، تمثل أول تجسيد لهذه النزعة في المعارك التي خاضتها السويداء ضد إبراهيم باشا بن محمد علي عامي 1837- 1838. ففي بداية الوجود المصري في الشام أُعفيت السويداء من التجنيد ومن نزع السلاح على نقيض ما حدث في كثير من المناطق، وذلك ليتمكن الدروز من حماية أنفسهم من عشائر البدو، لكن في مرحلة لاحقة طُلب منهم مئة وسبعون شاباً لتأدية التجنيد.
وإزاء هذا المطلب، اتجه يحيى الحمدان، شيخ مشايخ السويداء، إلى شريف باشا، حكمدار دمشق، وحاول ثنيه عن هذا القرار وإقناعه بدفع بدل عن خدمة هؤلاء الشباب، لكن شريف باشا رفض بل وأهان الحمدان، فاعصتم الدروز الرافضون في منطقة "اللجاة" في جبل حوران، وتحالفوا مع بدو "الصلوط" المتضررين أيضاً من سياسة إبراهيم باشا، وانضم إليهم بعض الفارين من التجنيد من الطوائف كلها، وبعضهم من درعا ونابلس ووادي التيم وعجلون.
وعلى الفور، أمر حكمدار الشام بتسيير حملة عسكرية من أربعمائة فارس بقيادة علي آغا البصيلي في تشرين الأول/أكتوبر 1837، لكن الدروز أوقعوا بهم هزيمة نكراء ولم ينج من الحملة سوى ثلاثين فارساً، فأمر الحكمدار بتسيير حملة ثانية بقيادة محمد باشا في كانون الثاني/ يناير 1838 مكونة من ثمانية آلاف مقاتل، ولم تنجح هي الأخرى، ثم سُيرت حملة ثالثة بقيادة أحمد مينكلي باشا ولاقت نفس المصير.
وأمام هذا الفشل المتلاحق، سارت حملة رابعة بقيادة إبراهيم باشا نفسه، حاول فيها ردم برك الماء للضغط على الثوار ليستسلموا، وكاد أن ينجح، لكنه أصدر عفواً، فسلّم الثوار سبعمائة بندقية من سلاحهم وألفي بندقية من السلاح الذي استولوا عليه، وذلك لتعهد إبراهيم باشا بأنه سيعيد النظر في التجنيد وعدم مصادرة السلاح. وفي عام 1840، وبضغط أوروبي، انسحب إبراهيم باشا تاركاً سوريا للعثمانيين من جديد. وبحسب غرز الدين، كان من أهم نتائج هذه المعارك التحالف بين الدروز والبدو والحوارنة أمام الأخطار الخارجية.
على مدار تاريخها، مرت مدينة السويداء السورية بمنعطفات عديدة، فازدهرت في فترات، وعانت من الإهمال فترات أخرى وآل أمرها إلى أرضٍ خربة ومنفى للمغضوب عليهم، إلى أن قدم إليها الدروز.
أما ثاني تجسيد للنزعة المحلية الدرزية في السويداء فتمثل في معركة صد حملة قبرصي باشا في منطقة أزرع عام 1852، بعدما عاد العثمانيون إلى ممارسة سياسة إبراهيم باشا في الضريبة والتجنيد الإجباري ونزع السلاح، وأمام رفض الدروز لهذه السياسة بدأت الحملات العثمانية على السويداء ودرعا، لكنها منيت بالهزيمة.
وتجلى التجسيد الثالث لهذه النزعة في الانتفاضة العامية عام 1889-1890، وهي انتفاضة فلاحية بدأت جنوب شرق السويداء وضمت تحالفاً واسعاً من الفلاحين والمرابعين (عمال يزرعون الأرض مقابل الحصول على ربع المحصول)، للمطالبة برفع الظلم الواقع على الفلاحين من جهة المتسلطين الدروز والملتزمين والمقاطعجية وشيوخ المشايخ. يشير غرز الدين إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يقف فيها فلاحو الدروز في وجه شيوخهم، خاصة بعدما لجأ شيخ مشايخ السويداء آنذاك إبراهيم الأطرش إلى استقدام العثمانيين للقضاء على هذه الانتفاضة، كعادة المقاطعجية منذ القدم عندما تتعرض مصالحهم الشخصية للخطر.
وأسفرت هذه الانتفاضة العامية عن نتائج مهمة، منها حصول الفلاحين على بعض حقوقهم، ونشأة تنظيم "الزغّابا" عام 1893 في صلخد، بوصفه تنظيماً أهلياً تطوعياً يهدف إلى وقف الاعتداءات ومساعدة المغلوبين.
السويداء والثورة العربية الكبرى
من المحطات التاريخية المهمة لمدينة السويداء أيضاً مشاركتها في الثورة العربية الكبرى، وذلك لأسباب عدة، منها سياسة السلطان عبد الحميد الثاني، وسياسة الاتحاديين المنقلبين على السلطان عبد الحميد عام 1908. يروي غرز الدين، أنه في عام 1896 سيرّت الدولة العثمانية حملة إبادة من ثلاثين ألف رجل بقيادة أدهم باشا إلى السويداء، في سياق خلافات مع الحوارنة، فاحتلت الحملة السويداء، وقتلت ونفت آلافاً.
وفي عام 1910 سيرّ العثمانيون حملة أخرى بقيادة سامي الفاروقي، ونزعت سلاح الدروز، وأخذت بعض الشبان إلى التجنيد، ونفذت إعدامات بين صفوف الدروز، وهو ما أثار تعاطف الدمشقيين معهم، ونُظر إليهم باعتبارهم ثواراً ضد العثمانيين.
ومع مرور الوقت أصبحت السويداء ملجأ للثوار ضد الحكم العثماني، وطريقهم للتواصل والتنسيق. ويذكر غرز الدين أنه في البداية بدت النزعة القومية إصلاحية، لأنها لم تسع إلى فصل الولايات الناطقة بالعربية عن الإمبراطورية العثمانية، ولا إلى إيجاد أمة عربية ذات حدود إقليمية وثقافية، بيد أنه سرعان ما انتقلت هذه النزعة إلى المرحلة الثورية في ثورة 1916 من خارج سوريا وبمساعدة بريطانية لتقوم وحدة المملكة العربية السورية 1918.
ويذكر المُلهم وآخرون في موسوعتهم عن السويداء، أنه خلال الحرب العالمية الأولى حاول جمال باشا (السفاح) أن يوقف تيار الحركة العربية التي تناضل للاستقلال عن الدولة العثمانية في بلاد الشام بتقربه من بعض أعيان جبل الدروز، لكنه لم يوفق إلى ذلك، وظل العديد من قرى الجبل ملجأ أميناً لشخصيات عربية مناهضة للحكم العثماني، إلى أن أُعلنت الثورة العربية الكبرى في الحجاز عام 1916، فكان سلطان الأطرش في مقدمة من انضوى تحت لوائها حينما رفع العلم العربي الذي أهداه إياه الشريف حسين بن علي وحمله إليه المجاهد الدمشقي نسيب البكري، إذ رفعه فوق داره ببلدة "القريا"، ثم جهز حملة كبيرة من فرسان الجبل، وسار على رأسها من أعيان الجبل، أسد الأطرش، وحمد البربور عبد الله العبد الله، ومعذى المغوش، وتوجهوا الى العقبة بهدف الالتحاق بالجيش الفيصلي قبل أن تنتظم صفوفه لدخول أرض الأردن.
ولما بلغ الجيش الفيصلي في تقدمه شمالاً مدينة درعا كان سلطان الأطرش قد أعد كتيبة أخرى من فرسان الجبل ليقودها بنفسه الى دمشق، وقام بمهاجمة قوة عثمانية متمركزة في سفوح تلول "المانع"، لتكون كتيبته أول من تدخل دمشق في 30 أيلول/سبتمبر 1918، قبل وصول الجيش الفيصلي، ورفع رجالها العلم العربي على سارية دار الحكومة بعد إنزال العلم التركي عنها.
ثورة السويداء على الانتداب الفرنسي
سرعان ما تبدد أمل الدروز في التحرر من الحكم العثماني بعدما مُنحت فرنسا حق الانتداب على سوريا ولبنان، عقب هزيمة قوات الأمير فيصل في معركة ميلسون عام 1920 واحتلال القوات الفرنسية بلاد الشام، لكن الوقت لم يطل كثيراً حتى بدأت حركات التمرد والثورة تظهر في مختلف أنحاء بلاد الشام، وكان أبرز تلك الثورات وأطولها عمراً ثورة دروز جبل حوران ضد الفرنسيين عام 1925، وفق ما يذكر عباس بو صالح، وسامي مكارم، في كتابهما "تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي".
وبحسب صالح ومكارم، لم تكتف فرنسا بالحيلولة دون قيام دولة عربية مستقلة، بل عملت أيضاً على تقسيم البلاد السورية وخلق دويلات جديدة على أساس إقليمي وطائفي. فبعد إنشاء دولة لبنان قُسمت سوريا إلى أربع دويلات مستقلة بعضها عن بعض، هي دولة حلب ودولة جبل العلويين ودولة دمشق ودولة جبل الدروز.
ثم أعيد النظر في هذا التقسيم سنة 1922، فأقيم اتحاد ثلاثي بين دويلات دمشق وحلب وجبل العلويين، ثم عُدّل هذا القرار بسلخ دولة جبل العلويين عن هذا الاتحاد، وجعل حلب ودمشق دولة واحدة اسمها الدولة السورية، فيما أُبُقي جبل الدروز منفصلاً عن هذه الدولة، وذلك إمعاناً في سياسة التجزئة الطائفية.
ولم تكتف سلطات الانتداب بالتجزئة السياسية، بل أقامت حواجز جمركية وزادت الضرائب، وحصلت معاش الموظفين ونفقات الجيش من الموارد الضريبية التي فرضتها على السكان. وبدلاً من أن تبعث الحكومة الفرنسية بخبراء وموظفين أكفاء لتدريب الموظفين المحليين على إدارة شؤونهم كما ورد في مشروع الانتداب، بعثت موظفين مُشبعين بروح استعمارية ومشهورين بعدم الكفاءة، فأساءوا إلى سكان البلاد الواقعة تحت الانتداب. ولكن تذمر السكان بشكل خاص كان من دائرة الاستخبارات التي فرضت عليهم جواً من الإرهاب وأخذت توزع عليهم التهم، حسبما يذكر صالح ومكارم.
ولم يكن الدروز في جبل حوران أقل استياء من بقية الوطنيين السوريين تجاه سياسة الانتداب، فالتفوا حول سلطان باشا الأطرش، وقام بانتفاضته الأولى ضد الفرنسيين في 1921، والتي مهدت لثورته الكبرى عام 1925 حيث هاجم مع الثوار سرايا الحكومة ومقر البعثة الفرنسية وأحرقوها.
غير أن السلطات الفرنسية لم تتأخر عن إرسال قواتها من أجل القضاء على الثورة في مهدها، فخرج القومندان نورمان على رأس حملة عسكرية إلى صلخد والتقى بقوات سلطان الأطرش في موقعة الكفر في 21 تموز/يوليو 1925، ومنيت القوات الفرنسية بهزيمة نكراء.
وسرعان ما جهزت السلطات الفرنسية حملة عسكرية جديدة أسندت قيادتها إلى الجنرال ميشو، والذي سار نحو السويداء لإنقاذ الجنود الفرنسيين المحاصرين في قلعهتا، فالتقى قوات الدروز في معركة المزرعة في 2-3 آب/أغسطس 1925، وانتهت المعركة بهزيمة ثانية للفرنسيين، كما يروي صالح ومكارم.
من المحطات التاريخية المهمة لمدينة السويداء مشاركتها في الثورة العربية الكبرى، وذلك لأسباب عدة، منها سياسة السلطان عبد الحميد الثاني، وسياسة الاتحاديين المنقلبين على السلطان عبد الحميد عام 1908
وشعر الفرنسيون أن خطراً حقيقياً يحيق بهم فلجأوا إلى المفاوضات، وسعوا إلى الوصول إلى اتفاق مع ثوار الجبل، وفي هذه الأثناء وصل وفد دمشقي من زعماء حزب الشعب للتشاور مع سلطان باشا لتعميم الثورة في أنحاء سوريا، ومن ثم قُطعت المفاوضات وانتقلت الثورة إلى مرحلة جديدة شملت عدداً من محافظات القطر.
وفي الثالث والعشرين من آب/أغسطس أصبح مركز الثورة في منطقة المقرن الشمالي، وأذاعت الثورة بياناً موجهاً إلى العرب السوريين بتوقيع سلطان الأطرش قائد جيوش الثورة الوطنية العام، يدعوهم إلى الثورة على الفرنسيين، أعقبه تشكيل مجلس وطني لقيادة الثورة، ومجلس وطني له مهام متعددة، وكذلك محكمة ثورية تنظر في قضايا الخيانة والتجسس.
وعلى الصعيد العسكري، شن ثوار الدروز هجوماً على دمشق في الرابع والعشرين من آب/أغسطس، لكنهم لم يتمكنوا من دخولها بسبب كثافة الطيران الفرنسي وعدم استعداد دمشق لنجدتهم. وبعد هذا الفشل انتقلت فرنسا إلى الهجوم فكانت معركة المسيفرة يومي 16 و17 أيلول/سبتمبر والتي انتهت بهزيمة الثوار، وبعد ذلك دخلت القوات الفرنسية إلى مدينة السويداء.
اندماج السويداء في الدولة السورية
وفي 7 أيلول/سبتمبر 1944 اجتمع مجلس محافظة السويداء وقرر بالإجماع الاندماجَ النهائي في سوريا الأم وإلغاء الامتياز المالي والإداري، على أن تبقى أحكام الشرع الدرزي مُطبّقة في المحاكم المذهبية الدرزية دون مساس، وفق ما يذكر المُلهم وآخرون في موسوعتهم.وابتداء من 20 أيار/مايو 1945 تحولت السويداء إلى مسرح لاجتماعات الشباب الوطني والعسكريين من أبناء جبل الدروز، بعد مماطلة الفرنسيين في الجلاء من سوريا، وفي 28-29 من نفس الشهر قام الشباب بحركة انقلابية على السلطات الفرنسية، ورفع العلم السوري فوق الثكنات العسكرية والدوائر الرسمية، واعتقل المندوب الفرنسي "سارازان" وسائر الضباط الفرنسيين الموجودين في السويداء، وامتدت هذه الحركة لتشمل كلاً من صلخد وشهبا وسائر نواحي الجبل. وفي عام 1946 نالت سوريا استقلالها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.