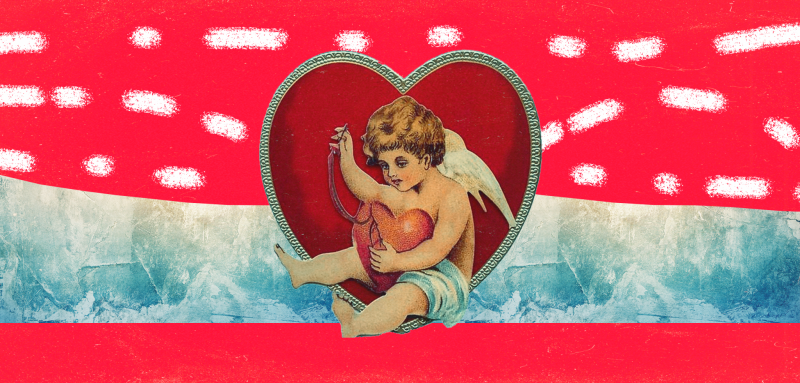يمرّ عيد الحب برومانسية تكاد تكون تامة، تمرّ المناسبة في بيوتنا وبلادنا العربية من المحيط إلى الخليج كحدث حلو المذاق، عيد تنتشر فيه باقات الورود، وهي كذلك فعلاً، إذ بمقدور الورود أن تحمل معانيها.
يمرّ العيد الجميل محتضناً تعابيرنا ومشاعرنا لمجموعات وأصناف من الحب: هو عيد حب العائلة، عيد حب الزوج والزوجة، عيد حب الأم، عيد حب الاولاد، عيد حب الجد والجدة وغيرها من التعابير التي أسميها تعابير الحب المتاحة والمقبولة في صالونات بيوتنا والفضاءات العامة، أو بمرادف آخر، هي تعابير الحب "الشرعي".
في هذه الصالونات وفي هذا الفضاءات العلنية، وبطريقة فهلوية، غاب ويغيب وجه مركزي للحب، يغيب هذا الحب الذي يربط بين روحين وجسدين، علاقة الحب بين ذكر وأنثى (أو مثلية)، علاقة ما قبل الزواج وما قبل الخطبة. إنه الحب المركزي المجازف، هذا الحب الحميمي، أول العشق وأول الشرار العاطفي.
حين نحتفل بعيد الحب، هناك إقصاء لعلاقات الغرام والعشق التي تحدث خارج حدود وطاعة القبيلة، العلاقات التي تعتبر بنظر غالبية مجتمعاتنا العربية الذكورية "جريمة"، فكل أشكال الحب في العلاقات الممأسسة لها مكان في الخطابات العلنية عن الحب واحتفاليات الحب.
الحب المتاح والمقبول في صالونات بيوتنا والفضاءات العامة، هو الحب "الشرعي".
في عيد الحب لا نتحدث عن كون العلاقات الغرامية مخالفة اجتماعية ودينية، لا نتحدث عن مأزقنا في قمع الحب وكبته، لا نتحدث عن الحب كحالة سرية عند معظمنا في فترة ما من حياتنا. في هذا اليوم المزين بالورود لا نتحدث عن أطنان الغرام الذي يولد في المدارس، في الجامعات، في الحانات، في الحفلات، في أماكن وميادين مختلفة. تولد وتشتعل العلاقات العاطفية، لكنها تبقى علاقات مختبئة، ما دامت لم تتمأسس وتتخذ توقيعاً اجتماعياً وذكورياً بالأساس، ليتمخض عنها مشاريع خطبة وزواج.
بديهية الحب وبديهية قمعه
نحتفل بالحب الواقع في مساحة الإجماع، الحب الذي يحدّثنا عن الحياة والأمل والتضحية والعطاء، هو الحب البديهي، مهرجان للحب يُقصي مجموعة "الغرام".
ملايين القلوب والأجساد التي تعيش قصص الحب والغرام الآنية تختبئ بهذا اليوم وغير مرحب بها، وإن أقدمت على طرق الباب ستلقى العقاب والصد.
في هذا اليوم لن نتحدث عن الحريات، عن الحب الذي يدفع بالأب لحبس ابنته، أو يدفع بالأخ لضرب أو قتل أخته. هذه المقالة قد "تفقِس" الاحتفالية وتعكر الأجواء الانتقائية لأنواع الحب المسموح به علانية. ولا بأس من تحمّل مسؤولية وعقبات تعكير الأجواء إذا كان هذا اليوم، وليس هذا اليوم فحسب، هو يوم الصمت عن حق المرأة في علاقاتها. في الفالنتاين، بنسختنا العربية على الأقل، يبدو الحب بديهياً وملائكياً، ما دام لا يتناول أحاسيس الهوى، الوله والولع التي تحرك العواطف، الحواس، الرغبات وملذات الجسد، وكأننا كائنات من خارج هذا الكون، متجاوزين لطبيعتنا البشرية، متجاوزين لطبيعتنا الاجتماعية.
حين نحتفل بعيد الحب، هناك إقصاء لعلاقات الغرام والعشق التي تحدث خارج حدود وطاعة القبيلة، العلاقات التي تعتبر بنظر غالبية مجتمعاتنا العربية الذكورية "جريمة"
هي سهرة للمحابس
في عيد الحب تنتشر السهرات الموسيقية: "نحتفل بالفالنتاين على أنغام الدي جي الفلاني أو الفرقة الفلانيّة…". هكذا تتدفق الإعلانات على شبكات التواصل وكأن الفالنتاين شامل للجميع. في الحقيقة، ومن دون أن تكون هناك قوانين وأنظمة مكتوبة، فإن معظم هذا الأمكنة بمناسبة مشابهة، هي ضمنياً وفعلياً، مساحة للأزواج المتصلين بعقود اجتماعية، خطبة وزواج، ويحملون رخصة أو إجازة هي عبارة عن محبسٍ بإحدى اليدين، أو إشارة أو علامة أخرى من علامات العقد الاجتماعي الزوجي، تمكّنهم من الاشتراك العلني في عيد الحب.
أما العلاقات الغرامية التي يخوضها الكثيرون بمستويات مختلفة ولم تخضع لمباركة اجتماعية أهلية، فتبقي بغالبيتها المطلقة في الخلف، وراء الكواليس، في اللقاءات المنفردة المنزوية، أو في الحانات والبارات في المدن الكبرى، بعيداً عن البلدات والقرى الصغيرة تفادياً للإشاعات، بعيداً عن القيل والقال، بعيداً عن أعين الناس وأعين الأوصياء، وعن أعين حراس العادات والتقاليد، حرّاس النسيج الاجتماعي وحراس سمعة العائلة.
غالباً ما يكون الاختيار بالابتعاد عن الأضواء والاحتفال سراً هو قرار الفتاة/المرأة، فهي الأكثر عرضة للملاحقة والتهديد والعقاب في مجتمع ذكوري يكون فيه سلوك الفتاة، وليس سلوك الفتى/الرجل هو مركز سمعة العائلة.
في دول ومجتمعات تعمل فيها دوائر بوليس للأخلاق تقبض على العشاق أينما وجدوا.
وهكذا تبدو الصورة في عيد الحب: لا مكان لعلاقات الحب التي "تلطخ" سمعة ومكانة العائلة أو بالتحديد "مكانة ذكورها". نحتفل بعيد الحب ومعظمنا، وإن أردنا أن لا نتهم بالمبالغة، فالكثيرون منا يطلقون أوصافاً على من تقيم علاقة الحب والغرام بـ "السايبة" و"الدايرة ع حل شعرها"، وهذه الأوصاف هي بمثابة أحكام لها تداعيات جدية ومصيرية. وإن كانت هذه الفتاة قد خاضت تجارب حب وغرام متعددة إضافية، يتخللها أنماط حياة كالرقص وشرب الكحول والدخان، فهي ليست بعيدة أن تصبح بنظر العقيدة الذكورية "شرموطة".
في مجتمع يعتبر الكثيرون من أبنائه أن جريمة الشرف ضد من تتمرد وتمنح نفسها وجسدها استقلاليته وحريته في اختيار علاقات الحب والغرام، هي عمل بطولي وجدعنة. وهؤلاء لن يترددوا بالافتخار بأن هذا النَص المقدم أمام القارئ يمثلهم، ويفتخرون بأنهم أبطاله وأنه لا مكان لـ" فساد الأخلاق" و"الرذيلة" في صلب صنف الحب هذا، في حين قد يذهب البعض للتحفظ على ما جاء في وصف لاحتفالية عيد الحب الانتقائية الاقصائية، واصفاً إياها بالمبالغة وإساءة لصورة مجتمعنا، أو أنه "ضروري ننشر غسيلنا الوسخ". وبالتأكيد هناك شريحة، وغالباً هي شريحة صامتة، قد تعتبر كتابتي هذه انعكاساً وتصويراً للواقع دون تجميل، فبعضهم قد يكونوا ممن عانوا ويعانون من الإقصاء والملاحقة والعقاب على خلفية علاقاتهم الغرامية.
هكذا تبدو الصورة في عيد الحب: لا مكان لعلاقات الحب التي "تلطخ" سمعة ومكانة العائلة أو بالتحديد "مكانة ذكورها"
مأزق الخروج من البوتقة
موقف إنكار الواقع الاجتماعي وتجنب مواجهة النفاق الاجتماعي والإقصاء في عيد الحب، بل الذهاب إلى تبني واقع وهمي مثالي، واقع مصطنع نموذجي، هو موقف، غالباً ما ينبع من شرائح اجتماعية وطبقية تحظى بدرجات من التحرر ويحظى أفرادها أيضاً بمعيار محسوب من الحرية الفردية، ترى في واقعها الخاص تمثيلاً للواقع، تتخذ من المشهد الخاص في بوتقتها الطبقية كتمثيل للمجتمع والتغيير "الحاصل" فيه، وقد يصل بهم الحال لرؤية واقعهم تمثيلاً للواقع الكلّي. بعض هذه الشرائح أو أغلبها صاحبة مواقف محافظة، تسعى لأن توازن بين مواقف وامتيازات طبقة برجوازية أو إنتلجينسيا أكاديمية أو مثقفة تتميز بها، وبين مواقف محافظة لا تعترض وتتقبل مقولة وجوهر "الحفاظ على النسيج الاجتماعي".
وطبعاً في واقعنا، لا مكان للحديث عن الحب المثلي، فهذا الصنف من علاقات الحب يعتبر صنفاً مريضاً، شاذاً، متطرفاً، وغير وارد أصلاً في الرؤى الاجتماعية السائدة وضعه على محور العلاقات
بين المعتقدات والمفاهيم المهيمنة على حدود وسقف الحب والغرام، وبين هذه الطبقة أو تلك البوتقة، وادعاءات الواقع الوردي، يتم إعدام العديد من العلاقات ويتم اختناق بعضها. بين رومانسية الاحتفالية المجتمعية العائلية وبين أريحية الجدل الطبقي حول الحب، تعيش قصص الحب خوفها ورعبها. وبين هذا وذاك، تبقى الهيمنة الذكورية على مساحات الحب وتموت الكثير من علاقات الغرام، وخصوصاً تلك العلاقات التي تحاول تجاوز الحدود الطائفية.
وتقمع أيضاً العديد من العلاقات بسبب الخلفيات الطبقية والاجتماعية "المتنافرة" لطرفيها، وطبعاً في واقعنا، لا مكان للحديث عن الحب المثلي، فهذا الصنف من علاقات الحب يعتبر صنفاً مريضاً، شاذاً، متطرفاً، وغير وارد أصلاً في الرؤى الاجتماعية السائدة وضعه على محور العلاقات. في عيد الحب لا تكتفي الرؤى الاجتماعية السائدة بإقرار المسموح من الحب والممنوع منه، ولا تمتلك حراساً كالأب والاخ والعم لتطبيق "شرع" الحب فحسب، بل تنضم للأدوات التنفيذية، المجتمعية والأهلية هذه، أذرع الدولة وبوليسها الأمني والاخلاقي: في دول ومجتمعات تعمل فيها دوائر بوليس للأخلاق تقبض على العشاق أينما وجدوا، وتمثّل بقصصه في الصحافة والمحاكم، تبقى احتفالية الحب منقوصة، معطوبة وموجعة حتماً.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.