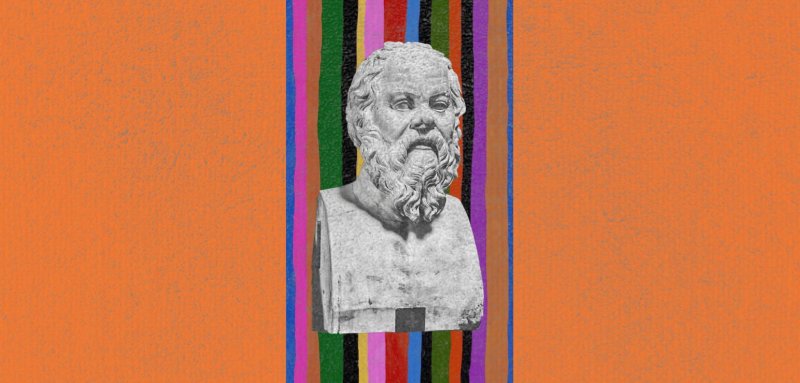تروي الأساطير الجرمانية قصةً عن شعبٍ من الشعوب التي عاشت على أراضي شبه الجزيرة الإسكندنافية قبل 5000 عام قبل الميلاد، كانوا قد اعتادوا أن يبذروا أراضيهم وعقب الشتاء يكون الحصاد بعد أن يكون المطر قد روى الأرض، وهكذا يعتاشون عاماً بعد عام، إلا في تلك السنة التي لم تمطر فيها السماء، ولم تُنبت الأرض ما فيها، حيث اجتمع الفلاحون ليفكروا بهذه الكارثة التي حلت بهم، فقال أحدهم: يبدو أن الإله "ثور" (إله الخصوبة والطقس) قد تعثرت عربته وهو في طريقه إلى أراضينا فلم يملأ السُحب بالمطر. وقال آخر: إنه لم يتعثر إلا من فرط خطايانا، أو إننا لم نعطه القدر الكافي من القرابين هذا العام. بهذا التفكير البدائي استطاعوا أن يعلقوا الكارثة على أسبابٍ ما ورائية تريحهم من عناء مواجهة حقيقة أن عليهم إيجاد بديل، لكنهم فضّلوا أن يموتوا جوعاً مطمئنين أن هذا هو قدرهم، وتلك هي مشيئة الآلهة.
هكذا اعتاد أن يفعل الإنسان في سحيق التاريخ قبل تَشكُل الحضارات، وبناء الأنا الإنساني القادر على التحليل والنقد، أي قبل إدراكه لهويته الفردية الإنسانية، والبدء بتثمين قيمة الحياة والصراع من أجل الاستمرار لا من أجل النجاة فحسب، بهذا المعنى نستطيع أن نجد عذراً لذلك الإنسان البدائي الذي كان يعيش كأي كائن حي آخر لا يدرك أنه موجود، فقط ينساب مع الطبيعة عاجزاً عن إدراك أن بمقدوره أن يتحكم بها، أو على أقل تقدير أن يُغيرَ فيها بما يضمن استمراره.
لكن كيف يمكننا أن نجد عذراً لشعوبٍ معاصرة تركت عقلها للغبار والرؤية الدينية الرجعية التي تعيد تمثيل عصر الآلهة والقوى الماورائية، مع فارق أن إنسان ما قبل الحضارة كان يعيش الحالة البدائية بشكل طبيعي تلقائي، أي لم يكن الامتثال للوهم يفرض عليه فرضاً كما يحدث مع تلك الشعوب التي لا تجد مشكلة في الخضوع لنظامٍ لاهوتيٍ جديد رغم كل الويلات التي يُذيقها إياها!
من قال إن عصر الآلهة والقرابين والكهنة قد انتهى؟
لقد ارتبطت القدرة على الابتكار والتحديث في أنماط الحياة منذ الأزل بمدى قدرة الشعوب على إيجاد الاستقرار المتوقف على توفر المقومات الأساسية للحياة كالماء وخصوبة الأرض وغيرهما من الأساسيات التي كانت تعطي للإنسان آنذاك فسحةً للتفكير والنقد والبناء، وبالتالي تشكيل حضارة أو شبه حضارة. وعلى هذا الأساس كان الإنسان يبدأ بالاعتماد على العقل بصورة بدائية، عوضاً عن الخضوع للأوهام والأفكار الخيالية المرتبطة بقوى ما ورائية تتحكم بكل شيء. وعليه يمكننا القول إن لجوء الإنسان للتسليم بالأوهام وتجاوز العقل نحو الإيمان المطلق بالخيال، ما هو سوى تعبير واضح عن عدم القدرة على مواجهة احتمالات الحياة بواقعية، فبدلاً من التفكير بحل، يتم أخذ الكارثة إلى سياقات متوهَّمة غير موجودة ليتمكن الإنسان من احتمالها.
إن ما كان يدفع الإنسان في القرون المظلمة إلى اللجوء لصناعة الوهم ثم الإيمان به هو عجزه عن مواجهة الطبيعة بالعقل في ظل وحشية نمط الحياة آنذاك، أما في الواقع المعاصر فتتكرر الحالة ذاتها ولكن مع الفارق أن ما يعجز الإنسان عن مواجهته ليس الطبيعة بل أنظمة الحكم، خاصةً الديكتاتورية، أو الدينية، أو أنظمة الحكم التي تعتمد على الحزب الواحد مع محاربة التعددية، وبالتالي يفقد الإنسان وجوده كفرد، ليتحول ذلك الوجود إلى انصهار تام ضمن جموع المحكومين، وبسقوط الفردية يسقطها العقل الناقد أو القادر على بناء تصوراته الخاصة عن الحياة، فتفقد الحياة معناها وقيمتها، ليصير الإنسان بعد ذلك ترساً تدور في محرك الدولة الضخم، بدون أي تطلعات أو محددات يفهم من خلالها ذاته الإنسانية، وعليه يرجع إلى حالة الإنسان البدائي العاجز عن الإحساس بوجوده بمعزل عن الكل المحيط به، والذي يختلق الأوهام الدينية أو اللاهوتية، بمعنى أدق، والتي يجد فيها عزاءه الوحيد عن حياةٍ مفرغة من القيمة، يقف فيها عقله عاجزاً عن المواجهة.
ما كان يدفع الإنسان في القرون المظلمة إلى اللجوء لصناعة الوهم ثم الإيمان به هو عجزه عن مواجهة الطبيعة بالعقل في ظل وحشية نمط الحياة آنذاك، أما في الواقع المعاصر فتتكرر الحالة ذاتها ولكن مع الفارق أن ما يعجز الإنسان عن مواجهته ليس الطبيعة بل أنظمة الحكم، خاصةً الديكتاتورية، أو الدينية، أو أنظمة الحكم التي تعتمد على الحزب الواحد
أما عند محاولة إيجاد أمثلة على نظام الحكم الديني الأبوي الديكتاتوري الذي يخلق تلك الحياة المفرغة من القيمة، نجد أنفسنا ضمناً ننظر صوب المجتمعات العربية، ولكن في حقيقة الأمر إنه لمن الجور أن نحصر حالة ذوبان الوعي الفردي الناقد في المجتمعات العربية فقط، فلكل الشعوب آلهتها المحببة، أو بالأحرى أوهامها المحببة، ولكن المفارقات دائماً تكمن في هامش الحرية الذي يحظى به الإنسان في مجتمعه وبين شعبه وتحت حكم نظامٍ ما.
في الحقيقة، إن ما تعيشه المجتمعات العربية المعاصرة التي يحكم الدين بُناها الاجتماعية بشكل مباشر، من تخبطاتٍ وصراعاتٍ وأزمات ما هو سوى نتاج للاستبسال المميت من قِبل القوى الحاكمة للحفاظ على حالة السيطرة الدينية الأبوية على المجتمع العربي، حتى إن بدت بعض تلك المجتمعات في ظاهرها منفتحة أو متحررة من الأغلال الكهنوتية، إلا أن ما يحكم البنى الاجتماعية من الداخل هو ذلك العقل المتدين الصارم، والذي يعشش فيه وهم الآلهة والقرابين إلى اليوم.
أما دور الحكومات فينحصر في الحفاظ على ذلك الشكل النهائي للمجتمعات العربية، مع احتكار الحقيقة لدى الطبقات البرجوازية التي يتفرع منها الحكام الفعليين للواقع العربي، ليظل المواطن يدفع عمره وحياته قرباناً للآلهة الرماديين كشرط لحصوله على تذكرة دخول إلى "أرض فالهالا" أو الفردوس أو الجنة كما تسمى في المحكي العربي اليومي.
"الحياة مظهر زائف، نحن ننتظر الجنة"
إنه الأمر ذاته في عصور ما قبل العقل. ما تغير هو مفهوم الآلهة، وشكل القرابين، وتعريف العبيد لأنفسهم! أما الطريقة التي يستخدمها أي نظام حكم عربي قائم على المرجعية الدينية الأبوية فهي ذاتها التي استخدمها الكهنة في عصور الظلام وما قبلها: إفراغ الحياة من قيمتها إن تم عزلها عن الماورائيات اللاهوتية، ثم إجبار الشعوب على الإقرار بأن الحياة مظهر زائف، وكل ما نفعله فيها هو أننا نبلي حسناً ونرضي آلهتنا وكهنتنا بالقرابين لننجو من لا معنى الحياة، وننتقل إلى الفردوس حيث سنكافأ باللذة الأبدية. أما القرابين فتحول شكلها من الشكل المادي إذ أصبحت حياة الفرد بكاملها تقدم كقربان عندما تسحق في الوعي الجمعي لتلك المجتمعات الخاضعة للحكم اللاهوتي أو الأبوي.
هذا ما تحدث به ضابط الأمن عندما واجهه أحد الأصدقاء في قبو التحقيق بأن ما يبحث عنه هو أكثر من تبديل في حكومات، أو ثورة تغيير وجوه، وأنه يبحث عن الإرادة الحرة للإنسان، أن يكون كل إنسان قادراً على بناء نمط حياته الخاص بحرية. عندها أُضيفت له تهمة جديدة، وهي محاولة نشر أفكار شيطانية غريبة تلوث استقامة المجتمع
وهذا ما تحدث به ضابط الأمن عندما واجهه أحد الأصدقاء في قبو التحقيق بأن ما يبحث عنه هو أكثر من تبديل في حكومات، أو ثورة تغيير وجوه، وأنه يبحث عن الإرادة الحرة للإنسان، أن يكون كل إنسان قادراً على بناء نمط حياته الخاص بحرية. عندها أُضيفت له تهمة جديدة، وهي محاولة نشر أفكار شيطانية غريبة تلوث استقامة المجتمع، وتخرب المشروع القومي-الديني لسيادة العالم من جديد. وبعد الانتهاء من جولة التحقيق تلك أخبره ضابط الأمن: "الحياة مظهر زائف، نحن ننتظر الجنة"، ربما تفسر مقولة الضابط كل شيء، أنه بعد قرونٍ من العيش مع التضليل الديني والوهم، يصبح من الأسهل تصديقه والاعتقاد به كحقيقة مُطلقة، وكل شيء سواها هو ضرب من ضروب المس الشيطاني، بل والدفاع عن ذلك الوهم بشراسة هائلة، حيث إنه المسوغ الوحيد لاحتمال الحياة، وإلا فكيف يمكن للمتدين العربي المحاصر بكل أنواع السموم الأبوية والدينية والكهنوتية؛ حتى صارت جزءاً من حمضه النووي؛ أن يفهم الجدوى من حياته إن واجه الحقيقة واستمع إلى صوت عقله لمرة واحدة فقط! هذه معضلة أخرى ليس منطقاً تجاوزها والاستمرار في كليشيه جدلية الملحد والمؤمن.
لماذا تصمت الشعوب المتدينة عندما تنتهك حقوقها المدنية؟
كثيراً ما نسمع في الأوساط العربية المختلفة عن اعتقالات بتهمة "الترويج لأفكار دخيلة على المجتمع"، أو "حمل أفكار غريبة"، ما يدعونا للتوقف عند الكثير من الأسئلة، فمثلاً، ما الذي ينتظره المجتمع الرافض للانفتاح على الأفكار التجديدية؟ لماذا يحافظ على كتلة من الموروثات والعادات والبنى الاجتماعية البالية ويتشبث بها باستماتة، ما الذي يريد تحقيقه من خلالها؟ هل حقاً يريدون سيادة العالم من جديدة بهذه التشوهات الفكرية العاجزة عن تحقيق التوازن للمجتمع نفسه!
في الواقع، إن حلم السيادة القومية ذاته في عالم حداثي براغماتي تحكمه المادة والمال والمصلحة، هو وهم جديد يضاف إلى لائحة طويلة من الأوهام المرافقة والمشابهة، والتي تحمل الشعوب على الصمت عندما تنتهك حقوقها وخصوصياتها الفكرية، وتطلعاتها نحو حياة ليبرالية مدنية.
بهذا المعنى يذهب مصطلح "الشعوب العربية المتدينة" إلى ما هو أبعد من الدين والآلهة والقرابين، والكهنة، وحراس المعبد، حيث إن حبك الخديعة لتلك الشعوب يتطلب أيضاً بُعداً قومياً، يتكامل وينصهر في البعد الديني، إذ يصبح الدين والدستور معاً، والآلهة والحكام، والكهنة ورجال الدين معاً، أما حراس المعبد فهم رجال الأمن، والقرابين هي تنازلات المواطنين عن حياتهم وحرياتهم مقابل وعودات من النظام اللاهوتي العربي الكلي بأن امبراطورية العرب الإسلامية قد اقترب ميعاد بزوغها، والتي ستحكم العالم من جديد وستسوده، وستصبح أنتَ أيها المواطن الذي قدمت لنا حياتك قرباناً أحد مواطني تلك الإمبراطورية العظيمة. ولكنْ للحقيقة رأيٌ آخر، فالعالم يرثه الأصلح الذي لا تسحره الأوهام، ولا تنطلي عليه خدع الأيدولوجيا اللاهوتية، ذلك الذي آمن منذ البداية بالعقل، دون اكتراث للقوميات أو السلالات أو أي وعي جمعي آخر قائم على التنافس من أجل التنافس.
تزيين القيود لا يحولها إلى مجوهرات، لابد من الانعتاق!
إن كل ما يتطلبه الأمر للانعتاق من المكيدة المركبة التي ترافق الوعي العربي منذ قرون، هو تثمين الحياة، وعدم المقايضة بها مقابل شراء الوهم وتصديقه، بل والصراع من أجل بقائه عوضاً عن الصراع لأجل معرفة الذات وتطلعاتها وتوجهاتها، وتحقيق حريتها من العبودية لأصنام النظام.
ولمّا كانت الحرية غير ممكنة إن جاورت الفروض الدينية/القومية التي يفرضها نظام الرب/الحاكم/رجل الدين، فإن الفرض الإنساني الأول لكل الشعوب المقهورة تحت حكم تلك الأنظمة هو بناء تلك الذات الفردية الناقدة خلف البنى الفاعلة في المجتمع الغارق في الأوهام، فالمعارضة القائمة على الرفض والنفي والانكماش حول الذات بعد اكتشافها، لا جدوى منها، كما أن رفض المجتمع كاملاً بينما أنت جزء منه، هذا يعني أنك أصبحت تقف في العدم.
بهذا المعنى، يكون الأحرى هو وضع القيم الفردية الثائرة والفاعلة خلف قيم المجتمع السائدة لتكون بذلك حركة معارضة مندمجة بمكونات المجتمع المراد انتشاله من الوحل والظلام، للوصول إلى حالة المجتمع المدني الحر الرافض للوصاية الدينية، والخلط بين الدستور والمخطوطات الكهنوتية بكل أشكالها ومصادرها، والذي يرفع عالياً قيمة حياة أفراده، إذ يدركون أن حياتهم هي فترة وجودهم الخاصة والفريدة، ولا يحق لأي نظام أو تيار أن يشاركهم خياراتهم فيها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.