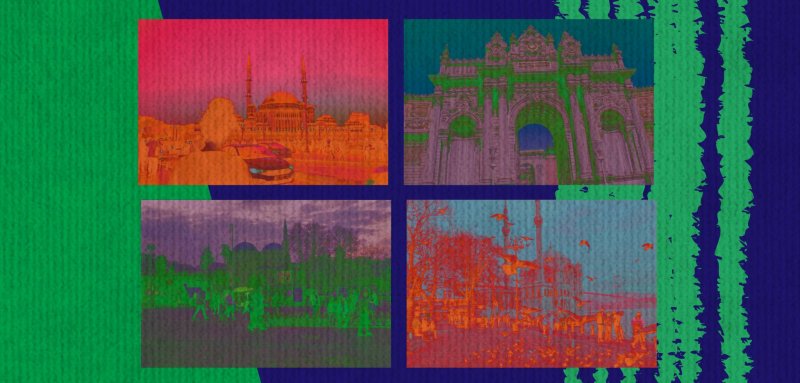اكتظت ساحة تقسيم عن آخرها بالسيّاح، واستطعت بسهولة تمييز لهجات عربيّة عدّة -خليجيّة وسوريّة ومصريّة-. كان أكبر تجمّع للجنسيّات العربية في إسطنبول، مما دعا بعض المطاعم إلى تقديم قوائم طعام مكتوبة بالعربية. اخترق شارعَ استقلال الترام الأحمر الشهير الذي تخرج منه رؤوس الركاب كما تخرج الثوميّة من السندويتش بعد أول قضمة، والذي حذّرني الأصدقاء من ركوبه حتى لا أتعرّض للنشل، فضحكت لأن صاحب التحذير لم يرَ قطعاً -لحسن حظه- ترام باكوس في الإسكندرية.
انعكس ذلك الجمع العربي على موسيقيي الشارع، الذين عزفوا كلاسيكيّات فيروز وبعض ألحان أم كلثوم إرضاءً لذوق المارة. استطعت تمييز رِيتم "المقسوم" الراقص يعزفه طبّال اصطحب فرقةً تغني بالتركيّة لكن بألحان تشبه الأغاني الشعبيّة المصريّة. وكان ذاك اختلافاً واضحاً عن موسيقيي الشارع في الجانب الآسيوي، الذين غلب على ألحانهم الشجن والحزن.

زحام تقسيم - بيه أوغلو
وبالتأكيد لم تحتوِ ريتماتهم الإيقاعيّة على "المقسوم"، وهو إيقاع شرقي راقص. بالطبع كانت موسيقى الشارع بعيدة كل البعد عن موسيقى النوادي الليليّة التي غلب عليها المزاج العام للأتراك المتغرّبين، فكانت أغانيها نسخة من قائمة البوكس أوفيس الأمريكي، لكن فقط بكلمات تركيّة. فضلاً عن النوادي المتخصّصة بموسيقى التيكنو والهاوس الرتيبة، متكررة الإيقاع، التي صدّرها لهم عالم برلين السفلي الصاخب.
أحسست بصمت الشارع والموسيقى وكل شيء فجأة، وأسرتني تلك الفاتنة المستلقية على جانبها. لم أشعر بنفسي إلاّ وأنا أدنو منها بخطوات متلاحقة ومتلهّفة. سألت البائع بغتةً: بكم قطعة البقلاوة تلك؟ "Bu cold baklava ne kadar"، فأعطاني إيّاها ومضيت. لحسن حظه أنه لم يقم بملاعبتي مثل بائع الآيس كريم الذي يشاكس الزبائن ويسحب منهم البسكوتة ضاحكاً، والذي قطعت عهداً على نفسي أنه إن فعل ذلك معي لقمت بتغطية وجهه بالآيس كريم والسباب الاسكندراني معاً.
في نهاية الشارع يقبع برج "غالاطا" وقد كان برجاً لمراقبة السفن في الماضي، ثم برجاً لمراقبة الحرائق، وأضحى الآن مزاراً سياحياً نستطيع رؤية مشهد بانورامي للمدينة منه.
سألت البائع بغتةً: بكم قطعة البقلاوة تلك؟ فأعطاني إيّاها ومضيت. لحسن حظه أنه لم يقم بملاعبتي مثل بائع الآيس كريم الذي يشاكس الزبائن ويسحب منهم البسكوتة ضاحكاً، والذي قطعت عهداً على نفسي أنه إن فعل ذلك معي لقمت بتغطية وجهه بالآيس كريم والسباب الاسكندراني معاً
وهنا ينتهي شارع استقلال المزدحم، وانتهت أيضاً رغبتي في رؤية المزيد من البشر، فاكتفيت بذلك القدر منهم، ولم أكتفِ من البقلاوة. فعرجت لأخذ المزيد، ثم اتجهت صوب المترو لأتذكر في طريقي ترشيحات الأصدقاء بتجربة "أضنة كباب" من أحد المحال الشعبية، الذي يقدم معه مسحوق الطماطم بالتوابل والثوم المسمّي "أتشوكا"، وقد كانا ثنائيّاً متجانساً يزعزع العقيدة من شدّة جماله. كم كانوا بارعين بأكلات الشارع، وكم كنت هدفاً سهلاً.

مسجد ساحة تقسيم
للوهلة الأولى بدا موقف "الدلامش" (جمع دولموش وهو الميكروباص الصغير) مزدحماً في أوُسكودار. فاليوم عطلة رسمية وقد انتهز الإسطنبوليّون فرصةَ الجوّ المعتدل ذلك اليوم للتنزّه. كنت قد خططت مسبقاً لزيارة حيّ "كوزغونشوك" القديم ذي البيوت الخشبيّة الملوّنة. وقد كان ذلك الحيّ موطناً في السابق لعائلات من الأرمن واليونانيين الذين رحل أغلبهم بعد موجة القوميّة التركيّة المصاحبة للجمهورية الجديدة عام 1923.
اللغات في إسطنبول
كانت شوارع إسطنبول تتحدث التركيّة، اليونانيّة، الأرمينيّة، وهم المنحدرون من السكان القدامى للقسطنطينيّة قبل مجيء العثمانيين، إلى جانب الإنكليزيّة والفرنسيّة. لكن بعد تأسيس الجمهورية الحديثة واشتداد القوميّة التركيّة وما قامت به الدولة من التنظيف العرقي، تمّ محو تلك اللغات كلها.
وكانت "ثورة الحرف" هي أولى الخطوات بفرض كتابة التركيّة بأحرف لاتينيّة بدلاً من الأحرف العربيّة، وقرارات أتاتورك بمنع ارتداء الأزياء العثمانيّة واستبدالها بالملابس الغربيّة الحداثيّة. إضافة إلى الآثار الجانبيّة لذلك، التي تضمّنت التضييق على المتحدثين بغير التركية ومنع الأكراد كمثال من إستخدام لغتهم في الشارع. فانتهى النموذج متعدّد الأعراق وبقيت منازلهم الملوّنة.
استمتعت بفنجان من القهوة في أحد مقاهي الشارع، ثم دخلت البستان الكبير الذي يتوسّط المباني الخشبيّة، والذي يمكن للسكان تأجير رقعة منه للزراعة أو قطف الخضروات وثمار الفاكهة مقابل دفع ثمنها. وهي فكرة رائعة لأكل طعام عضوي أولاً، وبالتأكيد خلق علاقة ارتباط بالأرض وبذاك الحيّ الجميل المطلّ على البوسفور.
تجوّلت في كوزغونشوك مطوّلاً إلى أن ضعفت أمام أحد محال "الدونر"، فطلبت "دوروم Dürüm"، وهي تشبه الشاورما لدينا ملفوفة بخبز رفيع يدعى "لاڤاش". جلست قرب الشاطئ مشاركاً وجبتي مع قطط الشارع البدينة -وقد فهمت الآن لماذا هي كذلك- وهم حتماً لو رأوا قطط "محطة الرمل" لسيّئة التغذية، لأشفقوا عليها.
ركبت الدولموش عائداً إلى أوُسكودار لأمارس هوايتي المفضلة وهي الغطس في متاهات الأسواق الشعبيّة، فتلك البازارات التركية لها طابع خاص وديناميكيّة مميّزة.
مفاصلة البائعين
نصحني الأصدقاء بضرورة مفاصلة البائعين، فحاولت ذلك مع بائع التوت مستعملاً كل الحيل التي تعلّمتها من أمي، فتارة أؤكد له أنني رأيت التوت أرخص عند بائع آخر وتارة أشكّك في بضاعته وأزعم أنها ليست ناضجة كفاية -مستويّة- لكنه أصرّ على موقفه، وانتهت كل الخدع التي أعرفها. فأعلنت الهزيمة واشتريت بالسعر الأول.
تباً، لن أحكي تلك القصّة لأمي، فقد تسافر خصّيصاً لتهزم ذلك البائع في مبارزة المفاصلة. وقد كتبت لها في الملحق بضع عبارات بالتركيّة لتساعدها في جولة السوق، إضافة إلى عبارات الترحيب والتحيّة لتحيي البائعين بعد انتصارها.
كان لدى الإسطنبوليّين عادةُ أكل السمك في سندويتش أحياناً ويسمى "Balık ekmek". فأخذت إكميك لآكله سريعاً، وأشحن مخزون الفوسفور بأسماك البوسفور، ثم أكملت جولة السوق لأجد نفسي محمّلاً بالأكياس مثل أي ربّة منزل تقليدية. الفرق هنا أنني في الأغلب دفعت ضعفَ ما كانت ستدفع هي.
نُصحت بضرورة مفاصلة البائعين، فحاولت ذلك مع بائع التوت مستعملاً كل الحيل التي تعلّمتها من أمي، فتارة أؤكد له أنني رأيت التوت أرخص عند بائع آخر، وتارة أزعم أن بضاعته ليست ناضجة كفاية، لكنه أصرّ على موقفه، وانتهت كل الخدع التي أعرفها
اتجهت صوب محطة خط مترو "مرمراي" لأعود إلى المنزل، فناداني ذلك اللحن الكلاسيكي للكمان من بعيد. كان عازفاً طاعناً في السن -قصير القامة- يعزف وسط ركاب المترو لحناً أشبه بالرثاء. كلما ازدحمت المحطة، ارتفعت ديناميكيّة عزفه وأدائه محاولاً جذب أموال العابرين بالطبع. فبدا وكأنه يؤلف موسيقى تصويريّة للمكان، تتصاعد كلما ازدادت الحركة وتهدأ كلما قلّت. ذلك التنوّع في موسيقى الشارع أثار اهتمامي حقاً، فموسيقيّو المناطق السكنيّة الأتراك يختلفون كلياً عن موسيقيي المناطق السياحيّة الراقصين كالأراجوزات.
أضفت إلى جدول أعمالي عادةً أخرى وهي التجوّل في "بحرية: Bahariye Caddesi" قرب ساحل كاديكوي لمشاهدة الغروب مستمعاً إلى الفرقة التي كانت تعزف هناك بشكل شبه يومي وتتكوّن من عازفي ساز ومغنّ. ارتبطت آلة "الساز" تلك -والتي تسمّي أيضاً بأغلاما- بالموسيقى الفولكلوريّة العثمانيّة، وهي تشبه العود قليلاً لأنها تلعب تردّد "الربع تون" لكنها أصغر جسماً وأطول عنقاً. تشترك فيها الموسيقى اليونانيّة، الأرمينيّة، الأذربيجانيّة، الكرديّة والشاميّة. وتسمّى في لبنان وسوريا "البُزُقْ".
هناك قاسم مشترك -ويا للدهشة- بين كل هؤلاء على الرغم من كل شيء، وهو طرب آذانهم لتلك الموسيقى الحزينة. كانت هناك فرقة أخرى تتكوّن من عازف غيتار وكاخون وكلارينيت تركي "G-Clarinet". يغيّرون مكانهم كل يوم، في محيط مرفأ كاديكوي غالباً. فأظلّ أتجوّل هناك باحثاً عن صوت ذلك الكلارينيت الساحر إلى أن أجدهم فأقف مستمعاً لأغنيتين -أو ثلاث- وأترك عشر ليرات في الحقيبة الفارغة أمامهم ثم أمضي.
الكلارينيت التركية هي آلة مشتركة بين الفولكلور التركي وموسيقى دول البلقان وتسمى "جيرناتا Gırnata" بالتركية، نادراً ما تستخدم في الموسيقى الكلاسيكيّة الغربيّة ولها صوت خفيض جذّاب. استطاع ذلك العازف جعل الكلارينيت تبكي وتصرخ -وتغني أيضاً- لشدّة مهارته. حتماً كان هذا هو صوت بكاء المدينة في أيامها الحزينة.
عميل مزدوج
اليوم السبت، وهو موعد مباريات فريق "فناربخشة" -فخر كاديكوي- فكانت مطاعم بَحريّة وحاناتها مكتظة بالجمهور ذي الأصفر والأسود. مشيت معهم قليلا هاتفاً: "Yaşa Fenerbahçe" كعميلٍ مزدوج، فقلبي سيظل مع الزمالك دوماً. ثم ركبت العبّارة إلى "إيمينونو"، فبرنامج اليوم سياحي تقليدي يتضمّن زيارة منطقة فاتح والسلطان أحمد. من الواضح أنّ سكان تلك المنطقة محافظون بعض الشيء. نستطيع رؤية ذلك في ملابسهم ومحالهم. ساقني الفضول إلى زيارة آيا صوفيا وهي الكنيسة الشهيرة في العهد البيزنطي التي تحوّلت إلى "مسجد القديسة صوفيا".
لم أصدق المشهد أمامي، أبراج كنيسة بزخارفها البيزنطيّة يعلوها هلال كبير. لوحة من الفسيفساء في المدخل تصوّر قديسين وصليباً على البوابة الخشبيّة، وفي الداخل صحون كبيرة معلّقة في الجدران عليها أسماء الصحابة والخلفاء الإسلاميين. لم يكن كل ذلك غريباً، فمفهوم طبيعة ذلك العصر العثماني الأول ونشأة دولتهم ورغبتهم في إذلال الأعداء. ما آذاني فعلاً وأثار اشمئزازي، كان رائحة جوارب الزوّار وقد خلعوا أحذيتهم قبل دخول المسجد. يا إلهي! رأيت الشيطان بعيني ذلك اليوم، فهو حتماً يسكن في حذاءِ أحدهم.

آيا صوفيا أو مسجد القديسة صوفيا
عبرت الساحة الممتلئة ببائعي الشاي والذرة -وتسمّى الذرة بالتركيّة Misir-، ففهمت لماذا ضحك ذلك السائق الأبله مِن قبل عندما أخبرته أنني من مصر. وصلت إلى جامع السلطان أحمد المقابل لآيا صوفيا والمسمّى بالجامع الأزرق إشارة إلى الخزف الأزرق الذي زيّن جدرانه. كان مبنى جميلاً وله قبّة داخلية مبهرة تجعلكم ترفعون القبعات لذلك النقّاش المحترف الذي نفّذها، وتفكرون أيضاً: كم كأس من الشاي شرب ذلك المحترف اللعين حتى ينفذ المبنى بهذا الإتقان.
أعطاني القدر ذلك اليوم فرصة أخرى للانتقام من بائع التوت، فذلك هو السوق المصري يبعد مسافة بسيطة من الجامع الأزرق. ركبت الترام متجهاً إلى السوق وهو الذي يشتهر بالبهارات والحلويات والطعام بصفة عامة. وقد عقدت النيّة على ممارسة مبارزة المفاصلة مع البائعين هناك. فبدأت مع أحدهم، وفاصلت ببراعة شديدة إلى أن أدركت أنني ما زلت في بداية السوق وما زال أمامي باعة آخرون، فتركته. فاستشاط البائع غضباً لأنني فاصلت ولم أشترِ. تباً، لم أعلم أنه جزء من آداب التسوّق، سأسأل أمي لاحقاً.
دخلت بعدها مطعماً شعبياً لآكل الشيش كباب المشهور، وتجاذبت أطراف الحديث مع النادل. فعرف أنني مصري ثم صاح: "اااه... مو صلاح"، فقلت له: ألم تسمع عن توت عنخ آمون مثلاً، أو الأهرامات؟ سبعة آلاف سنة اختزلتها في ابننا "مو صلاح"! ضحك قائلاً غنه يعلم الكثير عن مصر، فشكرته بالتركية على الطعام اللذيذ وانصرفت.
لم أفهم التركيّة، لكنني فهمت بوضوح شكواه من ارتفاع أسعار البنزين. أستطيع تمييز سبّ الحكومات ولعنها بأي لغةٍ كانت
كان التجوّل في أزقة إسطنبول يتضمّن صعود منحدراتٍ عالية، ونزولها بسبب الطبيعة الجبليّة للمنطقة. ما جعلني أندم على تقاعسي في تمارين يوم الأرجل في "الجيم". تباً لتلك المنحدرات التي فضحت عدم لياقتي واضطرتني لاستخدام تطبيقات التاكسي وتحمّل ثرثرة السائقين الذين -ويا للمفاجأة- كانوا مثرثرين مزعجين أياً تكن لغتهم.
لم أفهم التركيّة، لكنني فهمت بوضوح شكواه من ارتفاع أسعار البنزين. أستطيع تمييز سبّ الحكومات ولعنها بأي لغةٍ كانت.
وصلت وجهتي فتركت السائق الثرثار ودخلت أحد المقاهي وقد تعلّمت أن اطلب السكر "مضبوط" "Az şeker" أو بالدارجة "Orta". فقبل ذلك لم أعرف كيف أشرح لهم طلبي وشربت القهوة سادة رغماً عني لثلاثة أيامٍ عجاف، حتى تطوّعتْ إحدى صديقاتي لإعطائي تلك المعلومة الذهبيّة. وأقدم هنا شكراً واجباً للجندي المجهول مخترع القهوة التركيّة الذي لو كان الأمر بيدي لرشّحته لجائزة نوبل -مناصفةً مع مخترع التكييف المنزلي-. يجب أن نخجل كثيراً لأننا نحفظ عن ظهر قلب أسماء القادة العسكريين الذين احتّلوا العالم ولا نعلم شيئاً عن مخترع القهوة.
من النادر أن يشعر أحد بالملل هنا، حيث يمارس المرء بعض الرياضات الفرديّة في أزقّة إسطنبول ومنها تفادي المتسولين وبائعي الورود، نوم المسافات الطويلة في هافا باص العالق في الزحام، مبارزة المفاصلة في الأسواق والبازارات، صعود المنحدرات في شوارع غالاطا المائلة والتي تمنحك عضلات سمّانة تركيّة أصيلة، مزاحمة ركّاب الدولموش بالأكتاف. وهي رياضات ستمارسونها عنوةً لتنجون في أولمبيات الحياة اليومية. إضافة إلى رهانات -مع الذات- لتوقُّعِ حالة الطقس المتقلب والذي قد يفاجئكم بالأمطار في ذروة حرّ الصيف أحياناً.
في النهاية أعي جيداً سطحيّة مشاهداتي، فقد زرت المدينة بشكلٍ عابر، ولم أعش فيها مطولاً. لكنني أتمنى إثارة فضول القراء لمعرفة ماضيها وحاضرها، ولزيارة تلك المدينة المثيرة للاهتمام -وللشفقة أحياناً-.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.