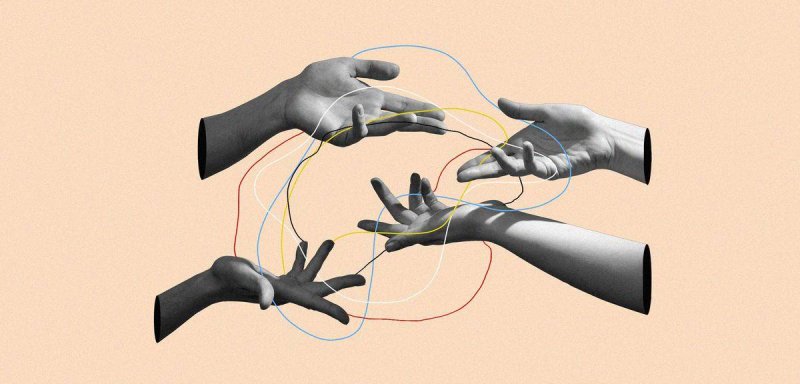كنت مع صديقتي الإيطالية في مقهى برليني صغير نتحدث عن الحياة باللغة الإنجليزيّة، وفي أحد التفاصيل الجوهريّة للحكاية ارتبكت صديقتي ولم تجد أي ترجمة للمفردة في الألمانيّة أو الإنجليزيّة. وأنا طبعاً لا أتحدث الإيطاليّة، فكان أن ذكرت لي عدة كلمات رديفة للمعنى بالإنجليزية ولكنها رغم ذلك، لا تشبه تماماً معنى الشعور الذي أرادت إيصاله لي، حسب قولها.
في كل مرة أردت الإسهاب في الحديث عما اعتراني من مشاعر في موقف ما باللغة الألمانيّة، أجدني أختصر الحديث ليكون مقتصراً على الصفات الأساسيّة مثل "جّيد" بدلاً من "بيطيّر العقل" أو "سيّىء"بدلاً من "بيفقّع".حضرتني تلك التفاصيل اللغوية والعاطفية عند قراءتي كتاب التواصل اللاعنفي لكاتبه مارشيل روزنبرغ الذي يقترح في كتابه أن التواصل بين الناس يصير عنيفاً بسبب وجود حاجة متعذرة التلبية، وبالتالي علينا صياغة احتياجاتنا في جمل واضحة للآخرين، لنمنحهم حق معرفة ما نحتاج، وأن نتعلم في المقابل تقبّل الرد سواء كان إيجاباً أم سلباً. ولتحقيق ذلك، يزوّد روزنبرغ القارئ بقاموس من المفردات التي تعبر عن المشاعر التي قد تعترينا في حال تمت تلبية احتياجاتنا، أو لم تتم. هذه المفردات من شأنها أن تكون أكثر دقة من مجرد قولنا "أشعر بشعور جيّد" وبالتالي تعمل على تفنيد مفردة جيّدة لمشاعر أكثر وضوحاً كأن نقول "أشعر بالهدوء -بالامتنان – بالسلام الداخلي". وبمقاطعة ذلك مع مجال عملي في الاستشارة الاجتماعيّة، أرى أن تلك أداة فعّالة لتسهيل التواصل بين مقدّم الاستشارة وطالبها. ولكن كيف يصير المشهد حين تقف اللغة عائقاً أمام التواصل؟ وكيف تتأثر عملية الاستشارة حين يتضافر ضعف مهارتنا في التعبير مع مشاكل اللغة؟ وللحديث عن ذلك أحاور كل من (أ.ح) التي تعمل في مشاريع عدة تخص اللاجئين-ات ومن ضمنها الوساطة اللغوية في برنامج خاص بالتوجيه المهني. وكذلك مصطفى حسين وهو ناشط سياسي واجتماعي ومستشار قانوني للاجئين وهو لاجئ سياسي من السودان يقيم في برلين منذ ثلاث سنوات.
تتعدد الصعوبات التي من شأنها أن تظهر في الاستشارة على اختلاف الغرض منها، سواء كانت اجتماعية أو مهنية أو قانونية أو مدرسية أو غيرها. لكن المشترك بين كل أنواع الاستشارات هو شكل التواصل الذي يستلزم وجود صاحب استفسار، أو سؤال أو حاجة، وشخص آخر يترتب عليه تقديم الإجابات أو الاقتراحات التي قد تكون حلاً أو خطوة نحو الحل. وكلّما كانت عملية التواصل أكثر وضوحاً، زادت إمكانية الوصول إلى الغاية المرجوّة من الاستشارة. وبالتالي، قد تشكّل اللغة العائق الأول أمام هذا التواصل الواضح لعدم قدرة كل الأشخاص على التعبير عن رغباتهم بلغة غير لغتهم الأم، أو حتى بلغتهم الأم، أو لقصور في عملية الترجمة التي لا تنقل المفردات مع محتواها العاطفي غالباً.
قد تشكّل اللغة العائق الأول أمام التواصل الواضح لعدم قدرة كل الأشخاص على التعبير عن رغباتهم بلغة غير لغتهم الأم، أو حتى بلغتهم الأم، أو لقصور في عملية الترجمة التي لا تنقل المفردات مع محتواها العاطفي غالباً
تترك هذه الصعوبات أثراً واضحاً على كل أطراف عملية الاستشارة من محتاجها إلى مقدمها إلى الوسيط الثقافي واللغوي، وعن هذا توضّح (أ.ح): "تعتري الأشخاص مشاعر الخجل بالدرجة الأولى بسبب عدم معرفتهم باللغة، وبالتالي يشعرون كذلك بالارتباك لعدم قدرتهم على شرح احتياجاتهم".
هل تكمن المشكلة في أننا لم نتعلم أن نلحظ احتياجاتنا وبالتالي استبعدنا كل المفردات التي من شأنها أن تعزز صوتنا كأفراد؟ وإن كان الأمر كذلك، فكيف نستعيد قدرتنا على إدراك احتياجاتنا والتعبير عنها بأي لغة نحب؟
غالباً ما تتداخل عوامل عدة في جلسات الاستشارة، فحتى وإن تمحور الموضوع بصورة أساسية حول البحث عن عمل، أو متابعة الدراسة مثلاً، فليس من المستبعد أن تظهر خلال الاستشارة الكثير من النقاط التي من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار المناسب، والتي قد تكون مرتبطة ارتباطاً غير مباشر بموضوع الاستشارة، فتكون مثلاً أقرب إلى التنشئة الاجتماعية التي مر بها الشخص، أو تجاربه العملية والعلمية السابقة، أو عدد اللغات التي يتقنها، أو مثلاً تعرضه إلى صدمة نفسيّة وغيرها من العوامل، وبالتالي من المجازفة ألا يكون مقدم الاستشارة على دراية جيّدة بكل العوامل التي من شأنها أن تؤثر في سير عملية التواصل، والاستشارة، واتخاذ القرار. ومن هذه الاقتراحات يذكر مصطفى حسين: "مفيد أن يكون من يعمل في هذا المجال هم المهاجرون-ات أو اللاجئون-ات بحيث يتم ضمان توافر عنصر الحساسية الثقافيّة" وهو ما تشير إليه أيضاً (أ.ح) في كلامها موضحة: "يمكن لذوي الخلفيات المهاجرة فهم ملامح التجربة بصورة أعمق، مما قد يساهم في تفادي تقديم بعض النصائح التي قد تشكّل صدمة لمتلقيها، أو أن يتم عمل دورات تدريبية للعاملين-ات في مجال الاستشارة بحيث تهدف إلى تنمية الحساسية الثقافية وفهم الصعوبات التي يمر بها المرء في البلد الجديد".
وفي الوقت الذي قد تكون فيه هذه المقترحات حلولاً معقولةً لتفادي الكثير من تحديات التواصل من الناحية الاجتماعية والتربوية والثقافية، ولكن كيف يمكن التعامل مع غيرها من العوامل التي قد تتطلبها عملية الاستشارة كالمعرفة القانونيّة ونظام الدولة الصحي والاجتماعي والتعليمي، وآلية تقديم الاستمارات والمصطلحات المهنيّة؟ وما السبب الذي يجعل المشهد يبدو على صورة ضفتين من غير الممكن اللقاء بينهما في الوقت الذي تحتاج كل منهما إلى الأخرى؟ وهل من الممكن أن تكون طريقة تعلمنا اللغة الأم أو أي لغة أخرى هي المشكلة، بحيث لا تذهب أعمق من التمكّن من تسيير الأمور الحياتية العامة دون التعمّق في مجال الانفعالات والعاطفة؟
وفي الوقت الذي قد تكون فيه هذه المقترحات حلولاً معقولةً لتفادي الكثير من تحديات التواصل من الناحية الاجتماعية والتربوية والثقافية، ولكن كيف يمكن التعامل مع غيرها من العوامل التي قد تتطلبها عملية الاستشارة كالمعرفة القانونيّة ونظام الدولة الصحي والاجتماعي والتعليمي، وآلية تقديم الاستمارات والمصطلحات المهنيّة؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.