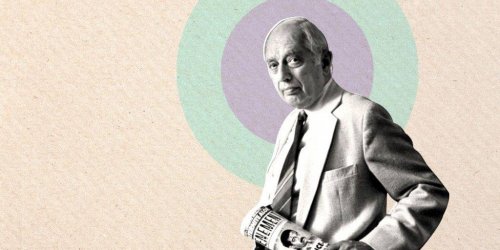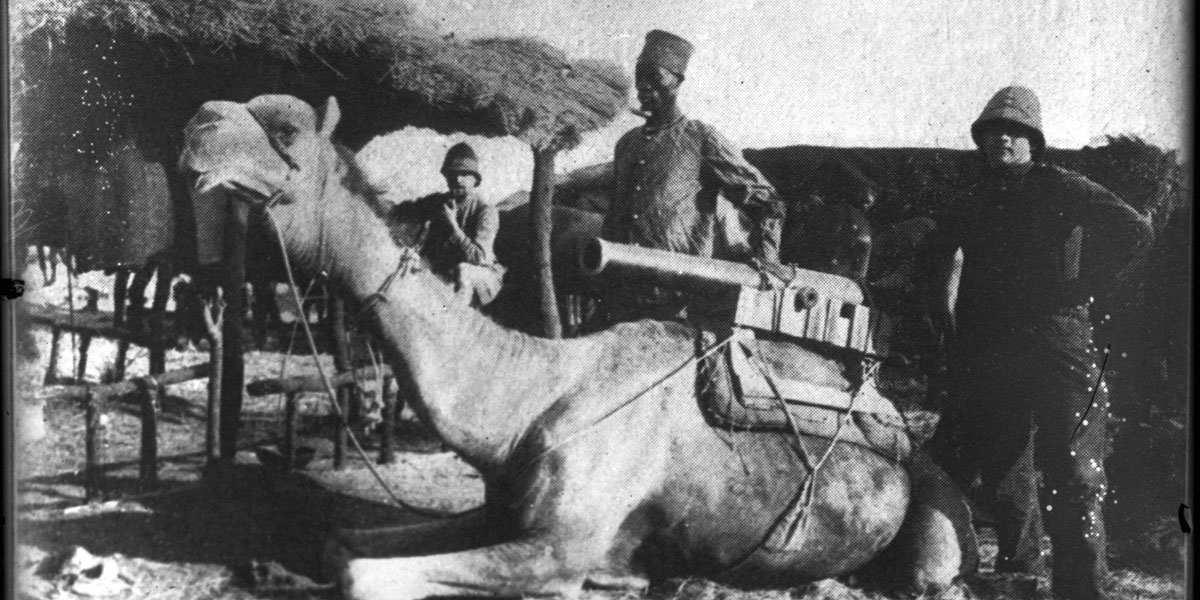قد تكون كتابات مستشرقات أوروبيات، عن مصر، جماليةً إلى حد كبير، لكنها لا تخلو من نظرة الاستعلاء، فبعضهن كنّ يرين أن نساء مصر، أقل جمالاً منهن، وأن المرأة المصرية لا قيمة لها في مجتمعها، لكن حديثهن عن التراث، والتاريخ المصريَين، لم يخرج عن إطار ما نقله التشكيليون الأوروبيون إلى أوروبا، والتي تمثلت في لوحات كلٍ من التشكيلي لودفيغ دويتش، وألفونس ليوبولد، وجان ليون، الذين وضعوا تجسيداً واقعياً للقاهرة القديمة، بما تتضمنه من ثقافات متنوعة، وسجلوا بالألوان، تراث الأحياء الشعبية والعمارة الإسلامية، وثقافتهما، ونجد هذه الأعمال في كتاب "وصف مصر".
"يا لها من سعادة في نسيم الليل البارد، أن تنساب في النيل بجوار معابد إسنا، وإدفو، وكوم أمبو. متعة تؤدي إلى مباهج أخرى في جدول مصر الرومانسي"؛ هكذا تحدثت أليزا فاي، عن مصر، في كتابها "رسائل من الهند"، الذي نُشر عام 1821، بعد أن تأثرت بلوحات التشكيليين عن وصف مصر، وتوقفت رؤيتها عند هذا التصور.
المرأة المصرية في نظر المرأة الإنكليزية
نوع من الطبقية والعنصرية، ظهر في كتابات سوزان فوالكان، التي سجلتها في مذكراتها الخاصة، وقد صدرت عام 1835، عن نساء مصر، على الرغم من أنها واحدة من المدافعات عن المرأة في الماضي، إلا أن نظرة الاستعمار الإنكليزي إلى البلاد العربية الخاضعة للاحتلال العثماني، لم تُمحَ مما كتبته، فالمرأة الفلاحة في نظرها، ليست جميلة، وكانت معايير الجمال لدى المرأة الأوروبية، في تلك الفترة، تتلخص في الخصر النحيف، والشعر الأصفر الناعم، والعيون الزرقاء والخضراء، والبشرة البيضاء.
أما في وصف المرأة المصرية، فقالت إنها محجبة! وليس لها مكان معترف به في العلاقات الاجتماعية! ثم ظهرت الطبقية في كتاباتها، عندما تحدثت عن نساء القصور، فتكلمت بنوع من الشموخ عن الصرامة والاحترام بينهن، في التعامل بين الأكبر والأعلى مرتبةً، واستخدام التصفيق، لإصدار الأوامر. بينما حين تحدثت عن الحمّامات الشعبية، ذكرت مشاريع الزواج التي تتم بين التجار، والفتيات القاصرات، وقد شهدت زواج تاجر في خان الخليلي، من فتاة قاصر لا تزيد عن الخمسة عشر ربيعاً، وإن كان زواج القاصرات يُعد ضمن الثقافة العرفية لدى العامة، فإنه ظالم للفتاة، وكان على الأرجح أن تنتقد هذا العرف، بدلاً من الحديث عن مراسم الاحتفال بهذا الزواج، الذي علّقت عليه بجملة واحدة ناقصة هي:" الزوجة في الشرق، ملكة ليوم واحد لا أكثر".
قد تكون كتابات مستشرقات أوروبيات، عن مصر، جماليةً إلى حد كبير، لكنها لا تخلو من نظرة الاستعلاء، فبعضهن كنّ يرين أن نساء مصر، أقل جمالاً منهن، وأن المرأة المصرية لا قيمة لها في مجتمعها
الإنكليزية أرفع منزلة من أي امرأة أخرى
ليست سوزان وحدها، التي نظرت إلى المصرية بعين التقليل، إذ إننا نجد في ما كتبته صوفيا بول، في كتابها "امرأة إنكليزية في مصر"، والذي صدر عام 1849، عن زيارتها لمن يُعددن من نبيلات البلد، تقصد نساء القصور، أنها كانت ترتدي تحت التزييرة (اللباس التقليدي التركي آنذاك)، الملابس الإنكليزية، كي تجنّب نفسها ضرورة الامتثال لعادات حريم القصر، التي تُشعرها بالإذلال، فلو أنها ارتدت الزي التركي، للزم عليها أن تؤدي التحية التقليدية المتّبعة بينهن، والتي عبّرت عنها بجملة "تبدي خضوعاً لا أقبله، ولا أود أن أشعر به، في حين أنني كامرأة إنكليزية، تعاملني أرقى السيدات ليس فقط كمثيلات لهن، بل يعتبرنني، غالباً، أرفع منهن منزلةً"، ويتضمن حديثها مصطلحات، وإيحاءات عنصرية، فهي ترى نفسها أفضل من سيدات القصر، لأنها امرأة إنكليزية فحسب.
مقاهي اليهود في مصر
تأملتُ حديث الكاتبة الروائية والرحالة البريطانية، هارييت مارتينو، في كتابها "الحياة الشرقية"، الذي صدر عام 1848، ولمعت الدموع في عينيّ، خاصةً عندما قالت: "مصر تستقبلك بشمس ساطعة، وضوء باهر، يخالطان شعورك الذي أتيت به، فإذا بها جميعاً تشكل انطباعك الأول الذي قل أن يتشابه فيه اثنان".
ربما لم يتغير ازدحام شوارع القاهرة الذي لفت أنظار هارييت، من تلك الفترة إلى يومنا هذا، لكن نوعاً من التناغم كان مثيراً للإعجاب، يتمثل في أن تجد المقاهي الشعبية يرتادها اليهود، والأرمن، والأتراك، والمصريون، من دون تفريق أو عنصرية. مجتمع واحد يشمل خليطاً من الأجناس فريد، والذي علّقت عليه قائلة: "أجناس متنوعة، وأزياء غريبة، وحركة عجيبة، لا مثيل لها في مدننا الغربية".
اختفاء الأسبلة في مصر
كان سوق الغورية، أبرز الأسواق التي سرقت أنظار هارييت، إذ راقبت فيه بائعي المنسوجات الحريرية الدمشقية، والهندية، والفارسية، ثم خطفتها أسواق العطور، ومياه الورد. قد تكون هذه الأماكن محتفظةً بعبقها التاريخي حتى الآن، إلا الأسبلة العامة، التي كانت تُبنى لمد السكان بالمياه، وقد برزت في كتاب هارييت، إذ قالت: "تكاد الأسبلة تزدان بها كل مفارق الطرق في المدينة، وهي غاية في الجمال، والرقة، وتبرز أناقة عمارتها في ثراء تفاصيلها، وفخامتها".
حكايات السيدة حاملة المصباح
لم تنتهِ الرحلة بعد، بل ربما ستبدأ من جديد، مع حديث السيدة حاملة المصباح، أو الممرضة الأولى فلورانس نايتنجيل، المرأة البريطانية التي وضعت أسس مهنة التمريض، وقواعدها، وجاءت في زيارة إلى مصر عام 1849، وقد دوّنت ما شاهدته خلال رحلتها، في كتاب "رسائل من مصر". كانت الإسكندرية أولى المدن التي زارتها، وشاهدت الزحف الأوروبي على ملامحها، وتأثرت بمظهر ازدحام الشوارع بالراهبات، وتنوع اللغات، والجنسيات.
بعد وصولها إلى القاهرة، تأثرت بهذه المدينة التاريخية، وقالت عنها إنها أجمل مكان على وجه الأرض، لكنها انتقدت النمط الأوروبي الذي سيطر على مصر، في بعض المظاهر. ففي تقديرها أن مصر صومعة دينية، مغطاة بالفلسفة، فيها تتجمع الأديان، وتلتقي الثقافات، ولا تحتاج إلى اقتباس طابع ثقافي من بلد آخر، بل تكتفي بجمالها المنفرد، متأسفةً على أن تطبع مصر بطابع أوروبي، لكن السيدة حاملة المصباح لم تلتفت إلى كون مصر، في تلك الفترة الزمنية، كانت محط إقبال العالم كله، خاصةً بعد اكتشاف حضارة المصري القديم. فكان الأوروبيون يفدون إليها، للبحث عن فرص العمل. ومع انتشار الرجال، والنساء، والتجار الأوروبيين، كان حتمياً أن تتغير مظاهر المجتمع الخارجية، لتتمكن من الدمج بين هذا التجانس الكبير من البشر. وفي تقديري، هذا أمر طبيعي. لكن المظهر الأوروبي لا يعبّر عن مصر الحقيقة، فهو في نظري ثقافة مكتسبة، وليس ثقافة نابعة من البلد نفسه.
المصريات والتماثيل الفرعونية
من داخل "بيت فرنسا" في الأقصر، كتبت لوسي داني جوردون، تخاطب زوجها، قائلةً: "إن هذا البيت يزداد جمالاً في عينيّ، يوماً بعد يوم. إنه مسكن واسع الأرجاء، جميل، تهفو إليه النفس، وإني آسفة لأنك لست معي، حتى تنعم بما أنعم به"، كانت هذه السيدة واحدة من نجمات المجتمع البريطاني، وقد جاءت إلى مصر للشفاء من مرض السل.
أُعجبت بتقدير عموم المصريين لإله الشمس الملك "آمون رع"، وتقديسهم إياه، وتعجبت من طواف المصريات بالتماثيل الفرعونية، عشماً في إنجاب الأطفال، وربطت بين احتفالات مريدي الشيخ أبي الحجاج، إذ يحمل مريدوه على أكتافهم الكسوة الخضراء التي صُنعت خصيصاً لضريحه، ولمواكب الفراعنة، وعلّقت قائلةً: "يُخيّل إليّ أن الموكب ينبعث من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر، مثلما كان يحدث في الأزمنة القديمة، مع فارق أن الفراعنة كانوا في ذروة أبّهتهم وجلالتهم"، ويوحي رأيها هذا بأن مواكب الصوفية، والأضرحة، أقل فخامة من أضرحة الفراعنة، واحتفالاتها.
في حين كان الأوروبيون يتغنون بمصر، ويفدون إليها من كل حدب وصوب، أرى اليوم الكثير من الشباب يدفعون أرواحهم ثمناً للهرب منها، باتجاه أوروبا
الإسكندرية في كتابات المستشرقات
تحت عنوان "رحلة في مصر"، نقلت الرحالة البريطانية مسز كاري، جولاتها داخل مصر، في عام 1863، وراق لها تعدد الأجناس التي شهدتها الشوارع المصرية. كانت رحلتها في عهد بناء محمد علي لمصر الحديثة، وعلى الرغم من أننا نجد الكثيرين يتغنون بالأعمال التي قدّمها هذا الرجل، إلا أنها لم ترَ ذلك في مدينة الإسكندرية تحديداً، وكتبت عنها تقول: "لن تستعيد هذه المدينة التاريخية مجدها، وعظمتها التي كانت عليها في عصور البطالمة والرومان"، وكأن المجد مقتصر على الرومان، والبطالمة فحسب. وقد غضت عينها عن مساوئ الرومان في مصر، وما فعلوه بالمصريين قديماً، مثل الاضطهاد الذي تعرض له الأقباط المصريون، وتمييز الرومانيين واليهود عن بقية المواطنين. لقد تعامل الرومان والبطالمة مع مصر، على أنها مستعمرة ليس إلا، ولقد أخمد الرومان ثورة المصريين في طيبة، وفرضوا حكم الإعدام على كل مصري يحمل سلاحاً، وفي رأيي أن الرومان، والبطالمة، وحتى المسلمين العرب، قد دخلوا مصر غزاةً مستعمرين، وليس "معمّرين".
ورأت كاري، أن بقاء المقابر، والمعابد، وحتى أديرة الآلهة، قائمة حتى اليوم، سببه اهتمام المصريين القدماء، وأحفادهم بالآلهة، أكثر من اهتمامهم بأنفسهم، وبمساكنهم، إذ صنعوا مساكنهم من الطوب الهش، وصنعوا مقابر الموتى من الأحجار. هذه نظرة قاصرة، فالمصري القديم كان يعتقد بوجود حياة بعد الموت، لذلك اهتم بحياته الأخرى التي كان يؤمن بها، وصنع مقابره على شكل قصور، ووضع فيها حتى الطعام.
ينتابني شعور بالبكاء كلما قرأت هذه الكتابات، لأنني أنظر كيف كانت مصر قديماً، وما آلت إليه اليوم. ففي حين كان الأوروبيون يتغنون بمصر، ويفدون إليها من كل حدب وصوب، أرى اليوم الكثير من الشباب يدفعون أرواحهم ثمناً للهرب منها، باتجاه أوروبا. أصبحت أخجل من نظرة الأوروبيين إلينا، كبلد نامٍ متكاسل، لا يتقدم، ويتراجع كل يوم فكرياً، ولا أعرف إلى من أوجّه لومي، وعتابي، لكني أنتظر الأمل.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.