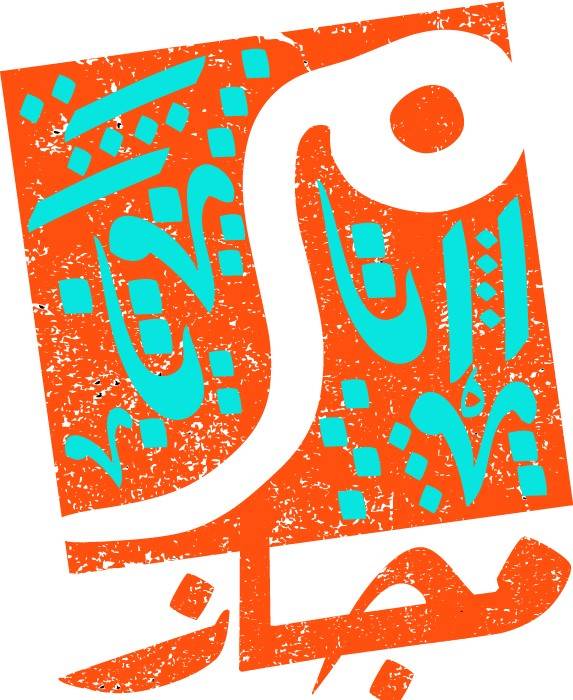 مجاز الحواس، جرح في هواء صافٍ
مجاز الحواس، جرح في هواء صافٍ
"العمر هزيمة"، جملة منسيّة تتوهّج في بالي كل حين بتحريض مؤثّرات متنوعة، أخمّن أنها لنجيب محفوظ في رواية ما أو حديث ما.
لأكون صريحة، غالباً ما تكون هذه المؤثرات نابعة من عمق مشاعري، ممّا يمور في أعماقي من عواطف وفي خلدي من أفكار في لحظات تأمّل لها علاقة بالحياة والعمر والمصير والنهاية، وللدقّة أكثر عندما أنتبه في لحظات حلم أو ذاكرة متوهجة بحمولة زائدة من الشجن، إلى أنّني اليوم غير أمس، وغير تلك التي كانت في الماضي، بل عندما تجتاحني موجة من مشاعر تغويني بفتنة ما وتحملني فوق أجنحة خيال مجنون مضمّخ بالحبّ، وربما أشعر بحاجتي إليه وأنّني جاهزة لأخوض مغامراته مثل المغامرة الأولى، بالاندفاع نفسه والتهور عينه والجنون ذاته.
وإنّني مستعدّة للاستسلام لتلك العاطفة وتركها تقودني بلا قيود إلى حيث الأسرار الغاوية، التي حرصت دائماً على أن أبقيها أسراراً مختومة، أغازل ختمها وأحلم كيف سأفضّه والوقوف على باب مغارته في لحظة انخطاف، كشامانة مغمضة العينين تتخاطر مع كائنات مقيمة في عتمتها.
ما زال الحبّ شاغلي وفراشتي التي ألحقها لأتبيّن سرّ ألوانها، أتابعه في كل شيء، في لقاء عاشقين منزويين في ركن يبدو محميّاً من البصّاصين، في عتمة صالة السينما وأضواء الشاشة تحيل الأجساد إلى ظلال تفضح أيادي أصحابها وهي تمتدّ لتلاقي أياديَ أخرى في حمأة المشاعر الملتهبة، في قبلة على الشاشة، في عصفورين يتناقران بشغف، في منظر شاب يحيط كتف صبية أو يحضنها وهي تستسلم بنشوة له.
في اللوعة التي يتضوّع بها صوت عبد الحليم، في آهات أم كلثوم، ودفء صوت نجاة الصغيرة، في شجن نازك وهي تغنّي: كل دقة ف قلبي بتسلّم عليك، يا وحشني، في قصيدة أسلمت نفسي لموجها المتدافع من بعيد، أو لأصابعها تتطاول صوبي، تلامسني فتشعل قلبي.
أتابع الحب في كل شيء، ويبهجني أن ألتقط ما يشي به، ويتصادى معه إحساس يبزغ كحبقة تتضوّع في نفسي، يربكني هذا التناغم، وأكثر ما يجعل قلبي يرقص: القبلة.
أمّا القبلة التي نقرت على قلبي كعصفور حطّ على نوافذ روحي، فقد "خلّعتني". كنت أقف على نافذة المطبخ حيث أسكن في برلين، أدخّن سيجارتي ونصف جسدي تقريباً خارجها كي أنفث دخاني ما استطعت إلى الخارج، وأسرح كالعادة في تأملّات قد لا أحتفظ بشيء منها.
أنظر إلى الشارع، إلى الحركة فيه، وأخفض بصري إلى تحت، حيث بوابة المطعم الصيني الواقع في الطابق السفلي تحت نافذتي مباشرة، أتفرّج إلى الداخلين والخارجين، أو أولئك الذين خرجوا ليدخنوا أمام الباب ثم عادوا لإكمال اجتماعهم حول المائدة، ليس من باب الفضول إنما من باب العادة، لكن ما حدث في ذلك اليوم كان أمراً مختلفاً، مشهداً وقع تحت بصري، ليس تحت بصري فقط، إنما تلقّفته عيناي وحضنه قلبي، خطف روحي إلى أقاصي الانفعال، أقاصي البكاء، أقاصي الفرح، أقاصي البهجة، أقاصي المعنى، وأعادني إلى الدهشة الأولى.
كانت تلك القبلة التي خلّعتني، مثل خميرة في روحي وفي خيالي، القبلة المضمّخة بشبق الحياة في امتلائها، تسلّلت إلى روايتي بأصابع قلبي قبل يدي... مجاز في رصيف22
كانا مسنّة ومسنّاً، أخمّن أن عمريهما تجاوز الثمانين، بكامل أناقتهما الرصينة، كانت تسند ظهرها إلى الجدار بجانب باب المطعم مباشرة، وهو يقف مقابلها، يمد يديْن راجفتين إلى صدرها، كانت يداه تحاولان إغلاق أزرار سترتها الخارجية، ترتجفان بينما أصابعه تحاول إحكام العروة من الزر، أغلق الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم... إلى أن وصل بعد طول جهد وصبر وارتجاف إلى الزر الأخير، رفع يديه إلى كتفيها وسوّى السترة فوقهما بالارتجاف عينه، ثم.... اقترب منها، نظر مليّاً في وجهها مع ابتسامة تشاركت غضون وجهه وأخاديد عمره المرصوف خلفه في صنعها، وطبع قبلة طويلة على فمها.
أحاط ذراعها المتدلّية بجانبها بيده، ومشيا متخاصرين. كانت تتوكّأ على عكّازٍ بيدها الأخرى يساعدها في السير، بينما تشحط ساقها المشلولة خلفها ويدها العاطلة عن الفعل مستسلمة ليده يقود خطواتها.
قبلة فجّرت المعنى في خلدي، ودفعتني إلى لملمة شظاياه ليصبح شغلي الشاغل وشغفي المتجدّد، في محاولة لأفهم القبلة بعد أن توهّمت زماناً أنني فهمتها، وعشتُها أيضاً، لتأتي قبلة من شخصين في "شتاء العمر" وليس في خريفه، فتقلب الطاولة وتعيدني إلى البدايات واقفة على حدود الدهشة.
صرت أستعيد المشهد كشريط أوقفه عند كل تفصيل، أكثر ما وقفت عنده كان القبلة، تلك التي توّجت تشاركاً جسديّاً وظيفيّاً بالدرجة الأولى، فقد كان إدخال الأزرار في عرواتها لتبكيل السترة وحماية جسد الآخر، الشريك، هو الهدف الأول، لكنه كان هدفاً يخرج عن نطاقه الوظيفي ليدخل منطقة أكثر حميمية وعمقاً، كان إدخال السعادة إلى قلب الشريك غاية سعى إليها الرجل الراجف بسبب العمر وخيانة الجسد بكل إصرار وحبّ.
بماذا كان يفكّر ويشعر حينها؟ هل كان ذاك الجسد المقابل له بتهاويه الدامغ نحو العجز حاملاً برهانه معه، يحمل غواية بدل تلك الجامحة التي امتلكها زماناً؟ هل كانت برودة جسد في الثمانين تصلّبت شرايينه وتراخت عضلاته وترهّلت أجهزته، قادرة على تعمير مجال من الجاذبية حوله تدخل الشريك في موجاته المخدّرة؟ أم هل كان لتلك الندوب العنيدة التي حفرتها السنين على الوجه، فخلطت تعبيراته وصارت خليطاً من اللذة والألم، من الضحك والبكاء، من البهجة والإحباط.
هل كان لها أن تضرم ما انطمر تحت رماد السنين المحترقة والأعمار الماشية في تهاويها المتخامد من ذرى العاطفة الجامحة، باتجاه قيعان الألغاز المتضافرة في النهايات المتوّجة بالموت؟ هل في هذه القبلة من الشبق ما يقدر على إضرام الشهوة في جسدين دخلا في تخاريف المفاهيم وامتحانات الذاكرة وانسراب الرغبة في سراديب الزمن؟
ما زال الحبّ شاغلي وفراشتي التي ألحقها لأتبيّن سرّ ألوانها، أتابعه في كل شيء، في لقاء عاشقين منزويين في ركن يبدو محميّاً من البصّاصين، في عتمة صالة السينما، في حمأة المشاعر الملتهبة، في قبلة على الشاشة، في عصفورين يتناقران بشغف.. مجاز في رصيف22
بقي هذا المشهد الموغل في الأسرار ماثلاً في بالي وفي روحي، ينهض كلّ حين كلوحة بديعة، إلى أن تسلّل من دون أن أقصد إلى روايتي الأخيرة "اسمي زيزفون" التي دفعتُ بها إلى دار النشر منذ مدة قريبة. بلى، من دون أن أقصد أفلتت "زيزفون" من قلمي وراحت تعيش لحظتها الغارقة بالمتع المؤجّلة، بعد أن حاصرها سؤال الحياة، وهل يمكن القول عن حياة خالية من المتع إنها حياة؟
زيزفون التي اجتازت عتبة الستين تكتشفُ الحبّ فجأة، فتعيش لحظة الحقيقة مع سعيد ابن السبعين، تقول: أوّل مرّة أشعر أن الحياة تكثّفتْ حتى احتوتْها قبضةُ يدي، لقد لامستُها كالحقيقة، شعرتُ بطراوتها، ذقتُ حلاوتها، فهمتُ مفرداتها، كل ذلك في لحظة حبّ تأخّر عنّي بعُمْر. ثم تبوح: اجتزنا العتبة الأولى، واكتشفنا أن الحبّ وحده يهزم العمر مهما بالغ الجسد في خياناته.. ويقول لها: تنضج الحياة وتكتمل في الخريف، أنت الأجمل عندي في امتلائك هذا وقد انتظرته بفارغ الصبر والحكمة.
كانت تلك القبلة التي خلّعتني، مثل خميرة في روحي وفي خيالي، القبلة المضمّخة بشبق الحياة في امتلائها، تسلّلت إلى روايتي بأصابع قلبي قبل يدي.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


