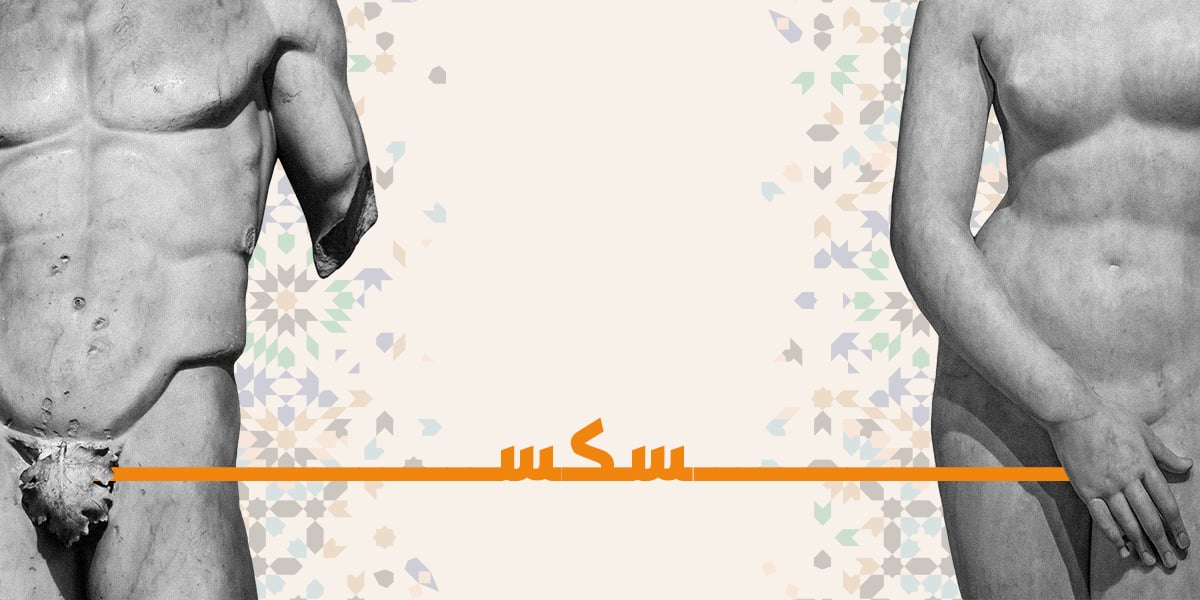عدتُ إلى إثيوبيا ولم أكن أعلم من أنا وما يمكنني أن أكون. حبي للاكتشاف ساعدني كثيراً على التأقلم مع بيئتي "الجديدة"، وما ساعدني على تنمية ثقتي بنفسي أني كنت محط اهتمام الجميع، هناك من يراني الجميلة وهناك من يراني "الفتاة الرائعة".
أصبحت تلك الفتاة الحلوة، صاحبة الابتسامة النقية والصدر الرحب وبدون شك سهلة المعشر، كان لدي شعبية في محيطي الجديد الذي عدت إليه بعد خمسة وعشرين عاماً من الانغلاق السعودي.
كي أكون صادقة، فقد عدت إلى مسقط رأسي، إثيوبيا، محطمة ومعدومة الثقة، كوني من دولة فقيرة ذات خلفية عاملة، لم أستطع أن أُكمل تعليمي الجامعي، وزني الزائد كان سبب في جعلي أكره نفسي أكثر، أحكام مسبقة ألصقت بي رغم أني التزمت كل التقاليد. حفظت القرآن والتزمت الصلاة. كنت تلك الفتاة التي تخاف من ظلها كي لا يفشي بسرها عن عدم وضوئها قبل تلك الصلاة، رفضت أي شاب أُعجب بي وخفت من أن اقع ضحية "الذئاب البشرية".
وجودي في أديس أبابا أدخلني إلى المجتمع الأوروبي، تعلمت اللغة الفرنسية وأنا أتحدث اللغة العربية، عملت لمنظمات غير ربحية وتطوعت في أكثر من مشروع غير ربحي، تعاونت مع كل أنماط المجتمع الطبيعي المنفتح، كنت أندمج مع الجميع والجميع اندمج معي، لكن في داخلي كان هناك المفتي الشيخ الصغير الذي يؤنبني على كل كأس نبيذ أتذوقها، على كل قبلة أسرقها من هنا أو هناك، ولقد أنّبني حتى على صداقتي مع مثليين.
وجودي في أديس أبابا أدخلني إلى المجتمع الأوروبي، تعاونت مع كل أنماط المجتمع المنفتح، كنت أندمج مع الجميع والجميع اندمج معي، لكن في داخلي كان هناك المفتي الشيخ الصغير الذي يؤنبني على كل كأس نبيذ أتذوقها، على كل قبلة أسرقها من هنا أو هناك، ولقد أنّبني حتى على صداقتي مع مثليين
كان عام كورونا، 2020، هو عامي الحافل بكل ما يمكن لإنسان أن يعيشه، اكتشفت ذاتي المستقلة المحاربة التي لن تخاف من شيء، أحببت نفسي بكل تلك المعاني التي تُحكى، أحببت ذاتي الوحيده وأردت أن أعرف من أنا بوجود أحدهم. بدأت المواعدات العاطفية من خلال تطبيقات المواعدة الإلكترونية، والتقيت برجال ونساء. لكن لم أستطع أن أفهم هؤلاء الغرباء ولم أستمتع بوجودهم. شعرت بالخواء في تلك الفترة، وكان اتزاني الذي زرعته قد تم حصاده من تلك المواعيد الفارغة.
في يوم من أيام السنة الماضية، جاءتني صديقتي حاملة خبر "أنها وجدت نصفي الآخر"، أي الشخص الذي طالما تحدثتُ عنه. وكانت تجزم أنني أعرفه. لم أهتم بما تقوله، ولم أجد سبباً يدعني أتحمس لحديثها عن شخص مجهول، حتى وصلتني دعوة لحفل رأس السنة الأثيوبي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر.
لم أرفض الدعوة، فصاحبتها فتاة أكن لها الاحترام. وجودي في تلك الليلة فتح عينيّ على ذلك الشاب صاحب الابتسامة الدافئة، لقد توغل في روحي من تلك اللحظة. شعرت بمشاعر لا يمكن أن أصفها لمجرد النظر إليه. كانت صدمتي حين قالت لي صديقتي "ما رأيك في غوستافو؟". كنت في حالة ذهول من مصادفة أنه ذلك الشخص الذي كانت تتحدث عنه بصورة دائمة، وكانت صدمتي أكبر عندما علمت أنه قريب صاحبة الدعوة للحفل.
تلك اللحظة التي رأيت فيها غوستافو كانت جميلة، رغم وجود امرأة معه، ولكن احترامه للمرأة التي كانت معه جعلني أكن له الاحترام والتقدير، اهتمامه بي كان واضحاً للجميع بالعموم ولي بالخصوص، شعرت بتلك النظرة المحبة المقدرة التي من النادر أن تُلمس في أول صدفة تقابل فيها أحدهم. قررت أن أترك الحفل والعودة إلى منزلي، فما كان منه إلا أنه طلب مني طريقة للتواصل معي من خلالها.
بدأنا بتواصل عن طريق واتساب، وكنت سعيدة بتواصلي الصريح والحقيقي معه، لم نستطع أن نتقابل ولكننا عرفنا كيف يصل أحدنا إلى الآخر مع بعض الثغرات بين أسبوع وآخر. إلى أن كسر عادتنا في الكتابة/ التشات، وبدأ الاتصال بي، وبعدها بدأنا نتحدث عبر الفيديو، وبعد شهرين من الاتصالات والمقابلات وسط كم من الأصدقاء كنا قد أصبحنا نلتقي وحدنا.
"أنا أحبك واحترمك بشدة"، عبارة جعلتني أعجب بغوستافو، رغم قصر قامته وصغر حجمه بالنسبة لي، لم أكن في يوم من محبي "الكول بويز" كما يسمونهم، لم أعتمد طريقة ستيف هارفي في التسعينيات يوماً، ولم أختبر هذا الشخص، تحدثنا وتواعدنا في يوم واحد وفي الموعد الثاني كنت في السرير معه.
لا أهتم بالحقيقة إن كنت سأواصل علاقتي معه أو مع غيره، هذا آخر ما أفكر فيه، لأن ما يجعلني سعيدة اليوم هو أن أول تجربة جنسية كانت رائعة، ولست نادمة عليها أبداً. لكن، كأني مستغربة من هذه الحقيقة؟
دخلنا غرفة الفندق. تبادلنا القبل، تحدثنا وعدنا إلى تبادل القبلات، شيئاً فشيئاً كنا عاريين نبحث عن الواقي الذكري. سألني شريكي سؤالاً على ما يبدو أنه كان سبباً في تغيير مفهومي لهذه العلاقة، وهو: "هل تقبلين أن نكمل ما بدأنا؟". أحببت شعوري وأنا أجيبه بـ "نعم". تلك الكلمة السحرية التي دمرت كل شعور بالذنب. كل شعور بالألم وكل شعور آخر، غير أنني أريد هذا الشخص أن يكون معي في هذه اللحظة.
غريب كيف تتحول الأمور بهذه السرعة وكيف أكون "عذراء" لمدة ثلاثين عاماً ومن ثم أستسهل المسألة بهذه الطريقة مع شاب بالكاد أعرفه.
اليوم، أشعر بنفس الشعور الذي كنت أشعر به وأنا "عذراء"، لم افقد شيئاً ذا أهمية ولم أندم على هذه التجربة. الجميل أنني لم أقع في حبه ولا أستطيع أن أضمن القول إني سأكون حبيبته رسمياً، ولم أقلق بهذا الشأن. فهذا الموضوع لم يشغلني. بل بالعكس لقد أهديت إلى نفسي أجمل هدية، وهي أن أكون في أول علاقة جنسية وأن تكون بهذه الروعة.
تجربتي هذه علمتني أن "عذريتي" ليست ذات أهمية، بل رغبتي هي أهم من كل شيء. لكن بنفس الوقت، كان من المهم أن أشعر باحترام شريكي وحبه لي، الاحترام الذي أستحقه كامرأة. أحببت أن صوتي ومشاعري وقراراتي لها مساحتها في هذه العلاقة، لا أحد يقرر عني ولا حتى هو. ومن هنا، لا أهتم بالحقيقة إن كنت سأواصل علاقتي معه أو مع غيره، هذا آخر ما أفكر فيه، لأن ما يجعلني سعيدة اليوم هو أن أول تجربة جنسية كانت رائعة، ولست نادمة عليها أبداً. لكن، كأني مستغربة من هذه الحقيقة؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.