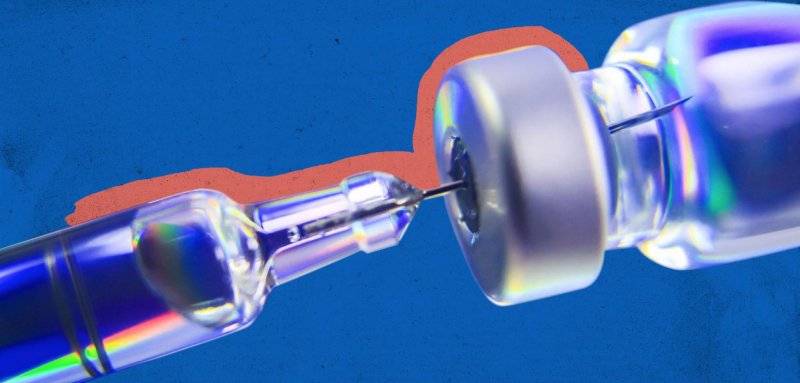في كلية الصحة العامة في جامعة يال، كان الأستاذ جايسون شوارتز منشغلاً بالحديث عن لقاح كورونا المُنتظَر مع زميله في الكلية جايمس هامبلين. الفيروس الذي جمع العالم على طاولة نقاش مستديرة بحجم الكوكب، سرت قناعة بأن اللقاح ضده هو خشبة الخلاص. لكن لدى شوارتز مخاوف من قناعة مُماثلة، فبرأيه "إن علّقنا جميع آمالنا على اللُقاح باعتباره الحل السريع، سنكون في ورطة".
السيناريو الأمثل بالنسبة للأستاذ المختص بسياسات التلقيح هو النجاح في تحدي الاستمرار بتطوير اللقاح حتى "بعد فوات أوان الحاجة الماسة والمُستعجلة إليه".
قد يبدو كلامه مستغرباً وبعيداً عن الرغبة الآنية لمن ينتظرون اللقاح بـ"نَفَس مقطوع"، لكن شوارتز يربط كلامه بمسألة الجاهزية لمواجهة كورونا وتطوراته المستقبلية. "كان يُفترض بالعالم أن يكون مستعداً طيلة العقد الماضي، منذ ظهور السارس. لو لم نضع أبحاث لقاح سارس في الأدراج، لكان لدينا اليوم كمية كافية من البيانات التأسيسية لمواجهة كورونا، ذي الصلة الوثيقة به"، يشكو الأستاذ موضحاً "مع سارس، كما هو الحال مع إيبولا، تبخّر التمويل الحكومي وتنمية صناعة اللقاح والعلاجات بمجرد زوال الإحساس بحالة الطوارئ… بعض الأبحاث أُهملت، لأن حالة التفشي انتهت، فانتَفَت الحاجة المُلحّة لتطوير لقاح".
لكن كورونا الذي لا يُشبه على سبيل المثال فيروسات أخرى بعوارضها شديدة الوضوح وأرجحية تسببها بالوفاة، بدا أكثر خطورة رغم كونه أقل شدة، فهو يقتل لكن لا يقتل دائماً، وينتشر لكنه ليس دائم الأعراض، ما زاد من صعوبة فهم تفاعله وتطوره، ناهيك عن احتوائه على المدى المنظور.
لا يبدو أن "الحاجة الملحة" في حالة كورونا ستنتفي سريعاً، ما دفع باحثي العالم ومختبراته للاستنفار طمعاً بإيجاد لقاح سريع، بعدما كان الاستثمار في مجال اللقاحات غير ذي جدوى، لاقتصار "المُنتَج" على فئات محددة، وعلى الحاجة إليه لمرة واحدة فقط في السنة أو مدى الحياة.
"سرعة البرق"
منذ العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، وتحديداً بعد أن تقاسمت الصين مع العالم تسلسل الحمض النووي (الجينوم) الخاص بالفيروس، سارعت الشركات والمعامل الحكومية لدراسة الأخير في محاولة لإنتاج اللقاح.

هكذا بدأت حوالي 35 شركة ومؤسسة أكاديمية بالعمل لتطوير اللقاح. أعلنت أربع جهات منها بدء اختباراتها على الحيوانات، فيما نشرت مجلة "Science" قصة جينيفر هالر باعتبارها أول فتاة تطوعت للخضوع لاختبار اللقاح التجريبي الذي تُطوّره شركة "مودرنا" للتكنولوجيا الحيوية (مقرها بوسطن).
"سرعة الشركات في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا تعتمد على استثمارها في فهم كيفية تطوير اللقاحات ضد عائلة كورونا التي تسببت بمشكلتين في العالم، الأولى في الصين بين عامي 2002 و2003 مع ظهور فيروس سارس الذي يؤدي إلى متلازمة الجهاز التنفسي الحاد، والثانية مع متلازمة الشرق الأوسط قبل سنوات"، كان هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لـ"تحالف ابتكارات التأهب للوباء" (CEPI) ريتشارد هاتشيت.
سحبت شركة "نوفافاكس" ملف لقاح "سارس" من الدُرج لتستند عليه في تطوير اللقاح الجديد، بينما اعتمدت "مودرنا" على ملف "متلازمة الشرق الأوسط". وبعد 63 يوماً، جرى اختبار اللقاح التجريبي على هالر ومجموعة صغيرة (حوالي 40 شخصاً) في مقر "كايزر برماننت" في أوكلاند.
"إن علّقنا جميع آمالنا على اللُقاح باعتباره الحل السريع، سنكون في ورطة"... ينتظر العالم اللقاح ضد كورونا بـ"نَفَس مقطوع"، لكن خبراء يحذرون من مغبة الاستعجال وتجاوز البروتوكولات المعتمدة، كما حصل مع لقاحات أخرى تبيّن لاحقاً أن آثارها الجانبية أخطر من الفيروس نفسه
حوالي الشهرين منذ بدء الأبحاث حتى الاختبار البشري مدة تُعتبر، بحسب البروتوكولات الطبية، قياسية. على سبيل المثال، استغرق اللقاح التجريبي لـ"زيكا" كي يخرج من المختبر إلى جسد المتطوع الأول عام 2016 نحو 190 يوماً، وقد وُصفت الفترة وقتها بـ"سرعة البرق".
لكن استعراض السرعات هذا قد يخلق آمالاً كاذبة، إذا ما جُرّد عند طرحه من عوامل أخرى مفصلية في عالم التلقيح، منها المرتبط بالجانب الأخلاقي للتجارب أولاً واحترام المراحل البروتوكولية المعتمدة ثانياً والأخذ بالاعتبار الآثار الجانبية ثالثاً، ومنها المرتبط بعدالة التوزيع وتحرير اللقاح من ضغوط السياسة والاقتصاد حين يُصبح جاهزاً.
الأسئلة الأخلاقية
لنترك الجانب الطبي المتعلق بشكل اللقاح وطريقة عمله، لأن النقاش ليس أبداً مع اللقاح أم ضدّه، ولنعد قليلاً إلى تجارب سابقة لفهم الجانب الأخلاقي.
عام 2014، كان إيبولا يحصد المئات يومياً، وبحسب الخبراء "لم يكن هناك وقت للانتظار"، فلم تُجرَ الاختبارات المعتادة بل قررت السلطات الصحية استخدام اللقاحات التجريبية للمرض في غضون أشهر معدودة، فيما يتطلب الأمر سنوات عدة للتأكد من سلامة أي لقاح جديد وفعاليته قبل السماح باستخدامه.
وقتها كان إجراء تجارب على متطوعين أصحاء مطروحاً كما الحال اليوم مع كورونا، ما ولّد أسئلة أخلاقية عدة ينفع كذلك طرحها اليوم، ومنها: هل يمكن للقاح لم يحصل على موافقة نهائية بعد أن يعطى لكل الناس أو لقلة محدودة؟ هل يجب إعطاؤه للعاملين في الحقل الطبي أولاً؟ هل أولوية إعطائه تكون لمنطقة موبوءة بشدة (كانت ليبيريا في حالة إيبولا) أم لمنطقة تقترب من السيطرة عليه (غينيا)؟ هل يتم إبلاغ الناس أن اللقاح سيحميهم أم يُعطى لهم مع ضمان حفاظهم على كافة التدابير الاحترازية التي سبقت اللقاح؟
بخصوص لقاح كورونا المنتظر، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطويره قد يستغرق سنة ونصف السنة، فيما يحتدم الجدل طبياً بين فريقين: الأول يحذر من الآثار الجانبية للاستعجال، والثاني يضغط لأجل اختصار مراحل بروتوكولية تعرقل طرح اللقاح سريعاً في السوق.
والمراحل البروتوكولية في العادة ثلاث، بدءاً من اختبار اللقاح على عشرات المتطوعين الأصحاء بغية رصد آثاره الجانبية، ثم توسيع الاختبار ليشمل المئات في مناطق موبوءة بهدف اختبار مدى فعاليته، وصولاً إلى المرحلة الثالثة حيث يُجرّب على عدة آلاف في مناطق موبوءة، على فترة زمنية طويلة، لتأكيد النتائج.
وفي هذه المراحل قد يظهر أن اللقاح غير آمن و/ أو غير فعال، من هنا يحذر فريق من الباحثين من مغبة تخطي التجارب السريرية أو الاستعجال فيها، إلا في حال كان العمل على لقاح شبيه بلقاحات سابقة، وهي ليست الحالة مع كورونا المستجد حيث أن التقنيات المقترحة لبناء اللقاح ضده غير مُجرّبة إلى حد كبير في وقت سابق.

من المؤيدين لضرورة التروّي، مدير "مجموعة مايو لأبحاث التلقيح" غريغوري بولاند الذي يوضح كيف أن "نقل اللقاح من المختبر إلى الفضاء البشري العام يتم عادة بوتيرة بطيئة وكلفة عالية، فمنذ بدء البحث حتى تسويق اللقاح قد يستغرق الأمر عادة من سبع إلى عشر سنوات أو أكثر، وحوالي مليار دولار أمريكي… من أجل تقليل الأضرار".
البروتوكولات في مواجهة الحاجة الملحة
لا شك أن جودة اللقاحات اليوم ودقتها أكبر من السابق بفعل تطور الطب والمختبرات، لكن ثمة متغيرات لا تُحصى تؤثر على ردة فعل جسم الإنسان، ومنها جهاز المناعة لدى كل شخص، الحالة البدنية، والبيئة المحيطة بما في ذلك التعرض لأشكال أخرى من الفيروس…
في السياق، تُذكّر رابطة الكليات الطبية الأمريكية بلقاح شلل الأطفال الذي طوّره جوناس سولك في الخمسينيات والذي يُعتبر من أكثر قصص المناعة نجاحاً، لكن الاستعجال في طرحه آنذاك تسبّب بوفيات كثيرة، من هنا توصي بضرورة الانتظار أكثر من عامين قبل طرح اللقاح الجديد للاستخدام.
وفي مثالين أكثر حداثة، الأول تزامن مع انتشار موجة إنفلونزا الخنازير عام 2009، حيث تم تصنيع لقاح "Pandemrix"، بـ"سرعة قياسية" وطرحه للاستخدام، ليتبيّن في عام 2018 أنه لم يتم اختبار التأثيرات الجانبية للقاح وقتها، بعدما كشفت "British Medical Journal" أن الشركة المصنعة كتمت تقارير مسبقة تؤكد احتمال إصابة من يأخذ اللقاح بمرض النوم القهري/ التغفيق (nacrolapsy/ يفقد الدماغ قدرته على السيطرة في النوم والاستيقاظ).
وللعلم، فإن فرنسا وحدها اشترت وقتها نحو 950 مليون جرعة من اللقاح بأكثر من ملياري يورو، ولم يُستعمل من اللقاح أكثر من 6 ملايين جرعة بعدما تبيّن أن الإنفلونزا ليست بتلك الخطورة، بينما جرى التخلص من الكمية المتبقية لانتهاء صلاحيتها، وهذا تفصيل سنعود إليه في الجزء المتعلق بعدالة التوزيع.
أما المثال الثاني، فهو لقاح "فيروس التهاب الكبد ب" (hepatite B) الذي جرى الترويج له على عجالة، ليتبيّن لاحقاً أنه يسبب مرض التصلب اللويحي، وقد رفع العديد من ضحايا اللقاح دعاوى في هذا الشأن.
في المقابل، يُسوّق باحثون لنظرية أن المتطوعين الأصحاء يجب أن يصابوا عن قصد بالفيروس لتسريع إنتاج اللقاح، ويحذرون من أن تأخر اللقاح كل أسبوع يرافقه عدة آلاف من الوفيات في العالم. يعترف هؤلاء أن تجاوز المراحل محفوف بالمخاطر، لكنه يربطون توفير الوقت بـ"غاية أسمى" هي الحد من عدد الوفيات، ويدعون إلى تشدد أقل في التعامل مع اللقاح.

أصحاب هذه المقاربة يروّجون لضرورة تجاوز المرحلة البروتوكولية الثالثة في مقابل حقن 3000 متطوع بصحة جيدة باللقاح واختباره على مدة زمنية قصيرة، مستندين إلى توقيع هؤلاء إخلاء مسؤولية بينما يراعي الخبراء معايير اختيارهم فيحرصون على انتقاء أشخاص من ذوي القدرة البدنية القوية، فيما يضمنون لهم أفضل رعاية صحية ممكنة بعد حقنهم.
لوبي شركات الدواء واستثمار الهلع
في أماكن مختلفة، يحتفي العالم بتوحد الجسم العلمي والمخبري حول هدف واحد، ويكثر الثناء على روح التشاركية العالية السائدة المخالفة لما اعتاده هذا الجسم من تطوير الأبحاث سراً، لكن على ما يقول بيتر هوتز: "الحديث عن مدة تتراوح بين 12 إلى 24 شهراً لطرح اللقاح، يبقى سيناريو متفائلاً".
"إن كانت بيولوجيا الفيروسات وتكنولوجيا اللقاحات عوامل مقيّدة، فإن السياسة والاقتصاد يشكلان الحاجز أمام تحصين الجهاز المناعي"... مع سباق أكثر من 35 جهة لإنتاج اللقاح، يحضر تحدي ضمان وصوله العادل للجميع، في مقابل مصالح لوبي شركات الدواء
لكن لنفترض أن اللقاح الفعّال قد أُنجز، ماذا يحصل بعد ذلك؟ يأتي هنا جواب صاحب الكتاب الشهير "نهاية الأوبئة" جوناثان كويك ساخراً بالقول "إن كانت بيولوجيا الفيروسات وتكنولوجيا اللقاحات عوامل مقيّدة للسرعة في الإنجاز، فإن السياسة والاقتصاد يشكلان الحاجز أمام تحصين الجهاز المناعي للفرد".
يقول كويك: "لم يكن لأي من التطورات الإيجابية التي نعيشها أن تحدث دون منظمة الصحة العالمية، لكن الأخيرة لا تملك حرية التصرف إلا بسماح أعضائها بذلك. هؤلاء تراجعوا عن التمويل منذ الأزمة المالية عام 2008".
بموازاة هذه المسألة، يحضر التحدي أمام شركات الدواء لإنتاج كميات كافية عالمياً من اللقاح بعد إقرار السلطات الصحية له، والكثير من الشركات لا تملك القدرة الإنتاجية اللازمة.

لكن التحدي الأكبر يكمن في مسألتين مترابطتين: ضمان الوصول العادل ميسور التكلفة للقاح، تحديداً إلى الدول الفقيرة والنامية، في مقابل تشابك مصالح السياسة والاقتصاد مع مصالح شركات الدواء.
خلال تفشي إنفلونزا H1N1 عام 2009، تضررت المكسيك مثلاً بشدة، بعدما منعت أستراليا صادرات اللقاح حتى تأخذ حاجتها منه، وكلما دخل العالم في وضع الإغلاق والوقاية كلما كان من الصعب تقييم المخاطر بشكل صائب وتوزيع الأدوات بشكل فعال.
ثمة اختلال متأصل بين الحاجة والقوة الشرائية عندما يتعلق الأمر باللقاحات، حيث تحظى بالأخيرة الدول ذات القدرة الشرائية المرتفعة، تاركة الأكثر فقراً تتخبّط مع حاجتها.
في معرض المخاوف المتداولة من عدالة توزيع اللقاح، يُطرح دور لوبي شركات الدواء، المعروف بـ"بيغ فارما" (Big Pharma) والذي تدور حوله الكثير من نظريات المؤامرة.
شركات كثيرة من هذا اللوبي سارعت لتطوير اللقاح لأنها ترى فيه "فرصة العمر"، على قول صاحب كتاب "فارما: الجشع والأكاذيب وتسميم أمريكا" جيرالد بوزنر.
يُعطي بوزنر مثالاً عن عقار "sofosbuvir" المضاد للفيروسات الذي يستخدم لعلاج "التهاب الكبد سي". العقار الذي أُنتج ببحث ممول من المعاهد الوطنية للصحة، أي بتمويل عام، مملوك الآن من شركة "Gilead Sciences" التي تتقاضى 1000 دولار عن كل حبة. ربحت جلعاد 44 مليار دولار من الدواء خلال السنوات الثلاث الأولى في السوق.
يدور النقاش اليوم حول القيود المفروض وضعها على تلك الشركات عند إنتاج اللقاح، بين من يشدد على ضرورة كبح جماحها في مقابل من يسوّق لخطورة ذلك على حماستها في الإنجاز. نسب الوفيات المتصاعدة والهلع الذي تشارك وسائل إعلام كما صناع رأي في صنعه، يترك لتلك الشركات - المشهورة بتشابك مصالحها مع سياسيين وأطباء - فرصةً لوضع شروطها.
فوق ما سبق، ثمة الاختلال المتأصل بين الحاجة والقوة الشرائية عندما يتعلق الأمر باللقاحات، حيث تحظى بالأخيرة الدول ذات القدرة الشرائية المرتفعة، تاركة الأكثر فقراً تتخبّط مع حاجتها.
وإن خَطَر في بال طبيبين فرنسيين (على الأقل كونهما عبّرا عن الأمر) أن بالإمكان تجربة اللقاح، قبل طرحه، على أفارقة (بحجة أنهم لا يلبسون أقنعة ولا علاج لديهم) وعاملات جنس (بحجة أنهن معرّضات أكثر ولا يحمين أنفسهن)، يعني أن تسليع البشر والفوقية يسريان على تقديم اللقاح، لكن بشكل عكسي. وإن قامت دول، في لحظة هلع وحاجة عالمية، بمصادرة كمّامات، فكيف سيتم التصرّف مع اللقاحات؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.