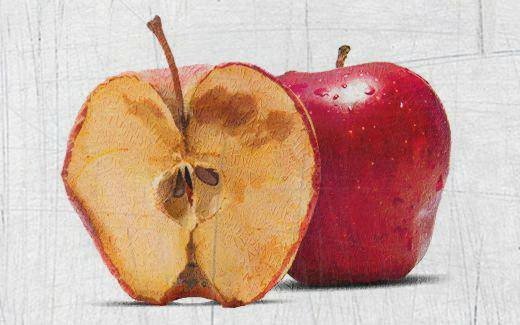نحن شعب فخور بنفسه، شأننا شأن كل شعب، لكننا نختلف في كوننا نظن أننا دائماً في المقدمة. نحن فينيقيا قدموس وهنيبعل. نحن فخرالدين وبشير الثاني. نحن كارلوس سليم... شعب عريق جمع حصاد آلاف السنين من الحكمة التي تخوّله أن يكون رائداً في كل المجالات.
الطائرة على وشك الإقلاع متجهة الى بيروت، لكن فجأة نسمع نداء القبطان: "تماشياً مع توجيهات طيران الشرق الأوسطـ يجب أن نعود الى البوابة. هذا كل ما نستطيع أن نقوله لكم". تعود الطائرة المليئة بالمسافرين إلى المحطة الثالثة في مطار هيثرو ببطء قاتل. الركاب يهمسون بكلمات تعبّر عن استياءهم، كلّ منهم يختار طريقته الخاصة. أكثر الكلمات التي تصل إلى أذنيك يقتصر على حرفين أو ثلاتة. حروف غدت جزءاً من لغتنا اليومية. يتبادل المسافرون الآراء حول سبب العودة إلى الباب. لكلّ منهم نظريته الخاصة.
بعد تأخير لأكثر من ساعة، تصفعني العبارة التالية: "لا تكرهوا شيئاً لعلّه خير لكم". نظرت إلى مصدر الصوت فشاهدت رجلاً يزن أكثر من مئة كيلوغرام بكثير ويجلس على أحد مقاعد الدرجة الأولى. طوال الرحلة سأعيد الالتفات إليه لأراه إما يضحك أو يقرأ في كتابه المقدّس أو يشاهد أفلام كرتون. لا أحبّذ أي حديث عن الآخرة في الطائرة. اعتبره "بلا ذوق". فنحن عرضة لأي شيء في السماء. لا مزاح هنا. فجأة، تسكت محرّكات الطائرة. ومرّة ثانية يتحدث القبطان إلينا معلناً أنه علينا إضافة كمية من الوقود تكفينا للوصول إلى باريس الشرق. ساعة أخرى تمضي ونحن نزحف على المدرج إلى نقطة التعبئة. لسنا كارهين لأيّ شيء. قيل إن الطاقم الأرضي اللبناني الذي لم يتغير منذ عشر سنوات، نسي أن يسلّم القبطان مستنداً لا يحقّ للطائرة أن تغادر من دونه.
وصلنا إلى "مطار رفيق الحريري الدولي". الإسم كافٍ لتذكيرنا باغتيال وطن. أخرج من صالة الوصول لأواجه مشهداً يؤكد لي ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسبة الولادات. كل مسافر ينتظره عشرة أشخاص على أقل تقدير. يتبادلون معه البكتيريا والفيروسات عن طريق القبل ودموع الفرح المنهمرة. أشقّ طريقي بهدوء بين أشخاص يسدّون الممر الضيق، غير مكترثين بغيرهم، لأخرج من المطار. فور عبور ظلي للبوابة الخارجية يهجم عليّ عشرة سائقي سيارات ويعرضون خدماتهم عليّ. لن استخدم تاكسي المطار فتسعيرته أربعون دولار. مبلغ غريب عجيب يُفرض على الراكب في سيارات لم تتم صيانتها منذ سنوات. استقلّ سيارة عمومية عادية، يقول لي السائق التسعيرة المعتادة: "قدّ ما بدّك" أي أن التسعيرة تخضع للحديث المرتقب مع السائق وسعر المنزل الذي سيقلك إليه. الطريق نصفه معتم، الكهرباء مقطوعة، لكن المفاجأة الكبرى هي إغلاق أكبر جادة مؤدية إلى منزلي لأن إحدى الشخصيات السياسية المقيمة بالقرب منّي تشعر بالخطر. لا أحد يتململ. أتبادل كلمات قليلة مع السائق وأخبره بأن حق الإنسان في الوصول إلى بيته أهم من الحفاظ على أمن شخصية مهددة كان بإمكانها أن تهاجر مثلها مثل أغلبية الشعب اللبناني المهدّدة بأشكال مختلفة.
الفائدة 7% على الدولار في قطاع مصرفي حجمه 170$ مليار دولار، أي أن الفائدة الممنوحة أعلى بعشرين مرّة مما هي عليه في السوق العالمي. والسبب؟ نسبة الفائدة هي انعكاس لفوضى الغابة اللبنانية، لقصر النظر، للفساد، لضعف المؤسسات وسياسات "الترقيع". ما هي تداعيات ذلك؟
أصل إلى المنزل. بوابة المبنى لا تفتح. الأقسام الأرضية مؤجرة إلى مطاعم. وطبعاً، كل سائق يقوم بإيصال كيلو بطاطا له الحق في صدم البوابة. حاول حارس المبنى ضرب جهاز التحكّم لعل البوابة تفتح. فالضرب هو الوسيلة الأولى لمعالجة الأمور. على الطريق إلى الطابق الرابع، يتوقف المصعد ٣٠ ثانية لأن الكهرباء انقطعت، 30 ثانية تمكّنك من مراجعة أشياء كثيرة في الحياة. أدخل إلى المنزل. التلفزيون لا يعمل. أتصل بشركة الصيانة فيطالعني المجيب بتفسيرات غريبة عجيبة فهمت منها أن "الكابلات" التي باعوني إياها تتسبب في انقطاع الصورة. بعد إلحاحي، يأتي عامل الصيانة ليبدّل شريط الـHDMI . ترجّاني ألا أقول إنه أعطاني الشريط الذي كان بحوزته. "كبسته" عشرين دولار لأن سعر خدمته "قدّ ما بدّي". حتماً، كان يعلم أن مشواره بعشرين دولار. أشعل التلفزيون. أمضي سهرة موسيقية مع نساء انتهت مدّة صلاحيتهن الاستعراضية في القرن الماضي. بالكاد أميز بينهنّ. كلّهن خضعن لسكين الدكتور نفسه وفي وجوههن ملامح كائنات فضائية.
حان وقت النوم. أنظف اسناني بمياه مالحة، نشتريها من مصادر مجهولة. تُتداول أخبار تقول إنها قد تكون ملوثة. أسمع ضجيج السيارات وكأنها تمر من داخل منزلي. الزجاج مزدوج، صنع في المانيا ومركّب على إطارات متينة صلبة تعتبر أفضل ما في الأسواق العالمية. لكن العمّال الذين قاموا بتركيبها تركوا ثلاثة ميليمترات فراغ بين الزجاج و الحائط. أهدئ نفسي بكلمات قصيرة و اتقبّل الوضع، حامداً ربّي على نعمته.
في الصباح، أخرج بصعوبة من المرآب، فالموقف المخصص لي مباح للجميع لأنني لا أملك سيارة. اضطر إلى إخراج درّاجتي النارية عابراً مسلكاً متعرجاً بين السيارات لقطع المسافة القصيرة التي تفصلني عن المكتب. تنتابني الرغبة في القيادة على الرصيف مثل باقي سائقي الدراجات النارية. اسيطر على رغبتي هذه مخاطراً بحياتي بين سائقين معظمهم لا يدرك مفهوم الـ"بلايند سپوت"، القاتل الفتّاك.
أخيراً، أصل إلى أمام المكتب وخوذة الدراجة على رأسي كالمعتاد. يتلاعب بي رجال "السيكيوريتي"، مجتهدين كل يوم اجتهاداً جديداً حول الأمكنة المخصصة لركن الدراجات النارية، ما يضطرني إلى إخراج ورقة نقدية صفراء تغير القانون حتى اليوم القادم. لا يوجد أي مكان مخصص للدراجات النارية أو الهوائية في بلاد الرانج روفر والمرسيدس. أدخل إلى المكتب. ألقي التحيّة على عامل النظافة الذى اعرفه منذ سنين. بالكاد يجيب. يفتح يده من دون تردد لاستلام الورقة النقدية الحمراء التي اعتاد على أن يأخدها منّي دون النظر إليّ أو شكري. يتأفف كثيراً ويتأخر على كل شيء إلا على الصلاة التي يقيمها على درج البناء الفخم.
اهمّ بالذهاب لاستشارة طبيب يعمل في أحد أكبر المستشفيات. أصل إلى صالة انتظار شاغرة. قبل ثلاث دقائق من موعدي تزف لي موظفة الاستقبال خبر اضطرار الطبيب إلى التأخر نصف ساعة. في النهاية لم يصل قبل ساعة وربع بالكامل قضيتها في مسامرة السيدة جاهداً نفسي بالحديث بالفرنسية وفي الاستماع إلى حديثها مع مندوبة مبيعات شركة أدوية عالمية. استفسرت منها عمّا إذا كانت شركتها تدفع للطبيب عمولة إن وصف أدويتهم، فحدّثتها عن تغطية الشركة لرسوم الاشتراك في محاضرات ومؤتمرات وتغطيتها لمصاريف السفر وعن غيرها من المغريات. المغري في الحقيقة كان المندوبة نفسها: يخجل القمر من جمالها، كما يقال. بالكاد ترتدي بعض الملابس. قميصها ضيق إلى درجة أنها ليست بحاجة لارتداء حمّالة صدر. اصابع رجليها مطلية باللون الزهر وظاهرة من حذاء كعبه أطول من عشرة سنتيمترات. استقل "سرفيس" مشترك. يقرّر السائق، لسبب ما، أن دخولي إلى سيارته سيكلّفني أجرة راكبين. وقبل الوصول إلى النقطة المتفق عليها، يقول لي: "الطرق مقطوعة، انزل هنا". نزلت. اكتشفت أن الطريق ساكلة لكنه أراد اختصار المسافة على نفسه.
أعود إلى بيتي في المساء. انتظر عامل صيانة طال انتظاره. وصل حاملاً صندوقاً يبدو أنه مثقل بكل ما يحتاجه وأكثر. طبعاً، طلب منّي قلم، ومتر للقياس، ولم يكن معه "المفك الفرنجي" المطلوب. حلف بحياة أولاده أنه كان داخل الصندوق. على كل حال، كان عليّ أن أساعده في عمله، لأن مساعده اضطر للذهاب إلى ورشة ثانية. سألته إن كان قد شارك في دورة تدريبية، فنظر إليّ ورباً، ففهمت.
استحميت بالماء المالح فأعطاني شعور الخارج من مياه البحر. ارتديت ملابسي وذهبت إلى مطعم ياباني لتناول طعام العشاء. أكثر شيء يشبه اليابان في المطعم كان النادل الفيليپيني. شكله غريب. يقطّع السمك المثلج وكأنه لحم أرانب. اعتاد اللبنانيون على الإكثار من الملح والسكّر على الوجبات اليابانية ليطغى طعمهما على طعم و رائحة ما يسمّى بالسوشي.
نسيت أن أذكر أن المسؤول عن حسابي المصرفي هاتفني والابتسامة حتماً كانت على وجهه رغم أنني لم أره. هكذا تخيّلته. إستدرجني إلى عملية ايداع نتيجتها خسارة 20 يوم فائدة. قبلت. بعد انتباهي إلى ذلك، شعرت بألم الاغتصاب، لكنني سرعان ما سيطرت على الموقف وألقيت اللوم على نفسي لطمعي بفائدة السبعة في المئة على الدولار. الفائدة سبعة في المئة على الدولار في قطاع مصرفي يتعدّى حجمه 170 مليار دولار، أي أن الفائدة الممنوحة أعلى بعشرين مرّة مما هي عليه في السوق العالمي للدولار. ما سبب ذلك؟ تجربتي التي عرضت 24 ساعة منها توضح السبب. نسبة الفائدة هي انعكاس لفوضى الغابة اللبنانية، لقصر النظر، للفساد، لضعف المؤسسات وسياسات "الترقيع". ما هي تداعيات ذلك؟ يشتري المصرف المركزي الوقت لتسيير شؤون الجمهورية الجديدة ولتوفير السيولة لكنه يخفق في الخروج من دوّامة شراء الاستقرار والأمن. معدلات الفائدة التي يعطيها المصرف المركزي خطيرة تمجّد الكسل وتلغي حسّ المبادرة والتفكير في الاستثمار في قطاعات منتجة. لا يمكن لهذا الحال أن يستمر. ماذا لو واجه البلد أزمة "صغيرة" تضطره إلى رفع معدّل الفائدة؟ الفائدة العالية عليها أن تذكرّنا يومياً بأن اقتصادنا و موجوداتنا مهددين بالزوال، والسبب في ذلك سياسي أولاً و أخيراً.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.