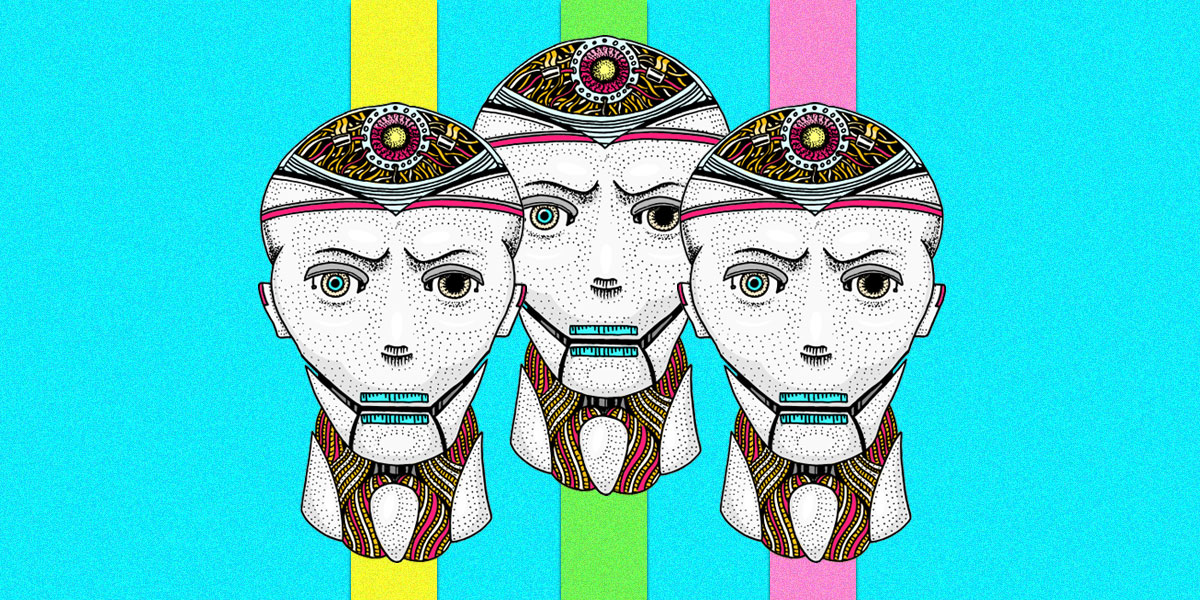تموت العائلة، هذا ما سنعترف به. سنخرج إلى الأسواق والملاهي ونتسلق الأدراج ونسافر مع روبوتات أو أشباه عائلة. سنضم عائلاتنا الافتراضية إلى أحوالنا الشخصية، ونقول: هاكم عائلتي الواسعة. خيال العائلات لا يقاوم. تلك التي نمقتها ونحبّها في آن واحد، وتمسي ظلالنا التي نتعثر بها، حتى لو قطعنا شرايينها جميعاً. العائلة إرث ثقيل علينا أن نجرجره خلفنا. ونكوّم خيباته في كل رحلات وحدتنا ولقاءاتنا مع آخرين.
ومنذ خروج الفرد عن سياق البطريركية الأبوية وهو يسعى إلى الالتحاق بفردانية تريد تأسيس عائلتها الخاصة. فالعائلات لا تموت، هكذا يقول منطق المؤسسة الدينية. يوصل الفرد العائلة بأخرى، تكون أربطتها الأقوى قائمة على الدم والقرابة. وهذا يعرفه علم الاجتماع، بأنه العائلة الممتدة. تلك التي نوسع فيها العائلة الأولى. نسختها التي فشلت في ربط الأفراد بعضهم ببعض، وجعلتهم يمقتون قراباتهم. أو أنها أقحمتهم في دوائرها رغماً عنهم. العائلة تتفنن في الإرغام والإذعان. هذه هي قواعد اللعبة. أن تكون فرداً في جماعة العائلة عليك أن تنضبط في حدودها. زيارات وواجبات وتقاليد وقيم وأعراف تجلها وتعتبرها مقدّسة، حتى لو كانت بالية وتافهة ومذلة وجارحة. كل هذا قد (وهذا احتمال الثائرين) ينتهكه الفرد لاحقاً، حين يطلق جناحيه بعيداً. وحين يخرج يجد أنه يصوغ عائلته، بضوابط أخرى. يختارها أو قد يذعن لبعضها وفقاً لمفهوم "ضرورات الاجتماع".
مع تطور العائلة، وانتهاء ما يسمى "العائلة الزراعية"، بما تقتضيه من لحمة وتكاثر وروابط شديدة القرب، صار الأبوان يتباهيان بتكوينهما أسرة مصغّرة، قد لا تعرف أجدادها ولا تربطها قرابات مباشرة. وتكتفي بعلاقات شبه سنوية مرتبطة بأعياد موسمية ودينية، كي تلتقي وتعترف بأنها من أصول واحدة ويربطها الدم. هذا لم ينتهِ في كثير من المجتمعات الريفية، غرباً وشرقاً. ففي الصين مثلاً، لا تزال هذه العائلة راسخة، رغم دخول "الموبايل" حياتها والسيارات الرباعية الدفع، إلّا أنها تجل كبيرها وقيمه ويتزوج بعضها بعضاً وترث نفس الصيرورة والسلوكيات. وتتباهى بالتصاقها المميت. وهذا موجود أيضاً في مجتمعاتنا العربية. ورغم تكيّف هذه الجزئيات مع التطور التكنولوجي والسياسي، واستثمار هذا المفهوم في قيّم الدول الحديثة، من خلال سياسات اجتماعية تشجع على الزواج، فإن كل هذا لن يمنع تهديد مستقبل العائلة كمفهوم وبنية في المستقبل. وهنا مخاوف الباحثين تكثر حول الفرد التكنولوجي، الذي قد يهجر العائلة التي ستموت مع الوقت بسببه. أي تكوّن مجتمع الأفراد التكنولوجيين، واتحادهم في وجه مفاهيم الزواج والتكاثر والاجتماع مع الآخرين حتى. ففي اليابان، يتأخر الزواج أو قد لا يحصل. دمى تقمن بدور الحبيبات. وإن العمل يأكل الوقت، فلا ضرورة لتأسيس عائلة.
العائلة إلى زوال، هذا ما يقوله الأنثروبولوجيون والباحثون في أحوال التربية والعائلة وعلم النفس الحديث. العائلة إلى موت لا رجعة منه. سنعترف يوماً بعائلة روبوتات تتجوّل بيننا. سينامون معنا في الفراش. سيذكروننا بساعات الأكل وسيطمئنون علينا برسائل إلكترونية عبر الهواتف الذكية أو الساعات المبرمجة وسينجبون روبوتات بشرية، بشر بهيئة روبوتات. سنراهم في المستقبل. هذا ما يتنبأ به العلماء. وما نراه هو بداياته في جلسات المقاهي، في المشي عبر الحدائق العامة، أو من خلال النظر إلى شلل العائلات الموزعة في المولات التجارية. كل ما تسير إليه العائلة، ذاهب الى هذا المصير: الزوال. حتى لو تمت "مسرحة" العائلة وادعاء أن كل شيء بخير.
خيال العائلات لا يقاوم. تلك التي نمقتها ونحبّها في آن واحد، وتمسي ظلالنا التي نتعثر بها، حتى لو قطعنا شرايينها جميعاً. العائلة إرث ثقيل علينا أن نجرجره خلفنا. ونكوّم خيباته في كل رحلات وحدتنا ولقاءاتنا مع آخرين.
وهنا مخاوف الباحثين تكثر حول الفرد التكنولوجي، الذي قد يهجر العائلة التي ستموت مع الوقت بسببه. أي تكوّن مجتمع الأفراد التكنولوجيين، واتحادهم في وجه مفاهيم الزواج والتكاثر والاجتماع مع الآخرين حتى.
سنعترف يوماً بعائلة روبوتات تتجوّل بيننا. سينامون معنا في الفراش. سيذكروننا بساعات الأكل وسيطمئنون علينا برسائل إلكترونية عبر الهواتف الذكية أو الساعات المبرمجة وسينجبون روبوتات بشرية، بشر بهيئة روبوتات.
أمامي في المقهى تأتي العائلات وتغادر. أراها أفواجاً من حيث جلوسي. مترهلة ومتعبة. ترخي أبدانها حول الطاولات. وترمي الأشياء المحمولة على الكنبات الصغيرة. تكوم الجاكيتات الملونة والبائسة التي تتشابه بأرواحها والأمصال المعلقة فيها. الحقائب الخفيفة التي تحشيها الأم بأغراض تظن أنها ستُستخدم في الخروج القليل: كريمات للجفاف، مشط صغير، فوط صحية، كوندومات للأب. منعاً للحمل الزائد. العائلة لا تحتاج إلى اطفال آخرين. يكفي ما جنت عليه الزيجات. هذا ما أقوله في رأسي وأنا أمطه كي أنظر إلى الأم التي تفتق فمها من كثرة الملاحظات الى أطفالها المتداخلين بعضهم ببعض، ومن خلال صراخهم لا تعرف أي اسم عليها أن تنادي فتختصر كلامها بـ"يا".
العائلات التي تأتي إلى المقهى تثبت أصابعها المتعرقة فوق الطاولات. آثار صغيرة تنام هناك لا تمحوها فوطة النادلة صاحبة الشعر القصير. تنظر إليهم بابتسامة خبيثة ولئيمة. تبتسم لأنها اعتادت. لها عائلة أيضاً. عائلة لا يمكن أن تراها يوم السبت. عائلة عادية مع أب أو من دونه. لا يهم. الأشكال تتغيّر، والعلاقات والزيجات والارتباطات لم تعد بوجه واحد. ولكل منا عائلته التي يريدها حوله. تكفيه أو تكفيه الوحدة. وستكون عائلته افتراضية. أزرار فايسبوك تتيح هذا. تختار على فايسبوك أمك وأباك وشقيقك. حتى لو لم تعرفهم. يكفي أنك تروقك حيواتهم عبر هذا الفضاء الأزرق وتشاء أن تكون واحداً منهم. أن تربطك بهم هذه الأزرار وهذا البعد حتى.
تثرثر العائلات. تسكت. تقرأ في الهواتف. تلتهم ما في الصحون. تتضاحك. تُدخل الأم طفلتها إلى الحمام. يبكي الطفل. يعبس المراهق. العائلات تتكوم في المقهى، فوق الكراسي الكثيرة. أراقبها. أتوقف عند سيدة وحيدة في آخر المقهى. تبتسم للجالسين. مثلي. نتشاطر الجلسة معهم. وكل منا يقول قلبه: "نحن مثال لنهايات العائلة".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.