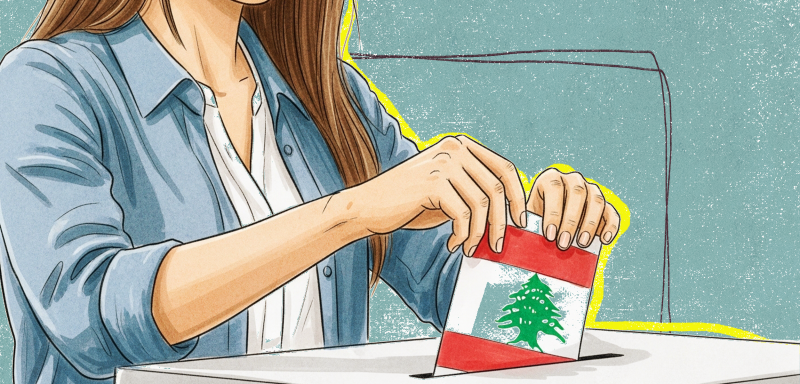منذ أن بدأت المرأة اللبنانية تنال حقَّ الترشّح والاقتراع عام 1952، كانت حاضرةً في المشهد السياسي برغم القيود البنيوية التي كبّلت مشاركتها. ففي عام 1953، خاضت علياء الصلح، ابنة رئيس الوزراء الراحل رياض الصلح، تجربةً رائدةً بترشّحها إلى الانتخابات النيابية، لتكون أول امرأة لبنانية تعلن حضورها في هذا المجال، ممهدةً الطريق أمام أجيالٍ من النساء الطامحات إلى التغيير. وبعدها بأعوام، وتحديداً عام 1957، تلتها نساء رائدات مثل لور تابت وماري دبس، اللواتي واجهن مجتمعاً لا يزال متردداً في قبول النساء في مواقع القرار.
شكّل فوز ميرنا بستاني في الانتخابات الفرعية، عام 1963، في دائرة الشوف محطةً مفصليةً، إذ أصبحت أول نائبة في البرلمان اللبناني، لتفتح الباب أمام مشاركة نسائية طال انتظارها. وبرغم أنّ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975 عطّلت الحياة السياسية وأوقفت المسار الديمقراطي، فإنّ النساء ظللن فاعلات في المجتمع المدني، وساهمن في إعادة بناء الحياة العامة بعد انتهاء الحرب عام 1990.
وقد ظلّ حضور المرأة يتأرجح بين التقدّم والجمود، منذ استئناف الانتخابات عام 1992 وصولاً إلى انتخابات 2022 النيابية، وانتخابات 2025 البلدية، متأثراً بالبنى الطائفية والحزبية الذكورية، لكنه لم يتراجع عن هدفه المركزي: الوصول إلى تمثيل عادل لا يقلّ عن 30% في مواقع القرار. ومع ذلك، ما زالت العقبات الثقافية والسياسية والمؤسساتية تحول دون تحقيق هذا الهدف بالكامل، برغم نضال الحركات النسوية المستمر منذ عقود. فهل تكفي الكوتا لتصحيح الخلل البنيوي في النظام السياسي اللبناني؟ أو أنها مجرّد مسكّنٍ مؤقتٍ يخفي عمق المشكلة في بنية الثقافة الذكورية، ونظام الزعامة العائلية والطائفية الذي لا يزال يتحكم في مسار المشاركة السياسية للنساء؟
صخرة الواقع الاجتماعي
في ربيع العام 2022، قرّرت الدكتورة سمر أدهم، خوض الانتخابات النيابية في دائرة البقاع الأولى، على لائحةٍ مستقلةٍ عن الأحزاب، لتكون المرأة الوحيدة بين مجموعة من الرجال. تقول: "لم أشعر بأي ضغوط سياسية في البداية. بالعكس، كان هناك ترحيب بوجودي كامرأة في الحوارات واللقاءات، وكأنّ حضوري يعطي ثقةً وراحةً، خصوصاً للنساء اللواتي التقيتهنّ".
لكن هذه الثقة التي لمسَتها في بعض المناطق، سرعان ما تكسّرت على صخرة الواقع الاجتماعي التقليدي: "كنت أسمع من بعض الأشخاص إنو المرأة ما فيها تقوم بدور الرجل ببعض المهام... برغم إنو في مناطق تانية شجّعتني ودعمتني كتير"، تضيف.
بين الدعم العائلي الذي حظيت به، وتشجيع زملائها في اللائحة، تقول سمر إنّ تجربتها الانتخابية كانت "رائعةً برغم الصعوبات"، وهي لا تستبعد إعادة خوضها في العام 2026، إذا توافرت الظروف المناسبة، لكنها تؤكد في الوقت نفسه: "أنا بشجع على الكوتا النسائية، بس بعتبرها خطوة أولى، مؤقتة، لحدّ ما المجتمع يتقبّل الدور الطبيعي للمرأة بالسياسة".
هل من الممكن للكوتا أن تؤدي دورها بمعزل عن إصلاح أوسع يشمل تطوير قوانين الانتخابات؟ وهل تتحقق فقط بنصٍّ قانوني، دون تغيير البنى الذهنية والاجتماعية التي ما زالت تنظر إلى النساء كـ"استثناء" في السياسة، وتربط أدوارهنّ بالفضاء الخاص لا العام؟
تكشف تجربة الدكتورة سمر أدهم، عن عمق المعضلة البنيوية في النظام اللبناني، حيث لا تقاس المشاركة السياسية بقدرات الأفراد بقدر ما تحددها الولاءات الحزبية والطائفية.
في هذا السياق، تصبح المرأة، مهما بلغت من كفاءة، رهينة منظومة سياسية تعيد إنتاج الإقصاء عبر خطاب الحداثة نفسه الذي تدّعيه، فتصير المساواة شعاراً، لا ممارسة.
عوائق بنيوية
أظهرت الانتخابات البلدية في أيار/ مايو 2025، بعض التقدّم في مشاركة النساء، حيث شكّلن نحو 12% من مجموع المرشحين للبلديات، مقارنةً بنحو 7% في عام 2016. أما نسبة النساء اللواتي انتخبن في المجالس البلدية، فقد وصلت إلى 10.37%، مقابل 5.4% في انتخابات 2016. وبرغم هذا التقدّم الواضح على الورق، لا تزال الفجوة بين الطموحات والواقع كبيرةً، ما يعكس استمرار الهيمنة الذكورية على المجال السياسي اللبناني.
تشرح مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان في لبنان، الدكتورة جمانة مرعي، لرصيف22، أنّ الحركة النسائية اللبنانية منذ مؤتمر بيجين الرابع عام 1995، وضعت وصول نسبة المشاركة النسائية في الحياة السياسية خلال عقد من الزمن، إلى 30%، هدفاً، مضيفةً: "بالرغم من المبادرات العديدة والقوانين المقترحة، لم نصل حتى اليوم إلى هذا الهدف." وبحسب مرعي، طرحت الحركة النسائية مقترحات عديدةً، منها الكوتا النسائية على قوائم الترشيح بنسبة لا تقلّ عن 30%، ودعت إليها الحملات المدنية للإصلاح الانتخابي. وقد قدّمت هيئات عدة، من ضمنها الهيئة الوطنية للمرأة، مبادرات قانونيةً شاملةً لتعزيز التمثيل النسائي، لكنها اصطدمت بعوائق بنيوية: غياب الإرادة السياسية، الطبيعة الطائفية للقانون الانتخابي، وتعاطي الأحزاب مع الكوتا كمسألة شكلية أكثر من كونها التزاماً حقيقياً.
وتشير مرعي، إلى أنه "حتى الأحزاب التي تعلن دعمها للكوتا على المستوى النظري، غالباً لا تطبقها داخل هياكلها التنظيمية أو في انتخاباتها الداخلية. في المقابل، لا تزال المعايير التقليدية لتقييم المرشحين/ ات تقدّم الرجال على النساء، بحجة أنّ الرجال يحققون أرقاماً أعلى في الانتخابات." وإذا كان هناك جانب آخر يعقّد المشهد، تتابع مرعي، فهو البيئة المجتمعية نفسها: "النساء غيّرن نظرتهنّ إلى قدراتهن وأدوارهن، لكن المجتمع لم يغيّر بعد ثقته بقيادتهنّ. لهذا، تمكين المرأة لا يقتصر على القانون أو الأحزاب، بل يشمل بناء بيئة سياسية ومجتمعية حاضنة قادرة على منح النساء فرصاً حقيقيةً للمشاركة واتخاذ القرار".
"عندما جزّأنا الحقوق السياسية للنساء بين الحياة الخاصة والعامة، فقدت قيمتها وقوتها وقدرة تأثيرها، ولهذا رأينا في العديد من اللوائح الانتخابية نساءً وُضعن كديكور انتخابي، لا كمشاركات حقيقيات في صنع القرار"
وعليه، يعكس تاريخ مشاركة النساء في لبنان مساراً من التقدّم المحدود وسط تحديات هيكلية وثقافية، فبرغم وجود الكفاءات النسائية، تبقى العقبة الكبرى ماثلةً لا في قدرة النساء على القيادة، بل في البيئة السياسية والمجتمعية التي لا تزال تقيّدها.
من البيت إلى البرلمان... التحديات كثيرة
في لبنان، لا يمكن الحديث عن مشاركة النساء في السياسة بمعزل عن البنية الاجتماعية والثقافية التي تعيد إنتاج التمييز من داخل الأسرة نفسها. فالمعادلة التي تبدأ من "البيت"، تنعكس على البرلمان والبلدية والمجتمع، لتشكّل حلقةً مغلقةً يصعب كسرها.
في هذا الاطار، تقول مرعي: "ما لازم يغيب عن بالنا إنو حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، لكن بلبنان في تجزئة واضحة بين حقوق المرأة السياسية في الحياة العامة، وحقوقها السياسية داخل الأسرة".
توضح مرعي أنّ قوانين الأحوال الشخصية، القائمة على المرجعيات الدينية، لا تزال تحرم النساء من المساواة الفعلية، إذ تمنح الرجل سلطة اتخاذ القرار وتمنح المرأة دوراً "رعائياً". تقول: "القوانين جعلت الرجل ربّ الأسرة، والمرأة ربة المنزل؛ هو يقرر، وهي تدير". بهذا المنطق، تُفصل المرأة عن مفهوم المواطنة المتكاملة، ويُختزل وجودها في أدوارٍ خاصة، تقيّد حضورها في الفضاء العام وتضع سقفاً غير معلن لطموحها السياسي. وترى مرعي أنّ هذا الفصل بين الفضاء الخاص والعام أفقد مشاركة النساء معناها الحقيقي: "عندما جزّأنا الحقوق السياسية للنساء بين الحياة الخاصة والعامة، فقدت قيمتها وقوتها وقدرة تأثيرها، ولهذا رأينا في العديد من اللوائح الانتخابية نساءً وُضعن كديكور انتخابي، لا كمشاركات حقيقيات في صنع القرار".
في انتخاباتٍ تُبنى على أساس طائفي في المستوى النيابي، وعائلي في المستوى البلدي، يصبح تمثيل النساء مشروطاً بولاءات ما قبل سياسية: "يا غيرة الدين إذا المرأة بدها تمثّل الطائفة، ويا غيرة العيلة إذا بدها تمثّل العائلة"، تقول مرعي، مضيفةً أنّ "العقلية الذكورية والإقطاع العائلي ما زالا يحكمان المشهد السياسي اللبناني، ويقفان كجدارٍ صلب أمام النساء الطامحات إلى مواقع القرار. في هذا السياق، لا تقاس التحديات بعدد المقاعد أو القوانين فحسب، بل بمدى تحرّر المرأة من هذه البنى التي تعيد إنتاج السيطرة بشكلٍ ناعم، من داخل المنزل إلى المنبر السياس، فالمرأة التي تُمنع من اتخاذ قرارٍ داخل أسرتها، كيف يمكن أن تقنع المجتمع بأنها قادرة على اتخاذ قرارٍ نيابي أو بلدي؟".
"شو عم تعملي بالسياسة؟"
تظهر تجربة لبنان الانتخابية أنّ التمثيل السياسي للنساء لا تحدّه الإرادة الفردية فحسب، بل منظومة كاملة من القوانين والهياكل والعقليات التي تقصي المرأة بشكلٍ غير مباشر، كما تشرح رئيسة منظمة "ففتي ففتي"، جويل أبو فرحات، إذ إنّ القانون الانتخابي نفسه يشكّل أحد أبرز العوائق أمام ترشّح النساء وفوزهنّ. فاعتماد الصوت التفضيلي يجعل المنافسة داخل اللائحة الواحدة شرسةً، ويصبّ في مصلحة المرشّحين الذين يحظون بدعم حزبي واسع أو شبكة مالية وإعلامية قوية، وهي امتيازات يندر أن تتوافر للنساء المستقلات. وتضيف أبو فرحات أنّ التفاوت في الموارد المالية يفاقم الفجوة الجندرية في المشهد الانتخابي، إذ تبقى الإمكانيات الاقتصادية والإعلامية محصورةً في يد الرجال، في ظلّ غياب سياسات عادلة للميراث والملكية والدخل، كما أنّ الظهور الإعلامي مشروط غالباً بالقدرة على الإنفاق، ما يجعل الوصول إلى الجمهور ميداناً غير متكافئ.
من جهة أخرى، لا تزال الذهنية الاجتماعية والثقافية تعيد إنتاج الأدوار التقليدية للنساء، حيث تواجَه المرشّحات في بعض المناطق بتساؤلات من نوع: "شو عم تعملي بالسياسة؟"، وكأنّ المجال العام حكرٌ على الرجال. وتلفت أبو فرحات، "إلى أنّ التجارب العربية القريبة تُظهر أنّ الإرادة السياسية قادرة على كسر هذه الحواجز عبر تبنّي قوانين كوتا فاعلة، كما حصل في السعودية والإمارات، حيث باتت نسبة تمثيل النساء في المجالس تتراوح بين 20 و50 في المئة، فيما لا يزال لبنان متأخّرًا من حيث تمثيل النساء في البرلمان".
قوانين الأحوال الشخصية تحرم النساء من المساواة الفعلية، وتفصل المرأة عن مفهوم المواطنة المتكاملة، والأحزاب لم تطبّق الكوتا التي تدعمها داخل هياكلها التنظيمية أو في انتخاباتها الداخلية... كيف؟ ولماذا؟
تعمل منظمة "ففتي ففتي"، منذ عام 2021، على الدفع باتجاه إقرار قانون الكوتا النسائية، بالتوازي مع جهود مناصرة داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومع خمسة من الأحزاب الكبرى التي أبدت دعمها المبدئي للفكرة. إلا أنّ الانقسام السياسي والملفات الانتخابية الأخرى، مثل اقتراع المغتربين والـ"ميغاسنتر"، تجعل قضية الكوتا في مرتبة ثانوية على جدول النقاش النيابي بحسب أبو فرحات. وبرغم ذلك، تستمر الحملة عبر إستراتيجيات متعددة، تشمل الضغط التشريعي والإعلامي، والتعبئة الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤكد أبو فرحات أنّ الهدف هو ضمان إدراج مشروع القانون على جدول جلسة عامة قبل انتخابات 2026، فمن دونه سيبقى الحديث عن المساواة مجرّد شعارٍ بلا ترجمة فعلية في صناديق الاقتراع.
الكوتا كمدخل أساسي...
بينما تتعدّد المقاربات، تتقاطع مواقف الناشطات النسويات عند حقيقة واحدة: لا يمكن لأي حديث عن ديمقراطية أو عدالة اجتماعية أن يُبنى على تغييب النساء عن القرار. ترى أبو فرحات، أنّ الكوتا ليست ترفاً سياسياً، بل "حاجة إلى إعادة التوازن"، فهي الأداة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في أكثر من مئة دولة لتصحيح الخلل البنيوي في المشاركة السياسية. فغياب النساء عن البرلمان، بالنسبة لأبو فرحات يعني غياب أصواتهنّ عن التشريعات، وعن رسم ميزانيات وإستراتيجيات تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء، كما حدث في لبنان حين استثنيت الفوط الصحية من قائمة السلع الأساسية خلال الأزمة، في مفارقة تعبّر عن عمق الإقصاء.
فيما تشرح مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان في لبنان، جمانة مرعي، أنّ الكوتا لا يمكن أن تؤدي دورها بمعزل عن إصلاح أوسع يشمل تطوير قوانين الانتخابات والأحزاب نفسها لتتبنّى تمثيلاً نسائياً لا يقلّ عن 33%، انسجاماً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فالمساواة، بحسب مرعي، لا تتحقق فقط بنصٍّ قانوني، بل بتغيير البنى الذهنية والاجتماعية التي ما زالت تنظر إلى النساء كـ"استثناء" في السياسة، وتربط أدوارهنّ بالفضاء الخاص لا العام.
في جوهرها، ليست الكوتا نهاية الطريق، إنّما بدايته، وهي مدخل لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنات، ولتحويل المشاركة السياسية من امتيازٍ إلى حقٍّ فعليّ. إذ إنّ الكوتا بذاتها تطرح سؤالاً أبعد من مجرد عدد المقاعد: أيّ لبنان نريد؟ لبنان تدار فيه السياسة من غرف مغلقة ومصالح ضيقة، أو لبنان يتيح لكل امرأة أن تكون شريكةً في القرار؟
بهذا المعنى، تعود القصة إلى بدايتها، حيث المفارقة اللبنانية بين خطاب الحرّيات وممارسة الإقصاء، وبين صورة بلدٍ منفتح وواقعٍ سياسيّ لا يزال يدار بعقلية ذكورية وطائفية، غير أنّ صوت النساء، اليوم، لم يعد على الهامش، بل في قلب المعركة نفسها.
*أُنتج هذا التقرير بالتعاون مع فريدريش إيبرت - مكتب لبنان FES.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.