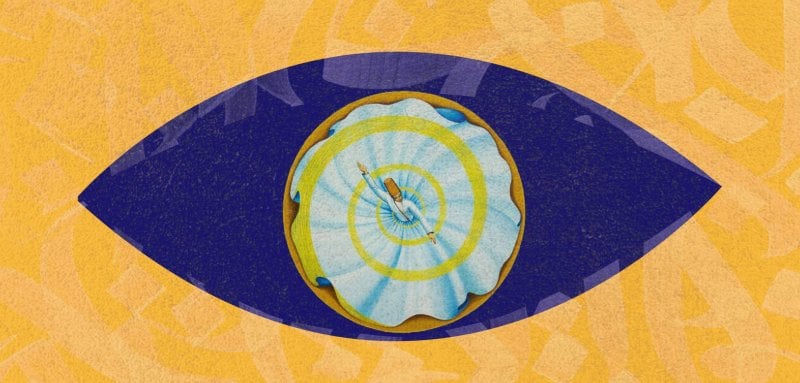في السادسة من عمري، حيث كنت أفهم أن الحياة ما هي سوى لهو ولعب وأشياء أخرى لا أكترث بالاطلاع عليها، لكن السنوات حين مضت، أجبرتني على اعتزال اللعب مبكراً قبل بلوغي سن التقاعد، ووضعتني في مصاف الحائرين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقضون حياتهم ما بين النورِ والظلام، الإيمان والكفر، الحقيقة والخيال.
نشأت في حيرتي هذه منذ كنتُ صبياً يعيش طفولته بأحد المناطق القاهرية المستوطنة بأفكار أهلها، المتعصبة للدين بغلظة، كانت تُرهبني من الله وترغمني على الذهاب إليه كرهاً، حيث كان من حولي يأتون بشرائط الكاسيت لأولئك المشايخ الذين يدلون بنصائحهم لمستمعيهِم بأصواتهم العالية الخشنة المخيفة، ربما نسوا عمداً الأخذ بقول لقمان لابنه: "واغضُض من صوتِكَ". كانوا كذلك يتحدثون عن النار وأهوال القيامة برعب شديد. كم كانت تفزعني هذه الأصوات حتى أنني كنت أخشى ارتكاب الخطأ خوفاً منهم وليس من الله.
لم يكن لي حينئذ محراب للتعرّف على الله دون خوف سوى مجلس الذكر الذي كان يعقده شقيق والدتي بالعقار الأسفل بين الحين والآخر، حيث كان يجتمع أصدقاؤه في منزله ليأكلوا ويتسامروا ويتناوبوا الأحاديث الهزلية عن الحياة، ومن ثم يلتفون في شكل حلقة ويبدؤون الذكر الذي لم أكن أفهم مغزاه أيضاً، ولا أتذكر من طقوسه سوى الخمسة جنيهات التي كنت أحصل عليهم مكافأة لحضوري المجلس كاملاً مع أبناء العائلة.
كان من حولي يأتون بشرائط الكاسيت لأولئك المشايخ الذين يدلون بنصائحهم لمستمعيهِم بأصواتهم العالية الخشنة المخيفة، ربما نسوا عمداً الأخذ بقول لقمان لابنه: "واغضُض من صوتِكَ"
مضت الأيام وصرتُ شاباً لا أستمع للشرائط المخيفة ولا أتردّد على مجلس الذكر الذي اختفى مريدوه شيئاً فشيئاً عن بيتنا، ولم أجده في مكان آخر، أو بالأحرى كنت أخشى الوقوع في فخ الكفر، حسبما كان يلقنني المتشددون ويحذرونني من الاقتراب من مساجدهم، لأنهم يؤدون طقوساً لم ترد في الدين وتُعد بمثابة خروج عنه، فزادت حيرتي وغمرتني الظلمة في عز النهار، وكأنني موسى يسأل: "ربِ أرني أنظر إليك"، فتأتيه الإجابة: "لن تراني"، فيفهم عقلي أنه لم يحن الوقت بعد.
2017، كان ذلك العام بمثابة تحسّسي الطريق إلى الله، فقد كنت أدرس الأدب التركي الذي يتضمن مؤلفات لروائيين وشعراء متصوفة، لم أكن أفهم ما هو التصوّف، ذلك الذي يرد ذكره في كل كتاب ومجلد، وتتحدث عنه الأستاذة بأسلوب سلس، ناعم وهادئ، لكنه يبدو وأن بينه وبين مجلس الذكر الذي كان يعقده شقيق والدتي طقوساً مشتركة، وذات نهار سئلت أستاذتي: ما هو التصوف؟ فأرشدتني لتصفح كتاب "الفكر الباطني في الأناضول" والذي وجدت في صفحته الأولى تعريفاً مبسطاً لحاجي بكتاش، شيخ الطريقة البكتاشية التي انتشرت في بلاد الأناضول والروملي على امتداد سبعة قرون، حيث يقول عن التصوف هو: "ألا تكسر قلوب الناس، ولا تنكسر لهم".
أربكني المفهوم فصرتُ أقرأ بنهم واهتمام عن المتصوفة وحكاياتهم وتعاليمهم وطريقة عبادتهم التي لجأوا إليها لشعورهم بالحاجة للسكينة الروحية والانفصال عن الواقع الأليم، ومن القراءة للاستماع لأشعار ابن عربي، ابن الفارض، جلال الدين الرومي، الحلاج... إلخ، وتزامن ذلك مع تعرفي على شباب متصوفة أتراك يعيشون بالقاهرة، وترددي إلى منزلهم، حيث كانت تلمس روحي أفكارهم البريئة، كالتي كان ينتهجها صديقي الذي يرقد في السماء الآن، أنس دوغان، حيث كان يؤدب نفسه لشهر وأكثر باعتزال الطعام وتناول حبات التمر فحسب، لأنه وقع في ذنب أغضب الرب، والتوبة النصوح كما اتخذوها من أسلافهم يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وعدم الإصرار بالحنان ومهاجرة سيء الخلان.
وكان دوماً ما يتردد بينهم معنى لم أكن ألمسه حينئذ وهو "الزهد"، فمن خلاله يحاولون التخلص من الطمع والسعي إلى الفيض العميق والذي يعني التطهر من الأنانية والغرور والكبر والتكلف، فالإنسان لم يخلق للمظاهر الخداعة، بل هو مصدر انبعاث الحب ويجب عليه أن يتعامل مع الآخرين بقلب رقيق.
والحب لديهم يعني رؤية الله في وجوه الناس والشعور بوجوده وعظمته، فعندما يتحد الإنسان بالله يتحقق له الجذب الصوفي والعرفان، ومن ثم يصل إلى الكمال الروحي والخلود ووحدة الوجود، والذي يقول فيها حاجي بكتاش: "هل تعتقد أنه من الصعب أن يكون الإنسان إنساناً؟ عليك أنت والحبيب ألا تعرفا الأنانية. لو أساء الناس إليك، احسن إليهم واهرب من الزينة، وسترى أنك أنت والناس سواء، وستسعى في الخير للناس، ولا تراهم أدنى منك وستفتح قلبك، وتمد يدك إلى غيرك بالعون، فلا تبتعدن عن الوحدة، ولا تركنن إلى السكون، ولا تهربن من واجب الضيافة، لأنها تجلب لك بركة الله في معاشك وحياتك، ولا تنس أن حبة عنب واحدة تعصر وتقدم لأربعين شخصاً، ويتوقف قلب الأربعين، فحياء القلب الواصل واضح في دم الصورة".
في هذا الوقت، بدأت أضع قدمي في طريق الوصول إلى الله، حتى وإن كان ذلك مجرد قراءات واستماع وحضور جلسات للفهم دون فعل، لكنني لم أتخلص بعد من الأفكار الراسخة بذهني منذ الصغر، فما زلت أتوجه كل جمعة لأحد المساجد، واستمع لأحد الخطباء الذين ينتقون من الدين ما يرغبون إيصاله فحسب بلهجات متعصبة وفظة، وذات جمعة وجدته يستشهد بأحد الأحاديث النبوية، لإثبات صحة الخطبة التي تقول إن على المرأة السمع والطاعة للرجل وأنها لا ترتقي لمناقشته، وأن السجود لو كان لغير الله في الأرض، لأمر الله المرأة بالسجود لزوجها، ومن هنا قررت ألا أعود لهذا الخطيب مرة أخرى.
من الجمعة لنظيرتها، 6 أيام حائراً باحثاً عن قُبلتي البديلة، والتي قرّرت بأن تكون في أحد مساجد الصوفية الذي يبعد عن منزلنا حوالي 10 دقائق. كنتُ متوجساً من خطواتي تلك لكن لا مانع من التجربة، وبالفعل ذهبت وجلست بين الصفوف أستمع للخطيب ذي الوجه الذي لم تفارقه الابتسامة وهو يتحدث عن كل شيء في الحياة، بنبرات هادئة دون ترهيب أو تخويف أو استناد لأحاديث ومقولات لا تمت للعقل البشري بصلة.
من أجمل الأشياء الدافئة أيضاً فنجان الشاي الذي يحتوي على ثلاث رشفات فحسب، ويقدم للحضور بعد نهاية الذكر، أحببته حتى شعرت بأنه ليس كأي شاي، لأن اليد التي أعدته خلطت ماءه بالذكر وليس بالسكر
انتهت الخطبة ولململت نفسي مسرعاً، حينما لمحت عيناي وسمعت أذناي أولئك الذين يرتدون قبعات بيضاء وجلابيب مهندمة لبدء الذكر. وخرجت وانطلقت نحو المنزل خوفاً من مشاركتها طقوسهم الكافرة -حسب اعتقادي- الناجم عن التحذيرات التي تلقيتها في الماضي الذى بدا لي أنه على وشك الاحتضار.
عُدت في الجمعة التالية، وقرّرت أن أجلس لمدة دقائق عقب الخطبة، وإن وجدت أي طقوس خارجة أغادر فوراً، وتركت نفسي وجلست في الدائرة وأخذت أقرأ معهم سورة يس ومن بعدها بعض الأذكار، وفي الختام الدعاء لمن حضر وغاب ومن ثم ينتهي كل شيء ويذهب كل منا لقضاء حوائجه اليومية.
في هذا النهار كنتُ أسير في طريق العودة للمنزل، أقل حيرة مما سبق، شعرت بأن خداع الماضي قد انتهى، وأنني الآن أختار في أي الطريقين أمضي، لم تكن لحظة ضعف أو تصحيح قناعة أو تكفير عن ذنب، بل كانت لحظة وصول حاولت خلالها مواصلة شحذ مشاعري وإحاطة شمعتها حتى تبقى متقدة.
وتوالى ترددي على الحضرة ما بين يومي الجمعة والأحد، وبدأت الأخذ عنهم الكثير من الرِفق واللين والسماحة، فهناك دون أن يخبرك أحد ستتعلم "الأدب" مع الله، فهم يعلقون لافته تحمل دعاء "يارب علمنا الأدب" والتي تشير لاستقبال البلايا دون ضجر أو تذمر، ومن أجمل الأشياء الدافئة أيضاً فنجان الشاي الذي يحتوي على ثلاث رشفات فحسب، ويقدم للحضور بعد نهاية الذكر، حيث أراني خلاله كالطفل الذي ينتظر هِدية نهاية العام مكافأة لما خاض واجتاز، أحببته حتى شعرت بأنه ليس كأي شاي، لأن اليد التي أعدته خلطت ماءه بالذكر وليس بالسكر، فقد علمني هذا الفنجان أن كل ما خُلط وامتزج بالذكر، اطمئن قلبه وفاح عبيره، وصار له مذاق لا تألفه الذاكرة الحسية في سواه.
الآن وقد وصلت، أنظر لأحد الأطفال الذي حضر مع والده، وأحاول رؤيتي في صغري بالحضرة المنزلية عبر ملامحه. أرى نفسي في هذا الطفل شريد الذهن، ذي الوجه الملائكي الذي لم تدنسه الأيام بعد، وهو يخفق قلبه ويتلعثم في الذكر منهمكاً ولا يلاحق الناضجين، فيأخذ هدنة بين الفينة والأخرى وكأن الفكرة تمضي في عقله. أصغي إلى عينيه، وتعابيره الهادئة وشعاع وجهه، ونبراته التي تتساقط من شفتيه بالهمس، حيث يبدو مشوشاً وهو يلتفت لانتباهي معه، فيلوي شفتيه بابتسامة ودية، فأقابله بمثلها وكأنني أخبره من تجربتي ألا يحتار ويحفظ النصيحة الصوفية المأثورة المعلقة على باب المسجد: "اسلك طريق الهدى ولا يضرك قلِّة السالكين، واترك طريق الردى ولا تغُرك كثرة الهالكين".
أما أنا فأعود لاستكمال لحظاتي في شكل مسترخِ أشبه بالنوم، وتنساب روحي وأنسى من أكون. يأخذني الذكر إلى الطبيعة النائية حيث أنهار الخلد، وأثناء ترديد العشيرة "لا إله إلا الله"، تغفل عيناي دون أن يصدر لها عقلي أمر، وأدخل في نوبة انعزال كلي عن الناس، ومن ثم يتهيأ لي فتاة ذات بشرة مخملية رائقة، على قدر كاف من الجمال، تكسو وجهها الأغصان وتزدهر منه الورود. لها عينان داكنتان وعلى وجنتيها ترتسم ابتسامة عذراء لم تنكشف على أحد قبلي، وأدخل في حالة من النشوة العميقة، حينما نتبادل الحديث بنظرات هائمة، واستشعر حينئذ انفطار السماء في تحليقي، وانتثار الكواكب في وصولي، وانفجار البحار في غرقي، وبعثرت القبور في موتي، أشكو لها مآثم الدنيا في أفكاري، ووسوسة إبليس لانحرافي عن المنهج، ونزاعاتي الداخلية المهلكة.
تقطب حاجبيها دون أن يرمش لها جفن، وترمقني بنظرات تمزج الحدة بالعطف، وتتسلل إلى أذني من زمرة الحاضرين "وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى". تنتفض أوصال النفس الأمارة بالسوء من بين جنبات روحي، فأتمايل برأسي مبدياً الاستجابة والخشوع، وما إن وصل مولانا لنهاية الذكر، أطلت على روحي فانتعشت، وكأنها تمنحني نذراً من الحب، وتلوح بيديها مودعة، ولا تتغير ابتسامتها ولا تشوبها نزاعة الفراق، كما هي حانية تظل ريشة لاتفارقها الألوان، وكأنها تخبرني بأنني ما دمت هُنا... ستدوم هنا.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.