لعلّ السؤال الذي ظلّ مطروحاً طوال صفحات كتاب "الحلم البوليفاري" للشاعر والرحالة العراقي باسم فرات، هو: "إلى أيّ مدى يمكن أن يتشابه البشر ويلتقون ويتّفقون في الحياة والعادات والتقاليد والمشارب والقناعات الداخلية العميقة؟".
على مدار صفحات هذا الكتاب الذي يجوب في رحلة شيقة في الأكوادور مع إشارات وحديث ومقتطفات عن البيرو وكولومبيا، يظلّ الكاتب مشغولاً بالذاكرة، بالحنين، وبالتأمّل المرتحل للبعيد، حيث تستدعي لديه كنيسة "القينتشه" التي يرتادها المؤمنون لقضاء حوائجهم، ذكرى كربلاء وكيف يتضرّع السائلون بحركات مشابهة عبر رفع اليدين باتجاه السماء، والهمس بالدعاء؛ مثل هذه اللقطات تظلّ حاضرة لتخلق مشهداً في بلد بعيد، يقع في قلب أميركا الجنوبية، ببلد آخر هو وطن الكاتب الذي يثير لديه الشجن، يقول: "وجدتُ نفسي هنا أعود في كتاباتي عن الأمكنة الجديدة للمكان الأول بشكل كبير، الكتابة عن المكان تُغري بالمقارنة بين مكانين أو أكثر، وهو ما دأبتُ عليه في كتاباتي.".
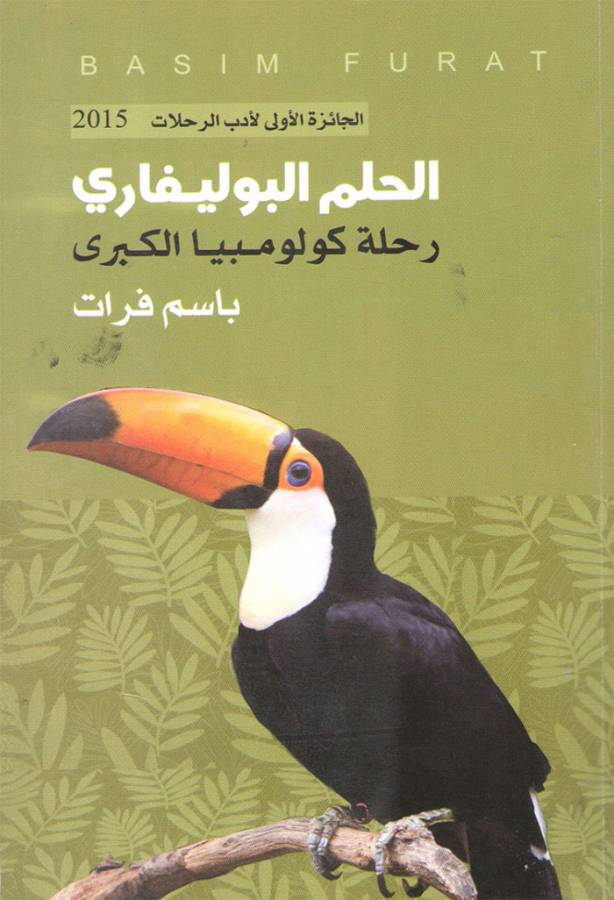
تستند تلك المقارنات في كتابة باسم فرات إلى تبيان التنوّع الذي تحفل به تجربة السّفر بكلّ ما فيها من تدفقٍ خصب، خاصة وأن الكتابة غير معنية بإصدار حكم ما لصالح الأفضل. الكتابة لا تنشغل بالتفضيل بل تقدم رؤية كاشفة، مع ترك مساحة للقارئ ليشارك في التقييم.
تأتي كلمة " الحلم البوليفاري" من رغبة الزعيم اللاتيني سيمون بوليفار بتوحيد دول أميركا اللاتينية، وهنا يذكر المؤلف حادثة مهمة كان شاهداً عليها يقول: "أتذكر خطاب الرئيس الأكوادوري روفائييل كوريه بعد فوزه بالانتخابات للمرة الثانية، كانت الجملة التي ختم بها خطابه أمام الجماهير المحتشدة: تعيش وحدة أميركا اللاتينية، ورددت الجماهير (تعيش تعيش)، وكأن المشهد في بغداد القوميين العرب، أو قاهرة جمال عبد الناصر".
الجهل البيئي في البوليفار يستدعي أيضاً عند الكاتب علاقة المجتمعات العربية بفكرة المساحات الخضراء، وعدم اكتراث الحكومات بأهمية وجود مساحات خضراء في كلّ مساحة تضمّ تجمعات سكنية
تبدأ رحلة الكاتب في "الحلم البوليفاري" من غابات الأمازون، رئة العالم، حيث كان ارتحاله في هذه الغابات من أكثر لحظات حياته رعباً، لأن كلّ الاحتمالات مفتوحة على المجهول، بدءاً من توقع التيه وفقدان طريق العودة، مروراً بخطر لدغات الحشرات والأفاعي، أو ظهور حيوانات مفترسة. ينساب الوصف السلس والدقيق للمكان، للأشجار العملاقة التي تدافع عن نفسها عند الاقتراب منها بأن تبثّ سمّاً تتفاوت درجاته، كذلك الأغصان المتشابكة التي تقطع الطريق على البشر. يعتمد باسم فرات في كتابته عن الغابة على استنفار حواسه الباطنية لتستوعب هذا الكمّ من الجمال الباذخ.
الطبيعة الزاخرة في عنفوانها الأول والفتي تحضر في "محمية ياسوني" حيث الشمس تنحجب عن البشر خلف الأشجار العالية الكثيفة. هناك بالقرب من نهر ياسوني أحد تفرعات نهر الأمازون تظهر دورية عسكرية تجبر الكاتب ودليله على الذهاب إلى نقطة تفتيش، هذا المشهد يعلق عليه المؤلف قائلاً: "هكذا أمور منتشرة في أميركا اللاتينية ومناطق متعددة من الشّرق الأوسط، ثمة عدم ثقة بين الشعب والحكومة".

لكن سِحر محمية ياسوني الذي يتجاوز الوصف، يجعل الكاتب يحسّ أنه في ملكوت الدهشة؛ فكلّ جزء وكلّ زاوية في المكان هي لوحة تفننت الطبيعة في رسمها. لا يتوقّف سرد الرحلة في "الحلم البوليفاري" عند العلاقة مع الطبيعة فقط، بل يغوص في كشف حقائق تتعلق بغابات الأمازون هذه المنطقة التي تخصّ مستقبل البشرية كلها؛ منها أن تربتها غير خصبة على عكس ما قد يظنه البعض، بل إن قطع أي شجرة فيها سوف يلزم لنموّ أخرى مكانها سنوات مديدة، إلى جانب ظهور أخطبوط الشركات النفطية التي تسعى للتنقيب عن النفط، في المقابل لم تقف حكومات العالم المتقدم والثري مع شعوب هذه المنطقة لتمنع التنقيب عن النفط، وتضع برامج توعية بالبيئة ومشاريع مساعدة لتطوير حياة السكان الأصليين فيها.
إن هذا الجهل البيئي في البوليفار يستدعي أيضاً عند الكاتب علاقة المجتمعات العربية بفكرة المساحات الخضراء، وعدم اكتراث الحكومات بأهمية وجود مساحات خضراء في كل مساحة تضمّ تجمعات سكنية.
الأماكن التي يرتادها الكاتب في رحلته متنوعة وحافلة بوجوه متعددة للحياة الطبيعية والمدنية، يقتفي في لقائه مع الأميرة كويلاغو ظلال أهرامات "كوتشاسقي" المبنية من 1500 سنة، والمصنوعة من الطين والرماد وفضلات حيوانات اللاما، ونباتات جافة؛ بعض الأهرامات تحوي سلالم أو مدرجة وأخرى لا تحوي، وأحدها على شكل عقرب، ومن استخداماتها الصلاة، وقد وجدوا فيها 556 جمجمة، أما طريقة الدفن فيها تقوم على وضع الجثة بطريقة القرفصاء. لكن هذه الأهرامات يجدها لا تُقارن بعظمة أهرامات مصر.

ويحكي المؤلف كيف سكن في العاصمة كيتو، في شقة تمنحه النظر إلى جبال "غواغوا بيتشينتا"، والتي غامر بتسلّقها يوماً وقضى ليلة هناك كادت أن تودّي بحياته. ويقدّم مقارنة أخرى بين الأكوادور والحياة في العراق، إذ يكتشف أن ثمار شجرة البنّ الأكوادوري تُعتبر الأجود في أميركا الللاتينية، لكنّهم لا يجيدون صنعه ليتمّ تصديره إلى كولومبيا حيث يعاودون استيراده من جديد. يقول : "تذكرتُ الكثير من منتجاتنا في العراق والمنطقة، حيث يتمّ تصديرها لتعود لنا مصنعة فندفع للشركات الأجنبية أضعاف ما جنيناه منهم".
يقدّم الكاتبُ مقارنة بين الأكوادور والحياة في العراق، إذ يكتشف أن ثمار شجرة البنّ الأكوادوري تُعتبر الأجود في أميركا الللاتينية، لكنّهم لا يجيدون صنعه ليتمّ تصديره إلى كولومبيا حيث يعاودون استيراده من جديد
يكشف أيضاً عن تفصيلات دقيقة للأماكن الثقافية التي زارها في رحلته اللاتينية، مثل "متحف الكاتب ريكاردو بالما" ، وأهرامات ليما، ومتحف "أمانو" وهذا المتحف جعله يكتشف تماثيل لأعراق شتى تدل على علاقات تجارية لسكان المنطقة منذ القدم مع العالم. كما يتحدّث عن زيارته متحف خوان مونتالفو، كاتب الأكوادور الأول، الذي يُعدّ سرفانتس أميركا اللاتنية رغم قلّة كتبه. يقول: "المتحف يُعدّ من معالم المدينة، وأحد مراكزها السياحية والتجارية أيضا".
ليل بوغوتا عاصمة بلاد ماركيز
بعد وصوله إلى مدينة "بوغوتا" ليلاً، يتسلّل الكاتب بحثاً عن مطعم كي يتناول فيه عشاءه، وفي اللّيل يشاهد الوجه المعروف عن العاصمة الكولومبية: سكارى ومدمنون ينتشرون في الشوارع والطرقات، جعلته يرجو في قلبه سرّاً: أن يتمكّن من تناول طعام العشاء.
لا يخفى على أحد أن كولومبيا تعتبر بلداً وقع ضحية الحروب الداخلية والمخدرات، وتناحر المافيات. لكن في ذات الوقت هناك وجه آخر لهذا البلد الذي أنجب عملاق السرد غابرييل غارسيا ماركيز. يزور المؤلف المكتبة الوطنية التي لم تخلُ من الكتب العربية، ثم "متحف النقود"، وتستدعي ذاكرته النقود العربية التي سُكت في القرن الثالث قبل الميلاد، ويجدها أكثر رُقياً واحترافية من نقود سُكت في كولومبيا قبل ثلاثة قرون فقط.
ثمّ يزور متحف فرناندو بوترو الذي يمتاز فنّه برسم السمنة المفرطة في البشر والحيوانات والفاكهة، ثمّ ينتقل إلى متحف الملابس والأزياء ويحتوي قطعاً قديمة للغاية من الأقمشة وأزياء مناطق كولومبيا جميعها.
المقارنة مع الواقع العربي تمتدّ إلى وجوده في مدينة "بوغوتا" عاصمة كولومبيا حيث التوقف أمام صور ماركيز الكبيرة المنتشرة، والتي تكشف عن الاعتراف بالكفاءة والموهبة للمبدع الخلاق، في مقابل هذا يستدعي الكاتب صور بدر شاكر السيّاب، ومشهد جنازته الحزين والذي زاده المطر أسى.

يكتب باسم فرات، وهو الرحالة الجسور الشغوف بالمغامرة عن شعوب أميركا اللاتينية بمحبة كبيرة، ينغمس في طقوسهم، ويتسلّل إلى عاداتهم ليشاركهم السّهر والرقص في أعراسهم وحفلاتهم وطقوسهم الدينية حتى وإن كان يجهل لغتهم إلا أنه يتواصل معهم بلغة المحبة ورغبة المعرفة والاكتشاف العابرة للحدود. وهو في كتابته يصل حديثه عن المكان بالفنّ والشعر، بالتاريخ والأدب، ويرى في نفسه الغريب الذي صار واحداً منهم.
الجدير بالذكر أن باسم فرات حصل على جائزة الشيخ زايد في عام 2019، عن مجمل مؤلفاته في أدب الرحلات، وكان كتاب "الحلم البوليفاري" قد نال الجائزة الأولى لأدب الرحلات (الأديب والرحالة ناجي جواد الساعاتي) عام 2015.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


