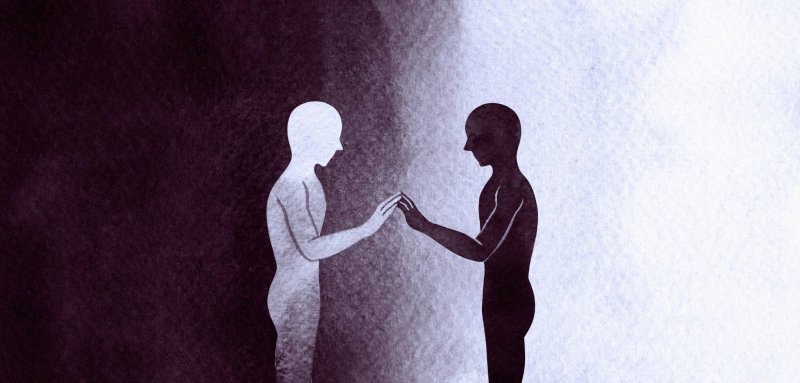اتجه العديد من فلاسفة التنوير الأسكتلنديين والمفكرين الصينيين، وعلى رأسهم كونفوشيوس، للدفاع عن ضرورة العاطفة فيما يتعلق بالمسائل الأخلاقية والإدراك غير الواعي لمفاهيم الخطأ والصواب.
وأرجع معظمهم الأحكام الأخلاقية لدى الإنسان لمنظومة غريزية غير مرتبطة بالضرورة بأسس التربية والمؤسسات الدينية والقانونية. وقد تطور هذا المفهوم عن الحكم الأخلاقي ليشمل التقمص العاطفي للحالات الشعورية للآخرين، من حزن وخوف ونفور، بحيث أصبح معياراً أخلاقياً لدى العديد من المنظرين في الموضوع.
ويبدو أن نظريات التقمص العاطفي قد غزت العديد من العلوم، مثل دراسة المجتمع والسلوك البدائي، فبحسب الباحث الهولندي في السلوك البدائي فرانز ديوال: "لم نعد نعيش في عصر يسوده المنطق بل التقمص العاطفي"، أو علم النفس والاجتماع كما عبر الباحث النفسي جوناثان هايدت: "نحن لسنا قضاة، بل محامون يختلقون المبررات بعد أن تتم الأفعال". وحتى في نظريتها عن التقمص العاطفي في السرد الروائي اعتبرت الكاتبة سوزان كين أن "زمننا محكوم بردات الفعل العاطفية على أفعال الآخرين" لدى سماع مآسيهم أو القراءة عنها.
وقد ظهر لهذه النظريات مناهضون يجادلون بعدم كفاءة العاطفة في إصدار الأحكام الأخلاقية الصائبة، مثل البروفيسور في علم النفسي الأمريكي ريتشارد ديفيدسون، والكاتب والفيلسوف الأمريكي سام هاريس، والفيلسوف الأسترالي بيتر سنغر. ولعل أبرز من قاوم الانقياد خلف التقمص العاطفي، الأمريكي بول بلوم، في كتابه "ضد التقمص العاطفي"، فاعتبر أن "ما يميز إنسانيتنا هو قدرتنا على إعمال التفكير العقلاني في المسائل الأخلاقية"، وبحسب قوله: "صحيح أننا نمتلك المشاعر، غير أننا نمتلك بشكل مساو القدرة على تجاهلها"، وبالنسبة له هذا لا يخولها أن تكون معياراً أخلاقياً.
كل هذه النظريات تضعنا في مواجهة تساؤلين رئيسيين، ما هي نظرية التقمص العاطفي؟ وكيف حاول المناهضون لها تقويضها وإثبات وجهة نظرهم؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذا المقال.
التعاطف كقيمة مغروسة في الطبيعة الإنسانية
هل أصابتك عدوى الضحك دون سبب واضح عند مشاهدة أحدهم ينفجر ضاحكاً؟ هل اغرورقت عيناك بالدموع لمشهد حزين من مسرحية أو مقطع من رواية تراجيدية؟ هل تأثرت بمأساة أحد المقربين لدرجة شعرت فيها أنك تعاني ألمه، وشعرت بالسعادة عندما ساعدته لتجاوز هذا الألم؟
التقمص العاطفي... هل أصابتك عدوى الضحك دون سبب واضح عند مشاهدة أحدهم ينفجر ضاحكاً؟ هل اغرورقت عيناك بالدموع لمشهد حزين من مسرحية؟ هل تأثرت بمأساة أحد المقربين لدرجة شعرت فيها أنك تعانين ألمه؟
إذا أجبت عن الأسئلة السابقة بـ"نعم"، فأنت حالة موصوفة لدى الفيلسوف الأسكتلندي آدام سميث، الذي أشار في أطروحته "عن الشعور الأخلاقي" (1759)،، أن الإنسان، وبغض النظر عن مدى اعتقادنا بأنانيته، يمتلك بطبيعته مبادئ تزرع فيه اهتماماً برعاية الآخرين، وتجعل سعادتهم ضرورية له، حتى لو لم يتحصل على شيء سوى متعة مشاهدته لنتائج مساهمته في مساعدة الآخرين. هذا ما أسماه الشعور بالشفقة أو التعاطف عند بؤس الآخرين، غير أن هذا التعاطف، بالنسبة له، يتجاوز كونه إدراكاً واعياً لأحزان الآخرين لينتقل إلينا في كثير من الأحيان، وهذا برأيه لا يقتصر على الأشخاص الإنسانيين ذوي الطبيعة الخيرة، على الرغم من أنهم قد يشعرون به بشكل أكبر من غيرهم.
وبحسب سميث، إن "مجرد مظاهر الحزن أو الفرح تلهمنا لمستوى مماثل من التعاطف مع الخير أو السوء الذي أصاب شخصاً يهمنا، فيترك أثره علينا". ولكنه لا يعتقد أننا نتعاطف بنفس القدر مع مشاعر الغضب، وكأن الطبيعة تعلمنا أن نأخذ موقفاً مضاداً لمشاعر الغضب أو الاستفزاز حتى نتبين سببه. وقد اعتبر نقاد هذا الطرح، ومنهم بول بلوم، أن هذا الإحجام عن التعاطف مع مشاعر الغضب هو بحد ذاته قدرة واعية على تنحية المشاعر وإعمال المنطق قبل الانقياد لتقمصها.
ولقد أشار سميث إلى أثر التعاطف على الشخص المصاب نفسه، فبدا أن تعاطف الآخرين يؤدي إلى تفريغ بعض من أعبائه، فهو يشارك أحزانه ولو عن طريق السرد الذي قد يجددها ويحيي ذكراها، لكنه يسعد بكل هذا ويشعر بالراحة بسبب شعوره بتوحد شعوري مع الآخرين يعوضه عن مرارة حزنه.
وقد تم تكريس هذا المفهوم عن التقمص العاطفي بعد الحرب العالمية الثانية في الاستشارات النفسية والاجتماعية لضحايا الحرب وخاصة من قبل النسويات العاملات في هذا المجال مثل غوردن هاميلتون وفلورنس هوليس اللتان أكدتا على العوامل التي تترافق مع التعاطف من قبول للآخر وتفهمه ودعمه وأهمية هذه العوامل في قراءة نفسية ومعالجة اجتماعية لوضعه
الإيثار هو محرك التعاطف
هل شعرت أن تلقيك لمعاناة أحد المقربين هو أقل ألماً من مشاهدتك له وهو يتألم؟ وماذا عن الغرباء؟
تقترح سال ميرز في مقالها "التقمص العاطفي ومفهوم الأخلاق" أن التعاطف ليس إلا فعلاً متخيلاً يسعى لفهم الآخر من منطلق ذاتي، ولذا فهو برأيها "يتضمن جهداً لإعادة إنتاج خبرات الآخرين بكل أبعادها الشعورية والمادية"، وهذا بالضرورة ليس محايداً من الناحية الأخلاقية، "فأنت تختبر إنسانية الآخر بنفسك" كما تشير ميرز.
وقد وضع عالم الاجتماع الأمريكي دانيل باتسون هذه النظرية قيد التجربة في فرضيته "عن التعاطف الناجم عن الإيثار"، أن التعاطف يثبط الأنانية ويحرك دافع الإيثار لتقديم المساعدة. لقد تم اختبار هذه الفرضية من خلال تجارب أجريت على طالبات جامعيات شاهدن زميلاتهن يتلقين الصدمات الكهربائية، ومن ثم يعطيهن فرصة مساعدتهن عن طريق تلقي ما تبقى من الصدمات بأنفسهن. في كل من التجربتين سهّل المراقب الهروب من المشهد أمام المتفرجات ثم صعّبه، إلا أنهن فضلن المساعدة بدل الهرب، ما يدعم فرضية أن التعاطف يحرك الدافع للمساعدة. غير أن نفس هذه التجربة أظهرت نتائج مختلفة عندما شاهدت الطالبات أخريات خارج دائرة صداقاتهن يتلقين الصدمات الكهربائية، ففضلن الخروج بدلاً من تقديم المساعدة.
وبكل حال فقد جادل نقاد هذه الفرضية أنه لا يوجد دليل جازم على صحتها، ففي حال كان الهدف من الحد من محنة الآخر هو تجنب الضيق الناجم عن امتناعك عن المساعدة، فهي ليست بدافع الإيثار، بل استجابة للأنانية التي دفعتك للتخفيف عن الآخرين لاجتناب ضغطك النفسي.
تخلصنا من الجشع، بدأنا عصر التقمص العاطفي
هكذا بدأ فرانز ديوال كتابه "عصر التقمص العاطفي" (2009) ، ليقول بأن العالم بدأ أخيراً يصحو من مبادئه الأنانية ويسعى لوحدة المجتمع العالمي، لتقمص آلام بعضنا البعض ومحاولة شفائها، وهذا بالنسبة له هو سبب وجودنا على الأرض. وقد اعتمد على دراسات بيولوجية لإثبات أن جذور الأخلاق الإنسانية واضحة في الحيوانات الاجتماعية مثل القرود. فيذكر أن شعور الحيوانات بالتعاطف وتوقعها لمعاملة مماثلة من قبل أقرانها تعد سلوكيات أساسية لحياة مجموعة الثدييات، وبالتالي يمكن أن نطبق الحالة نفسها على المنظومة الأخلاقية التي تحكم المجتمعات البشرية.
وهذا يوافق وجهة النظر التي يطرحها مارك هوزر، الباحث في علم الأحياء التطوري، في كتابه "العقول الأخلاقية" (2006)، وبرأيه أننا نظهر استعداداً غريزياً لاكتساب الحس الأخلاقي، لكنه يختلف تبعاً للقدرات الفردية، تماماً كاختلاف الاستعداد لاكتساب اللغة. "نحن نمتلك غريزة أخلاقية"، يقول هوزر، "وقد خضعت للتحول عبر ملايين السنين من التاريخ التطوري"، وبرأيه فإن العقل الواعي عاجز عن الوصول إلى الأحكام الأخلاقية الفورية التي تولدها هذه الغريزة، وهذا يظهر في القرارات السريعة التي يجب اتخاذها في مواقف الحياة أو الموت.
ألا يوجد معيار أخلاقي خارج مضمار العاطفة؟
في كتابه "أطفال فقط" (2013)، يجادل بول بلوم أن أصول المفاهيم الأخلاقية قد تتكون دون تمحيص واع، مثل حس الصواب والخطأ الموجود عند الأطفال، حتى في ظل غياب الإدراك الواعي للمسائل الأخلاقية، ويعتقد بناء على ذلك بوجود دليل على تطور الأسس الأخلاقية عبر عملية الانتقاء الطبيعي ومن غير تفكير ودراسة.
ولكنه يعود ليشير في كتابه "ضد التقمص العاطفي"، (2016) إلى قابليته للتعليم والتطوير بالمخيلة، فمنذ الطفولة المبكرة تردد الأنظمة التربوية عبارة "ضع نفسك مكان الآخرين"، وهذا جيد في حال استخدم لتحقيق الخير وتحسين حياة الآخرين، ولكن ماذا إذا انحصر في الأفق الضيق لمحيط محدود من المعارف والمقربين؟ ألا يوجد في هذه الحالة محرك آخر لفعل الخير غير التقمص العاطفي؟
يعتقد بلوم أن القيمة الحقيقية لطبيعتنا العاطفية قد أبخست، لأن قراراتنا الأخلاقية تشكلها بشكل أساسي قوة التقمص العاطفي، وهذا برأيه ما يجعل حال العالم أسوأ. فبالنسبة له تعريف سميث للتعاطف يحمل ضمناً تسليط الضوء على دائرة ضيقة في الزمان والمكان الذي نعيش فيه، ويعمينا هذا عن معاناة الآخرين، الغرباء الذين لا نتقمص مشاعرهم، وبالتالي يضع المعيار الأخلاقي ضمن الأطر الضيقة للعنصرية، ويهدد بنتائج سلبية على المدى الطويل. ويحدد بلوم النتائج السلبية له بتفضيل الفرد على الجماعة وتوليد العنف ضد الجماعات الغريبة التي لا ننتمي إليها عاطفياً، وهذا ما يشكل برأيه الدافع للحروب والأعمال الوحشية تجاه الآخرين.
التعاطف الاجتماعي لضبط العاطفة والقانون لضبط الأخلاق
يميز بلوم بين التعاطف الاجتماعي والتقمص العاطفي. فالتعاطف الاجتماعي يسمح بأن تفهم معاناة الآخرين وآلامهم دون اختبارها بنفسك، وبالتالي الشعور بالمسؤولية تجاه الجماعة دون توجيه العاطفة لضحية بعينها. فمثلاً، هؤلاء القلقون حول المشكلات التي تواجه مستقبل البيئة، من تلوث واحتباس حراري ونفاذ المصادر الطبيعية، يحاولون إيجاد حلول لهذا المشكلات دون ارتباطها بدافع عاطفي تجاه فرد محدد أو جماعة معروفة، ومع ذلك فهم يملكون معياراً أخلاقياً يحكم لخير الإنسانية جمعاء.
لكن بلوم يشير إلى أهمية فرض قانون مطلق على الناس بدل من خضوعه لظروفهم وأحكامهم الخاصة، لأن ما يهم في حياتنا العملية ليس التعاطف وإنما القدرة على ضبط النفس وإعمال الذكاء لتقديم المساعدة، فتشرّب آلام الآخرين يشل قدرتنا على التخفيف عنهم.
ويذكر بلوم قصة البروفيسور زيل كرافينسكي، الذي قدم ثروته للأعمال الخيرية وتبرع بكليته لشخص غريب، وسط اعتراضات العائلة والأصدقاء. وقد برر دافعه قائلاً: "تشير الأبحاث العالمية إلى أن فرص الموت خلال التبرع بالكلية تصل إلى 1/4000، وبامتناعي عن التبرع أكون قد فضلت حياتي 4000 مرة على حياة رجل آخر، وهذا أمر غير مبرر أخلاقياً".
ويستنتج بلوم أن الناس المدفوعين بالمنطق والتفكير العقلاني هم أكثر قدرة على المساعدة من هؤلاء المدفوعين بالعاطفة.
سقطات العاطفة وتبعيتها للأهواء الفردية
يستند بلوم إلى دراسات علم النفس السلوكي التي أجريت على أفراد عرض عليهم مساعدة بعض المتشردين ومدمني المخدرات، فأثبتوا عدم تفهمهم الاجتماعي لهؤلاء الأفراد الذين ظهروا بصورة منفرة، بل حتى أنهم جردوهم من إنسانيتهم. وفي تجارب أخرى أجريت لمشجعي فريق كرة قدم يتعرضون لوخز الإبر، أظهر المشجعون لنفس الفريق ردة فعل متعاطفة مع ألمهم، بينما أظهرت سلوكاً أكثر عنفاً وشماتة عند المشجعين لفريق منافس.
كما يستعين الكتاب بنظريات لعلم النفس الإجرامي أثبتت أن المجرمين المضطربين نفسياً يعانون من فرط في التعاطف ونقص به على حد سواء. فهم في غاية اللطف عند غواية الضحية وفي غاية الوحشية عند اغتصابها. وهذا يعود إلى قدرتهم على التلاعب بالتقمص العاطفي لأهوائهم الفردية.
يخلص بلوم إلى أن المعاناة البحتة كنتيجة وحيدة للتقمص العاطفي تفقده جدواه الأخلاقية، فكما أثبتت تجارب باتسون، يصبح الهروب من مشاهدة معاناة الآخرين حلاً أسهل من تقديم المساعدة، وبالتالي نحن نؤذي العالم بطريقة لا أخلاقية عبر معيارنا الأخلاقي ذاته: "اقلب الصفحة، سد أذنيك، أشح بنظرك، فكر بشيء آخر أو خذ قيلولة".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.