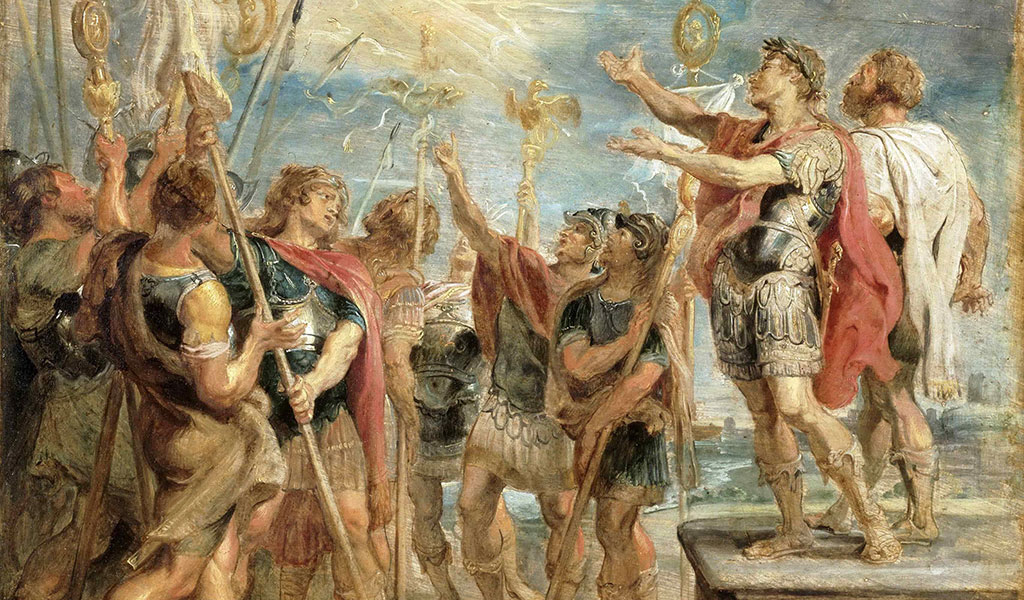في صيف عام 2012، جاءني صوت باسم يوسف عبر ذبذبات التليفون مفاجئاً. كنت أتابعه منذ نحو عامين حين كان يسجل فيديوهاته على يوتيوب من حجرة غسيل في شقته، ويتخذ فيها قالب الفكاهة النقدية للصور الإعلامية، خلال ثورة يناير.
فوجئت بأنه في زيارة لأمريكا، ويعمل على برنامج من ثلاثين حلقة، ستبثه قناة خليجية مُشفرة، يدور حول العرب في أمريكا، وتقريباً هناك مَن حدّثه عن كاتب يقود تاكسي، فأراد أن أكون في البرنامج.
اتفقنا على موعد لقاء في مطعم قريب من الفندق الذي ينزل فيه فريق عمل البرنامج، بالقرب من ميدان "تايمز سكوير". حين حاولت الخروج من محطة "السابواي"/ "المترو" لعبور شارع 42، لم أتمكن من ذلك. فعناصر من شرطة مدينة نيويورك يمنعون العبور، لأن موكب الرئيس باراك أوباما سيمر بعد قليل في الشارع، ليحضر هو وزوجته عرضاً فنياً في أحد مسارح برودواي.
اضطررت للعودة إلى تحت الأرض بحثاً عن مخرج يكون على الجهة الأخرى من الشارع، وما أن وصلت في موعدي إلى المطعم الإيطالي، وسلمت على باسم، وكانت أول مرة نلتقي.
كان يرتدي "فانلة" بيضاء وتاركاً لحيته نابتة، وخصلات الشعر البيضاء تغزو فروة رأسه. اعتذرت عن التأخير خمس دقائق بسبب إجراءات الأمن لأن الرئيس أوباما سيمر. ما أن قلت ذلك حتى انتفض هو وبعض ممَّن يعملون معه، يجرون باتجاه الشارع، لعلهم يشاهدون الرئيس وموكبه.
عادوا بعد عشر دقائق وكان الموكب قد مرّ بالفعل، لأن الشرطة لا تمنع الحركة سوى فقط خلال الدقائق التي يمرّ فيها الموكب. وبينما كان يتحدث باسم عن فكرة برنامجه، فإذ ببلال فضل يدخل من باب المطعم. هو الآخر كان يقضي بعض الوقت في أمريكا، وكان من عاداته، كما قال في ما بعد، أن يقضي شهراً كل عام في بلد ما.
بلال له حضور طاغٍ، يسحب هواء الكلام كله تقريباً من المكان، وكانت أول مرة أيضاً نلتقي، فما أن قيل له هذا فلان، وجدته يتحدث إليّ وعني كأنه يعرفني جد المعرفة، مشيراً إلى كتابي "مهاجر غير شرعي" وما كتبه عنه في "أخبار الأدب" الأستاذ جمال الغيطاني.
نظرة الزائر والنظرة الأعمق
حاول باسم أن يعود إلى حوارنا عن فكرة البرنامج الذي يصوره عن العرب في أمريكا. كنت أحاول أن أقول إن هناك فرقاً بين نظرة الضيف، نظرة الزائر، للثقافة وللمجتمع، وبين النظرة التي تذهب أعمق قليلاً من نظرة الزائر، وإنه إذا خدشنا السطح قليلاً سنجد عنصرية ما زالت ترعى، وتمييزاً، وتمركزاً حول الذات، في المجتمع الأمريكي، فبجانب بريق حداثة الشاشات الضخمة في ميدان "تايمز سكوير" وأضواء مسارح برودواي، هناك تحديات موروثة داخل الثقافات والمجتمعات الأمريكية، وإن هناك فارقاً أساسياً هو أنهم كمجتمعات يتعاملون مع نقاط نقصهم هذه ويحاولون مواجهاتها.
تقريباً، لم أستطع أن أكمل فكرتي، ليقاطعني بلال، ومن بعده باسم، دفاعاً ليس عن أمريكا تحديداً، بل عن الحداثة وعن التقدم وعن المدنية وعن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإنْ لم يستخدما هذه الكلمات، كمَن يقول إنك متجنٍّ وغير مُنصف. هذا الموقف أتوقف عنده الآن لأفكر فيه قليلاً.
فأنا مقيم منذ عقدين إقامة دائمة وهما زائران. ليست القضية هنا مقارنة بين مقيم وبين زائر، فقد تكون مقيماً وغير مهتم بدراسة الأمر والقضية، ورؤيتك تكون سطحية. لكن تقريباً أنا مهتم بالقضية وأعيشها حتى في حياتي الخاصة.
حاولت أن أقدم رؤية نقدية، وهما يدافعان، بل إن تفسير بلال الذي أتى في فقرة من فقرات البرنامج ذاته في ما بعد، هو أن "هناك مَن يأتون إلى المجتمع الأمريكي وحين يفشلون في تحقيق أهدافهم، يكون عندهم شبه غضب ضد المجتمع، يغطون به فشلهم، لكن المجتمع الأمريكي مجتمع مفتوح ومجتمع الفرص للجميع، بدليل انتخاب أوباما ذاته رغم أصوله الإفريقية من أبيه المهاجر المسلم".
الحاجة إلى رؤية نقدية
لو وسعنا النظرة إلى الأمر قليلاً في ثقافتنا العربية وفي جانبها السياسي تحديداً، سنجد أكثر من ذلك. سنجد أنه يتم التعامل في الغالب مع الإمبراطورية الأمريكية على أنها تملك "تسعة وتسعين في المئة من أوراق اللعبة" في منطقتنا وفي حياتنا، فيتم تفسير كل شيء وكل ظواهر الحياة وكل مشكلاتنا بأن وراءها أمريكا.
ويكون رد الفعل المعارض لهذا التوجه هو الحديث عن تعددية الغرب وكونه ليس كتلة واحدة، وعن إنجازاته الحضارية من علوم ومستحدثات تكنولوجية وفنون وحقوق إنسان وديمقراطية، إلخ، وأنه لا يجب أن نكتفي بتعليق أخطائنا على شماعات الآخرين.
نحتاج إلى رؤية نقدية واسعة وليس مجرد ردود أفعال وقتية تحرّكها الانفعالات المباشرة. ثقافة مجرد رد الفعل تنتهي بنا إلى أن نكتفي بالبحث عن حكم أخلاقي، بأن الفعل أو الظاهرة أو الشخص مجرد: خير/ جيد/ حسن، أو: شر/ سيئ/ قبيح، مجرد حكم أخلاقي قائم على وهم سابق نقرر فيه إذا كان هذا الطرف أو ذلك الفاعل هو عدو لنا أم حبيب، أو بعبارة أخرى، نسأل أولاً هل هو "منّا أم علينا"، "معنا أم ضدنا"، وبناءً على الإجابة على هذا السؤال نحكم بالصدف أو بالكذب على على ما يقوله.
بعبارة أخرى، يكون الحكم بالصدق أم بالكذب مرتبطاً بمدى ثقتنا بالشخص، وليس قائماً على حجة أو بيّنة ولا على دليل من داخل القول ذاته أو من تناسق الفكرة أو من منطق الظاهرة وحسب شروط عملها والقوانين التي تحكم حركتها.
لم أستطع أن أقول كل هذا حينها أو أشرحه وأصل بين ممارستنا الفكرية الحديثة وممارساتنا التراثية القديمة. حاول باسم أن نعود إلى الحديث عن برنامجه.
"تجربة ترامب وغيره من السياسيين الغربيين، وتجربة الحركات الشعبوية، ربما تكشف أن معارك الحرية والمساواة ومحاربة التمييز والتفرقة ومواجهة السلطوية والاستبداد، تحتاج إلى المحاربة من أجلها في الغرب وليس فقط في الشرق"
"ربما نحتاج كثقافة إلى أن نخرج من أسر ردود الأفعال التي فرضت علينا أن ننجر خلف أسئلة وقضايا وطرق تفكير عطّلتنا وشغلتنا عن أسئلة أهم، أسئلة أهملناها وانشغلنا بما تحدّانا به آخرون، فانخرطنا ندافع عن أنفسنا ونُفاخر ونبرر"
تمييز في أمريكا
تم تصوير البرنامج في ثلاثين حلقة، وعُرض على القناة المُشفرة، وأُتيح للجمهور العام في قنوات أخرى بعدها بعام، لكن الظريف أن ما يقرب من تسعين في المئة من قصص البرنامج كانت حكايات يقصها أمريكيون عرب وأمريكيون من أصول مسلمة في الشرق، عن تجارب لهم في حياتهم مع التمييز المباشر وغير المباشر، وجوانب من الاضطهاد بدرجة أو أخرى، وأيضاً حديث عن الحريات التي يتمتعون بها مقارنة بما هو متاح في البلاد التي هاجروا منها أو هاجر منها الآباء.
لكن ليس هذا مربط الفرس، ومصدر الظرف، بل المربط هو أنه بعد هذه الوقائع بعام واحد، وبعد أحداث عام 2013 في مصر وإزاحة حكم تنظيم الإخوان بالقوة المسلحة وبنوع من مساندة شعبية، وبداية التضييق على الحريات، وفي القلب منها حرية التعبير، بدعوى الاستقرار ومواجهة الإرهاب ومواجهة المؤامرات الخارجية، شهدت مصر حالة نزوح لفنانين وكتاب وإعلاميين ونشطاء، الظاهرة التي تصحب كل عهد للحكم في مصر منذ سيطرة الجيش على الحياة السياسية عام 1952، رغم أنها خفتت في العقدين الأخيرين من حكم مبارك، فكان رحيل باسم وبلال إلى أمريكا للإقامة شبه الدائمة بأسرتيهما وليس لمجرد إقامة ضيف أو زائر.
وجاءت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وتجلّى التيار الشعبوي داخل المجتمع الأمريكي، والذي يعلن غضبه من الأوضاع التي يمر بها المجتمع، التيار الذي استثمره الملياردير دونالد ترامب، في حملته الانتخابية التي ضرب فيها كل أساطير حساسية الخطاب السياسي في العقود السابقة عليه، فقامت حملة ترامب الانتخابية على فكرة أن مشاكل الرجل الأبيض الأمريكي الفقير الاقتصادية هي نتاج المهاجرين الزاحفين من الجنوب إلى الولايات المتحدة ويحملون معهم الجريمة، والمسلمين الذي يزرعون الإرهاب، والنساء اللواتي يأخذن كل يوم مساحة من أرض الرجال البيض الذين انبنت عليهم حضارة ومجد الغرب وحضارة ومجد أمريكا التي يجب أن تكون أولاً.
المعركة ضد الاستبداد
تجلى خطاب شعبوي ضد الآخر على السطح، ليقوم باسم ذاته بعمل برنامج كوميدي عبارة عن تغطية لحملة ترامب ضد المسلمين تقريباً، يلتقي فيه بمساندين لحملة ترامب خلال الحملة الانتخابية وتصوير تصوراتهم ومواقفهم من الآخر ومنه هو كفرد من أصول مسلمة وعربية.
ورغم أن باسم يحاول بكل طاقته ألا يكون منعزلاً عن الحياة الأمريكية ويريد أن ينخرط فيها فنياً، بتقديم عروض كوميدية باللغة الإنكليزية، والكتابة بالإنكليزية، فقد واجه الحقيقة الجلية وهي أن عالم الإعلام الأمريكي ليس ساحة مفتوحة للمنافسة والسباق بين منافسين ومتسابقين متساوين، بل هي بنية وهيكل تراتبي سلطوي، ترتيب حسب التجمع السكاني وحسب الأصول التي تنتمي إليها، وأن الأعداد القليلة التي تكسر هذه القاعدة هي أكبر دليل على وجود هذه البنية التراتبية أكثر مما هي دلائل على عكسها.
بل إن تجربة رئاسة ترامب وغيره من السياسيين الغربيين، وتجربة الحركات الشعبوية، ربما تكشف أن معارك الحرية والمساواة ومحاربة التمييز والتفرقة ومواجهة السلطوية والاستبداد، والدفاع عن حقوق وحريات الإنسان كإنسان وكمواطن، هي معارك تحتاج إلى المحاربة من أجلها هناك وهي كذلك تحتاج إلى نفس المواجهة والجهد والعمل هنا، وأن الفرق بين هنا وهناك، وهو فارق في الدرجة وليس فارقاً في النوع، رغم تغير أشكال التمييز وطرق كراهية الآخر، سواء باسم الهوية أو الدفاع عن أصالة أو عن دين، أو باسم التمييز ضد الآخرين تحت شعار "أمريكا أولاً"، أو "ألمانيا أولاً".
ربما نحتاج كثقافة إلى أن نخرج من أسر ردود الأفعال التي فرضت علينا أن ننجر خلف أسئلة وقضايا وطرق تفكير عطّلتنا وشغلتنا عن أسئلة أهم، أسئلة أهملناها وانشغلنا بما تحدّانا به آخرون، فانخرطنا ندافع عن أنفسنا ونُفاخر ونمجد تارة ونبرر تارة أخرى.
وربما صعود الحركات الشعبوية كشف أن معركة الحرية والمساواة ومحاربة التمييز والتفرقة ومواجهة السلطوية والاستبداد، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومواجهة عقلية التقليد تحتاج إلى المحاربة، هنا وهناك. والله أعلم.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.