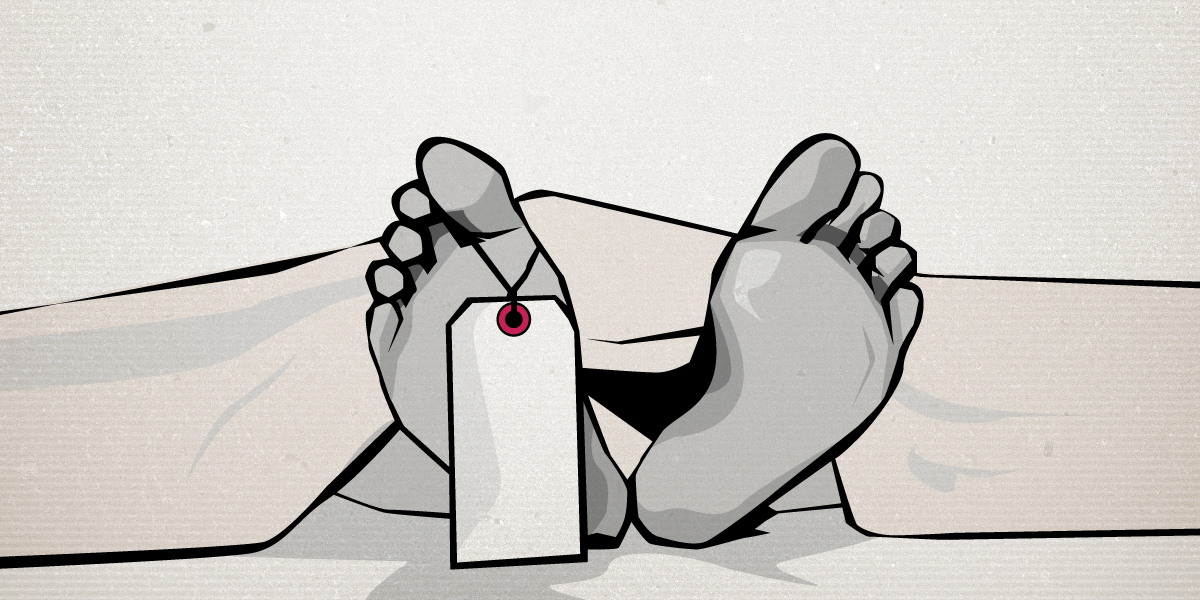كما كلّ الأطفال في العالم، أنا لي أيضاً صورة أظهر فيها عارياً. صورة مربّعة، بالأسود والأبيض، وعمري سنة واحدة. كان أبي قد التقط الصورة. الصورة معوجّة تماماً. كلّ الصور التي التقطها أبي تقريباً، ولا أعرف لماذا، معوجّة. مصاصة بلاستيكية كبيرة تتدلّى من عنقي بخيطٍ، ونظراً لعُريي، وكوني ذكراً، ظهرتْ منسجمة جدّاً في الصورة.
واقفٌ على الكرسيّ. بيدٍ أمسك أعلى الكرسيّ، والأخرى طليقة. ملتفتٌ أنظر إلى مكان ما خارج الصورة. من المحتمل أن أمّي كانت هناك تراقبني. الصورة كلّها معتمة إلا المكان الذي وقفت عليه.
يبدو أن أبي كان قد حدّد مكان الكرسيِّ بشكلٍ كي لا يقع على ابنِه سوى خطٍّ رفيعٍ من الضوء. أعشق هذه الصورةَ الآن، لكنّني لن أنسى أبداً أنني كم كنتُ غاضباً من وجودي فيها. أتذكّر جيّداً أنه كان لدينا صورٌ أخرى بزاوية مثل هذه، وبتغييرات طفيفة.
أظنّ أنني كنتُ في الصفّ الثالث أو الرابع الابتدائي حين استللتُ تلك الصورَ من الألبوم واحدة تلو الأخرى ومزّقتُها، ولحسنِ الحظّ فلتتْ هذه من يدي، ومازالت باقية. لقد مرّ ما يقارب ثلاثون عاماً على ذلك الوقتِ، لكنني مازلتُ أفكّر بين حينٍ وآخر بلحظةِ تمزيق تلك الصور، ببعثرتِها في الزقاق، وبالعبءِ الثقيل الذي رُفعَ من عاتقي بعد تمزيقِها؛ شعورٌ يشبه التخلّصَ من جريمةٍ كان ينبغي ألّا تحدث.
مشهدٌ جليل، وموتٌ جليل، وكأنّ عريَه مختفٍ. ربما كنتُ أشعر كذلك لأن المكان كان فارغاً. ربما لأنه كان بعمري، أو لأن كلينا كنا جندييْن. على أيّ حال، ولأيّ سبب، كان سعيداً. لا مرافق له. لا أحد يراه. ربما كانت المرّة الوحيدة التي لم أخجل من رؤية عُريِ أحدأتحدّث عنها الآن بسهولةٍ بالغة، بل حتى أشعر بالحزن لأني قمتُ بذلك. أشعر بالحزن لأنني فقدتُ اللحظات التي سبقتْ وتلتْ تلك الصورة. أبي ليس مصوّراً، غير أنه كان يعرف قيمة تلك اللحظاتِ جيّداً. كان يمكنني فهمُ كثيرٍ من الأشياء إن كنتُ أشاهد تلك الصور اليوم، لكنّني قد خسرتُ كلّ تلك الأشياء. ولماذا أتحدّث اليوم عن عُريي في طفولتي، ليس مهمّاً، وأكتبُ عنه بعدم اكتراث، ولكن، هل إنني أشعر بإحراج تجاه عُريي اليوم؟ ألم يغيّر هذا البُعد والمسافة الزمنية البعيدة شيئاً في ماهية القضية؟
المشكلُ في الحقيقة هو أن هذا الشعور مازال باقياً. أيّام الخدمة العسكرية، ربّما بعد مرور ستة أشهر على الحرب العراقية-الإيرانية، لا أتذكر لأيّ سبب كان عليّ أن أذهب إلى مغسلة الأموات في مدينة دِزفول (جنوب إيران).
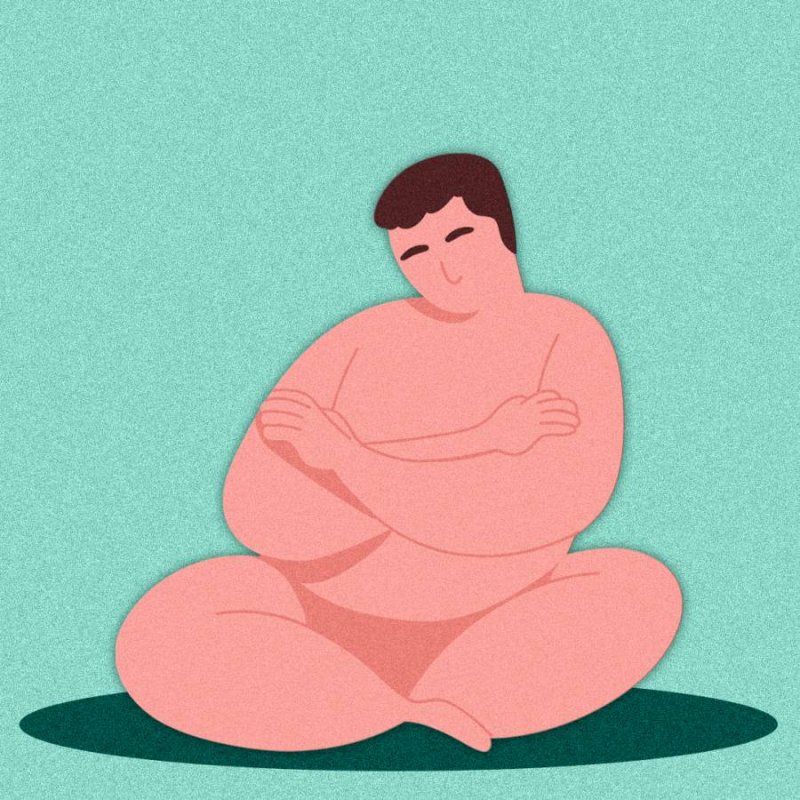
كان مكاناً فارغاً. ثمة صخرتان مقعّرتان قليلاً. كانوا قد وضعوا الصخرتين فوق منصّة عالية، يبلغ ارتفاعها طولَ شخص طويل القامة تقريباً. ربّما كان ذلك الارتفاع من أجل ألّا يرى عانةَ الجسد المرافقُ أو أيُّ شخص آخر سوى الغسّال. على كلٍّ من الحجريْن كان شخصٌ. أحدهما شابٌّ والآخر كبير في العمر، يبلغ حوالي سبعين عاماً، ومعه عدة مرافقين. كان الغسّال مشغولاً به. وحين انتهى منه، أخذوه هاتفين بالسّلام والصلوات. عندما ذهب جميعُهم، عرفتُ أن الشابّ لا مرافق له. أشعل الغسّالُ سيجارة، ووقف جنب الباب ليأخذَ قسطاً من الراحة. اقتربتُ قليلاً من جثمان الشابّ. كان عمرُه عشرين عاماً تقريباً. تحديداً بعمري عند ذلك الوقت. ثيابه كانت خلف الصخرة. من رتبته العسكرية على كتفه واضحٌ أنه كان جنديّاً أيضاً. قال الغسّال إنه فقد حياته إثر صراع صغير، لكنني لم أرَ أيّ أثرٍ للرصاص على جسدِه، أو لم أتذكّر على الأقلّ. طويل القامة، عاديٌّ، ونحيف بعض الشيء. إحدى يديه كانت انزلقت إلى خارج الصخرة، وقد سحب كتفه قليلاً إلى الأعلى.
إنني لا أخشى الموت. رغم ذلك دائماً ما تزعجني فكرةٌ: لسوء الحظّ لا حيلةَ أمامي بعد الموت ألّا أكون عارياً. أخشى تلك اللحظة التي يغسلونني فيها، وأنا موضوع هناك دون إرادة، ويشاهدني الكلّ بسهولة وارتياح
رأسُه على الصخرة مائل إلى تلك اليد بشكلٍ كنتُ أستطيع رؤيةَ وجهه. كان جسدُه مائلاً بشكل جميل. قسمٌ من جسدِه مختفٍ في انحناءة الصخرة، وثمّ مائل أيضاً نحو خارج الصخرة بطريقة كانت تتدلّى من الصخرة إحدى رجليْه من ناحية الركبة. تماماً كما لو أنه المسيح ابن مريم.
كنتُ أنظر أليه مندهشاً فقط. مشهدٌ جليل، وموتٌ جليل، وكأنّ عريَه مختفٍ. ربما كنتُ أشعر كذلك لأن المكان كان فارغاً. ربما لأنه كان بعمري، أو لأن كلينا كنا جندييْن. على أيّ حال، ولأيّ سبب، كان سعيداً. لا مرافق له. لا أحد يراه. ربما كانت المرّة الوحيدة التي لم أخجل من رؤية عُريِ أحد. أنا لا أخاف الموت، أبداً! ربما لأني كنت في الحرب؛ ربما لأني رأيتُ كثيراً من الجثث؛ قد مات كثيرٌ من أصدقائي بالقرب مني.
لا يهمّ السبب، المهمّ أنني لا أخشى الموت. رغم ذلك دائماً ما تزعجني فكرةٌ: لسوء الحظّ لا حيلةَ أمامي بعد الموت ألّا أكون عارياً. أخشى تلك اللحظة التي يغسلونني فيها، وأنا موضوع هناك دون إرادة، ويشاهدني الكلّ بسهولة وارتياح. لن أموت في شبابي، ولن يكون موتي مثل ذلك الشابّ. قد يمكن التخلّص من تلك الصورِ بسهولةٍ، ولكن، لا مفرّ من هذا أبداً!
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.