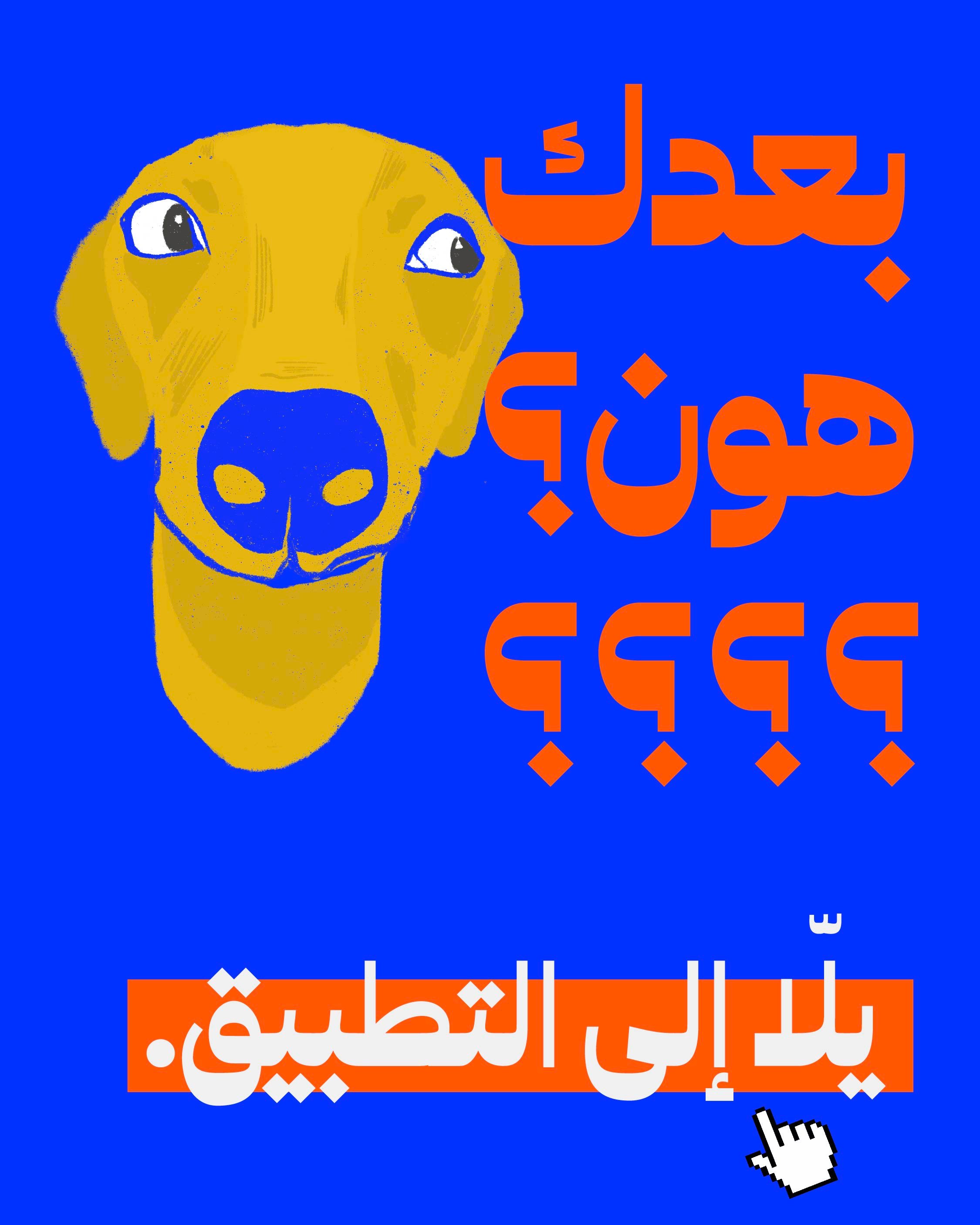في رواية "تفصيل ثانوي"، للكاتبة عدنية شبلي، نقرأ حكاية اغتصاب امرأة فلسطينية على يد جندي إسرائيلي إبّان نكبة عام 1948. ليست الحكاية مجرد توثيق لجريمة، بل استعادة لما طُمس، وإضاءة على ما أُقصيَ طويلاً من الذاكرة الجمعية الفلسطينية. لا اسم للضحية، ولا صوت، ولا سياق يروي ما قبل الجريمة أو ما بعدها. كأنها مجرد "تفصيل" صغير في مجزرة كبيرة، في تهجير شعب، في هدم وطن.
لكن، هل الألم الشخصي قابل للتصنيف؟ وهل يُمكن للذاكرة الجماعية، مهما اتسعت، أن تُنْصف تلك اللحظات المنفردة التي لا يراها أحد؟
هل الألم الشخصي قابل للتصنيف؟ وهل يُمكن للذاكرة الجماعية، مهما اتسعت، أن تُنْصف تلك اللحظات المنفردة التي لا يراها أحد؟
تفصيل ثانوي… حين يُختصر الجسد في الهامش
حين اختارت عدنية شبلي، أن تُعنون روايتها بـ"تفصيل ثانوي"، كانت تشير، بشكل صادم، إلى الطريقة التي تُهمَل بها النكبات الفردية في ظلّ الكوارث الكبرى. كأنّ ما جرى لامرأة فلسطينية عام 1949، من اغتصاب على يد جنود الاحتلال، ليس سوى هامش لا يستحق الذكر أمام مشهد النكبة الأشمل. لكن الجريمة التي بقيت مطموسةً، بلا اسم ولا صوت، تعرّي الطريقة التي تتحوّل بها المعاناة الشخصية إلى هامش في السرد الجمعي. وكأنّ الجسد الذي تمّ انتهاكه لا مكان له في الذاكرة، لأنه لم يُغيّر مجرى التاريخ، أو لأنه لا يَصلح رمزاً.
في المجاز السياسي، لا صوت للجسد. يُختصر الإنسان في صفات عامة: شهيد، لاجئ، مقاوم، ناجٍ. لكن ماذا عن المرأة التي نزفت وحدها في العراء؟ عن الصرخة التي لم تصل، والدم الذي لم يجد عيناً تبكيه؟ حين تتحوّل التجربة الفردية إلى عبء على الخطاب العام، يفقد الحكي صدقه، وتُبتَر الحكاية من لحمها الحيّ.
لقد تحوّلت النكبة، مع الزمن، إلى إطار جمعي ضخم، تحمله الشعارات والخطب والرموز، لكنّها في كثير من الأحيان لا تحمل التفاصيل الأكثر وجعاً: الخوف المعزول، الصمت القاسي، ولحظة الانكسار داخل جسد امرأة لا يعرف أحد من تكون. وحين يُكرَّس الوجع العام كبديل من الألم الخاص، نُصبح أمام صورة مُجردة: وطن مكسور، بلا ناس مكسورين. وحين يُحتفى بالمأساة الكبرى بوصفها أسطورة نضال، تُنسى الحكايات الصغيرة التي شكّلت هذه الأسطورة، وتُهمّش تفاصيلها الهشّة، كأن لا قيمة لها إلا إذا خدمت الرواية الأكبر.
في غزّة اليوم، كلّ شيء يحدث أمام الكاميرا، ولا يُرى. يُوثّق العالم أسماء الشهداء، يعدّ الجثث، ينقل صور الأطفال تحت الردم، ثم يمضي. لكن ما لا يُلتقط هو الذي يبقى: الصوت الخفيض لرضيع يبكي تحت الأنقاض، ولا يسمعه أحد.
نكبة مستمرة… غزّة كمرآة للجراح المُعادة
في غزّة اليوم، كلّ شيء يحدث أمام الكاميرا، ولا يُرى. يُوثّق العالم أسماء الشهداء، يعدّ الجثث، ينقل صور الأطفال تحت الردم، ثم يمضي. لكن ما لا يُلتقط هو الذي يبقى: الصوت الخفيض لرضيع يبكي تحت الأنقاض، ولا يسمعه أحد. يد صغيرة ممدودة من فجوة في الإسمنت، تنكمش ثم تسكن. تفاصيل كهذه لا تدخل التقارير، ولا تُستخدم في نشرات الأخبار. تُحذف، لأنها "صغيرة"، لأنها لا تغيّر شيئاً، لأنها لا تصرخ بما يكفي. وهكذا، يُعاد إنتاج "تفصيل ثانوي" كلّ يوم، بمشهد جديد، وجسد جديد، واسم لن يُذكَر مرتين.
في الرواية الوطنية، تُستبدل القصص الحقيقية بمجازات: غزّة الصامدة، غزّة العنيدة، غزّة التي لا تنكسر. لكن الحقيقة أنّ غزّة تنكسر كل ساعة، على جثّة طفل، على أمّ تنتحب، على بيت يُنسف بمن فيه. المجاز لا يسع كل هذا الألم. لا يسع صوت الأب الذي يحفر بيديه ليُخرج ابنه، ثم ينهار حين يلمس جلده بارداً. ولا يسع النظرة الأخيرة التي لم تُمنح، والوداع الذي لم يحدث. هذا كلّه يُهمَّش لأنّ الحكاية الأكبر تحتاج إلى بطولة لا إلى بكاء، إلى صمود لا إلى عجز، وإلى صورة مثالية لا إلى صورة بشر.
غزّة ليست شعاراً. ليست صخرةً تتلقّى الضربات وتبتسم. غزّة ناس: كلّ واحد منهم قصّة كاملة، بتفاصيلها، بانهياراتها، بصراخها في وجه السماء. حين نكرّر صور الضحايا من دون أن نعرفهم، من دون أن نسمع ما كانوا يحبّون أو يخافون، نكرّر الخطيئة نفسها التي حوّلت المرأة المغتصبة في صحراء النقب إلى "تفصيل ثانوي". الفرق هو أنّ الكاميرات صارت أكثر حدّةً، والقصف أكثر اتساعاً، والأنين أكثر عزلةً، فحسب.
لقد تحوّلت النكبة، مع الزمن، إلى إطار جمعي ضخم، تحمله الشعارات والخطب والرموز، لكنّها في كثير من الأحيان لا تحمل التفاصيل الأكثر وجعاً: الخوف المعزول، الصمت القاسي، ولحظة الانكسار داخل جسد امرأة لا يعرف أحد من تكون.
من يملك الذاكرة؟ ومن يُقصى منها؟
الذاكرة الجمعية الفلسطينية، مثل سائر الذاكرات الجمعية عند الشعوب التي ذاقت قهر الاحتلال، تنتقي رموزها بعناية: الطفل الذي يحمل المفتاح، الجدّة الجالسة على الحدود، الخيمة التي لم تُطوَ منذ 77 عاماً، والعلَم الذي لا يسقط. هذه الرموز، وإن بدت مألوفةً لكثرة ما تكرّرت، تبقى ضروريةً في تثبيت السردية الوطنية، لأنها تمنح الجماعة الوطنية نقاطاً ثابتةً في وجه الانهيار، وتعيد تشكيل الهوية وسط الفقدان.
لكن الخطورة تكمن حين تتحول هذه الرموز من وسيلة للتثبيت إلى أداة للإقصاء. فحين يُستبعد ما لا يخدم الرواية الكبرى؛ كالجنون الفردي، الألم النفسي، والتجارب التي تُحرج الخطاب العام كقصة اغتصاب أو انهيار أو رغبة في الفرار، يُدفع الألم الشخصي إلى الظلّ، ويُعامَل كأنه شوائب لا تليق بصورة الصمود. لا لأنّ هذه الحكايات غير مهمّة، بل لأنها "زائدة عن الحاجة" في النصّ البطولي، أو موجعة أكثر من أن تُروى، أو لأنها تطرح أسئلةً لا يريد أحد مواجهتها.
لكن الخطورة تكمن حين تتحول هذه الرموز من وسيلة للتثبيت إلى أداة للإقصاء. فحين يُستبعد ما لا يخدم الرواية الكبرى؛ كالجنون الفردي، الألم النفسي، والتجارب التي تُحرج الخطاب العام كقصة اغتصاب أو انهيار أو رغبة في الفرار، يُدفع الألم الشخصي إلى الظلّ، ويُعامَل كأنه شوائب لا تليق بصورة الصمود
لا هامش في الألم... إعادة الاعتبار للحكاية المنسية
في زمنٍ تُعاد فيه النكبة كل يوم، من المهم أن نقف أمام الحكايات الصغيرة، تلك التي لا تجد مكاناً في العناوين ولا تحفظها الشعارات. لأنّ النكبة، وإن كانت حدثاً سياسياً وجمعياً، فإنها لا تكتمل إلا بتفاصيلها: الجسد المرتجف، النداء الأخير، الجسد المبتور، والصمت الذي لا يسمعه أحد.
في قلب هذا كلّه، تنهض الـ"أنا" من قصيدةٍ لمحمود درويش، لا كضميرٍ فرديّ منعزل، بل كجذرٍ حيّ في أرض المعاناة: "وأنا أسيلُ دماً وذاكرةً أسيل". ليست "أنا" درويش، هنا، اعترافاً ذاتياً فحسب، بل هي صوت جسدٍ ينزف ويتذكّر، صوت إنسانٍ صار كلّه ذاكرة. هذه الـ"أنا" التي تسيل مع الدم، وتتشظّى مع الذاكرة، تُذكّرنا بأنّ كل نكبة هي أوّلاً مأساة فرد، وأن كلّ "أنا" تُدهس في الظلّ، هي مركز الحكاية، لا هامشها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.